لست من نسل الأمازونيّات، لكنّي محاربة | شهادة في الرواية

تحيّة طيّبة لأهل فلسطين وأرضها، لأنّني بهذه الزيارة أقطع خيط التخيّل الذي جعل فلسطين حلمًا في البال، لتكون منتصبة أمامي، لحمًا ودمًا وحجرًا وشجرًا.
آتيكم محمّلة بثقل يسمّونه إنجازًا، وأشعر به قيدًا يمنعني من أن أكون إنسانة أخرى جديدة. في مقام الشهادة على ما كتبت، أعدّد عناوين رواياتي الأربعة عشر، ومجموعاتي القصصيّة الثلاث، وكتابات في الرحلات أو فنّ الكتابة، ومقالات متفرّقة أكلتها أوراق الصحف. وقد تحني الجوائز هامتي، لكنّي أضيق بكلّ هذا بحثًا عن الكاتبة الجديدة فيّ.
أسباب أعمق للكتابة
كتبت في بداياتي بعفويّة، غير مدركة، تمامًا، أنّ كتاباتي تسترعي الانتباه بسبب انتمائي إلى جنس المرأة، لا بسبب انتباه دقيق ومسؤول لما يحتويه نصّي من فنّ أو فكر أو مقولات. وكان لانتباه الناس شأن في تنبيهي إلى ما يتوجّب عليّ من أنوثة في النصّ، وما يلزمني من انخراط في الدفاع عن قضيّة المرأة، حتّى صرت أتبنّى القول إنّني أكتب كي أفسح للصرخة الحبيسة في أعماقي، أو أمنح مساحة للهمسة المحظورة، أو كي أدسّ أناملي الصغيرة بين الأكفّ الخشنة التي طبعت العالم بختم الرجولة المطلقة، أتسلّل عبر الشقوق الصغيرة في بوّابة القوانين والتقاليد والمتعارف عليه، كما تداهم نسمة هواء حبيسًا ساكنًا، وكما ينسلّ خيط ضوء من فتحة خفيّة في حجرة مظلمة. تبنّيت تلك المقولات وما زلت، لكنّي، في أعماقي، أتوق إلى التحرّر منها، وإيجاد أسباب أعمق للكتابة، وقضايا أكثر تحرّرًا من الانحيازات الفئويّة. هكذا فقط يمكنني تحقيق ذاتي وذوات البشر الكثر الذين يشكّلون عجينة أعمالي الروائيّة.
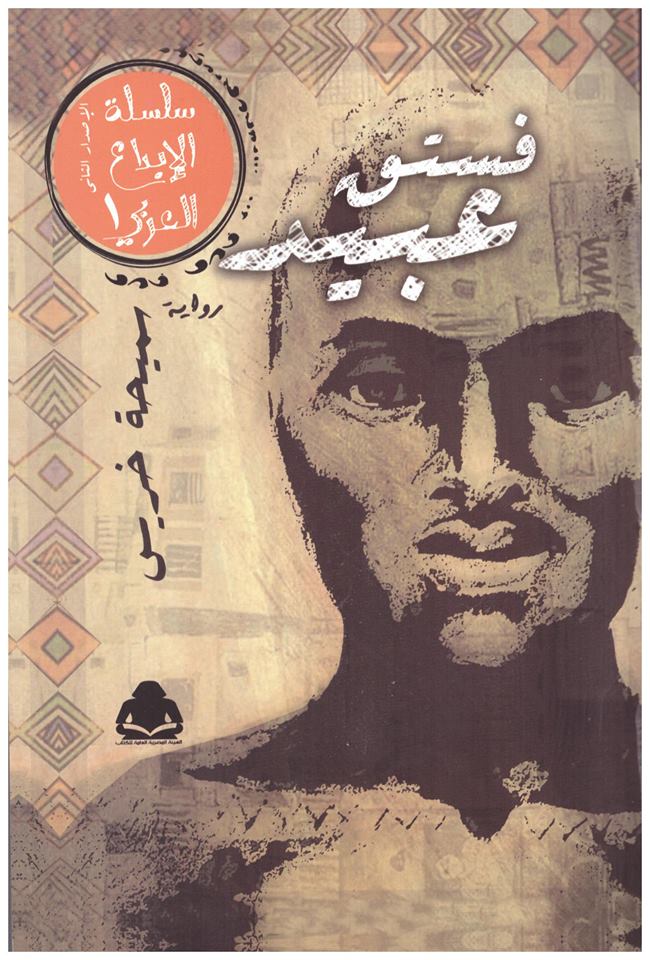
تحمل اللغة ما يفيض ويتشكّل في الروح والعقل، وإذا تراكمت التجربة أكداسًا من مشاعر ومعارف وأفكار، فإنّها ستركب سفين الرواية دون سواها، حيث المساحات لا حدود لها، والأفق متّسع المدى، لكنّ الرواية لا تأتيني وحدي في رسالة خاصّة، إنّها صوت أكثر عمقًا من أن يكون فنًّا فردانيًّا، إنّها تراكم خبرات جمعيّ، موجة هائلة تجرف معها جيلًا كاملًا، يحاول الذاهبون إليها الوقوف بصلابة لتأمّلها، كما يتأمّلون ما محته على الرمل من آثار، وما ستتركه من بلل. ورأيتني واقفة بينهم، جيش من الروائيّين، رجالًا ونساءً، نحاول فهم العالم والمشاركة في تشكيل معانيه القادمة.
الوقوف والنظر إلى الخلف
في كلّ مفترق تاريخيّ أو فكريّ أو اجتماعيّ، كلّما عصف في الكون خراب، أو اكتمل للعمران بناء، يكون لازمًا على الروائيّ الوقوف والنظر إلى الخلف، حيث لن يصير ملحًا، لكنّه سيعرف أين تقف قدماه، وسيقدّر الخطوة القادمة التي يشتهيها. الروائيّ من بين كلّ بنّائي الفنون السرديّة والشعريّة، المحكيّة والمكتوبة، عليه أن يقف هذه الوقفة الفاحصة، ويكتب.
واليوم، أتأمّل كلّ ما سلف، وأشعر بالعجز عن تفكيك كلّ تلك المعاني حول الكتابة، ربّما لذلك الغباش الذي يعتري الصورة الراهنة، ولأنّ النابل والحامل يختلطان، والثوابت تهتزّ كأنّ زلزالًا ضربها. لا يفارقني السؤال الذي قضّ مضاجع الكتّاب منذ فجر الكتابة: هل سنغيّر شيئًا حقًّا؟ ربّما لأنّ الموجة، هذه المرّة، عارمة وموجعة، ومدمّرة إلى حدّ لم أكن أتصوّره، فقد خدعنا زماننا بهدنة قصيرة، ظننّا فيه أنّ الحياة هي تلك الساكنة التي نحياها، وكانت تمور في أعماقها بلهب يخرج، اليوم، ليأكل الأخضر واليابس؛ لهب مجنون قد ينتج عالمًا مجنونًا بعدنا، إلّا إذا انصاع لأحلامنا المحلّقة، وجاد على الأجيال القادمة بعالم يستحقّونه، تسوده العدالة والحرّيّة وتستوفي الحقوق.
مع ذلك نكتب، من حصيلة الآبار الصافية التي تجري في أنفسنا مجرى الأنهار، على الرغم من فداحة السؤال الذي لا إجابة له، نكتب محكومين بالأمل، ومنصاعين لطبيعة البشريّة في النضال من أجل الاستمرار، نكتب شهودًا على عصرنا، شهودَ حقّ في زمن التدليس والتزوير.
ماذا تفعلين هنا؟
إلّا أنّ السؤال الذي يواجه الكتّاب يحفر عميقًا في وجدان الكاتبات: ماذا تفعلين هنا؟ إذا كان المشروع كلّه معلّق في أرجوحة الشكّ واللا جدوى، ماذا تفعلين هنا؟ تتسلّين باللعب مع الحروف أو مواجهة أضواء الكاميرات، واتّخاد وضعيّات جادّة على صفحات الجرائد؟ لماذا كانت الكتابة خيارك؟ ما من قانون يلزمك أن تصيري كاتبة، كما ثمّة وسائل أخرى متاحة لتحقيق الشهرة ومغازلة الأضواء. وكيف تفرّين من دوّامة الحياة التي علقت بها، بصفتك امرأة أنيطت بها أدوار معروفة راسخة لازمة، في هذا الراهن على وجه التحديد؟ الأمّ، والزوجة، ومهندسة الحياة الأسريّة، والحبيبة، وأكثر من ذلك؛ الحصى التي تسند الزير، اليد التي تهزّ السرير، وتسند العالم من أن يميد.
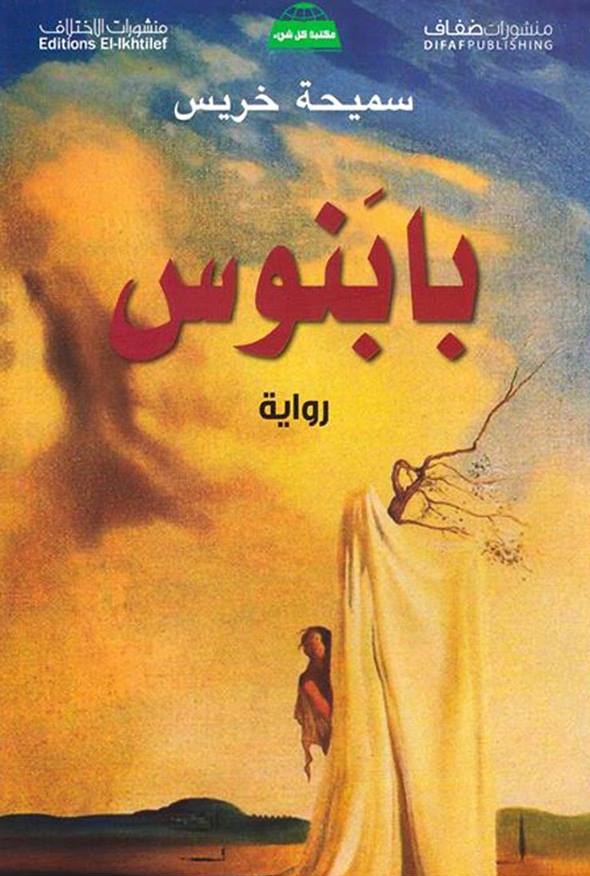
ثمّة سلسلة من المهامّ المجدية التي لا تستقيم الحياة من دونها، لكنّي أجد كوّة سرّيّة لأذهب إلى الكتابة وأشكّل العالم كما أراه، وكما يحلو لي، وكما أتمنّاه؛ أشذّبه مثل شجرة ورد، أرتّبه مثل سريري، وآلف فوضاه مثل حجرة الجلوس في بيت العائلة، أملي عليه أفكاري مثل ابنتي، وأعانده وأشاكسه مثل زوج. أحبّه كعشيق سرّيّ، وأنفخ عليه ليطير مثل خلّ كرهته، أصطحب كلّ أدوار الأنوثة معي إلى الكتابة وأمنحها صادقة حارّة.
نستكمل مهمّة الجدّات
في خضمّ الراهن الأليم، ماذا يمكن للمرأة الكاتبة أن تضيف؟ أليس الأجدى أن تنصرف إلى مطبخها وتملأ بطون الأولاد، وتهيّئ المنزل للزوج، وتستمتع بعلاقاتها الاجتماعيّة؟ هو سؤال يبدو أنّه يصدر من العامّة الذين لا يتوخّون تجميل طروحاتهم، كما لا يدّعون الثقافة. لكنّي، وبحكم تجربتي مع فئات نخبويّة، أحسست بالسؤال يخاتلهم فيعتنقونه سرًّا وجهرًا، كلّ وفق موقعه، وبحسب دائرة الضوء حوله؛ يسألون ماذا تريد المرأة من هذا الدور الجديد!
يكمن الخلط، هنا، في إنكار أنّ الحكاية دور نسويّ بامتياز، منذ فجر التاريخ، وقبل أن تتعلّم أمّهاتنا فكّ الخطّ، وقبل أن يتكرّم علينا النظام التعليميّ بالكتابة؛ كانت الجدّات فنارات المساء التي تمسح العتمة من أخيلة الصغار، وتفتح الباب على مصراعيه للحكايات الملوّنة كي تدخل. لم تكن الأسرّة والفرشات الصغيرة للنوم فقط، لكنّها مكان مخصّص للتحليق، حيث من تلك المساحة الضيّقة يبدأ المشوار، كلّ مرقد سجّادة علاء الدين الطائرة، نحلّق ونحن نائمون فوقها إلى مدن بعيدة وعجائب مذهلة، وتطلّ علينا الأميرات والفتيات الضائعات في الغابات، نسمع همهمة الغيلان ومقارعة سيوف الأولاد الشطّار، وزئير الوحوش، وخطو الملوك، وقعقعة أحصنة الفرسان، تظلّلنا الغابات، ويعيينا صهد الصحاري، وتبلّلنا البحار، كانت هذه العوالم بعض من حيل الجدّات الحكّاءات.
وحين تعلّمنا واستقام القلم بين السبّابة والوسطى، اكتشفنا بوّابة أخرى للحكايات، سريرًا لا تنامون فيه، ولكن تتنقّلون عبره إلى عوالمنا. إنّنا، باختصار، نستكمل المهمّة التي بدأتها المرأة الجدّة، لكنّ أدواتنا مختلفة. كما تتراكم في أذهاننا عصور من البحث عن شقوق في الجدار، وأزمنة من الأنوثة اللعوبة، وتلك المعذّبة، وكلّ ما حفلت به البشريّة من خير وشرّ.
محاربة
كلّ القواسم المشتركة بين الكاتبة والكاتب تنتج أدبًا جميلًا، إنّها ذاكرة الإنسانيّة المدوّنة في الخطاب السرديّ، لكن لذاكرة المرأة حساسيّتها التي تشبهها، كما أنّ صوتها المكتوب صوت طازج لم يُسمع من قبل إلّا لمامًا، وفي فترات تاريخيّة متباعدة. ما بين الخنساء ومي زيادة اندثرت آلاف الصيحات التي لم تصلنا، العباقرة فقط التقطوا أهمّيّة وجدوى هذا الصوت في بناء الحضارات، فأطلق ابن عربي قولته الشهيرة: "كلّ مكان لا يؤنّث لا يعوّل عليه".
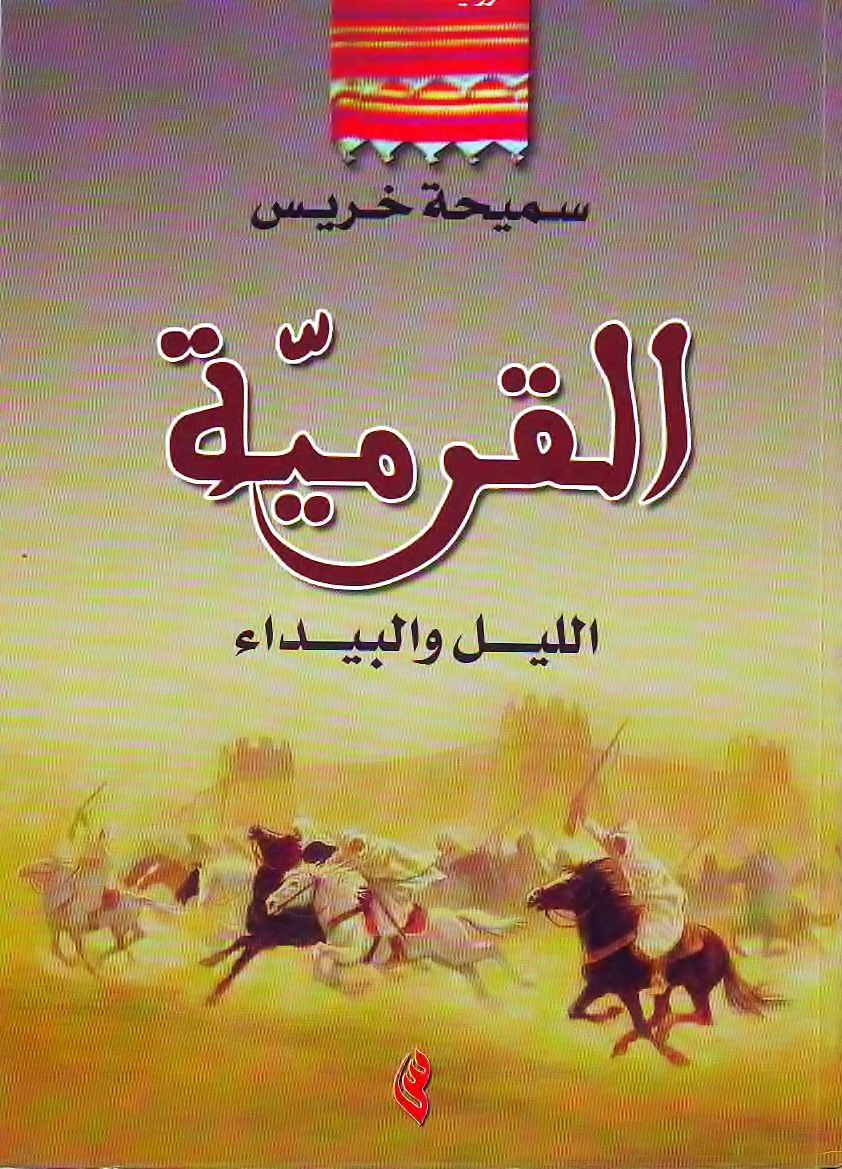
مع ذلك، لست من ناشطات الجندر المتحمّسات، وإن أحببت حماسهنّ، وقدّرت نتاجهنّ، لكنّي من عائلة الإنسانيّات الأوسع، التي تعترف بفضل التراكم المعرفيّ الذي أنتجه الرجل في الفكر والفنّ والأدب، وإن كانت لي ملاحظاتي على دوره في الحروب والسياسة والأخلاق. لست من نسل قبيلة الأمازونيّات المحاربات، فلم أحترم من السلاح إلّا الحجر في يد طفل يتصدى للدبّابة، لكنّي، مع ذلك، من جيل المحاربات اللواتي نبشن تاريخهنّ وواقعهنّ الاجتماعيّ، بحثًا عن الحقيقة.
حين تشكّل وعيي، كانت النسوة حولي يقطعن المسافات الطويلة وصولًا لنيل حقوقهنّ وإثبات أنفسهنّ، يترك لهاثهنّ المتعب ضبابًا حائرًا على أسطح المرايا التي يتزينّ أمامها، ينخرطن في التعليم والنضال والعمل، ويقمن فوق أدوراهنّ بأدوار جديدة، ويخضعن لتحوّلات كبرى، كما يعانين مثل كامل الأمّة من وطأة الهزيمة، ومن نداءات الأحلام، وتبعات تمنّي النصر والحياة الكريمة. يصارعن لترسيخ مفهوم الحرّيّة من دون أن يلحقن الأذى بمكتسبات الرجل، فما زال هو الآمر الناهي.
نسوة من لحم ودم
أمّا في أوراق الروايات، فإنّهنّ يقفن عاشقات حائرات مكسورات، زوجات مغلوبات على أمرهنّ، أمّهات خرافيّات، وفي أحسن الأحوال مناضلات يمثّلن أبواقًا لأيديولوجيا حزبيّة ما، أو صوتًا لقضيّة ينتصرن لها. وقد لاحظت أنّ معظم الروايات التي كتبتها النساء استعارت النماذج النسويّة من النمط الذي رسّخه الأدب سابقًا، الأدب الذي كتبه الرجال، أو نسوة خجولات يدخلن عالم الكتابة متردّدات.
لم تولد من رحم الكتابة نسوة حقيقيّات من لحم ودم، وقد لفتت انتباهي لهذه التفصيلة المريعة الباحثة كورنيلا خالد، حين تناولت أعمال نسوة صنّفن بأنهنّ الأعلى صوتًا عندما يتعلّق الأمر بصوت الجندر القويّ، أمثال نوال السعداوي وغادة السمّان، إذ وجدت الباحثة أنّ شخصيّات رواياتهنّ ينكفئن على الورق مهزومات.
أخافتني هذه الملاحظة، تمامًا. إذا كنّا نريد إعلاء صوت المرأة، فلماذا لا يشكّل الأدب رافعة تعينها في نضالها؟ لا أعني، هنا، أن يحمل الأدب رسالة منبريّة، ولا أن يتحوّل إلى صراخ الندّابات، لكنّ الحياة الحقيقيّة حافلة بالنسوة الفاعلات، كما أنّ الأحلام تكتظّ بالانتصارات، والروح تهفو إلى غد أجمل.
الجديرات
لماذا، إذًا، لا نترك مثل هذه النماذج الإيجابيّة الفاعلة تتسيّد صفحات الروايات؟ عندما كتبت روايتي "شجرة الفهود"، استعدت نسوة مهولات حقًّا، نسوة عرفتهنّ وطفولتي تتفتّح مثل شرنقة، رضعت من قوّتهنّ وبأسهنّ، وفهمت تلك التوليفة العبقريّة من القوّة في أرواحهنّ ومواقفهنّ، من دون أن يفارقن أدوارهنّ الأنثويّة الطاغية، حبيبات، وأمّهات، وجدّات عطوفات.

عادت جدّة أبي، التي لحقت بها وهي في أواخر عمرها، لتسيطر على ذهن الطفلة التي تنظر إليها كأنّها معجزة تسير على قدمين. رأيتها تسوس مجتمع أسرة ممتدّة بنجاح، كما لمحت التمايز بين بقيّة النسوة اللواتي أحطن بي وشكّلن فهمي عن الأنوثة. تناثرت هؤلاء النسوة في مجمل رواياتي، يقلن ما أعتقده عن الكامن في المرأة من قوّة وقدرة، حتّى بتّ أتعجّب إذا ذكرت امرأة مقهورة مكسورة. القويّات الجميلات الوفيّات المحبّات كنّ أجدر من سواهنّ في ضخّ دمائهنّ الحارّة الأصيلة في النصّ وشخوصه المتخيّلة، اللواتي استعرن ملامحهنّ وحكاياتهنّ وجيناتهنّ من نسوة حقيقيّات من لحم ودم، هنّ مَنْ يجب أن تراهن عليهنّ الكتابة لإحداث تغيير في العالم، ولتصويب مقولة الأدب، كي لا تكون المرأة في نسيجه مجرّد حلية أو إضافة هامشيّة، وفي أحسن الأحوال، فكرة مستعارة من ذهن رجل، أو بطن رواية محفوظيّة.
تنطبق هذه الرؤية على كلّ فئة بشريّة أخرى؛ لا يمكن للإنسان أن يكون هامشيًّا في الرواية لأسباب عنصريّة، أو طبقيّة، أو فئويّة.
صفات أنثويّة
خلخل دخول النساء إلى مضمار الكتابة، من جانب آخر، مفاهيم فنّيّة على مستوى الشكل أيضًا، فالأفكار التي راجت حول ضرورة تخلّي الرواية عن الشاعريّة، لتصبح أكثر صلابة، صارت قلقة، ولا يمكن أن تفسّر جماليّة ونجاح روايات لا ينطبق عليها هذا الرأي. لقد أعادت النساء إلى الكتابة جريان نهر اللغة المحلّقة الجميلة. لهذا، وكما تحدّثت في أكثر من موقع، لا يزعجني أبدًا التحدّث عمّا يسمّى بـ "الأدب النسويّ"، بل إنّني أخاطب الكتابة من موقع الأنثى، بكلّ صفاتها التي تمنح الحرف بهاءه؛ فمنذ النصّ الذي نسب إلى أنثى "ألف ليلة وليلة"، صار لنا أن نتأمّل الأسباب وراء غياب كاتبيه ونسبته إلى شخصيّته في نسيجه، وهي شهرزاد. هل لأنّ هذا النصّ العبقريّ خالف فحولة الشعر المعهودة بسرد يقترب من سرد الجدّات والأمّهات؟ هل كان هذا النصّ نسويًّا بامتياز؟ نصّ غامض يلفّه الارتياب، في الوقت نفسه الذي هو نصّ إبداعيّ تتناسل فيه القصص من بعضها البعض، محلّق، خلّاق، يخفي معان كثيرة وراء بساطة خادعة. أليست هذه صفات أنثويّة؟ النصّ النسويّ، في تقديري، يشبه النساء عطاءً وجمالًا وتخييلًا وتحليقًا، كما قد يكون قاس أحيانًا، وليّن طيّع أحيانًا أخرى.
هذه الصفات في صالح أيّ نصّ مكتوب، ويدهشني أن ثمّة كاتبات يعجزن عن تفجير صفاتهنّ الأنثويّة في النصّ، ويعمدن إلى كتابة نمطيّة تدرّبن عليها في كتابات صمّاء انتهى زمنها، كما يدهشني أن ثمّة رجال، كتّاب كبار، تمكّنوا من تحقيق هذه الصفات الخلّابة في نصوصهم، فكتبوا كتابة أجمل.
كتابة تؤثّث العالم جمالًا
استطاعت الروائيّات ترك بصمات خاصّة ذات أهمّيّة على مجمل الأدب العالميّ، كذلك هو الأمر في الأدب العربيّ، ولعلّي حين أعدّد أظلم ذلك الفيض الجميل من العطاء، لكنّي لا أظنّ أنّ الأدب يمكنه تجاهل تجارب مميّزة كتجارب رضوى عاشور، وهدى بركات، وعالية ممدوح، ورجاء عالم، وآسيا جبّار، ولطفيّة الدليمي، ونجوى بركات، وليلى الأطرش، وليلى العثمان، وسواهنّ من الزميلات المبدعات الحاضرات في هذا الملتقى إضافة نوعيّة، وغيرهنّ ممّن تعرفون ولا يتّسع المجال لذكرهنّ.
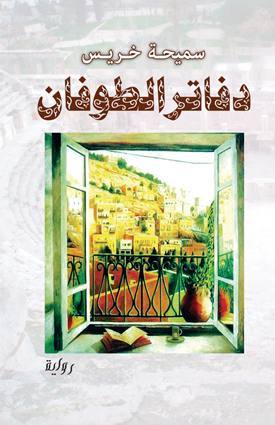
من هنا، أعترف وبالي مرتاح بما يسمونه الكتابة النسويّة، وبفهم خاصّ لي، لا علاقة له بالمفاهيم النقديّة المنتسبة إلى حركة الجندر، والتي تجعل كتابة النسوة مهمّة مقدّسة تتبنّى قضايا النساء، وتبحث عن لغة جديدة لم يعمدها الرجال. كما أنّ تفسيري الخاصّ لا علاقة له بالمفاهيم الانطباعيّة التي تروّج في الصحافة، وتنظر إلى الكتابة النسويّة بصفتها إضافة هامشيّة على تاريخ الأدب، يعتريها ما يعتري المرأة من ضعف. لكنّي أختار قناعة خاصّة تقول: إنّ الكتابة النسويّة هي تلك التي تؤثّث العالم جمالًا، وتمنحه خصبًا، وتجعله حيًّا قابلًا للتناسل والتوالد.
إنّه الفنّ يمنحننا أجنحته، ليمكّن البشريّة من الطيران الحرّ، وليفتح الأبواب للأحلام والأمنيات، كما للمعرفة. لن تتوقّف الأسئلة عن مهاجمة العقول الحرّة، ولن نكفّ عن أداء دور صائد الفراشات، لن تصير نصوصنا أفراسًا برّيّة كما نشتهي، لكنّها ستقع، يومًا، في كفّ قارئ، فنلتقي، ولو بعد ألف عام.
* تُنشر هذه المادّة ضمن ملفّ خاصّ بفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، يضمّ شهادات أدبيّة قُدّمت في ملتقى فلسطين الأوّل للرواية العربيّة، المنعقد في رام الله بين 7 -11 أيّار 2017، برعاية وزارة الثقافة الفلسطينيّة.
** روائيّة أردنيّة، عملت في الصحافة، وأصدرت أعمالًا روائيّة وقصصيّة عديدة. نالت عددًا من الجوائز الأردنيّة والعربيّة، منها جائزة الدولة التشجيعيّة ثمّ التقديريّة من الأردنّ، وجائزة أبو القاسم الشابي من تونس، وجائزة الإبداع العربيّ من مؤسّسة الفكر العربيّ. تُرجمت بعض رواياتها وقصصها إلى اللغات الإنجليزيّة، والألمانيّة، والروسيّة، والإسبانيّة، والصربيّة. كتبت فب مجال السيناريو الإذاعيّ والتلفزيونيّ، وتحوّلت أعملها إلى دراما إذاعيّة وتلفزيونيّة.







