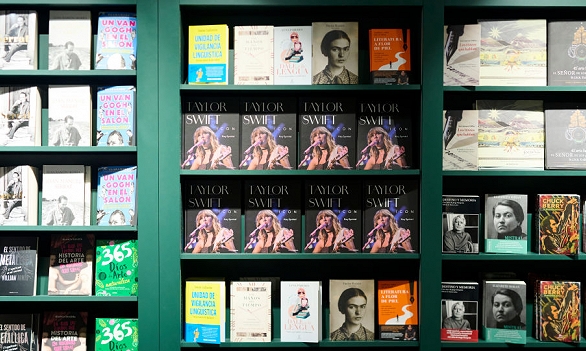أسامة سعيد؛ بالجِفْتِ والرّماد يكتب تاريخه
على بعد من هيمنة الكلمة وهيمنة السّائد، يرسم لنا أسامة لوحات تداعب ذاكرتنا من تلك الطّفولة الهائمة بالطّبيعة، كأنّها صور العودة إلى الوهم الفنّيّ الأوّل، ذلك الّذي يخلق اليوم مشروعًا جديدًا، لعلّه الوهم المتخيّل لفلسطين!

كثيرًا ما يتردّد في المشهد الثّقافيّ الفلسطينيّ موضوع الوطن والاحتلال، محورًا أساسيًّا في كلّ ما يطرحه المثقّف والمبدع في شتّى أعماله، فنرى التّطرّق لسلب الأرض ونهبها، وفعل المقاومة المسلّح، وانتفاضة الحجر، ومقاومة السّكاكين، والحواجز وهمومها، والنّكبة والنّكسة تاريخًا وبصمة، والمقاطعة بكلّ ما تحمله من همّ وتنفيذ، والحروب المتكاثفة على الشّعب الفلسطينيّ، والّتي لا تنتهي، وإلى غير ذلك من سِمات آنيّة لا تفتأ تشغل بال الفلسطينيّ في حياته اليوميّة، وما يتمخّض عنها في الصّحف والجرائد والنّشرات الإخباريّة، وصولًا إلى مواقع الإنترنت وشبكات التّواصل الاجتماعيّ المختلفة، فكلّها تصبّ في الوضع المتمثّل بصعوبات اليوميّ والآنيّ.
ما كان... ما سيكون
يحضر أسامة سعيد، الفنّان التّشكيليّ من قرية نحف الجليليّة الواقعة على تخوم الوطن المنسيّ، ليذكّرنا بأنّ ما كان هو ما سيكون، وما الحياة سوى هباء لأسطورة متداولة قد نبّأتنا بها الصّحف منذ عشرات السّنين! ها هو يقصّ علينا أحاديث الأوّلين، ينبئنا بأنّنا من جِفْتٍ وطين.

إنّه الفنّان التّشكيليّ الّذي تلقّى دراسته الفنّيّة في المهجر الألمانيّ، حيث مارس الفنّ هناك سنوات طوال، ليعود إلى الوطن المنسيّ محمّلًا بهاجس الذّاتيّ والجماعيّ في آن، مضمّنًا أعماله تلك الذّاكرة اللّونيّة لمادّة الأرض ذاتها، لذلك الوطن السّليب ذاته، للون الصّراع؛ لكنّه يقوم بذلك دون طنطنة زائدة ودون مزايدة! إنّه الفنّان ابن القرية الّتي تبدو لنا للوهلة الأولى وادعة طيّبة هانئة، بما منحها الله من نِعَم. لكنّ الفنّان لا يرضى بالسّبات والخنوع، فيخلط لنا في رسوماته تقنيات تلك الأرض بمنتوجها الأوّل؛ إنّه الجِفْتُ والرّماد، ذلك الجِفْتُ الفلسطينيّ، رمز الحياة مذ وجدت الحياة، إنّه الزيتون؛ الشّجر، والحقل، والجذع، والورق، والغصن، والثّمر... وهو شاهد على مكان الجرن والمعصرة، يحمل نكهة قطرات الزّيت، فكلّها تذكّرنا بفطور الصّباح مع اللّبن في الحقل قرب تلك التّلّة المنسيّة... إنّها قصّة عائلة الفنّان أسامة، قصّة شعب بأكمله، كانت له جدّة طردها المحتلّ وهجّر أولادها بعد المذبحة في ميدان القرية... إنّها قصّة اللّجوء في المخيّم، تحكي ذاكرة الدّار وكلّ ما تبقّى في فلسطين الوهم... الرّماد... فلسطين الحقيقة!
الانتصار على الحصار
لا مكان لتردّيات المكان، فالحكاية كلّها ها هنا، في هذه الأعمال التّشكيليّة المتداولة بلغة فنّيّة جديدة، يجمع بها ذلك العالم الفنّيّ الغربيّ الّذي تأهّل به لدخول عالم الفنّ الحديث، بتقنيات الأكريليك والألوان الزّيتيّة، والتّقنيات المختلطة على القماش، فيخلط عصارة ذاكرة الأجداد وذاكرة الشّعب بذلك الجِفْتِ المتبقّي في معصرة الزّيتون، وبقاياه... إنّه نفس الجِفْتِ الّذي وجد به أهل غزّة الصّامدين ضالّتهم في الحصار والسّجن الجماعيّ منذ سنوات، ليعاودوا اختراع الحدث منه، بتحويله إلى وقود ورماد، بعد انقطاع الوقود المصريّ وارتفاع سعر نظيره الإسرائيليّ، وبهذا أصبح الجِفْتُ هو الانتصار على تلك المؤامرة الدّائمة على الشّعب الفلسطينيّ في غزّة هاشم، وفي كلّ مكان.

يحضر الفنّان أسامة ليرسم لوحاته بذات المادّة الّتي تحوّل الجِفْتَ إلى نار ووقود ليحيى به أبناء شعبه في غزّة. أمّا هو، ففي الجليل الصّامد يرتبط مباشرة بذلك المشهد اليوميّ، ليحيي به ذاكرة الجدّ والجدّة وطرد الأعمام إلى مخيّمات اللّجوء، ورواية سلب الأرض وتحويلها إلى مستعمرة صهيونيّة تأكل من الأرض تباعًا ولا تزال. ولعلّ الفنّان أسامة لم يفكّر لوهلة أنّه في حصار فعليّ كأهلنا في غزّة، بل هو هاجس الفنّان في حصار التّشكيل الفلسطينيّ أينما كان في هذا الوطن السّليب!
كتابة التّاريخ
المضامين متعدّدة والهاجس واحد، التّقنيّات مختلفة والهاجس واحد. المضامين كلّها تصبّ في قالب واحد، هو العمل الإبداعيّ الّذي بالكاد يكشف خفايا الجفت والرّماد والأكريليك، وألوان الزّيت ورقعة القماش المتبقيّة في الخفاء. تلك الخفايا الّتي تدغدغ الشّعور وتُشعِرنا لوهلة أنّنا أمام نكهة زهر اللّوز الجليليّ، أو مرونة غصن الزّيتونة، كتلك الّتي لا تزال على مرمى من تلك المستوطنة المتأهّبة دومًا لقلعها في كلّ لحظة، وما تبقّى للفنّان الفلسطينيّ سوى حفر الذّاكرة بالألوان والجفت والرّماد. هي الذّاكرة الأكيدة الباقية، أم لا؟

تنقل لنا لوحات أسامة سعيد، باللّون والصّورة، تعابير لوجدان فنّان يبحث عن مداخل الكلام ليحكي لنا حكاية شعب له عراقة التّاريخ، فيعيد بفرشاته مادّة متأصّلة بجذور الأرض الجليليّة، ليحيي بها حالة الخلق الأوّل وبدء الخليقة. يحمل الفنّان أيضًا ذاكرة الغربة من بلد التّساؤلات، تلك الّتي لا تزال تساؤلات فنّان يبحث عن الوضعيّة الملائمة لتخطيط لوحة تكون هي المعبّرة المُثلى عن أحاسيس الضّياع في صباح يلثم تلال قرية تحيطها ثعالب الطّريق والعبث! فيحاول من خلال فرشاته كتابة التّاريخ من جديد، لا مؤرّخًا أو شاعرًا أو أديبًا، بل هي الألوان الّتي بواسطتها يخلق الفنّان ذلك الفراغ المتحفّز للسّطو على آخر كلمة يصدرها من قلبه في النّزع الأخير.
تأثيرات
يواصل الفنّان أسامة سعيد خلق ذاكرة لونيّة لطبيعة كبرت معه وتبدّلت معالمها، لترتبط في الذّاكرة قصّة ذلك الجدّ الّذي هرَّب أولاده الثّلاثة الكِبار خارج القرية، مخافة العدوّ الغاشم، حيث غدت العائلة بين ليلة وضحاها، مثل بقيّة عائلات فلسطين، تحلم بالتّواصل واللّقاء، بمنأى عن العدوّ. وما بين اللّجوء والخيام والتّهجير، يكبر الطّفل الفنّان ليعرف الحقيقة المرّة بأنّ الوطن فكرة، وأنّ العائلة فكرة، وأنّ الأعمام المهجّرين فكرة، وأنّ اللّجوء فكرة، والغربة فكرة، فحوّل فكرة الغربة عن الوطن إلى حقيقة، وحوّل سنين غربته الجديدة في تعلّم الفنّ في ألمانيا إلى فكرة. وتأتي مرحلة الـتّأثيرات الفنّيّة الّتي لا بدّ منها، فنرى الفنّان يرسم بتأثيرات فنّيّة مختلفة. نجد أحيانًا الانطباعيّة، كلوحات كلود مونيه (Claude Monet)، إذ يستعمل الفنّان ألوانًا صارخة وحادّة لتعبر عمّا يجيش في صدره من أحاسيس تجاه الأشياء. كما نجد تأثير التّجريد في أعماله المختلفة، وما التّجريد سوى محاولة لرسم الصّورة المنظورة من خلال أحاسيس داخليّة يشعر بها الفنّان في أعماقه، ينقلها إلى أسطح القماش فكرة مجرّدة تكاد تعاكس المنظور البصريّ المحدود في ذاكرتنا المقولبة، فيصوّر لنا، بالتّجريد، أشكالًا وألوانًا وأفكارًا تبعثر في داخلنا كلّ ما عرفناه من قبل بالنّسبة لذلك المنظور!

تلك هي ضربات الفنّان أسامة الحادّة بفرشاته، أو بألوانه المتراكمة كتلًا من لون، يخلق بها عنفوانًا غريبًا على سطح القماش، فيذكّرنا بأنّ الفنّان قد بلور تجربته الفنّيّة هذه من خلال تعليمه في الأكاديميّات الألمانيّة، حيث تأثّر بلا شكّ بتيّار التّعبير الألمانيّ، مثل حركة الكوبرا (Cobra). وثمّة أيضًا تأثيرات هولنديّة من الفنّان الهولنديّ كارل آبل (Karl Appel)، والفنّان الدّانماركيّ أسجر يورن (Asger Jorn)، والألمانيّ جرهارد ريختر (Gerhard Richter)، وغيرهم. وثمّة تأثيرات فنّيّة أيضًا من مبادئ التّيّار البدائيّ الّذي اكتشفه الفنّانون الألمان، مثل لودفيج كيرخنر (Kirchner Ernst Ludwig)، والفنّان إريخ خيكل (Erich Keckel). ونجد أيضًا تأثّر أسامة سعيد بالفنّ الانفعاليّ لجاكسون بولوك، حيث عاصفة من المشاعر الّتي تغرقك في تراكماتها لتحتفي بها بعض لوحات أسامة. ولا بدّ من ذكر التّأثّر بحركة 'الجسر'، الّتي تكوّنت في برلين بداية القرن العشرين، بتعبيرها من خلال الفنّ التشكيليّ، عن الغربة في خضمّ المدينة الصّاخبة، وعبر خلق التّوتر اللّونيّ وذلك الصّخب الفنّيّ في اللّوحة.
إّنه فنّاننا الجليليّ أيضًا، الّذي يشعر بالضّياع في تلك المدينة الألمانيّة بُعَيْدَ انتقاله إليها عن قصد، حيث عايشها وعاش بها سنوات طوال![1]
وهم
لقد حوّل أسامة لعبة الرّسم الطّفوليّة إلى فكرة لكتابة ذاكرة لتلك اللّعبة الّتي سُرِقَت، فيقوم برسمها أحيانًا كأزاهير اللّوز والصّباح، وأحيانًا كجذوع زيتونة اقتلعتها دبّابات الدّمار. إنّها تلك الذّاكرة الّتي تسطو على المتفرّج لتحوّله، هنيهة، إلى لون من ألوان الفرح ليفصح عن المكنون. إنّها ذاكرة العائلة الّتي شُرِّدَتْ وطُرِدَ أبناؤها، فتشرّدوا في مخيّمات اللّجوء والدّمار دون بيت أو حتّى مفتاح! إنّها ذاكرة فلسطين الّتي تُعاد كلّ مرّة من جديد في لون آخر، في بيت قصيد، في رواية، في بسمة طفلة، في حجر، في سكّين! فيعيد الفنّان التّشكيليّ صياغة القصّة بألوان الفرح، لعلّ الفرح يأتي. أهيَ مجرّد أضغاث أحلام أم أنّه الفنّان الطّفل الّذي يتعامل مع الواقع بشكل مختلف؟!

على منأى من هيمنة السّلطة، وعلى بعد من هيمنة الكلمة وهيمنة السّائد، يرسم لنا أسامة لوحات تداعب ذاكرتنا من تلك الطّفولة الهائمة بالطّبيعة، كأنّها صور العودة إلى الوهم الفنّيّ الأوّل، ذلك الّذي يخلق اليوم مشروعًا جديدًا، لعلّه الوهم المتخيّل لفلسطين! هو الرّسم وحده الّذي يبقى الحقيقة الوحيدة اليوم لذلك الوهم المتخيّل في حدس الفنّان وفي هاجسه اليوميّ، هو الحنين، فتأتي أعماله التّشكيليّة مفصلًا لقراءة فنّيّة جديدة، فذّة في تقنّياتها، وفي تأثيرها، وفي سُبُلِها، وفي طرائقها المتعدّدة، في خلقها للمحسوسات؛ وما هي في الواقع سوى صورة لحياة وهميّة تعيش وتموت على القماش المتدثّر بالرّماد!
هنا... هناك
ثمّة مقاطع من الحياة تلازم ذاكرة الفنّان أينما سار وأينما انتقل، هذه الذّاكرة هي التي تحفّز الفنّان لمواصلة إبداعاته في كلّ مرّة من جديد؛ ففي الذّاكرة الأوّليّة لذلك الطّفل الّذي كان يحبو، انطبعت في الذّاكرة صورة الجدّ الّذي أمر أبناءه بالخروج من القرية والهروب خوفًا من إعدامهم على يد عصبة الهاجاناه الّتي دخلت القرية الوادعة في الجليل وأعدمت سبعة رجال في السّاحة المركزيّة، على سمع ورؤية من الجميع. إنّه تاريخ التّرهيب والوعيد! إنّه الاحتلال الأوّل الّذي بدأ يرسم معالم النّكبة الفلسطينيّة منذ أربعينات القرن الماضي، ولا يزال! انتهت الحرب وجاءت الهدنة، ومن خرج مُنِعَ من العودة إلى الدّيار، فتشتّت الأبناء، وجاء الطّفل ليكبر في كنف جدّه عبد الله وجدّته فاطمة اللّذيْن وجدا في الحفيد الجديد نوعًا من العِوَضِ عمّا ضيّعا من الأبناء. كبر الطّفل وترعرع في أرض جدّه، فعرف الصّخور وعمل في الحرث والحصاد، حرس الكرم من الثّعالب والذّئاب، عشق الطّبيعة وفصول السّنة الأربعة، وعرف التّلال وحدود القرية الممنوعة من النّموّ. وفي يوم من الأيّام، قرّر السّفر إلى ألمانيا لمواصلة دراسته الفنّيّة، ليصنع هناك حياة جديدة تحمل نكهة أخرى. كوّن عائلة في المهجر. أمّا ذاكرته فبقيت مرتبطة بالقرية الجليليّة، فعاد إليها بعد سنوات ليتقاسم الذّاكرة ما بين هنا وهناك. هنا ألوان الطّفولة، هنا الذّاكرة الأوّليّة، هنا الفكرة، هنا الحزن، هنا الفرح، هنا وهناك العائلة، هنا الأرض، هنا الزّيتونة، هنا اللّوز، هنا الصّخر، هنا الرّبيع الأمل!

أشجار الزّيتون الّتي استخلصها الفنّان أسامة سعيد من الجفت والرّماد هي خلاصة الهمّ الفرديّ هنا، وهي أيضًا تعبير عن الهمّ الفلسطينيّ العامّ أينما كان؛ ففي ذاكرة الفنّان الزّيتونة هي الشّجرة الّتي زرعها الجدّ في أرضه، والّتي اعتنى بها لسنين، فترعرعت واحتفى بها كلّ عام من جديد مع موسم جمع الزّيتون وعصره، ليغدو زيت الزّيتون عماد البيت، وروح الفقداء واللّاجئين في الشّتات، وضياء الأمل لأحفاد الحاضر؛ فيجمع الفنّان تلك الذاكرة من خلال الجفت المتراكم من بقايا ثمار الزّيتون المعصور، ذلك المتشبّع ببقايا الزّيت الأزليّ، ليشاكس به قطعة القماش المشدودة، ويضع عليها اللّون ليخلق به القصّة المؤوّلة أو المستترة خلف حجب الحقيقة المتلاعبة بنا، وكأنّنا لا نعرف الحقيقة، أو لعلّنا لا نريد أن نعرفها. هو الفنّان يعرفها حقًا؛ بالحسّ، بالوهم، بالحدس، بالذّاكرة، بالرّسم، باللّون، بالجفت، بالرّماد!
* تُنشر هذه المقالة بالتّعاون مع بيت مريم، حيثُ يُنظّم معرض 'سماء مكشوطة' للفنّان أسمة سعيد.
[1] بالنّسبة لـلتّأثيرات الفنّيّة على مشروع أسامة سعيد ومشواره الفنّيّ انظر: أسامة سعيد، تفتّح الرّبيع، كاتالوج لمعرض أقيم في صالة العرض للفنون أمّ الفحم، ٢٠١٥، ص ٢٧-٣٥.