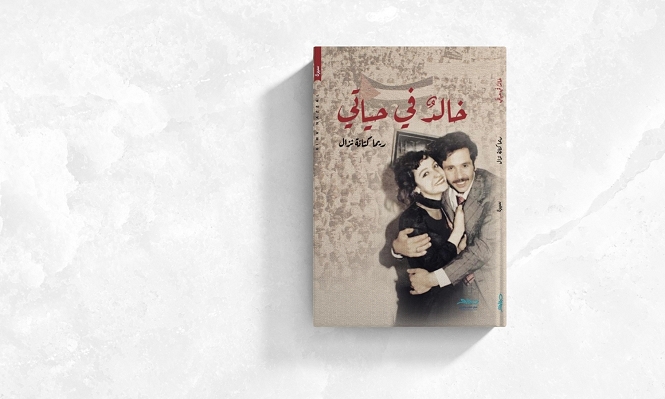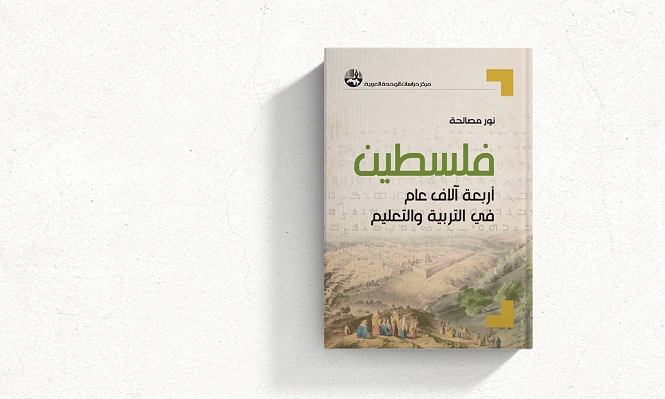الفردوس الموعود
"زيارتي الشهريّة إلى الزرقاء، حوّلها والدي إلى طقس جميل ومثير جدًّا؛ فما إن أصل عصر يوم الخميس حتّى أتغدّى وأغفو، لأستيقظ وأجده قد أقفل الدكّان مبكرًا وأعدّ مجلسًا فوق سطح المنزل في الصيف، أو أوقد المدفأة وأعدّ الشاي في الشتاء..."

"بعض ما أذكره"، كتاب في السيرة الذاتيّة للكاتب والأكاديميّ غسّان إسماعيل عبد الخالق، صدر مؤخّرًا عن الدار الأهليّة للنشر والتوزيع في الأردنّ، وهي تقع في 160 صفحة من القطع المتوسّط.
كتب الشاعر زهير أبو شايب تظهيرًا للكتاب جاء فيه: "فنّ السيرة فنّ متجهّم، ومشغول بانتشال الذكريات من الماضي بوصفها حياة منتهية وذابلة؛ وهذا ما يجعل الكتابة السيريّة، أحيانًا، أقرب إلى رثاء الذات منها إلى اكتشاف الذات، وأقرب إلى الذكريات منها إلى السيرة.
معظم السير التي قرأتها كانت تسبّب لي شعورًا غامضًا بالكآبة والشيخوخة، ما من شابّ يفكّر في كتابة سيرته، لا لأنّ حياته أقلّ نضجًا من أن تتحوّل إلى سيرة، بل لأنّها أكثر طزاجة من أن تتحوّل إلى ذكريات. لكن حين يريد الشيخ أن يكتب سيرته فإنّه (يعود إلى صباه)، أي إلى ذلك الزمن الذي كان يبدو له ضحلًا وقليل الكثافة. ما الذي تريد السيرة، إذن، أن تنقله إلينا: شيخوخة الكاتب التي نطلّ من خلالها على الموت، أم صباه الذي نطلّ من خلاله على الحياة؟ وهذا في التحديد ما استوقفني في هذه السيرة الرشيقة التي لا تذهب إلى ما مضى، بل إلى ما لايمضي من حيواتنا. نعم، ثمّة ما لا يمضي من حياة المرء، وهو ما ينبغي أن ننقّب عنه لنكتب سيرة فرحة وسلسة وقليلة التجهّم.
هذه سيرة نوستالجيّة خالية من أيّ رثاء مبطّن للذّات أو للعالم، وخالية من الهزام. إنّها سيرة فرحة ومكتوبة بروح شابّة ولغة مشرقة، وأحسب أنّها تختلف عن معظم ما قرأته من تلك السير التي يكمن خلفها ضمير متعالٍ هرم. هذه سيرة مضادّة للهرم."
تنشر فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة فصلًا من الكتاب بإذن من مؤلّفها.
***

شكرًا لريتشارد تيلر، مرشدي الأكاديميّ وأستاذ اللغة الإنجليزيّة الأمريكيّ، الذي نصحني بالانتقال إلى قسم اللغة العربيّة! قد تكون نصيحته أثمن نصيحة تلقّيتها في حياتي، ربّما كنت سأظلّ عالقًا مثل عشرات الطلّاب البائسين في قسم اللغة الإنجليزيّة، دون أن أستطيع التراجع إلى الخلف ودون أن أستطيع التقدّم إلى الأمام! وخاصّة أولئك الطلبة القادمين من القرى ويحدوهم الأمل بالتخرّج ثمّ الحصول على عقد للعمل في دولة من دول الخليج، لبناء منزل واقتناء سيّارة وعقد قرانهم على من تختارهنّ لهم أمّهاتهم من بنات الأقارب. لم يكن مزاجي سيّئًا وأنا طالب في قسم اللغة الإنجليزيّة، لكنّه غدا ممتازًا حين أصبحت طالبًا في قسم اللغة العربيّة؛ ها هنا أستطيع أن أتنفّس بحرّيّة تامّة، وأن أعبّر عن نفسي بطلاقة دون أن أحسب حسابًا للأخطاء النحويّة التي يمكن أن أرتكبها. وخلال بضعة فصول كنت قد تعرّفت ووثّقت علاقتي بعدد من الأساتذة المميّزين: الدكتور أحمد الزعبي، الدكتور علي الشرع، الدكتور عفيف عبد الرحمن، الدكتور إبراهيم السنجلاوي، وبوجه خاصّ الدكتور كمال أبو ديب. ثمّة أساتذة آخرون لكنّهم لم يدرّسوني أو أنّهم لم يتركوا علامات فارقة في ذهني. الدكتور أحمد الزعبي شدّني بتواضعه وبساطته وحسّه الوجوديّ الحزين. والدكتور علي الشرع الذي يميل إلى الانطواء فتح لي أبواب مدينة أدونيس وعوالم محمود درويش. والدكتور عفيف عبد الرحمن علّمني قراءة القصيدة الجاهليّة. والدكتور إبراهيم السنجلاوي الذي ارتحل مبكرًا وضع في يديّ مفاتيح القصيدة العبّاسيّة والمنهج الحضاريّ في النقد رغم حسّه الشعبويّ الساخر. وأمّا كمال أبو ديب فقد أعاد ترتيب كثير من القضايا والمسائل في ذهني رغم أنّه لم يدرّسني، لكنّني واظبت إلى التردّد على مكتبه والتحاور معه. كتابه "جدليّة الخفاء والتجلّي" كان محور حديثنا ليل نهار؛ أيّوب السامرائي الذي انتقل إلى قسم اللغة العربيّة من كلّيّة العلوم، وفؤاد اليزيد السنّي القادم من المغرب الأقصى، وزهير أبو شايب القادم من دير الغصون في فلسطين، وزياد أبو لبن وزياد بركات ومحمّد فرحان ثمّ لاحقًا معن البيّاري الذي كان ينتسب لقسم الصحافة لكنّه يقيم بين طلبة اللغة العربيّة.
كان كمال أبو ديب بمنهجه البنيويّ وبنيته الجسديّة الرومانيّة أسطورة اليرموك دون منازع، وقد استأثر لذلك بغير قليل من حسد وبغض الأساتذة التقليديّين. وقد زاد من ذلك الحسد وتلك البغضاء استعداده لاستضافة الطلّاب في بيته أو في أحد المقاهي للتحاور والنقاش. لكن كلّ ذلك لم يلغ حقيقة أنّ اليرموك ما بين عامي 1982 و1985 كانت الجامعة العربيّة الفضلى، وربّما كانت من أفضل جامعات العالم! فقد كان الدكتور عدنان بدران يرأسها ويديرها وفق رؤية ليبرالية جعلت منها محط أنظار كثير من الأساتذة والمفكرين العرب المرموقين، فضلًا عن كثير من الأساتذة الأردنيّين الأكفياء.
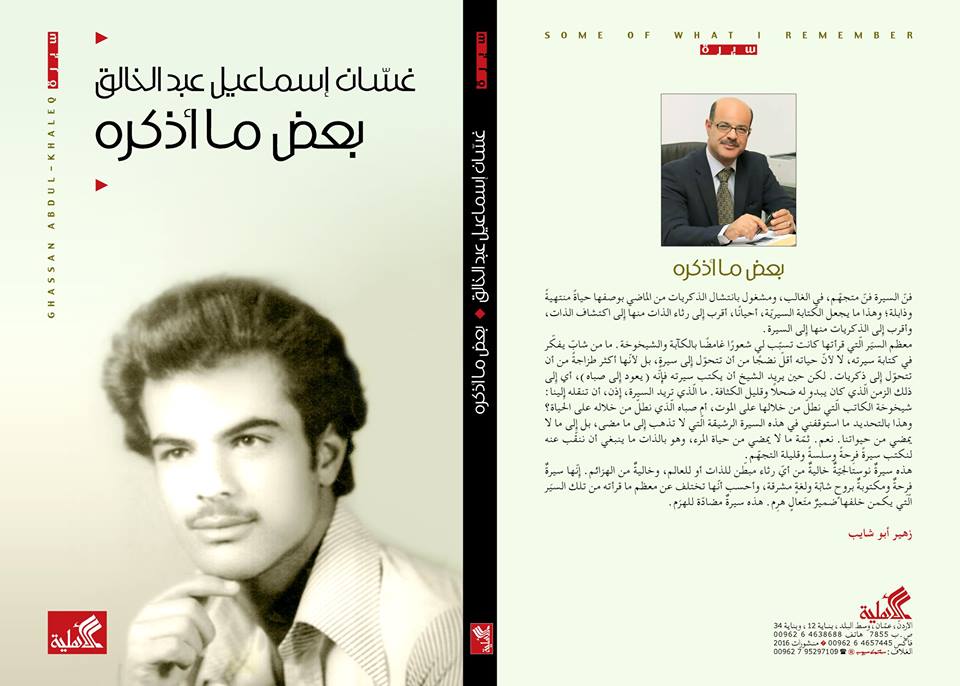
ولن أنسى ذلك الأسبوع الثقافيّ الذي نظّمه مركز الدراسات الإسلاميّة في الجامعة (1982) وكان يديره الدكتور فهمي جدعان؛ فقد قيّض لي خلاله أن أستمع لمحمّد عابد الجابري ولمحمّد أركون، فضلًا عن الاستماع لفهمي جدعان. كانت الجامعة خليّة نحل تمور بالحوار بين الأساتذة والأساتذة وبين الأساتذة والطلّاب وبين الطلّاب والطلّاب، ورغم أنّ عمادة شؤون الطلبة كانت تمثّل الاتّجاه الرسميّ في الجامعة، إلّا أنّها لم تتردّد في اجتذاب بعض الطلبة الواعدين، وقد دعاني حسين الرواشدة، الذي كان يرأس النادي الثقافيّ، لإحياء أمسية شعريّة في رحاب العمادة، فوافقت على الفور، وحضر الأمسية جمع غفير من الطلبة وصفّقوا لي بحماسة شديدة، إلى درجة أنّني أصبحت بعد ذلك محطّ تنافس ممثّلي الأحزاب والتنظيمات الأردنيّة والفلسطينيّة في الجامعة، فقد راح رمزي الخبّ يحاول اجتذابي باتّجاه الحزب الشيوعيّ، وراحت مريم أبو البندورة تستميلني باتّجاه حزب البعث، وراح جمال الطّاهات يزيّن لي الانضمام إلى الجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين!
لم تكن جامعة اليرموك، مصدر الإشعاع الثقافيّ والفكريّ الوحيد الذي صقل عقولنا، بل نافسها أيضًا فرع رابطة الكتّاب الأردنيّين الذي كان يمكن الوصول إليه انطلاقًا من جامعة اليرموك سيرًا على الأقدام، والذي واظب على إقامة ندوات أسبوعيّة، شعريّة وقصصيّة ونقديّة وفكريّة، وتعرّفنا من خلالها إلى هاشم غرايبة وسليمان الأزرعي وإسماعيل أبو البندورة ويوسف عبد العزيز وإبراهيم نصر الله وإبراهيم الخطيب ومحمود عيسى موسى وآخرين، وقيّض لنا نحن الطلبة أن نناقش بضراوة وأن نُدعى للمشاركة في السهرات التي كانت تعقب تلك الندوات.
هل كانت مدينة إربد بوصفها حاضنة لجامعة اليرموك وفرع رابطة الكتّاب الأردنيّين ما بين عامي 1982-1985 هي جنة الله على الأرض؟ نعم ... أظنّها كانت كذلك! بشوارعها النظيفة، ومطاعمها العامرة، ومقاهيها الوادعة، بمكتباتها، وأمطارها، وليلها الحنون. صحيح أنّها كانت قد ارتبكت قليلًا بعيد افتتاح الجامعة في عام 1977، لكنّها سرعان ما تجاوبت مع الطارئ الجديد الذي غيّر مجرى حياة أبنائها إلى الأبد. فبعد أن كانت مدينة وادعة تعجّ بالكهول والمتقاعدين الذين اتّخذوا منها منتجعًا هادئًا، إذا بها تتحوّل إلى مدينة جامعيّة تمور بالشباب، وإذا بها تتقبّل تدريجيًّا فكرة تأجير البيوت للطلّاب العازبين والطالبات العازبات، بل راح أهلها يتسابقون لبناء المزيد من العمارات والمنازل، ويفتتحون المزيد من المطاعم والمقاهي والمكتبات والمحالّ التجاريّة، وإذا أردت أن تتملّاها بحلّتها الجديدة، فما عليك إلّا أن تتمشّى سيرًا على الأقدام بعد عصر يوم الجمعة من كلّ أسبوع، لأنّها تكون قد أخذت استراحة طويلة من ضجيج أسبوع حافل بالحركة.

كنت أتحيّن هذا الوقت بالذات لأقصد أحد مطاعمها وأتناول طبقي المفضّل، الكفتة بالطحينة أو بالبندورة، مع صحن من السلطة الطازجة، ولأستمتع بعد ذلك بارتشاف كوب الشاي على مهل ثمّ فنجان القهوة الذي لا يحلو دون سيجارة "روثمان"! كنت أفعل ذلك أسبوعيًّا لأكافئ نفسي لقاء التزامي الذي لم أخلّ به إلّا مرات معدودة؛ فقد كان معظم زملائي ينطلقون إلى عمّان والزرقاء وغيرها من المدن الأردنيّة لقضاء عطلتهم الأسبوعيّة بين ذويهم وأقاربهم، وأعود أنا إلى المنزل المشترك مغتنمًا فرصة العطلة، فأرتّب المنزل كلّه، وأخرج كيس القمامة، وأنظّف ما تكوّم من صحون وأكواب، وأغسل ملابسي، وأستحمّ، وأعدّ لنفسي عشاء بسيطًا ساخنًا، ثمّ أسترخي أمام التلفاز لمشاهدة واحد من الأفلام السينمائيّة الرائعة التي كانت القناة الأجنبيّة في التلفزيون الأردنيّ تنتقيها بذائقة رفيعة مترفة، ثمّ أخلد لنوم عميق مريح طويل، حتّى إذا استيقظت سلقت بيضتين وتناولتهما على عجل، لأنّني في غاية اللهفة لإعداد القهوة وارتشافها على مهل مصحوبة بالعديد من السجائر. ثمّ أشرع بعد ذلك في القراءة ومراجعة الدروس وإنجاز التقارير المطلوبة، ثمّ أنطلق لتناول غدائي وأعود سيرًا على الأقدام ليبدأ الزملاء في التوافد من عمّان والزرقاء وغيرها من المدن، وقد تزوّدوا بمصاريفهم الأسبوعيّة، فأقتطع سلفًا من كلّ واحد منهم كلفة المؤونة وحاجيّات المنزل للأسبوع القادم؛ الشاي والسكّر والملح والزيت والخبز والصابون والورق الصحّيّ. وقد كانوا يدفعون المطلوب وأكثر بطيب خاطر، لأنّهم كانوا أحوج ما يكونون لمن يتابع مستلزمات المنزل.
لم أتدخّل في ترتيب أو تنظيم غرفهم، لكنّني لم أتسامح بخصوص نظافة الحمّام، وكنت أتطوّع لترتيب المطبخ أوّلًا بأوّل. ومع أنّ الفوضى العارمة كانت تعمّ غرفهم معظم الوقت، إلّا أنّهم لم يتردّدوا في التعبير عن رغباتهم في استعارة غرفتي كلّما زار أحدهم قريب أو صديق، لأنّني كنت أحرص على أن تظلّ غرفتي مرتّبة على الدوام، كي أستمتع بالنظر إلى رفوف مكتبتي وأقرأ أو أستمع لفيروز أو أشاهد واحدًا من الأفلام الأمريكيّة. وحين أنطلق إلى الزرقاء لقضاء عطلتي الأسبوعيّة مع عائلتي في نهاية كلّ شهر، كنت أحرص على إقفال باب غرفتي بالمفتاح، خشية إقدام الزملاء على قضاء سهراتهم فيها وخاصّة خلال فصل الشتاء. كانوا أمناء جدًّا لكنّهم كانوا فوضويّين!
زيارتي الشهريّة إلى الزرقاء، حوّلها والدي إلى طقس جميل ومثير جدًّا؛ فما إن أصل عصر يوم الخميس حتّى أتغدّى وأغفو، لأستيقظ وأجده قد أقفل الدكّان مبكرًا وأعدّ مجلسًا فوق سطح المنزل في الصيف، أو أوقد المدفأة وأعدّ الشاي في الشتاء، لتنطلق بعد ذلك أحاديث الجامعة والامتحانات والزملاء والزميلات حتّى الفجر.

كان يسعد بالاستماع ويتفاعل مع ما أقول كما لو كان موجودًا في الجامعة، فإذا مرّ شهر أو شهران وسهرنا، دون أن آتي على ذكر زميل أو زميلة، ذكّرني به أو بها، بصيغة المتسائل الذي يتمنّى لو أنّ الجواب يأتيه بما يطمئن. أعطاني دائمًا كلّ ما طلبته من نقود ولم يطلب منّي مرّة تبريرًا أو تفصيلًا، وقد بذلت جهدي حتّى لا أتجاوز سقف المصروف الشهريّ الذي اتّفقنا عليه (80 دينارًا)، فضلاً عن رسوم الساعات المعتمدة في بداية كلّ فصل جامعيّ. وحدث أنّ صديقي وشريكي الأوّل في السكن، نزيه عبد الكريم، قد توجّه للزرقاء في نهاية الأسبوع ليحضر مصروفه ومصروفي، فنشل في طريق العودة إلى إربد، ولم يكن معنا ما يكفينا للإنفاق على الأكل والمواصلات وغير ذلك، فرحنا نأكل (نواشف) الموجود حتّى أتينا على كلّ شيء، بما في ذلك تغميس الخبز بماء الزيتون الحامض! منعنا الخجل من التصريح بتعرّضنا للنشل من طلب المساعدة، فلم نعد نزور في كافتيريا القرية الإنجليزيّة لاحتساء قهوة الصباح أو لتناول وجبة الغداء الشهيّة الزهيدة الثمن، وقد استرعى غيابنا انتباه زميلتينا العزيزتين، نهى وأريج، فلم تدّخرا وسعًا لدعوتنا وتحمّل كلفة الإفطار والغداء حتّى انقضى الشهر وتوفّر لدينا ما نردّ به الجميل لهما. ولو استمرّ نزيه عبد الكريم طالبًا في قسم اللغة العربيّة بجامعة اليرموك، لما رضيت بشخص آخر شريكًا لي في السكن سواه، لنبله وهدوئه وشهامته، إلى درجة أنّنا كنّا نضع مصروفينا الشهريّين في علبة واحدة، بغضّ النظر عن مقدار المصروف الذي ورد لأيّ منّا، ويأخذ كلّ واحد منّا من العلبة بقدر حاجته، ولو حدث أن أخذت أنا أو أخذ هو أكثر من مرّة في اليوم الواحد، لتغطية بعض النفقات الخاصّة بي أو به، فإنّ ذلك لم يدفع به أو بي لتكرار الأخذ بقصد التساوي في الإنفاق! لكنّ جامعة اليرموك لم ترق نزيه عبد الكريم، وراح ضيقه بها يتزايد حتّى توعّك صحّيًّا، فاضطّرّ إلى مراجعة أحد الأطبّاء في عمّان، وقد أخلّ ذلك بوضعنا الماليّ المشترك، فتأخّرنا عن دفع الإيجار الشهريّ، فاضطّررت تحت إلحاح المؤجّر، إلى مقايضته بالثلّاجة والارتحال إلى بيت عرار(«) في شارع البارحة، بعد أن وفّق نزيه في الانتقال إلى قسم اللغة العربيّة في الجامعة الأردنيّة التي راقته الدراسة فيها كثيرًا. ولم تطل إقامتي في بيت عرار الذي شاطرني السكن فيه زميلي زهران، الذي كان يدرس اللغة الإنجليزيّة ويبلي فيها بلاءً حسنًا، لأنّ البيت كان كبيرًا وواسعًا جدًّا في النهار، ومعتمًا وموحشًا وعالي السقف جدًّا في الليل. ورغم علوّ سقفه إلّا أنّني كنت أستطيع مشاهدة السحالي وهي تسعى على الجدران والسقف كلّ ليلة. ولم تفلح محاولات زميلي زهران الذي رافقته في مدرسة معاوية بن أبي سفيان وسبقني إلى الالتحاق بجامعة اليرموك، في إقناعي بالبقاء، حتّى بعد أن أطلعني على بضعة أعداد من مجلّة "المقتطف" وقد وشّحت صفحاتها بهوامش وملاحظات بخطّ يد عرار، كما كان يحبّ أن يجزم ويعتقد!

المرّة الوحيدة التي تجاوزت فيها الحدّ كثيرًا، عامدًا متعمّدًا، تمثّلت في إقدامي على إنفاق مصروفي الشهريّ كاملًا واستدانة مبلغ يماثله، لشراء بعض ما رغبت بشرائه من كتب في معرض جامعة اليرموك الدوليّ. ولولا أنّ صديقي عيسى العبّادي، طالب الماجستير في قسم اللغة العربيّة، وأحد المشرفين على المعرض، قد قام بإخراجي عنوة من المعرض، لاستدنت أكثر ممّا استدنت.
اشتريت مؤلّفات أدونيس كلّها، وغير قليل من مؤلّفات هيجل وزكريّا إبراهيم وجابرييل ماركيز وآخرين. وقد اضطّررت لاستئجار تاكسي حتّى أتمكّن من إيصال رزم الكتب إلى المنزل. قيل إنّ المعرض كان يضمّ مليون كتاب! لم أتأكّد من ذلك طبعًا، لكنّه كان يضمّ مئات الآلاف من الكتب قطعًا. وقد أصابني ذلك بنشوة عارمة لا تحدّ، فقد كنت مستعدًّا لإنفاق أيّ مبلغ أمتلكه ومهما كان باهظًا لشراء ما كنت أحلم باقتنائه وقراءته من كتب. وقد أودى الخجل بمعظم ما اشتريته من مؤلّفات أدونيس حين حضر صديقي مهدي نصير لزيارتي في منزلي بإربد، وأبدى رغبته باستعارتها منّي لشهر أو شهرين، فوافقت، وكان ذلك آخر عهدي بها، إذ إنّني أوصيت أكثر من صديق مشترك بأن يذكّر مهدي بإعادة ما استعار، لكنّني لم أر الكتب أبدًا. وأمّا مهدي، فقد رأيته بعد نحو سبعة وعشرين عامًا، حينما دعوته إلى منزلي بعد أن أصدر ديوانه "مئة نشيد لأقمارها الهائجة"، واستأنفنا صداقتنا. ومن المرجّح أنّ إعادة الكتب قد كان آخر همّه، لأنّه كما علمت لاحقًا، كان يواجه ظروفًا سياسيّة عصيبة ما كانت لتسمح له أو لغيره بفسحة للتفكير في إعادة بضعة كتب مستعارة.
كنت أقتني مكتبة كبيرة في غرفتي، لكنّها لم تكن الأكبر إذا قورنت بمكتبة صديقي عيسى العبّادي، طالب الماجستير المرهف، الذي كان يكتب أطروحته عن الروائيّ عبد الرحمن منيف، بإشراف الدكتور إبراهيم السعافين. ولم أعرف مثله شهامة وطيبة ورقّة قلب وغزارة دمع إذا رأى أو سمع ما يؤلم أو يحزن. وكغيره من طلبة الماجستير، فقد كان يعمل مساعد بحث وتدريس، لكنّ هذه الصفة التي تقابل صفة (معيد) في الجامعات المصريّة، كانت تقتصر على مساعدة الأساتذة في بعض المهامّ البحثيّة والمراقبة في الامتحانات. منزل عيسى كان قبلة كثير من الأصدقاء رغم صغر مساحته، ولم يكن يبخل على زوّاره بالكتب أو المأكل أو المبيت أو النقود، وكنت من أسعد الناس باجتيازه مناقشة أطروحة الماجستير وحصوله على الدرجة المنشودة.
كنت قارئًا نهمًا للكتب، لكنّني لم أكن الأكثر قراءة ونهمًا، إذا قورنت بطالب اللغة العربيّة المغربي فؤاد اليزيد السّني، الذي كان يقطن غرفة في إحدى حارات الرمثا بعيدًا عن الجامعة. وقد زرته مرّتين فهالني ما رأيت من حاله، إذ فوجئت بأنّه ينام على فراش ممدود على الأرض وليس في غرفته سوى سخّان كهربائيّ يغلي فيه الماء لسلق البيض وإعداد الشاي والقهوة في آن واحد! وخلا ذلك فقد كان يقضي جلّ وقته متمدّدًا على فراشه يقرأ ويقرأ ويقرأ. وكغيره من المثقّفين المغاربة، فقد كان مأخوذًا بالبنيويّة والبنيويّين، وبالكتّاب والفلاسفة الفرنسيّين، وكان الأقرب لكمال أبو ديب من الأساتذة، والأقرب إلى زهير أبو شايب من الطلّاب. ولم يكن زهير أبو شايب أقلّ منه قراءة، لكنّه كان أكثر انكبابًا على كتب الموروث من الشعر العربيّ القديم ومن كتب الصوفيّة والصوفيّين. والطريف أنّهما كانا على طرفي نقيض من حيث الاعتقاد والسلوك؛ ففؤاد كان عدميًّا فوضويًّا، وزهير كان مؤمنًا متحفّظًا.

أثّرت بي مقاربات زهير أبو شايب للشعر العربيّ القديم تأثيرًا بالغًا، وأظنّ أنّه أوّل من استرعى انتباهي لنجاعة المنهج الأسلوبيّ في تحليل النصوص الشعريّة، إذ دفع لي مرّة تحليلًا بخطّه الجميل الآسر، فبهرت بما قرأت ورأيت. وقد استخدمت تقنيّته في تحليل بعض النصوص الشعريّة حين درست الأدب العباسيّ على الدكتور إبراهيم السنجلاوي، فأعجب بما صنعت، وخاصّة على صعيد التقابل بين وعي الخصوبة (الحضارة) ووعي الجفاف (البداوة) في قصائد أبي نوّاس. ولم يكن إعجابي بزهير أبو شايب مقتصرًا على حسّه النقديّ الذكيّ والمرهف، بل كان يمتدّ ليشمل إعجابي بشاعريّته المحلّقة، ورغم أنّني حظيت بإحياء أمسية شعريّة باهرة في عمادة شؤون الطلبة، إلّا أنّني كنت أدرك إدراكًا لا لبس فيه أنّ زهير يتقدّمني ويتقدّم كلّ شداة الشعر في جامعة اليرموك. وربّما لهذا السبب استأنفت كتابة القصّة القصيرة، ثمّ غامرت بإرسال قصّة بعنوان "المتشرّخ" إلى الملحق الأدبيّ لصحيفة "صوت الشعب"، الذي كان يشرف عليه القاصّ إبراهيم العبسيّ، وكانت تمور بحسّ وجوديّ فاقع، فلم يتأخّر بنشرها، وأحدثت بعض الصدى بين الأصدقاء، لكنّها لم تخفّف من شعوري بالإحباط جرّاء اعتقادي بأنّني غير قادر على تجاوز غنائيّتي الرومانسيّة في الشعر! وكم أشعرني تخرّج زهير أبو شايب وسفره إلى اليمن بالوحدة الفكريّة، وخاصّة بعد أن تخرّج فؤاد اليزيد السّني أيضًا، لكنّني رجوت لزهير أبو شايب تحديدًا كلّ التوفيق.
بعد فؤاد اليزيد السنّي وزهير أبو شايب، كان يمكن لأيّ من الأصدقاء أن يرتّب قائمة القرّاء بالطريقة التي تناسبه، لكنّها ستشتمل بالتأكيد على: جمال مقابلة وزياد بركات ومعن البيّاري وجهاد أبو حشيش وزياد أبو لبن ومهى مبيضين ولميس البرغوثي وجمال الطّاهات وجمال يونس وعيسى العبّادي.
لم نكن جميعًا نتنافس في الدراسة، لكنّنا كنّا نتنافس في القراءة، وما إن يلمع نجم كتاب من الكتب، حتّى نتسابق لاقتنائه أو لاستعارته وقراءته. ولعلّ رواية جابرييل غارسيا ماركيز "مائة عام من العزلة"، كانت الأكثر استئثارًا باهتمامنا بعد أن تُرجمت إلى العربيّة، فقد تسابقنا لقراءتها، ورحنا نستعرض تأويلاتنا لها، تأويلًا بعد تأويل، وأظنّ أنّني ما كنت لأتوقّف عن قراءتها ثمّ إعادة قراءتها، لو لم أبادر لتنظيم فهمي وتأويلي لها، عبر مقالة نقديّة أسميتها "مائة عام من العزلة... بين سلطة الناقد وتمرّد النصّ"، ثمّ ألقيت بها جانبًا، لأعود إليها مضطّرًّا بعد سنوات.
(«) الشاعر الأردنيّ الأشهر، مصطفى وهبي التل.