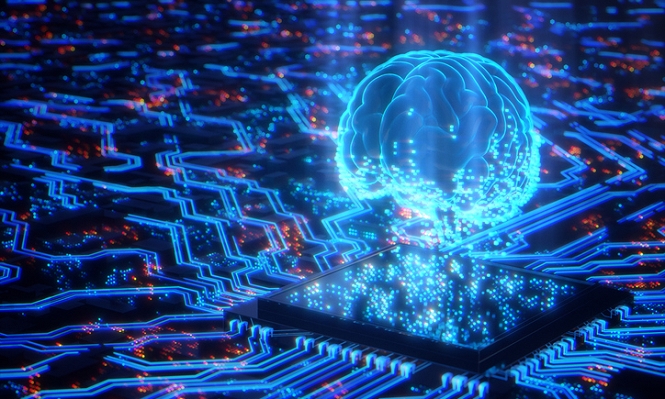البحر صورتنا: سوسيولوجيا الساحل الغزّيّ

"... فلتكُنْ هذي المدينة
أُمَّ هذا البحر، أو صَرْخَتَهُ الأولى.
علينا أن نغنّي لانكسار البحر فينا
أو لقتلانا على مرأًى من البحر،
وأن نرتدي الملح وأن نمضي إلى كلّ الموانئ
قبل أن يمتصّنا النسيان،
لا شيء يعيد الروح في هذا المكان"[1].
البحر والساحل في قارب علم الاجتماع
ظلّت العلوم الاجتماعيّة متحيّزة لليابسة، وما زال البحر، بوصفه فضاءً اجتماعيًّا، مُبْعَدًا عن الأرخبيلات البحثيّة لعلم الاجتماع المعاصر؛ بسبب اعتبار الإنسان مخلوقًا أرضيًّا (نقيض المائيّ)، رغم وجود محاولات قديمة تدرس البحر اجتماعيًّا، تعود إلى 1897 مع أبحاث فرديناند تونيس Ferdinand Tönnies حول البحّارة في ميناء هامبورغ، وغيرها في ما بعد، مثل تطبيق إرفنغ غوفمان Erving Gofmann لمقاربة «المؤسّسة الشاملة» على السفن والمهن البحريّة (1961).
ما يُشار إليه بـ «علم الاجتماع البحريّ» مجرّد تسمية اعتباطيّة، لعدم وجود أيّ جهود نظريّة لإنشاء حقل معرفيّ في علم الاجتماع، يختصّ ببحث القضايا البحريّة...
وجاءت في ما بعد محاولات أكاديميّة تصبّ في بحيرة ما يُطْلَق عليه «علم الاجتماع البحريّ -Maritime/ Marine Sociology » (يسمّيه البعض لإضفاء نوع من الدقّة «Sociology of Maritime Issues»)، وهي دراسات تهتمّ ببحث قضايا كالسياحة البحريّة، وحماية البيئة، والنشاطات الاقتصاديّة مثل عمل الصيّادين والبحّارة وعمّال الموانئ والمرافئ، وخصوصيّة عائلاتهم، أو ظواهر باتت عالميّة مثل الهجرة غير الشرعيّة. وفي المقابل، تبحث حينما ترسو على الشاطئ الثقافة البحريّة، وكيفيّة تأثير التطوّرات التكنولوجيّة والصناعات البحريّة في أنماط العلاقات الاجتماعيّة، بين الناس في البحر من جهة، والعلاقات بين المجتمعات والأمم والبحر من جهة أخرى[2].
لكن يُنْظَر إلى أنّ ما يُشار إليه بـ «علم الاجتماع البحريّ» مجرّد تسمية اعتباطيّة، لعدم وجود أيّ جهود نظريّة لإنشاء حقل معرفيّ في علم الاجتماع، يختصّ ببحث القضايا البحريّة، مع الإشارة إلى أنّ الدراسات الّتي تندرج في ظلّه تبحث موضوعات لم يلتفت إليها علم الاجتماع[3]. ولكي يتطوّر علم الاجتماع البحريّ، عليه أن يتجاوز الحدود النظريّة الكلاسيكيّة، مستفيدًا من التحوّلات النظريّة والمنهجيّة في العلوم الاجتماعيّة[4].
ومن جانب آخر، نجد الباحث الأستراليّ نيك أوزبالديستون Nick Osbaldiston يدعو من خلال ما يصفه بـ «سوسيولوجيا الساحل - Sociology of the Coast»، إلى إيلاء السواحل أهمّيّة بحثيّة، وتطوير مقاربات نظريّة وأدوات منهجيّة لفهمها[5]. ورغم عمله المهمّ في بحث بعض تجارب سواحل أستراليا، وتحقيبه فكرة البحر كما ترد في الميثولوجيا والأديان، ومرحلته لاكتشاف السواحل، ودخول الحداثة عليها وتفاعلها مع أنماط حياة السكّان الأصليّين، إلّا أنّه لم يُقَدِّم مقاربة أو فهمًا يمكّنان من بحث تجارب السواحل، ولا يمكن أيضًا تعميم خلاصات الدراسة بسبب محلّيّة تاريخ السواحل المبحوثة وخصوصيّته.

"البحر دهشتنا، هشاشتنا/ وغربتنا ولعبتنا/ والبحر صورتنا"[6]، يمكن النظر إلى نصّ محمود درويش هذا – بعد تجريده من سياقه – على أنّه مقولة سوسيولوجيّة؛ فالبحر مركزيّ بالنسبة إلى المدن الساحليّة، ويمكن اعتباره مرآةً للبنى الاجتماعيّة والثقافيّة، وكذلك عدسة بحثيّة بسبب كثافة التفاعل على خطّ الساحل ووضوحه. إنّ مراقبة تطوّر الساحل بوصفه وحدة تحليل، تاريخيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، أمر جوهريّ لفهم المجتمعات؛ فتمدين المساحة الرمليّة المفتوحة، ودخول مشاة الحداثة عليها، ومن ثَمّ تحوّلها إلى شاطئ و/ أو كورنيش، يترك آثاره في تربتنا القيميّة والثقافيّة وعلاقاتنا الاجتماعيّة؛ فحركة البحر تبيّن لنا كيف وصلت المجتمعات إلى ما هي عليه، لأنّ "المدن تربّي الأنهار، لكنّ البحار تصنع المدن"[7].
غزّة... بحر ليس كمثله بحر
رغم أنّها تشرب من مياه البحر ذاته، إلّا أنّ لكلّ واحد من السواحل هويّته وتاريخه، وفي ذلك تضاف خصوصيّة فريدة لساحل غزّة، أو كما يصفه أهله بـ «بحر غزّة»؛ ففي حين ترتبط السواحل ببعضها، يبدو ساحل غزّة بانعزاله أشبه بالجزيرة، إثر الحصار المفروض عليه من قِبَل الاحتلال الإسرائيليّ منذ عام 2006، ليكون حصارًا مركّبًا، برّيًّا وبحريًّا، ومن نوافل القول جوّيًّا. فإضافة إلى سرقتها حقل الغاز المكتشف في بحر غزّة عام 1999، ألغت إسرائيل فكرة البحر أمام الغزّيّين؛ إذ أيّ بحرٍ ذاك الّذي لا يُسْمَح بالإبحار فيه لأكثر من 6 أميال بحريّة! والوحش العظيم – بتعبير مجد كيّال – لا ينهش بطن غزّة فقط، بل تلاحق مخالبه الغزّيّين في بحرهم، من إطلاق مباشر للنار تجاه الصيّادين، وملاحقتهم، وتخريب معدّاتهم ومصادرتها؛ فالزورق العسكريّ الإسرائيليّ («الطرّاد» بتسمية الغزّيّين)، يحصد عشرات الضحايا سنويًّا.
لقد مثّل البحر مجهولًا لفترة طويلة بالنسبة إلى الغزّيّين؛ إذ كان يستحيل مشاعًا مخيفًا مع غروب الشمس، قبل أن يعبّد شارع البحر خلال عامي 1998-1999، وتحني عواميد الإنارة ظهرها لتضيئه، ويصبح من الممرّات الرئيسيّة الّتي توصل شمال قطاع غزّة بجنوبه. كما كان البحر مهدِّدًا لحياة الغزّيّين؛ إذ كانت عمليّات تهريب السلاح والمخدّرات تجري في البحر، والمطاردون يتّخذونه ملجأً[8]، واتّخذ هذا التهديد سياقًا آخر مع وقوع عشرات المهاجرين الغزّيّين ضحيّة لقوارب الموت بعد عام 2014. لقد أسهم كلّ ذلك في اضطراب علاقة الغزّيّين بالبحر.
كان البحر مهدِّدًا لحياة الغزّيّين؛ إذ كانت عمليّات تهريب السلاح والمخدّرات تجري في البحر، والمطاردون يتّخذونه ملجأً، واتّخذ هذا التهديد سياقًا آخر مع وقوع عشرات المهاجرين الغزّيّين ضحيّة لقوارب الموت بعد عام 2014.
"كم كنّا نحبّ الأزرق الكحليّ لولا ظلّنا المكسور فوق البحر!"[9]. لا يمكن تصوّر مدينة محاصَرة مثل غزّة دون بحر، ويبدو أنّه منفذها ومتنفّسها الوحيد بالمعنى الحرفيّ؛ فمحاولات كسر الحصار الّتي لم تكتمل، سيّرها الغزّيّون صوب البحر، ويبدو كذلك أنّ البحر ملجأ دائمًا للفلسطينيّين؛ فقد رجع مقاتلو «منظّمة التحرير الفلسطينيّة» بعد إخراجهم من بيروت عام 1982 إلى أصلهم: البحر[10]. وفي حين أنّ "البحر حديثٌ بين شاطئين"[11]، يعيش ساحل غزّة صمتًا منذ زمن، وحين أراد جاره المصريّ محادثته رمى إليه ستّة صيّادين عام 2019، ردّهم إليه بأكاليل، وحين حاول الساحل اليتيم تجاذب أطراف المحادثة بثلاثة صيّادين إخوة في العام الّذي يليه، ردّ إليه المصريّ اثنين منهم[12]، ليستعير أهله لسان فراس سليمان، ثمّ يقولون: "أخيرًا وصلوا... لكن في توابيت"[13].
وممّا يضاف إلى خصوصيّة هذا الساحل، أنّه بعد أن فتح ذراعيه، مقلّدًا باقي الشطآن في لعب دور الوجهة السياحيّة بعد «اتّفاقيّة أوسلو» وتأسيس «السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة» (1994)، واستقباله العديد من المخطّطات والمشاريع الاستثماريّة الأجنبيّة، سرعان ما حُرِمَ من السياحة الاقتصاديّة إثر الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية (2000). وبدلًا من السيّاح، صار يستقبل يوميًّا نحو 100 ألف لتر مكعّب من المياه العادمة (الصرف الصحّيّ) غير المعالَجة، لتستحيل أكثر من نصف مساحة خطّ البحر ملوّثةً، وغير صالحة للسباحة.
"هل أنت بحرٌ أيّها البحر؟"[14]، تساءلتُ مرّة حين كنت أسبح في بحر غزّة، ومع أنّه سؤال شعريّ، إلّا أنّه يعكس الحالة الّتي يحسّها الغزّيّ تجاه بحره، فأيًّا كانت النقطة الّتي يقف فيها، فإنّه يتراءى أمامه شيء من ملامح حلقة المصادرة - الحرمان؛ ففي أقصى الشمال تظهر عسقلان مضاءة ليلًا، وميناء يمتدّ عبر البحر، وفي البعيد نقطة الغاز المضيئة، وقُبالة مخيّم الشاطئ ما زالت سفينة «ساتْيا» الباكستانيّة تلوّح للمارّين مذ غرقت عام 1973، لتذكّرهم بأنّ لبحرهم أفقًا حقًّا.

ومع أن البحر مرآة المدينة وحقيقتها، إلّا أنّه يعطي صورة زائفة عنها، عندما تصوّر الكاميرات الطائرة من علٍ «شارع الرشيد» غرب المدينة. إنّ بحر غزّة «بورتريه» لحرمان أهله اليوميّ من حصّتهم في الكهرباء والماء والتنقّل. يقول ابن الضفّة الغربيّة أحمد جابر:
"لو أنّ أحدًا في ما مضى قال لي إنّه سيكون أوّل بحر أشاهده هو بحر غزّة، لأمضيت ليلتين في الضحك على مجرّد تخيّل هذه الفكرة الجنونية الأشبه بالحلم ]...[ سافرت بعدها ورأيت شطآنًا وبحارًا أخرى، لكنّ بحر غزّة يظلّ مختلفًا، مع أنّه البحر المتوسّط نفسه الّذي رأيته في عكّا ويافا ونابولي، إلّا أنّ تسميته بـ ‘بحر غزّة‘ لها وقعها الخاصّ، هذا البحر الفلسطينيّ، أو الشاطئ الّذي لا تستطيع الوصول إليه إلّا بعد اجتياز حواجز الاحتلال، رغم أنّه في دولتك. هذا البحر هو البوّابة الغزّاويّة نحو العالم، تراه يفتح يديه لك، ويقول: هلمّ إليّ. ومع هذا تظلّ حبيس الرمال، لا تستطيع الخوض فيه أبعد من كيلومترات، كأنّه الفاكهة المحرّمة"[15].
البحر في المخيال الغزّيّ
"في البدء كانت رغبة الإنسان في السباحة، ثمّ كان البحر أزرق هادئًا"[16]. لم تعرف غزّة من التضاريس غير البحر، إلى درجة أنّ ناسها يشيرون إلى أيّ مرتفع بالجبل، حتّى لو كان يتقافز بضعة أمتار فوق الأرض. إنّ ثقافتنا مفتونة ومقرونة بالساحل، وتعكس إعجابًا ورغبة في العيش بجانب البحر؛ فبالنسبة إلينا لا بحر إلّا بحر غزّة، فعندما يقف الغزّيّون أمام أيّ شاطئ، يحدّقون في الأمواج لاستعادة ماء قديم، أو يرمون ببصرهم نحو الأفق: غزّة، أو كما يقول حسين البرغوثي: كان البحر يُطاردني، وكان وجهي شاطئًا"[17]. وحتّى بعد خروجهم من غزّة، يبقون وفيّين للبحر على حساب المشاهد الطبيعيّة الأخرى، يقول أنس سمحان الّذي يقيم في الدوحة: "حتّى الصحراء أراها بحرًا!"[18].
والبحر بوصلة المدينة، فهو المَعْلَم الّذي يحدّد الجهات، ونحوه تتّجه حركة العمران، ويرتفع رأس المال الاقتصاديّ والاجتماعيّ بالقرب منه؛ إذ ترتفع قيمة العقارات، ويتردّد تعبير "نيّالهم! دارهم بتّطلّ ع البحر"، وحتّى اتّجاه قِبْلَة الصلاة يعرفها الغزّيّون بإعطاء ظهرهم للبحر...
والبحر بوصلة المدينة، فهو المَعْلَم الّذي يحدّد الجهات، ونحوه تتّجه حركة العمران، ويرتفع رأس المال الاقتصاديّ والاجتماعيّ بالقرب منه؛ إذ ترتفع قيمة العقارات، ويتردّد تعبير "نيّالهم! دارهم بتّطلّ ع البحر"، وحتّى اتّجاه قِبْلَة الصلاة يعرفها الغزّيّون بإعطاء ظهرهم للبحر. ويبلّل البحر قاموسهم اللغويّ؛ فحين يريد الغزّيّ التحذير من المجازفة، يقول: "البحر فش عليه كبير"، وعندما يضرب بكلام أحدهم عرض الحائط يصيح: "روح بلّط البحر"، ويدعو إلى عدم انتظار جزاء الإحسان: "اعمل خير وارمِ في البحر"، ويصف مَنْ لا حظّ له: "وجهه بِنَشِّف البحر"، ويعبّر عن وحدته وضجره: "بدّي أروح أشكي همّي للبحر". ومع ذلك، ورغم صغر حجم قطاع غزّة، ثمّة اختلاف في علاقات أهله بالبحر، وليس جميعهم «سَبّيحَة» (يجيدون السباحة)، كما هو شائع عنهم[19].
ثمّة جيل حُرِمَ من البحر؛ فمع إقامة مجموعة من المستوطنات الإسرائيليّة، في الفترة بين نهاية السبعينات وحتّى منتصف ثمانينات القرن العشرين، في شمال القطاع وجنوبه، مثلًا: دوغيت، إيلي سيناي، رافاح يام، موراج، نتساريم، تقلّصت مساحة البحر أمام الغزّيّين، وزاد التضييق بعد الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى (1987)؛ فقد بات خطّ البحر، الممتدّ من جنوب دير البلح وصولًا إلى الحدود المصريّة، بات شاطئًا للمستوطنين، ووجهة سياحيّة إسرائيليّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى خطّ البحر الممتدّ من منطقة السودانيّة شمال غزّة حتّى عسقلان. لقد انقطعت علاقة سكّان الجنوب، خانيونس ورفح على وجه الخصوص، ببحرهم تمامًا، منذ الانتفاضة الثانية حتّى الانسحاب الإسرائيليّ من قطاع غزّة عام 2005، وكانوا آنذاك يذهبون إلى شاطئ غزّة في مواسم التخييم لقضاء بعض الأيّام، مُحَمَّلين بكلّ ما يلزمهم كأنّهم على سفر، نظرًا إلى صعوبات التنقّل عبر «حاجز أبو هولي»، الّذي حوّل القطاع إلى ضفّتين حينها[20]. وهي علاقة باردة على العموم، لأنّ مركز المدينة في رفح وخانيونس يَبْعُد نحو 12 كلم عن البحر، وكذلك تفصل السوافي «تلال الرمل» بين أهل رفح وبحرهم. ربّما الاستثناء في حالتَي خانيونس ورفح، يكون لسكّان منطقة المواصي وتلّ السلطان لقربهما من البحر[21]. لا توجد علاقة يوميّة بين المدينة والبحر في خانيونس ورفح، بل هي أقرب إلى الرفاه الموسميّ[22]، ويعود ذلك إلى عدم الاستثمار في خطّ البحر الممتدّ من خانيونس حتّى رفح، كما هي الحال في مدينة غزّة؛ أي لم تتحوّل المساحة الرمليّة إلى شاطئ.

يمكن القول بأنّ مدن قطاع غزّة ساحليّة، لكنّها ليست بحريّة، ثمّ إنّ مراكز مدنها بعيدة عن خطّ البحر الّذي ظلّ مهجورًا لعقود طويلة، مع وجود العديد من الأحياء القريبة من خطّ البحر، وفي ذلك مخيّمان للاجئين: «مخيّم الشاطئ» في مدينة غزّة و«مخيّم دير البلح» أيضًا، وكذلك «القرية السويديّة» على الحدود الفلسطينيّة المصريّة، الّتي يُخْشى أن يبتلعها البحر.
الكورنيش بدل الشاطئ، والشاليه محلّ العريشة
لم يكن ساحل غزّة كما هو الآن قبل سنوات قليلة؛ فقد مرّ بتحوّلات عدّة بتعاقب الإدارات المختلفة عليه، وبمواكبته لمسار التمدين، من خطّ رملٍ إلى شاطئ، وصولًا إلى الكورنيش، وفي مسار معاكس في مواضع اجتماعيّة وثقافيّة أخرى.
يمكن القول إنّ ظاهرة السباحة في بحر غزّة بدأت بوضوح منذ ثلاثينات القرن الماضي، حتّى أنّ بلديّة غزّة أصدرت عام 1941 تعليمات تحت عنوان «نظام البلديّة ونظام الاستحمام بالبحر»، حدّدت فيه الملابس البحريّة المسموحة، وفي حين يرى أباهر السقّا أنّ ذلك قد يدلّل على انتشار ثقافة الشورت والمايو منذ زمن[23]، يشير محمود جودة إلى أنّ هذه التعليمات كانت تخاطب الأجانب بشكل رئيس وليس الفلسطينيّين؛ إذ كان هناك نوادٍ للضبّاط البريطانيّين في قطاع غزّة، منها «نادي التنس» الّذي تأسّس عام 1937، وحضر افتتاحه رئيس بلديّة غزّة آنذاك رشدي الشوّا. مع الإشارة إلى أنّ الكثيرات من نساء غزّة كنّ يسبحن بملابس قصيرة (شورت وبلوزة)، لكنّهن لم يعرفن المايو، وكنّ يفضّلن السباحة في الليل بعد أن يقلّ الازدحام على الشاطئ[24].
وبعد الانتفاضة الثانية، توقّف عمل العديد من المنتجعات السياحيّة مثل «الشاليهات» و«الواحة» [...] وحاولت الجماعات الإسلاميّة فرض نظام اجتماعيّ جديد، بعد أن عارضت لباس البحر «السافر»، وحرقت دور السينما ومتاجر الكحول...
وبعد الانتفاضة الأولى، وبتأثير من الحركات الإسلاميّة الصاعدة في غزّة، خاصّة «حماس»، بدأ العديد من المظاهر بالاندثار تدريجيًّا؛ إذ صارت النساء تسبح بالعبايات، وبعد «أوسلو»، كان يُسْمَح بارتداء المايو فقط في «منتجع الشاليهات»، الواقع أوّل «شارع الرشيد» غرب غزّة؛ لأنّ روّاده كانوا من الأجانب.
وبعد الانتفاضة الثانية، توقّف عمل العديد من المنتجعات السياحيّة مثل «الشاليهات» و«الواحة» (الّذي اِفْتُتِحَ عام 1998 شمال غزّة، وقُصِفَ عامَي 2004 و2008)، وحاولت الجماعات الإسلاميّة فرض نظام اجتماعيّ جديد، بعد أن عارضت لباس البحر «السافر»، وحرقت دور السينما ومتاجر الكحول، وصولًا إلى سيطرة حركة «حماس» على القطاع، وقد شطَحَ بعض عناصرها في تفكيره، وحاولوا فرض ارتداء «شورت شرعيّ» على مَنْ يرغب من الرجال بالسباحة في البحر.
"أيّ شيء ينتهي في هذه اللحظة،
في هذا الجسد؟
أيّ شيء يبتدئ؟
قد أكلنا اليابسة
وقتلنا البحر في رحلة صيدٍ يائسة
أيّ شيءٍ ينتهي
أيّ شيءٍ يبتدئ
بلدٌ يولدُ من قبر بلد
ولصوصٌ يعبدون الله
كي يعبدهم شعبٌ..."[25].

أمّا من حيث مسار التمدين، ففي حين بقي ساحل خانيونس ورفح شاطئًا موسميًّا، تُقام فيه «الاستراحات البحريّة» في موسم الصيف، تُقَدَّم المشروبات والأرجيلة للمصطافين، وتؤجّرهم العريشة خيمة جدرانها من سعف النخل، وسقفها من القماش، ومنها استراحة «الغروب» في غزّة، و«أبو زعرب» في رفح، تحوّل ساحل غزّة إلى شاطئ بالمعنى الاستهلاكيّ بعد «أوسلو»؛ إذ اسْتُثْمِرَ فيه بإقامة العديد من الفنادق والمنتجعات شمال المدينة وغربها، وأسهم في ذلك تعبيد شارع البحر (1998-1999)، وقد حافظ على موسميّته إلى حدّ كبير، وكان يغلب عليه طابع الرفاه العائليّ أو الجماعيّ؛ إذ لم تكن ثقافة الاستجمام الفرديّة قد تشكّلت لدى الغزّيّين.
اقترن «الفَدوس» (العطلة الصيفيّة) لدى طلبة المدارس لوقت طويل بالذهاب إلى البحر. وقد كان سكّان «مخيّم دير البلح» يتعاملون مع الخطّ البحريّ بوصفه مَضافة (غرفة استقبال ضيوف) – بسبب ضيق منازل المخيّم أيضًا – وفيه تُقام الولائم، وهو الوجهة الأولى لاستقبال ضيف من خارج البلاد. وفي موسم الصيف، يكون لكلّ عائلة عريشة على الشاطئ، وفي جانب منه تتّسع «ملاعب» لكرة القدم والطائرة[26].
وفي عامي 2012-2013، بُنِيَ «كورنيش غزّة»؛ لتتحوّل واجهة المدينة إلى اتّجاهات استهلاكيّة واجتماعيّة جديدة، ومنها زيادة عدد المقاهي على طول الكورنيش، الّتي يرتادها الناس طوال العام، سواء لمشاهدة مباريات كرة القدم، أو لعب الورق (الشدّة)، أو للعمل عبر اللابتوب، خاصّة مع تفاقم أزمة الكهرباء، أو هربًا من الحرّ صيفًا. وبات الناس يمارسون رياضة المشي بسبب توفّر فضاء مناسب. وربّما يظهر ما يُطْلَق عليه «كورنيش غزّة» أقلّ من نظرائه في مدن أخرى من ناحية عمرانيّة، إلّا أنّه يشترك معها في تحويل أنماط الحياة الاجتماعيّة نحو الفردانيّة، وتحويل خطّ الرمل البحريّ من موسميّ إلى دائم. وبسبب التلوّث العالي لبحر غزّة، ازداد عدد الشاليهات الخاصّة، وأصبح الناس يفضّلونها بسبب توفّر الخصوصيّة (للنساء خاصّة) والسباحة في ماء نظيف، لتختفي بذلك فكرة العريشة والتخييم على الشاطئ.
البحر لا يمثّل الشيء نفسه للجميع، فربّما يرى ابن مدينة غزّة فيه فكرةً للاستجمام، أمّا ابن الجنوب مثلًا فيراه مكانًا للعمل؛ للصيد أو جمع الزِفزف/ الرمل/ الصخور، الّتي تُسْتَخْدَم في أعمال البناء...
ومن جانب آخر، يمكن من خلال النظر إلى تفاعل المجتمع مع البحر، الانتباه إلى التفاوت الطبقيّ وعدم المساواة، خاصّة مع ارتفاع حجم البطالة، والتحدّيات الاقتصاديّة الّتي تواجهها الطبقة الوسطى في قطاع غزّة، وفي ذلك يرى جودة أنّه حتّى من خلال نوع السمك تستطيع التمييز بين الغنيّ والفقير؛ فثمّة عائلات لا تعرف من السمك إلّا نوعًا واحدًا: السردين، لأنّه الأقلّ ثمنًا.
إنّ البحر لا يمثّل الشيء نفسه للجميع، فربّما يرى ابن مدينة غزّة فيه فكرةً للاستجمام، أمّا ابن الجنوب مثلًا فيراه مكانًا للعمل؛ للصيد أو جمع الزِفزف/ الرمل/ الصخور، الّتي تُسْتَخْدَم في أعمال البناء[27]. ببساطة، وبشيء من الرمزيّة المباشِرة، بعد أن تمرّ من «فندق الروتس» في غزّة، الّذي يعدّ أحد أبرز معالم المدينة الفاخرة، تجد بسطة (عربة بيع جوّالة) اسمها «روتس الغلابة»، وقد يصل فنجان القهوة في الأوّل إلى 50 شيكلًا، بينما في الثاني بشيكل واحد فقط.
البحر الّذي ضيّعَ إلهًا
ربّما يكون طريفًا الإشارة إلى جانب آخر من قصّة «بحر غزّة»، وليس غريبًا من مدينة تحمل كلّ هذه المتناقضات، أن يستمرّ بحرها بقذف الفانتازيا نحو الشاطئ. ففي حين أُضْفِيَت القداسة على البحر في العديد من الديانات القديمة، بوصفه مَجْمَع الآلهة، وأظهر الكثير من روايات الخلق البحر غامضًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الديانات الإبراهيميّة، إذ "كانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرفّ على وجه المياه" (سفر التكوين، الإصحاح 1: 3). يبدو أنّ غزّة تكتب سرديّة مغايرة؛ ففي آب (أغسطس) 2013 عُثِرَ على تمثال برونزيّ للإله أبولو أمام ساحل غزّة، يعود تاريخه إلى 2000-2500 عام؛ ليختفي بعدها دون أن يُعْرَف إلى أين انتهى به المآل.

أخيرًا، يمثّل هذا المقال دعوة إلى الاستفادة من نظريّات السوسيولوجيا ومحاولات سوسيولوجيا السواحل والبحر، في بحث علاقة الفلسطينيّين بالبحر، وهو مدخل مهمّ لفهم تشكّل الثقافة الفلسطينيّة، وربّما تكون غزّة ميدانًا بحثيًّا أنموذجيًّا، بسبب علاقتها القديمة بالبحر، الّتي تعود إلى أكثر من 2800 عام، مع بناء «ميناء البلاخية/ الأنثيدون - Anthedon» من قِبَل الفلسطينيّين - الكنعانيّين، وميناء ميوماس الرومانيّ في ما بعد.
.........
إحالات:
[1] محمود درويش، «تأمّلات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسّط»، الكرمل، العدد 9 (1983)، ص 199.
[2] Emilio Cocco, «Theoretical Implications of Maritime Sociology,» Roczniki Socjologii Morskiej, no. 22 (2013), pp. 5-18.
[3] Agnieszka Kołodziej, «Maritime Sociology or Sociology of Maritime Issues? World Literature Review and Some Historical Considerations,» Roczniki Socjologii Morskiej, no. 23 (2014), pp. 54-62.
[4] Michael Poole, «Maritime Sociology: Towards a Delimation of Themes and Analytical Frameworks,» Maritime Policy and Management, vol. 8, no. 4 (1981), p. 219.
[5] Nick Osbaldiston, Towards a Sociology of the Coast: Our Past, Present and Future Relationship to the Shore (London: Palgrave Macmillan, 2018).
[6] محمود درويش، مديح الظلّ العالي (عمّان: الأهليّة للنشر والتوزيع، 2014).
[7] عبّاس بيضون، الموت يأخذ مقاساتنا (بيروت: دار الساقي، 2008).
[8] محمود جودة، مقابلة عبر الهاتف، 22/12/2020.
[9] درويش، مديح الظلّ العالي.
[10] حسين البرغوثي، الضوء الأزرق (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، 2004)، ص 19.
[11] مجد أبو عامر، مقبرة لم تكتمل (غزّة: دار خطى للنشر، 2018)، ص 21.
[12] " استشهد 5 صيّادين، واعتُقل 15 آخرون على يد قوّات الجيش المصريّ في عرض البحر منذ العام 2015. "أحدهم ساهم في إنقاذ صيّادين مصريّين... حادثة الأشقّاء الثلاثة تنكأ جراح غزّة"، الجزيرة، 30/9/2020، شوهد في 28/12/2020، في: https://bit.ly/2Jnhs2a
[13] فراس سليمان، أخيرًا وصلوا... لكن في توابيت (القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 2019).
[14] أبو عامر، ص 19.
[15] أحمد جابر، مقابلة عبر Facebook، 26/12/2020.
[16] مجد كيّال، مأساة السيّد مطر (عمّان: الأهليّة للنشر والتوزيع، 2016)، ص 7.
[17] البرغوثي، ص 113.
[18] أنس سمحان، مقابلة شخصيّة، الدوحة، 17/12/2020.
[19] جودة.
[20] «حاجز أبو هولي»، أو كما سمّاه الغزّيّون بـ «حاجز الموت البطيء» بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية، يكاد يكون الحاجز الأبرز في قطاع غزّة؛ إذ يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وكان يبيت الناس فيه منتظرين السماح لهم بالعبور، ويتعرّضون لأنواعٍ مختلفة من مضايقات جنود الاحتلال. وقد أُزيل الحاجز مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيليّ عام 2005.
[21] المرجع نفسه.
[22] محمود الشاعر، مقابلة عبر تطبيق Zoom، 26/12/2020.
[23] أباهر السقّا، غزّة: التاريخ الاجتماعيّ تحت الاستعمار البريطانيّ (1917-1948) (بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، 2018)، ص 216.
[24] جودة.
[25] درويش، «تأمّلات سريعة...»، الكرمل، ص 201-202.
[26] حمزة حسن، مقابلة عبر Facebook، 22/12/2020.
[27] جودة.
تُنْشَر هذه المادّة ضمن ملفّ «الساحل الفلسطينيّ»، بالتعاون بين جمعيّة الثقافة العربيّة وفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة ورمّان الثقافيّة، في إطار «مهرجان المدينة للثقافة والفنون» 2020.

شاعر وقاصّ وباحث من غزّة. حاصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة فلسطين، وماجستير العلاقات الدوليّة والعلوم السياسيّة من معهد الدوحة للدراسات العليا. صدرت له المجموعة الشعريّة "مقبرة لم تكتمل"، ويعمل محرّرًا في "مجلّة 28".