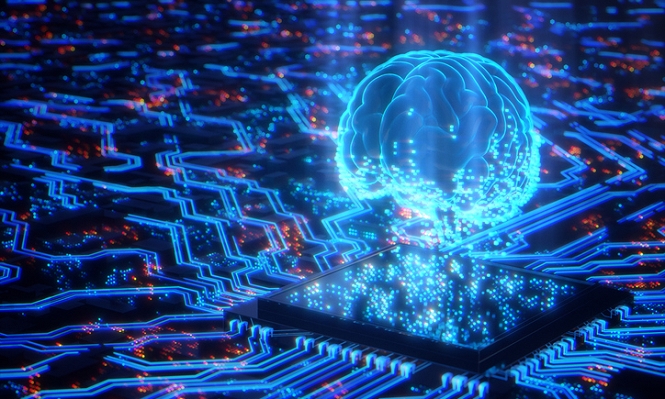لم ينتبه أحد لموتك | ثلاثة نصوص
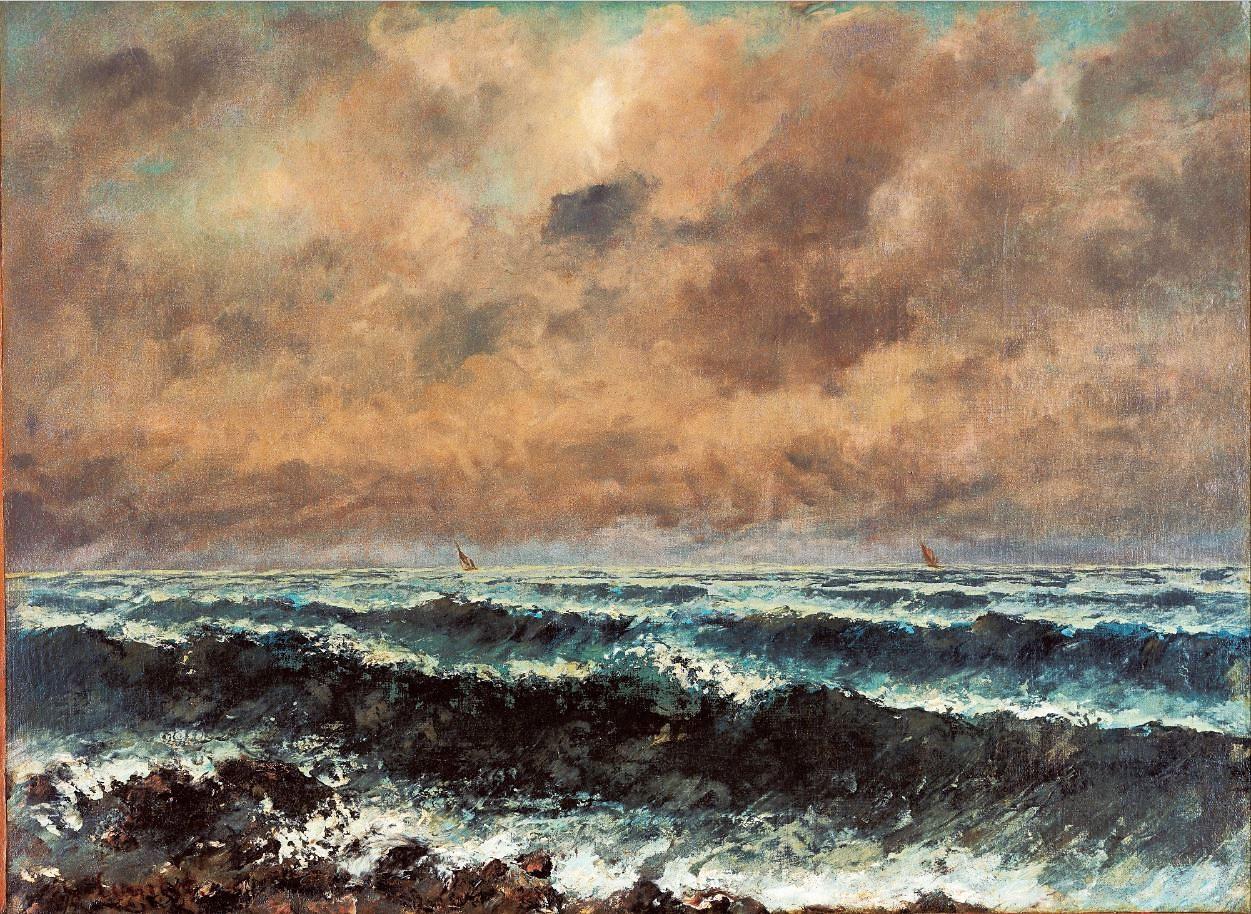
تبحث قصائد "لم ينتبه أحد لموتك"، للشاعر الفلسطينيّ السوريّ رامي العاشق، في موضوعات الموت تحت التعذيب، والمنفى، وقوارب الموت، والموتى، والحبّ، وتحمل بُعدًا وجدانيًّا، شخصيًّا في بعض الأحيان، كقصيدة "فطمة تحمل جرحين بيد واحدة"، وهي قصيدة كُتبت لوالدة الشاعر حين ركبت قوارب الموت إلى أوروبّا، وقصيدة "لا تسلني عن دمشق، ولا تنادني إليها"، الّتي كُتبت للشهيد همّام دياب، الّذي قُتل تحت التعذيب في سجون الدكتاتور بشّار الأسد. من جهة أخرى، ثمّة بُعد وجدانيّ عامّ، إنسانيّ، يتحدّث عن المتروكين، والمنفيّين، عن السوريّين الضحايا والناجين. قصائد "لم ينتبه أحد لموتك" تسأل أكثر ممّا تجيب، وتبحث في اللغة والأسطورة والدين، قصائد تتحدّث كثيرًا عن الموت، لكنّها تبحث عن الحياة.
على الرغم من تعدّد التقنيّات الشعريّة الّتي ضمّها الديوان، واختلاف طول القصائد، والعمل على التكثيف تارة والسرد تارةً أخرى، واختلاف المواضيع وطريقة البحث فيها، قرّر العاشق أن يحافظ على وزن القصيدة حاملًا في الكتاب، وهذا جزء من مشروعه الشعريّ الّذي بدأ بديوانه "سيرًا على الأحلام"، واستمرّ مع "لابس تياب السفر" ولو أنّ الثاني كان بلغة محكيّة، إلّا أنّه حافظ على الوزن، وكلا الكتابين الشعريّين حملا موضوعات متّصلة، على عكس كتابه الشعريّ الثالث "الرماديّ، الورديّ الجديد"، الّذي كان قصائد نثر عن موضوعة الشيخوخة.
في "لم ينتبه أحد لموتك" تطوُّر في الشعريّة، وتطوُّر في اللغة، وفي رؤية الشاعر للشعر أيضًا، وهذا يعكس تطوُّرًا في سيرة الشاعر الذاتيّة.

"لم ينتبه أحد لموتك"، الكتاب الخامس للعاشق، بعد "سيرًا على الأحلام" (2014)، و"مذ لم أمت" (2016)، و"لابس تياب السفر" (2017)، و"الرماديّ، الورديّ الجديد" (2018). يقع الكتاب في 108 صفحات من القطع المتوسّط، ويضمّ ثماني عشرة قصيدة، تنتمي فنّيًّا إلى شعر التفعيلة، كُتبت بين عامي 2014 - 2016، وحملت لوحة الغلاف توقيع الفنّان السوريّ عقيل أحمد.
تنشر فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة مجموعةً من نصوص "لم ينتبه أحدٌ لموتك".
*****
في ملعب البحر
أرى البحرَ...
ثُقبًا...
بلا وجه عاشقةٍ وانعكاسٍ
ولا خاصرة...
يمصّ النهايات وحلًا...
وموتًا...
ولا يعرف المهتدي... آخرَهْ!
أرى الماءَ... صلبًا...
لأنّي أخاف السقوطَ
وأخشى - كما قلعةُ الرمل تخشى - الزوالَ!
انتهينا مِرارًا...
ولم نعرف الموتَ
مَنْ أخّرَهْ؟
بحثتُ – انتقامًا - عن الأصلِ... أصْلي
ولم أعرف الله كي أشكرَهْ!
الّذين يشبهونَ الناس
لا يعبدون النارَ،
لكن يحملون الدفء أغنيةً عتيقة...
لا يعبدون الشمسَ،
لكن يسألون النور أن يبقى صديقا...
لا يعبدون الله!
لكن يبحثون عن الحقيقة!
لا يركبون البحر؛ يركبهمْ
ويرميهم - عراةً من ذواكرهم - بعيدًا
حيث شاءَ
الآن نعرف أنّ مَنْ ألقى يديه على البحار يقودها...
أمسى غريقا
لا يكتبون الشعر
بل وُلِدوا جميعًا
من بطونٍ
مارس الأبوان فنّ حكاية الألوان والأحلام فوق حدود ورْقتها الرقيقة
لا يصعدون إلى السماء
الأرضُ تعلو تحتهمْ
لتصير أجنحةً طليقة...
لا يطلقون النار في الأعراس
نسألهم: لماذا؟
ما الطريقةُ كي نصدّر ضحكتينِ مدى البلاد؟
فيرقصون ولا يجيبون احترامًا للموسيقا
لا يشبهون الناسَ
تعرفهم لغات الأرض آلهةً
وتُنكرهم بلاد اللهِ
تُنكرهم وتتركهم حفاةً
يسألون الله أن يغدو طليقا!
كم أنكرتْهم أغنياتٌ لم تُغَنَّ،
الأغنيات منازلٌ... مثل العشيقات اللواتي
بِعْنَ كلّ الناس من أجل الإلهِ
وما عرفنَ لهُ طريقا!
لا يشبهون الناسَ
يمشي الناس فوق دمائهمْ
هم غير مرئيّين جوعى!
واضحون إذا تمادوا شطر خبز بلادهمْ
لا صوتَ يُسمَعُ من صراخ نسائهمْ
لا صوتَ يُسمَعُ للمدافِع حين تقتلهمْ
ولكن...
يُسمَعون إذا تمادوا في السياسةِ
أو تمادوا في السؤال عن الحياةِ
ويتركون مدى الزنازين العتيقة!
ثلاث محاولاتٍ لأقول: أحبّك
-1-
قالتْ: أحبّكَ...
ثمّ ضاعتْ طفلةٌ كانتْ تشدّ عقارب الساعات للخلفِ، انتبهنا أنّ سرب الطائرات غدا بعيدًا
فاقتربنا...
والطائراتُ...
عرفن أنّ الجاذبيّة أسقطت تفّاحة الآباء من ذات السماءِ!
ولم تكن – في حينها - التفّاحة السوداءُ
تعرف كيف تجعل من تكسّرها انفجارا...
-2-
قالتْ: أحبّكَ...
مرَّ سجّانٌ...
فنامتْ...
والممرّ طريق شهقتِنا السريعُ
وبيننا لوحا حديدٍ
فيهما وجهان ينتظران أن يخلو الطريق من العدمْ!
قالتْ: أحبّكَ...
لم أُجِبْها!
لم أَجِدْها...
لم أنَمْ!
-3-
قالتْ: أحبّكَ...
بيدَ أنّ الموتَ
أخّرني قليلًا عن ملاحقة الشفاهِ،
وكنتُ أنوي أن أودّع قبح هذا الكونِ
في حضنٍ كهذا.
كنتُ أنوي
أن أصالح كلّ ساعات اللجوءِ
– وفي الحقيقة لم أقُلْ "ساعاتِ" إلّا كي تصير سنونيَ العشرون مليونًا ومليونًا -
وأنسى بعدها
كم كان يمكن أن ألوّن من سوادي لو عرفتُ الحبّ قبلُ!
وكنتُ أنوي
أن أعيد قضيّة التفّاح في عصر التطوّر...
* مَنْ سيغوي مَنْ؟
ستكشف كلّ أجهزة التنصّت لغزنا...
ما كنتُ أعرفُ
أنّ شيئًا ما سيمنع كشف هذا اللغزِ!
أنّي...
إن تحقّقت النبوءةُ
واستطعتُ العود للماضي الحبيبِ
وإن تمكّنت العدالة من شفاء الجرح في عنقي
سأبحث مرّةً أخرى عن الموت العظيمِ
لأعرف اللغز الأخير وأنتهي!
كم كنتُ أنوي
أنْ أوزّع لاجئين هناك
في عبث الشتاتِ
ملوّنين بلا ملامح لاجئينَ
ولا موسيقا في اللغات ليُعرَفوا،
وبلا ذواكر في مؤخّرة الرؤوس
تشدّ للأدنى وللأدنى،
وأن أعطي القصيدة كلّ يومٍ حقّها،
وأردتُ أن أعطي صغاري صنعة الأحلامِ
في قبو الخرابِ
وأن أعلّمهم جميعًا
- رغم أنّي أكره الأطفالَ -
أصوات النساء مدى الفِراشِ!
وأن تكون المرأة الوطن الجميلَ،
وأن يكون وفاء عشقٍ مطلقٍ نحو الجمال
وليس للأوطانِ!
أن يحظوا بألف هُويّة وإقامةٍ ووثيقةٍ،
أن ينجبوا في كلّ عاصمةٍ ولدْ!
ليست بلادًا تلك مَنْ تخفي النساء عن الهواءِ،
أريد جيشًا كاملًا وملوّنًا نزقًا!
وأنوي؛
كنتُ أنوي...
أن أقول لها أحبّكِ
– قبل ثانيةٍ -
وأصعد نحو عينيها
وأطبع قبلةً تأبى الزوال
* سيعرف الناس النساء من العيون
وكنتُ أنوي
أن أراقب صمتها وذهولها،
وتخدّر الشفتين في الشفتينِ،
أنهارَ التعرّقِ
حين تمتزج انتصارًا نخبَ ملح حريقنا،
شبق الموسيقا
وانتهاء الخمر في شهْقِ الخوابي.
كنتُ أنوي...
أن أقول لها الحقيقة:
إنّني لن أستطيع لها وفاءً...
جيش أبناءٍ يحتّم أن أكونَ بلا وطنْ!
كم كنتُ أنوي...
أن أقول لها الحقيقة كلّها،
وأضيف في متن الحقيقةِ:
"إنّما الأعمال ليستْ بالنوايا"!

شاعر فلسطينيّ سوريّ، عاش في مخيّم اليرموك بدمشق، ودرس في "الجامعة الإسلاميّة" ببيروت. خرج من سوريا لاجئًا عام 2012، بعد اعتقال وملاحقة من قِبَل نظام الأسد، بعدها سافر إلى ألمانيا عام 2014، حيث يعيش الآن ويترأّس تحرير "مجلّة فنّ" الثقافيّة العربيّة الألمانيّة، ويدير "مهرجان أيّام الأدب العربيّ الألمانيّ"، ويعمل قيّمًا على سلسلة ندوات عن الأدب العربيّ، في "دار الأدب" ببرلين.