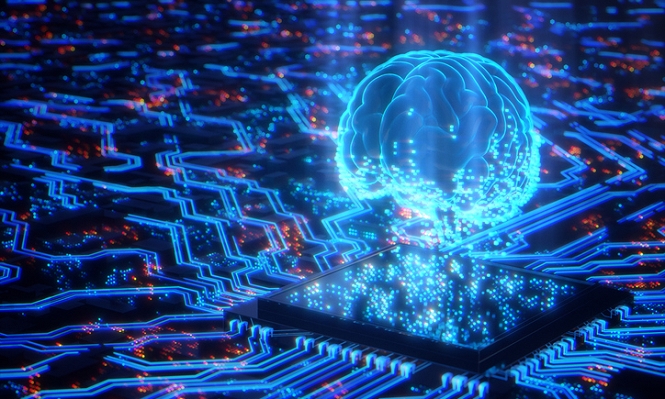نواطير الرمل... ريف الساحل الفلسطينيّ

ينبغي لكلّ واحد يكتب عن المتوسّط أو يُبحر فيه، أن يكون له سبب شخصيّ. في ذلك يقول بريدراك ماتفجيفتش في مؤلَّفه عن المتوسّط بعنوان «تراتيل متوسّطيّة»، إنّه ليس ضروريًّا أن نتعرّى في البحر من أجل انتزاع حقّنا في القول فيه، فالمتوسّط بنفسه يتعرّى أمام زائريه، كي يمنحهم فرصة الحديث عنه.
ما الّذي تبقّى لنا نحن الفلسطينيّين من حصّتنا في ذاكرة المتوسّط، بعد أن كنّا شعبًا من شعوب سواحله؟ فالقطيعة مع ساحلنا التاريخيّ الممتدّ من الزيب شمالًا إلى تخوم غزّة جنوبًا، قطعت بنا إلى حدّ افتقادنا مواردنا الاجتماعيّة والثقافيّة فيه. ليس لأنّ المتوسّط مَنْ ابتلع ساحلنا، إنّما البحر ذاته من حمل إلينا مُبْتَلِعينا منذ مطلع القرن الماضي.
ينظر البعض منّا إلى المتوسّط عند كلّ لقاء به، كما لو أنّه يراه لأوّل مرّة، إذ لم نَعُد نجيد اقتراح أنفسنا عليه إلّا كسيّاح. غير أنّ في ذاكرتنا ما يحتاج إلى نفض رمل البحر وغبار الدهر معًا...
ينظر البعض منّا إلى المتوسّط عند كلّ لقاء به، كما لو أنّه يراه لأوّل مرّة، إذ لم نَعُد نجيد اقتراح أنفسنا عليه إلّا كسيّاح. غير أنّ في ذاكرتنا ما يحتاج إلى نفض رمل البحر وغبار الدهر معًا، لاستعادة ملامح حكايتنا مع بحرنا، هناك في ريف فلسطين البحريّ، حيث كان نواطير الرمل.
قرى الحافة – المغاريب
استرخت كتابة تاريخ ساحل فلسطين في مدنه الّتي حطّت على البحر، مثل عكّا وحيفا ويافا حتّى عسقلان، إلى حدّ ابتلع فيه تاريخ المدن الساحليّة ذاكرة ريفها. كان ريف الساحل يجدل بين فلّاحين جاورت قراهم البحر، وبدو افترشت مضاربهم الرمل على حرف البحر، كما تعوّد بدو ساحل فلسطين أن يُطْلِقوا على حافته.
كان الشريط الساحليّ قبل النكبة مبذورًا بقرى الفلّاحين، الّتي أُطْلِقَ عليها وعلى أهلها اسم «المغاريب»[1]، غير أنّ من «قرى المغاريب» ما تجرّأت على حافّة البحر، وحطّت عليه مباشرة، مثل قرية «جورة عسقلان» في قضاء غزّة، الّتي لم يخلُ أيّ بيت فيها من بحّار، وأسدود شماليّ عسقلان الّتي تمدّدت فوق رملها المسمّى الـ «بَرص»، ناعم إلى حدّ لم يكن يجد فيه أهلها حجرًا لوضعه شاهدًا على قبر ميّتهم.
إلى الشمال من يافا، كان عرب «الجماسين» يجمعون بين حياة الفلاحة والبداوة معًا، واقترن اسم قريتهم بقطعان جواميسهم الّتي كانت تتّخذ من طين شاطئ البحر مهجعًا لها لتبرك فيه، ثمّ قرية «الحرم – سيّدنا عليّ»، الّتي وُلِدَت من مقام الشيخ المجاهد عليّ بن عُلَيّـم، الّذي جاور البحر من زمن الصليبيّين، مرورًا إلى الشمال بقرية «أمّ خالد» من ريف طولكرم الساحليّ، الّتي يُقال إنّ محصول بطّيخها في الموسم الواحد، كان كافيًا لردم شاطئ البحر.
كان الشريط الساحليّ قبل النكبة مبذورًا بقرى الفلّاحين، الّتي أُطْلِقَ عليها وعلى أهلها اسم «المغاريب»[1]، غير أنّ من «قرى المغاريب» ما تجرّأت على حافّة البحر، وحطّت عليه مباشرة...
ثمّ «جسر الزرقا»، قرية الصيّادين الناجية والمهدّدة حتّى يومنا، على ضفّة نهر التماسيح، وأُطْلِقَ عليه «نهر الزرقا»، فكان اسمها. وإلى «الطنطورة» جنوبيّ حيفا الّتي اشرأبّت حافة المتوسّط بل تمدّدت إلى داخله عبر جُزُرِها الخمس. ثمّ منها شمالًا ببضعة كيلومترات، قرية «كفر لام» الّتي ظلّ صدف البحر يفترش شاطئها حصيرًا، تغسله أمواج الجَزْر والمدّ، وإلى الشمال منها، قرية «صرفند الساحل»، مُطِلَّة على البحر، تفصلهما بيادر القرية المُصْفَرَّة بحبّ قمحها وحبّات رملها، وصولًا إلى قرية «الزيب» شمال عكّا، الّتي تجرّأت على البحر وأدارت واجهات بيوتها إليه، فسمّاها أهلها بنت البحر.
بـدو البحر
تُحيلنا البداوة في العادة، إلى البادية والبيئة الصحراويّة في فلسطين، غير أنّ ذلك لم يكن صحيحًا قبل النكبة؛ إذ ثمّة مضارب بدويّة حطّت على حافة المتوسّط منذ مطلع القرن السابع عشر الميلاديّ. اقترنت عودة توطّن ساحل فلسطين في ظلّ الدولة العثمانيّة بعد انقطاع وقطيعة امتدّا قرونًا من الزمن، بالبدو الّذين دفع بهم العثمانيّون على سيف البحر كنواطير عليه[2].
امتدّ الحضور البدويّ على سيف البحر ما بين شمال غزّة وجنوب حيفا، منهم: عرب «الصقرير» و«الملالحة» شماليّ عسقلان، وكذلك عرب «إجليل الشماليّة» شمال يافا، ثمّ عربان بدو قضاء طولكرم الساحليّ مثل عرب «بصّة الفالق» (بركة الشيخ رمضان)، وخربة «الزبابدة»، وبدو «وادي الحوارث» منهم شمالًا. إلى الشمال في قضاء حيفا الجنوبيّ على ساحل البحر، حطّت عربان «الفُقرا» أو بلد الشيخ محمّد الحلو، وكذلك بدو «برّة قيسارية»، وعرب «المِفْجَر»، ومضارب بدو «الظهرة والضميري»[3].
لم يدفع البحر بدوه وعربانه إلى احتراف مِلاحة الماء، بقدر ما علّمهم فِلاحة الأرض على حافته. اقترب البدو من المدن الساحليّة المرفئيّة وتوطّنوا بجوارها، فنقل الغلال وتفريغ الأحمال الّتي لم تقدر عليها الخيل والبغال على الرمال الساحليّة، استدعيا حاجة الفلّاحين وتجّار المرافئ لجِمال البدو من أجل النقل عليها؛ ممّا يفسّر لنا واحدًا من دوافع توطّن البدو على ساحل البحر. ومع أنّ البدو وحتّى فلّاحي الساحل، قد تجنّبوا الغطس بلجّة البحر طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إلّا أنّهم زعموا ملكيّة أمواجه، كما عبّروا عن ذلك بقولهم "في البحر، لنا سبع موجات".
سبع موجات
يقول الحاجّ فيّاض خميس ابن «عرب الفُقَـرا» الساحليّة: "كان إلنا بالبحر سبع موجات"[4]، وكذلك "وصلت حدودنا للموجة السابعة بالبحر"، في تعبير آخر على لسان السيّد نمر مصطفى ذياب، من بدو «إجليل القبليّة» قضاء يافا[5].
فالقول "لنا في البحر سبع موجات" يدلّ على فكرة الملكيّة في البحر، بكلّ ما تعنيه كلمة ملكيّة من ممارسة ومعنًى، فقرى الفلّاحين ومضارب البدو الساحليّة، كان أبناؤها يرون أحقّيّتهم في السيادة على طول الشاطئ الرمليّ...
إنّ تعبير «سبع موجات» الّذي وُلِدَ على ألسنة فلّاحي ريف فلسطين الساحليّ وبدوهم، يبدو لنا مجازيًّا للوهلة الأولى، غير أنّ في هذا التعبير المجازيّ، حمولة مادّيّة تعكس علاقة سكّان ريف الساحل ببحرهم. فالقول "لنا في البحر سبع موجات" يدلّ على فكرة الملكيّة في البحر، بكلّ ما تعنيه كلمة ملكيّة من ممارسة ومعنًى، فقرى الفلّاحين ومضارب البدو الساحليّة، كان أبناؤها يرون أحقّيّتهم في السيادة على طول الشاطئ الرمليّ المحاذي لقريتهم أو مضربهم، وكذلك السيادة على مياه البحر داخل الشاطئ نفسه.
ترتّب على ممارسة هذا الحقّ منع أهل البلد، ولا سيّما البدو، لأيّ غريب يحاول أخذ رمل «الزفزِف» من شاطئهم المحاذي لقريتهم أو مضربهم، والزفزِف من الرمل الخشن الّذي كان يُسْتَخْدَم لأغراض البناء. وقد منع فلّاحو الريف الساحليّ وبدوهم مراكب صيّادي المدن، من صيد السمك في مياه البحر المحاذية لشواطئ قراهم ومضاربهم، في ممارسة تشبه فكرة «المياه الإقليميّة وحقّ السيادة عليها» لدى الدول في التاريخ الحديث.
عدا السيادة والحقّ في ملكيّة مياه البحر، فإنّ لتعبير «سبع موجات» دلالة تحيل إلى النفوذ الفرديّ أو الجماعيّ داخل القرية أو المضرب البدويّ، لناحية حيازة الأرض الزراعيّة الممتدّة على سيف البحر. واستُخْدِمَ التعبير بالمعنى المجازيّ أيضًا، في ظلّ النزاع على الأرض بين أيّ شخصين في القرى والمضارب الساحليّة؛ فعند التوسّط لحلّ النزاع، ومن أجل دفع أحد الطرفين إلى التنازل، كان يُقال له: "تنازل نهبك سبع موجات في البحر"، في إحالة إلى التعويض المعنويّ في البحر، مقابل التنازل عن قطعة أرض على ساحله.
مَشالِح البحر
في شبه إجماع على أنّ السباحة في ساحل بحر المتوسّط، لم تُمارَس إلّا في أواخر ثلاثينات القرن العشرين[6]، فإنّ هذا يصحّ على سكّان المدن الساحليّة في عكّا وحيفا ويافا، وليس الريف، خاصّةً أنّ تاريخ السباحة في فلسطين مختزل في التأريخ للمدينة الساحليّة.
لم تكن النساء في «الطنطورة» يسبحن إلّا ليلًا، وتحديدًا في الليالي المُقْمِرَة، فالليل بعتمه كان يحجبهنّ عن أعين الرجال، ما يمنحهنّ خصوصيّة التعرّي في البحر، فضلًا على أنّه كان التعميم يجري على أهل القرية بموعد نزول النساء للمَشْلَح...
عرف أهل الريف الساحليّ على المتوسّط السباحة منذ مطلع القرن العشرين، لا بل قبل ذلك لدى بدو الساحل، الّذين ارتبطت ممارسة السباحة لديهم بالاستحمام وغسل أبدانهم في البحر؛ إذ كان بدو «وادي الحوارث» يغطسون في ماء البحر المالح، لتلييف أبدانهم بالصابون فيه، ومن ثَمّ الخروج منه إلى نهر واديهم للغطس ثانيةً في الماء الحلو بعد المالح، وهو ما عوّدهم بشكل تلقائيّ على السباحة في البحر[7].
حتّى في «قرية الجورة» عند عسقلان جنوبًا، فقد تعرّف أهلها العوم في ماء البحر، ضمن موسم «أربِعة أيّوب» الّذي كان يُقام على شاطئ القرية. عدا أنّ أهل الجورة كانوا بحّارة وصنّاع سفن، وارتبط بناء المراكب فيها بعائلات يعود أصول بعضها إلى الصليبيّين، مثل عائلة «قنّـن»، و«دار الحاجّ إسماعيل» الّذين احترفوا صناعتها[8].
في قرية «الطنطورة» شمالًا، اتّخذت السباحة قاموسها الخاصّ بها، فتسمية «المَشْلَح» أطلقها الطناطرة على ذلك المكان الّذي تعوّد رجال القرية ونساؤها خلع ثيابهم والسباحة فيه، داخل شاطئ البحر. اختير المَشْلَح في ذلك المكان؛ لأنّ فيه جزيرة أتاحت للنساء وضع ثيابهنّ والاستراحة فيها.
لم تكن النساء في «الطنطورة» يسبحن إلّا ليلًا، وتحديدًا في الليالي المُقْمِرَة، فالليل بعتمه كان يحجبهنّ عن أعين الرجال، ما يمنحهنّ خصوصيّة التعرّي في البحر، فضلًا على أنّه كان التعميم يجري على أهل القرية بموعد نزول النساء للمَشْلَح قبل يوم أو يومين من نزولهنّ، لتذكير الرجال بمجانبة الشاطئ[9].
من عند «جورة عسقلان» جنوبًا، وشمالًا حتّى «الزيب»، لا نواطير عند البحر ظلّت ولا مغاريب. لم يبق من ريفنا البحريّ غير «جسر الزرقا»، يتيمة مثل زُرْقَة بحرها، ورمله الّذي استقوى عليه أسمنت الغرباء...
للذاكرة
من عند «جورة عسقلان» جنوبًا، وشمالًا حتّى «الزيب»، لا نواطير عند البحر ظلّت ولا مغاريب. لم يبق من ريفنا البحريّ غير «جسر الزرقا»، يتيمة مثل زُرْقَة بحرها، ورمله الّذي استقوى عليه أسمنت الغرباء، مقتلعًا منه حِجار أهله المغاريب.
ستظلّ حكاية بحر فلسطين، مرهونة بذاكرة ريفه وشاطئه الّذي ظلّ أهله يتذكّرونه، في الشتاء جزيرة من الوحل، وفي الصيف ذريرة من الرمل، تمشطه قوافل البدو مُحَمَّلَة بالقمح والبطّيخ، تلوّح خلفها سواعد الجمّالين الّتي لوّحتها شمس البحر. بحر فلسطين الّذي ظلّ يحمل موجه الموج، ليغسل بزبده أَخُفَّ الجِمال، وحوافر الخيل، وكواحل أقدام النواطير.
.........
إحالات:
[1] إحسان تمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج 1 (دمشق: مطبعة ابن زيدون، 1938)، ص 59.
[2] أشارت المصادر إلى صدام بدو ساحل فلسطين مع فخر الدين المعني الثاني، في مطلع القرن السابع عشر الميلاديّ. راجع: محمّد كرد علي، خطط الشام، مج 2، ط 3 (بيروت: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات، 1983) ص 263.
[3] عن توطّن هذه العشائر البدويّة على ساحل المتوسّط، راجع: موقع فلسطين في الذاكرة، ضمن برنامج التاريخ الشفويّ للنكبة الفلسطينيّة.
[4] مقابلة شفويّة مع الحاجّ خميس فيّاض، عرب الفُقَرا، موقع فلسطين في الذاكرة، ضمن مشروع التاريخ الشفويّ للنكبة الفلسطينيّة، تاريخ المقابلة 22/6/2006، أجرى المقابلة: ركان محمود.
[5] مقابلة شفويّة مع السيّد نمر مصطفى ذياب، إجليل القبليّة، موقع فلسطين في الذاكرة – ضمن التاريخ الشفويّ للنكبة الفلسطينيّة، تاريخ المقابلة 6/7/2008، أجرى المقابلة: ركان محمود.
[6] عن ذلك، راجع: سليم تماري، الجبل ضدّ البحر، (رام الله: مواطن المؤسّسة الفلسطينيّة لدراسة الديمقراطيّة، 2005)، ص 26.
[7] مقابلة شفويّة مع السيّد جميل درسيّة، وادي الحوارث، موقع فلسطين في الذاكرة – ضمن مشروع التاريخ الشفويّ للنكبة الفلسطينيّة، تاريخ المقابلة 3/8/2005، أجرى المقابلة: فوّاز سلامة.
[8] مقابلة شفويّة مع السيّد سعيد خليل مسحال، جورة عسقلان، موقع فلسطين في الذاكرة – ضمن مشروع التاريخ الشفويّ للنكبة الفلسطينيّة، تاريخ المقابلة 27/6/2013، أجرى المقابلة: ركان محمود.
[9] مقابلة شفويّة مع السيّد عبد الجبّار أبو الشكر، الطنطورة، موقع فلسطين في الذاكرة – ضمن مشروع التاريخ الشفويّ للنكبة الفلسطينيّة، تاريخ المقابلة 17/3/2007، أجرى المقابلة: ركان محمود.
تُنْشَر هذه المادّة ضمن ملفّ «الساحل الفلسطينيّ»، بالتعاون بين جمعيّة الثقافة العربيّة وفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة ورمّان الثقافيّة، في إطار «مهرجان المدينة للثقافة والفنون» 2020.

باحث في العلوم الاجتماعيّة. حاصل على ماجستير فلسفة التاريخ من الجامعة الأردنيّة، وماجستير في الدراسات العربيّة المعاصرة من جامعة بير زيت. يعمل في مجال الاستكمال التربويّ في القدس، ويكتب المقالة في عدد من المنابر الفلسطينيّة والعربيّة.