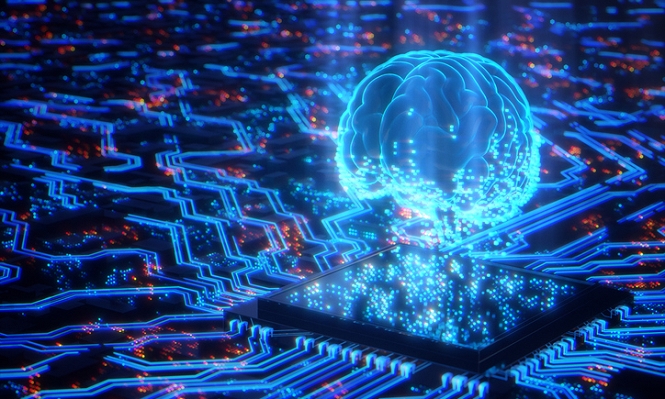ملح بحر يافا... لأوّل مرّة

يوم السبت، الثامن من آب (أغسطس) 2020، بدأت الأخبار تتسرّب عن توافد المئات من أبناء شعبي الفلسطينيّ من الضفّة إلى داخل الخطّ الأخضر، ليس عن طريق حواجز التفتيش إنّما «بالتهريب»، لزيارة بلدهم المحتلّ منذ عام 1948، خاصّة مدن الساحل في فلسطين: يافا وعكّا وحيفا، وذلك عبر فتحات موجودة في جدار الفصل العنصريّ. قرّرت أن أذهب وأوثّق اللحظة الّتي ربّما لن تتكرّر كثيرًا، أو ربّما لن تتكرّر أبدًا ما دام الاحتلال موجودًا على هذه الأرض! هكذا، ودون أن أفكّر طويلًا قرّرت أن أوثّق لحظة لقاء الإنسان الفلسطينيّ مع بحر بلاده لأوّل مرّة في حياته، أن أوثّق انفعالاته، مشاعره، نظراته، كلماته، لمساته...
بدأت المشي في شوارع يافا، والتنقّل بين شواطئها ومتنزّهاتها، تأثّرت كثيرًا بما أراه فعلًا، لم أعتد على رؤية يافا بهذا المشهد قبلًا؛ فغالبيّة مَنْ فيها في هذه اللحظة فلسطينيّون!
سافرت من الرينة، قريتي الصغيرة في منطقة الناصرة، إلى يافا. فور وصولي اتّجهت نحو الشاطئ وأنا أحمل ثلاث كاميرات. بقدر ما شدّتني اللحظة هذه والحدث نادر الحصول، لم يهمّني الثقل الّذي أحمله، وصعوبة التصوير الفوتوغرافيّ والفيديو في نفس الوقت.
بدأت المشي في شوارع يافا، والتنقّل بين شواطئها ومتنزّهاتها، تأثّرت كثيرًا بما أراه فعلًا، لم أعتد على رؤية يافا بهذا المشهد قبلًا؛ فغالبيّة مَنْ فيها في هذه اللحظة فلسطينيّون!
في كلّ الأماكن الّتي تجوّلت فيها، كان الحديث الطاغي بين الناس باللغة العربيّة، كلّما نظرت حولي رأيت أمامي فلسطينيّين، وكأنّني أعيش في فترة مختلفة عن الّتي أعيشها، رأيت النساء بلباسهنّ الفلسطينيّ وجلابيبهنّ في كلّ مكان، رأيت الناس والأطفال يلعبون ويمرحون، يستمعون إلى الموسيقى، يتأمّلون الطبيعة، يفردون موائدهم على العشب وعلى رمل الشاطئ بعفويّة. فجأة وعلى غير العادة، أشتمّ في المنطقة رائحة المقلوبة، صوّبت نظري نحو الرائحة، وإذ بي أرى نحو عشرة أشخاص يجلسون حول طنجرة كبيرة، وامرأة تقلبها على صينيّة كبيرة، فتفوح تلك الرائحة الزكيّة في هواء يافا.

مشيت أكثر إلى الأمام، وإذ بمجموعة من الشبّان يحضرون الأرجيلة، ويضعون أمامهم صحن اللبنة المغمور بزيت الزيتون، وإلى جانبه صحن من الزيتون الأخضر المخلّل، وصحن من البطّيخ. كلّما مشيت أكثر وأكثر في الطريق رأيت ما يجب أن أراه، وما يجب أن يكون في هذه البلاد، الرائحة والمشهد للحضور الفلسطينيّ، أن أرى يافا مزدحمة بأهلها الأصليّين.
أمشي وأسأل كلّ مَنْ مرّ قبالتي عن الشعور الّذي يعيشه مع هذه اللحظة. ومن شدّة تأثّري بالمشهد بكيت، دون أن أعلم السبب الحقيقيّ لبكائي! أكان تأثّرًا بالمشهد أم ألمًا على يافا ونكبتها؟ أم أنّه كان فرحًا وأملًا بمستقبل مختلف؟
حرمان الإنسان الفلسطينيّ من أبسط حقّ له في بلاده الّتي وُلِدَ فيها، وهو رؤية البحر والاستمتاع بالطبيعة، أيضًا جريمة من جرائم الاحتلال الصهيونيّ في حقّ الشعب الفلسطينيّ في الضفّة. جيل بأكمله في فلسطين كبر ولم يعرف ما يعنيه البحر، وما معنى السباحة في مياهه والشعور بملوحته.
مع قلوب النساء والأطفال والرجال والشباب والشابّات، الّذين يرون البحر للمرّة الأولى في حياتهم، ذهبت مشاعري بعيدًا، مع عيونهم ومشاعرهم، تنقّلْتُ من مكان إلى مكان، تحدّثت معهم، أكلت معهم، بادلتهم الابتسامات والدمعات والضحكات...
مع قلوب النساء والأطفال والرجال والشباب والشابّات، الّذين يرون البحر للمرّة الأولى في حياتهم، ذهبت مشاعري بعيدًا، مع عيونهم ومشاعرهم، تنقّلْتُ من مكان إلى مكان، تحدّثت معهم، أكلت معهم، بادلتهم الابتسامات والدمعات والضحكات، لعبت قليلًا بالكرة مع الأطفال على الشاطئ، كلّ مَنْ طلب منّي أن أصوّره صورة تذكاريّة صوّرته فورًا. كانت المشاهد واللحظات مؤثّرة ومليئة بالحكايا والقصص والمعاني، رأيت أمام عينيّ مَنْ بكى أمام البحر، ومَنْ وقف أمامه مذهولًا لدقائق، ينظر دون أن يستطيع الكلام بأيّ كلمة أمام الكاميرا، رأيت مَنْ ضحك، ومَنْ تألّم، رأيت وعشت معهم كلّ المشاعر المتناقضة الّتي يعيشها الفلسطينيّ في أرضه.
محمود من نابلس، شابّ في الخامسة والأربعين من عمره، يقف قريبًا من السور في منطقة الميناء مع زوجته وابنته وابنه، يتأمّل البحر تارة، وتارة أخرى يتابع ضحكات ولديه وهما يقفان بالقرب منه. موجة قويّة وعالية تضرب السور وتبلّلهم، ليفرّ الطفلان راكضَيْن منها، ثمّ يعودان للوقوف مجدّدًا عند السور، ينتظران موجة أخرى، وصوت ضحكاتهم يطغى على الأرجاء. اقتربتُ من هذه العائلة، وأخذتُ لهم صورًا تذكاريّة عدّة، وطلبتُ من محمود أن يحدّثني عن شعوره، وعن التجربة الّتي مرّ بها من أجل أن يصل إلى يافا والبحر، فقال: "جيت لهون تهريب من الفتحة أنا وزوجتي وأولادي، طلعنا من الساعة خمسة ونصّ الصبح، وبعد ما مشي الباص صار فيه إطلاق نار وضرب قنابل، عمري 45 سنة عندي بنت وولد، إحنا الأربعة أوّل مرّة بنشوف البحر، أنا ولا بعمري شفت البحر ولا شمّيت ريحته ولا حسّيت بملوحته، أنا عليّ منع أمني لأنّي كنت أسير وقضيت 8 سنوات في السجن، ولا عمري شفت بلدي يافا، أنا من هون، أنا من يافا، مش مصدّق إنّي بجدّ موجود بيافا وبحرها، اللّي سمعت عنهم كثير من أبوي وستّي وسيدي. هلّأ أجاني تلفون بحكولي إنّه الفتحة اللي طلّعنا منها الجيش سكّرها". في اللحظة الّتي عرفت منه أنّه أسير محرّر وممنوع أمنيًّا، أوقفت التسجيل عبر الكاميرا، وتابعت تدوين ما يقوله عن طريق الكتابة، كان يتكلّم معي والابتسامة في وجهه، والقلق واضح في نبرات صوته، سألته: "هل أنت خائف من العودة؟"، أجابني: "بعرفش شو رح يصير، بسّ رح أنبسط باللحظة وبشوفِة بلدي لأوّل مرّة بحياتي، بدّيش أفكّر باللّي جاي، بكفّي أشوف هلّأ فرحة بنتي وابني قدّامي، مبسوط كثير إنْهم شافوا البحر بطفولتهم، أنا لليوم بسّ لعرفت شو يعني بحر".

قلت له وأنا أبتسم: "وكيف شفتلنا يافا؟"، أجاب: "يافا، فشّ كلمة توصفها، وفشّ كلام يوصف شعوري بهاي اللحظة".
أخرجت من حقيبتي بضع حبّات سكاكر، أعطيتها للطفلين، ودّعت العائلة ووعدتهم أنّ الصور ستبقى محفوظة عندي دون أن أنشرها، حفاظًا على سلامتهم، وأن أرسلها إليهم فقط. تبادلنا أرقام الهواتف، وأكملت المسير في اتّجاه الشاطئ في حيّ المنشيّة.
حرماني من رؤية البحر لثلاث سنوات في فترة الاعتقال والسجن، وبعد أن اعتدت زيارته قبل الاعتقال أسبوعيًّا، جعلني أهتمّ بكلّ كلمة تخرج من إحساس مَنْ أقابله، وهو يتحدّث عن أهمّيّة البحر وما يمنحه للإنسان، من إحساس جميل وراحة نفسيّة لمَنْ يعاني من ضغوطات مستمرّة في الحياة، وخاصّة حين تكون ناتجة عن احتلال استمرّ كلّ هذه السنوات الطويلة.
وصلت الشاطئ في حيّ المنشيّة، الحيّ الّذي تحوّل إلى متنزّه بعد تدميره تمامًا عام 1948، ولم يتبقّ منه شيء سوى مبنًى فلسطينيّ واحد، حوّلته السلطات الإسرائيليّة في ما بعد إلى متحف باسم «إيتسيل»، العصابة الّتي دمّرت الحيّ وطهّرته عرقيًّا من الفلسطينيّين عام النكبة. خلعت حذائي، وبدأت أمشي على الرمال حافية.
توقّفتْ عيناي عند سماح، ابنة الـ 32 عامًا، وهي جالسة على رمال الشاطئ بجلبابها الأسود، تنظر إلى البحر، والموج يلطم فيها بين لحظة وأخرى. حين اقتربت منها وطلبت أن تحدّثني عن اللحظة الّتي تعيشها الآن، فورًا طلبتْ منّي أن أوقف التصوير...
توقّفتْ عيناي عند سماح، ابنة الـ 32 عامًا، وهي جالسة على رمال الشاطئ بجلبابها الأسود، تنظر إلى البحر، والموج يلطم فيها بين لحظة وأخرى. حين اقتربت منها وطلبت أن تحدّثني عن اللحظة الّتي تعيشها الآن، فورًا طلبتْ منّي أن أوقف التصوير، قائلة: "اكتبي ولا تصوّري". احترمت طلبها الشرعيّ ونفّذته فورًا. أطفأت الكاميرا، وعدت إلى الدفتر والقلم مجدّدًا. سألتها: "هاي أوّل مرّة بحياتك بتشوفي فيها البحر؟"، أجابت: "آه، أوّل مرّة بحياتي بشوف البحر، وبدخل على بلدنا في 48... أنا من طولكلرم، زوجي شهيد، وأصلًا عليّ منع أمني، زوجي استشهد وهو راجع من يافا عالبلد بالطريق الالتفافيّة، شافوه الجيش، خاف يمسكوه لأنّه بفوت وبطلع تهريب، وبدون تصريح، وصار يركض، الجيش طخّوه". توقّفتْ عن الحديث لحظات وبدأتْ بالبكاء، ثمّ أكملتْ: "أوّل مرّة بكتشف إنّه طعم ميّة البحر مثل طعم الدمعة اللّي نزلت هلّأ من عيني". تنفّستُ عميقًا، وشعرت مع كلماتها بغصّة تملأ قلبي، لم أستطع أن أكمل الحديث معها، فما قالته كان كافيًا لاختصار الحقيقة والواقع والحكاية، قبّلتُ جبينها وقلت لها: "أهلًا وسهلًا فيكِ ببلدكِ يافا". ابتسمت وعادت تلعب مع أمواج البحر، لأكمل طريقي باحثة عن حكاية أو دمعة أخرى من ملح هذا البحر.
كثيرة هي المشاهد الّتي وثّقَتْها كاميراتي، وكثيرة هي الحكايا الّتي دوّنها قلمي، لكنّ أهمّها قصّة واحدة ووحيدة، يجب أن تُقال في كلّ زمن، وفي كلّ مكان، إنّنا شعب نحبّ الحياة، وكلّ هذه الأرض من النهر إلى البحر اسمها فلسطين، وأنّ صمت العالم على جرائم هذا الاحتلال في حقّ هذا الشعب هو الجريمة الكبرى، وأنّ مشهد قرانا ومدننا الفلسطينيّة كيافا وعكّا وحيفا وأمّ خالد، وهي ممتلئة بأهلها الأصليّين، هو المشهد الطبيعيّ الّذي يجب أن يكون في هذه البلاد.
تُنْشَر هذه المادّة ضمن ملفّ «الساحل الفلسطينيّ»، بالتعاون بين جمعيّة الثقافة العربيّة وفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة ورمّان الثقافيّة، في إطار «مهرجان المدينة للثقافة والفنون» 2020.

شاعرة ومصوّرة وناشطة سياسيّة واجتماعيّة فلسطينيّة، وأسيرة سياسيّة محرّرة. أنهت الثانويّة العامّة في بلدتها، الرينة، ثمّ درست الهندسة والبرمجة، ومن ثمّ الإعلام والإخراج السينمائيّ.