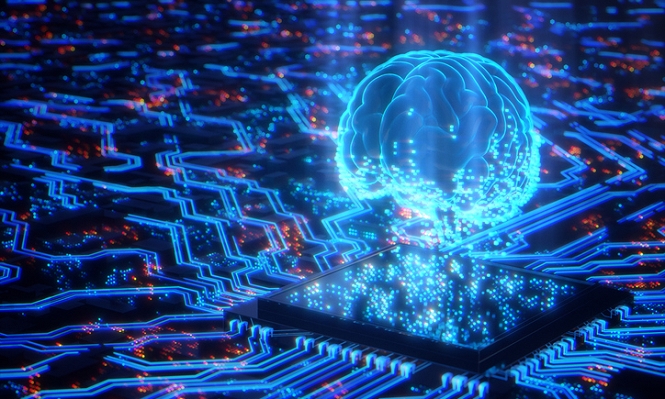الولد الفلسطينيّ متعب
كانت الفكرة أكبر من مجرّد لقاء كاتب، بل أتصوّر أنّها تجاوزت ذلك لتكون لقاء مع أحد أبرز النصوص التي حرّكت فعل الكتابة لديّ وجلبت لي فلسطين التي يعرفها دحبور كاملة، حيّة ومليئة بالرائحة والصوت والعذوبة والجمال، إلّا أنّ هذا اللقاء لم يحدث.

"لأنَ الوردَ لا يجرح قتلتُ الورد
لأنّ الهمس لا يفضح سأعجن كلّ أسراري بلحم الرّعد
أنا الولد الفلسطيني."
(من قصيدة ’حكاية الولد الفلسطينيّ‘ لأحمد دحبور).
هكذا حضر أحمد دحبور في المرّة الأولى، حين كنتُ طالبًا في الثّانويّة العامّة بمدرسة عبد القادر الحسينيّ في محافظة خانيونس جنوب القطاع، حينها كان الأولاد الفلسطينيّون في الجنوب يقرؤون حكاية الولد الفلسطينيّ الحيفاويّ في الشّمال.
قرأت القصيدة مرارًا، تناولنا جماليّاتها بالشّرح والتّفصيل، حفظتها كي أكتبها في امتحان اللّغة العربيّة وأنشدتها في الصّفّ على مسامع الجميع، وقد حلّت في الذّهن والوجدان بعذوبة غير مسبوقة.
لم تعد قصيدة "حكاية الولد الفلسطينيّ" جزءًا من المنهاج الدّراسيّ الّذي ظلّ دحبور حبيسه بالنّسبة لي، لكنّها ستكون مفتاح الوصول إليه ومحرّك البحث عنه لاحقًا، إذ وقع بين يديّ بعد سنوات ديوان "كسور عشريّة"، وهو صادر عن مؤسّسة تامر للتّعليم المجتمعيّ، ليحضر نصّ الثّانويّة العامّة مرّة أخرى.
قراءة "كسور عشريّة" أيقظ لديّ رغبة في القراءة المتوسّعة في نتاجات دحبور الشّعريّة، والتّعرّف إلى الكاتب وعالمه. ولحسن الحظّ، ما زال دحبور على قيد الحياة، نصًّا وشخصًا وحضورًا ثقافيًّا وأدبيًّا.
دحبور ينتمي لجيل فلسطينيّ فريد، خلق واقعًا مغايرًا من ملامح المأساة الفلسطينيّة الحادّة، وهو الّذي خرج من أتون النّكبة مختزلًا في ذاكرة الطّفل الصّغير مدينة حيفا، ذاكرة يذوب فيها حتّى الأعماق، ويعيش حالة من الحنين المتّقدة إليها كلّما اشتعل الاسم أو هبّ نسيم شماليّ.
يتجلّى ذلك بوضوح حين يخرج الولد الفلسطينيّ، صاحب الملامح الفجّة، من زقاق المخيّم نحو الشّعر مباشرة، بسجيّة الرّاعي ومخيّلة الجدّة، ليخلق الشّعر الّذي يصنع الفارق، ويرخي جدائله في بئر الجرح الّذي لا ينضب. على الرّغم من الحالة الّتي يشكّلها دحبور في الهويّة الثّقافيّة الفلسطينيّة، والّتي تشبه فلسطين تمامًا، فلسطين النّاهضة والمتعثّرة في ذات الوقت، ظلّ شاعر فرقة العاشقين في الظّلّ، رغم أنّه أنجز الكثير ومارس الكتابة والحبّ والثّورة والحياة والفعل الثّقافيّ والمعرفيّ بجدارة واقتدار، واستطاع تكوين وعيه الثّقافيّ الرّحب من خلال قراءات متنوّعة ومكثّفة وعميقة، في موضوعات كثيرة، ليكون المثقّف النّوعيّ وصاحب القلم الّذي يكون إمّا رصاصة أو كعكة عيد في يد حيفا.
آثر دحبور أن يبقى إلى جوار الشّجرات الّتي حدّثته الجدّة عنهنّ، أو في ذلك البحر الّذي وعدته أمّه أن تحضره له كاملًا متكاملًا، يمتلكه بمفرده فيسمح لمن شاء من أصدقائه أن يدخله، أو يستبعد من يريد.
لطالما رغبت بشدّة أن ألتقي دحبور، ففكرة لقائه تعني لي قبل أيّ شيء القدرة على مشاهدة النّصّ الأوّل.
كانت الفكرة أكبر من مجرّد لقاء كاتب، بل أتصوّر أنّها تجاوزت ذلك لتكون لقاء مع أحد أبرز النّصوص الّتي حرّكت فعل الكتابة لديّ وجلبت لي فلسطين الّتي يعرفها دحبور كاملة، حيّة ومليئة بالرّائحة والصّوت والعذوبة والجمال، إلّا أنّ هذا اللّقاء لم يحدث. وحين كان أحد الأصدقاء يلتقي بدحبور، كنت أشعر بغصّة، ولأنّني عجنتُ كلّ أصواتي بلحم الرّعد، لكن دون جدوى، لم ألتقِ به حتّى هذا اليوم الّذي يرقد فيه الولد الفلسطينيّ على سرير المرض، ذلك كون بلاد الله ضيّقة على الفقراء، ولأنّها أيضًا واسعة، وقد تصفح يا أحمد القصيدة والوجع والحياة.
حين يكون أحمد دحبور مريضًا، يكون جزءًا من الهويّة الثّقافيّة لجيل واسع من الشّباب الّذين قرؤوا وحفظوا جيّدًا "حكاية الولد الفلسطينيّ" وأغاني فرقة العاشقين مرضى ومتعبين، ويكون وجه حيفا الّذي يغسله البحر والملح والتّراتيل مريضًا، وتكون الشّجرات الّتي تحدّثت عنهنّ الجدّة مريضات أيضًا، وتكون الذّاكرة الفلسطينيّة مريضة.
ربّما تكون فرص اللّقاء الآن أقلّ، لكنّني أعلم جيّدًا أين يمكن أن أرى دحبور، حيث الرّؤى مشتغلة والأخيلة أشرعة تنعكس على أحد وجوه فلسطين، وجه الكاتب الّذي قرأت له نصًّا في الثّانويّة العامّة.