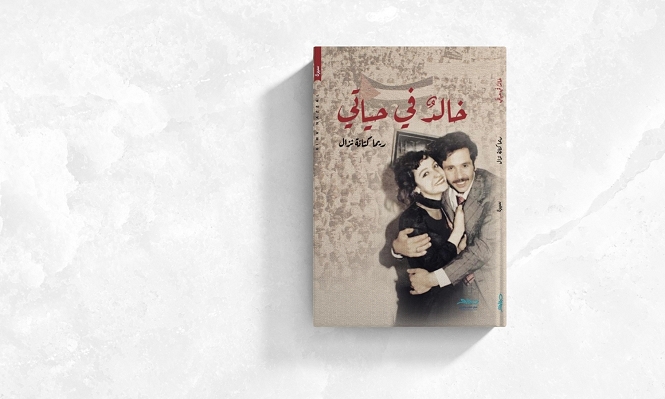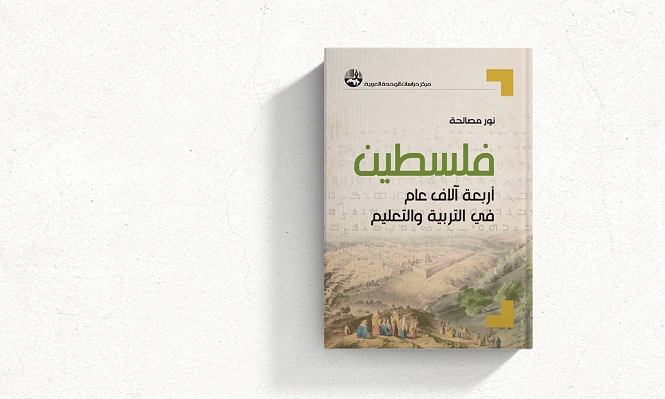هنا الوردة؛ رواية دون كيشوت العربي
يستطيع تمييز الفروق الدقيقة، أحيانًا، بين خطٍّ وآخر من العائلة نفسها. لو سُئِلَ يونس عن سرّ معرفته بهذا الفنّ المخصوص، دقيق القواعد والأحكام، لقال بنفاد صبر مصطنع بعض الشيء: إنّه التعوّد ليس إلّا. فهذه الخطوط هي، بعد كلّ شيء، مهنة عائلتي!

'هنا الوردة'، عنوان رواية للكاتب أمجد ناصر*، صدرت مؤخّرًا عن دار الآداب في بيروت، وهي تقع في 224 صفحة من القطع العاديّ، وقد صمّم غلافها الفنّان نجاح طاهر.
جاء في تظهير الناشر للرواية: 'يونس الخطّاط، بطل رواية 'هنا الوردة' الذي يبتلعه الحوت المجازيّ، شخصيّة مثيرة للإعجاب: فهو مزيج من العاشق، والمتمرّد، والمغامر، والحالم الذي يمشي إلى هدفه الكبير، جارًّا معه سائر شخصيّات الرواية التي ترى حقيقته، بينما هو الوحيد الذي لا يرى ذاته، لأنّه ببساطة، 'دون كيشوت عربيّ.'
وجاء أيضًا: إنّ لدى دون كيشوت تابعه الأمين الذي ينبّهه إلى حقيقة ما يجري في الواقع، لكن من ينبّه يونس؟ هناك من يقدّم نفسه في مستهلّ الرواية كأنّه الكاتب، بيد أنّنا سنعرف، من دون إبطاء، أنّه ليس إيّاه، وذلك في إطار لعبة سرديّة مدهشة تسكنها الشعريّة في الأعماق. هذه الرواية لا بدّ منها لمعرفة ما جرى في زمن عربيّ عاشت فيها الأحلام (أم الأوهام؟!) كـأنّها حقائق، والحقائق كأنّها أحلام.
تُنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة مقطعًا من 'هنا الوردة'، بإذنٍ من مؤلّفها:
 بقي يونس حبيس غرفته باستثناء مروره السريع، بين حين وآخر، في بهو الفندق ومطعمه، حيث رأى، مرّةً، في البهو الذي تتدلّى من سقفه مروحة كبيرة، خليطًا متنافرًا من النزلاء، ريفيّين في عباءات وأغطية رأس وعُقل غليظة، موظّفين حكوميّين، أو تجّارًا في حِلل كاملة وربطات عنق يتصبّبون عرقًا، بضعة أجانب يرتدون بنطلونات جينز وقمصانًا نصف كم، بعضهم يعتمر قبّعات عريضة يجفِّفون عرقهم بمناديل جيب. بين الأخيرين لاحظ وجود امرأة شقراء ترتدي بنطلون جينز وقميصًا كتّانيًّا مجعّدًا، وتنتعل صندلًا جلديًّا. كانت أعين الرجال الريفيّين، ومن يبدون موظّفين حكوميّين أو تجّارًا، مسلّطة عليها كرادار نَشِط. كانوا يعانون من الحرارة، أو ربّما من منظر المرأة الشقراء، التي تتحرّك في كرسيّها بحرّيّة وتضع ساقًا على ساق، ما يجعل قدمها البيضاء في الصندل الجلديّ عرضة لمزيد من النظرات. مغناطيس نظرات.
بقي يونس حبيس غرفته باستثناء مروره السريع، بين حين وآخر، في بهو الفندق ومطعمه، حيث رأى، مرّةً، في البهو الذي تتدلّى من سقفه مروحة كبيرة، خليطًا متنافرًا من النزلاء، ريفيّين في عباءات وأغطية رأس وعُقل غليظة، موظّفين حكوميّين، أو تجّارًا في حِلل كاملة وربطات عنق يتصبّبون عرقًا، بضعة أجانب يرتدون بنطلونات جينز وقمصانًا نصف كم، بعضهم يعتمر قبّعات عريضة يجفِّفون عرقهم بمناديل جيب. بين الأخيرين لاحظ وجود امرأة شقراء ترتدي بنطلون جينز وقميصًا كتّانيًّا مجعّدًا، وتنتعل صندلًا جلديًّا. كانت أعين الرجال الريفيّين، ومن يبدون موظّفين حكوميّين أو تجّارًا، مسلّطة عليها كرادار نَشِط. كانوا يعانون من الحرارة، أو ربّما من منظر المرأة الشقراء، التي تتحرّك في كرسيّها بحرّيّة وتضع ساقًا على ساق، ما يجعل قدمها البيضاء في الصندل الجلديّ عرضة لمزيد من النظرات. مغناطيس نظرات.
بدا وجود الأجنبيّة الشقراء نافرًا، بل فريدًا كأنّها المرأة الوحيدة على الأرض، حتّى إنّ يونس، العاشق الولهان، لم يستطع منع نفسه من النظر إلى خصل شعرها الأشقر المتهدّلة على وجهها، رغم أنّها تكبره، كما تبدو ملامحها، بعشر سنين على الأقلّ. فكّر كيف يبدو العاديّ، خارج نسيجه واعتباراته، غير عاديّ بالمرّة، كيف يكتسب حضورًا وثقلًا قد لا يتوافر عليهما في سياقه الطبيعيّ فيبدو كأنّه طفرة، وكيف يشفّ عن جوهر ليس من لدنه، أو كأنّ هذا الجوهر النفيس كان جوهره طوال الوقت، ولكنّنا لم ننتبه إليه من قبل إلّا عندما وُضِعَ في حالة نُدرة.
أذهله أنّه نسي، للحظة، حبيبة قلبه رلى وراح يُحدّق في خصل شعر المرأة، بل أمكنه، وهو يعبر البهو سريعًا، أن يرى طرفًا من سروالها الداخليّ. كان أبيضَ، مُخَرَّمًا. أزعجه الأمر. أزعجه أكثر أنّ طرف سروالها الداخليّ الذي لمحه عندما كانت تميل، بجذعها، إلى الطاولة، تراءى له، غير مرّة، وهو مستلق على سريره تحت المروحة الخاملة، فحاول طرده باستدعاء تعويذة مضادّة: صور مختلفة لرلى. صورتها تضحك فتتحرّك غمازتاها كبؤرتي عاصفة مُهدِّدَة، صورتها تطوّقه أو تمسّد جبينه كأمّ صغيرة، صورتها هذه أضحكته من أعماقه، تقطف وردًا جوريًّا من حديقة ذويها على صوت مغنّيتهما المفضّلة. يلوم الورد الذي جرح أيادي كثيرة بمن فيها أيادي الجناينيّة. تطبيق ساذج لأغنية حبّ تدشينيّة في علاقتهما المشبوبة!
نبّهه وجود المرأة الأجنبيّة إلى أنّه لم يشاهد امرأة أخرى في بهو الفندق، أو في مطعمه، بل لم ير امرأة، حتّى تلك اللحظة، بين موظّفي الفندق. بدا له الأمر غريبًا. حتّى في الشوارع التي دخلتها سيّارة الأجرة، وصولًا إلى محطّة الحافلات القادمة من الخارج، لا يتذكّر أنّه رأى امرأة وجهًا لوجه أو في مرمى البصر، سوى بعض العباءات السود التي كانت تتراقص في بعض الشوارع الفرعيّة، التي لم يجرؤ على التوغّل فيها خوفًا من طلب عون غير مطلوب في حالته. فأين نساء هذا البلد؟
عندما سمع كلام المجموعة الأجنبيّة التي كان أفرادها يرتشفون شايهم من كؤوس شفّافة منمنمة، عرف لغتهم التي تعلّمها في المدرسة، ففهم أنّهم يتعقّبون، على الخارطة، خطّ رحلات المراكب التي تعبر أطلال الممالك البائدة في هذه البلاد.
كانت لغرفته نافذة تطلّ على الشارع الذي يقع فيه الفندق، وبدا له شارعًا رئيسيًّا بسبب المحالّ التجاريّة وحركة السيّارات والسابلة التي تنقطع، تدريجيًّا، مع منتصف الليل، ليحلّ محلّها صمت ثقيل، مريب. كان بمقدوره أن يرى من نافذة غرفته جانبًا من ذلك الشارع الطويل. عيادات أطبّاء، محالّ ثياب، مطاعم، مكتبات. عراقة مُغْبَرَّة، عِزٌّ تبديه تفاصيل صغيرة متلكّئة في بعض المباني الذي يمزج بين الطرز المحليّة القديمة والمؤثّرات الخارجيّة، تفاصيل أزمنة ولّت تكافح من أجل بقاء غير مضمون: تشبيكات خشبيّة، توريق جصّيّ لنباتات وزهور وأشكال هندسيّة متداخلة، بلكونات عائليّة مهجورة للضجيج والغبار القادمين من الشارع التجاريّ.
لفتت نظره دقّة الخطوط التي كُتِبَتْ بها لافتات المحالّ. فهي تتراوح بين الثلث والتعليق والرقعة والديوانيّ الغنوج، منفّذة بمزاج فنيّ رائق وحِرَفيّة عالية، وتنافس خفيّ لأيد تحوّل بعضها، على الأغلب، إلى تراب. كان معظم اللافتات مكتوبًا بهذه الخطوط الأليفة إليه. يستطيع تمييز الفروق الدقيقة، أحيانًا، بين خطٍّ وآخر من العائلة نفسها. لو سُئِلَ يونس عن سرّ معرفته بهذا الفنّ المخصوص، دقيق القواعد والأحكام، لقال بنفاد صبر مصطنع بعض الشيء: إنّه التعوّد ليس إلّا. فهذه الخطوط هي، بعد كلّ شيء، مهنة عائلتي!
كان يسمع، قرابة منتصف الليل، أصواتًا كالنشيج تعبر الشارع بتقطّع، كأنّها طعنات حادّة في جسد الليل. لم يرَ أصحابها لكنّه قدّر أنّهم سكارى. قدّر، أيضًا، أنّ ذلك النشيج الموحش غناء طالع من حزن دفين يُسْفِرُ عن وجهه العاري، على ما يبدو، تحت وطأة السُّكر الشديد. نشيج. أصوات حلقيّة ناهرة. هرولة. ثمّ صمت يعمُّ الشارع. تكرّر سيناريو النشيج والأصوات الحلقيّة الناهرة والطراد والصمت كلّ ليلة، وفي التوقيت نفسه تقريبًا.
* أمجد ناصر شاعر وروائيّ أردنيّ يقيم في لندن، عمل في صحيفة 'القدس العربيّ' منذ صدورها عام 1989، وقد أصدر عددًا من الدواوين الشعريّة وكتب أدب الرحلة، وتُعَدّ 'هنا الوردة' روايته الثالثة.