كتابة العزلة... عزلة الكتابة

خاصّ فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة
تغيّر مسار سؤال العزلة المُلحّ والمواظب بمجيئه وذهابه إلى أذهان الكتّاب، أختبئ في مكان ما مثلما اختبأ الجميع في البيوت، صمْت منفلت في الشوارع، بينما البيوت باتت موطنًا للصخب والخوف والأسئلة والهواجس والكوابيس الجماعيّة، بعد أن كان الكابوس حدثًا فرديًّا مميّزًا ينجح في إرهاب شخص واحد لا غير.
في الغالب تكون العزلة فعلًا اختياريًّا، يُقدم عليه الكاتب متعاليًا نوعًا ما عن الانخراط في الشؤون المجتمعيّة والسياسيّة، أو محاولة للاستفراد بالزمن دون الخوف من فقدان الصوت والحركة في الخارج، وإزعاج العالم المكتظّ، وتأثير أخباره الجيّدة والسيّئة، إلّا أنّ الحالة الآن عزلة عالميّة إجباريّة للمرّة الأولى على هذا النحو من الشمول والكثافة.
ما زال الحكم مبكّرًا على ما ينتج من موادّ أدبيّة وفنّيّة في الفترة الحاليّة؛ إنّ ما ينتج الآن يحمل آثارًا لجملة مشاعر متناقضة واضطرابات إنسانيّة، وهي أعمال مولودة في ظروف خانقة اقتصاديًّا وسياسيًّا، حالها يشبه أدب الحرب، عندما يكون الاختباء الملجأ الوحيد من الموت، أو السجن حين تكون العزلة إجباريّة.
كان سيوران يكتب عن العزلة ويعيشها وينظّر لها، يقول: "جميع الطرق تؤدّي إلى ذواتنا"، كانت فلسفة الانفصال عن الآخرين طريقته للانخراط الشعوريّ بهم، وفهْم عوالمهم الخاصّة وعالمه المشتبك والكتابة عنهما. إذا كانت الحياة واحدة من محفّزات الكتابة، والعزلة مكان إعادة تشكيل المادّة الخامّ، الناتجة عن الانغماس في العالم الخارجيّ العامّ لإخراج مادّة جديدة، فالظرف الآن من الصعب أن يُنْتِج فنًّا؛ لذا كان لي حديث مع عدد من الكتّاب في أجناس أدبيّة مختلفة، حول ماهيّة الكتابة وأسئلتها وجدواها في عزلة الوباء.
ليس حقيقيًّا أنّنا لا نحبّ الحياة

القاصّ عامر علي الشقيري، صاحب "هزائم وادعة" (2013)، و"تداعيات مسخ مسالم للغاية" (2015)، قال: "إنّ ما يحدث الآن عزلة إجباريّة كنت مرغمًا عليها؛ وهنا تكمن صعوبتها وحدّة انعكاساتها على تفصيل يومي. في البدء كان الخوف، أو فلنقل الرعب، كان أكبر من الكتابة ومن الأحلام، الرعب الّذي جعل الهواء ثقيلًا، وانسحب على كلّ شيء: مقبض الباب، صوت خطوات تائهة في الخارج، نوبة سعال بعيدة تزامنت مع هبّة ريح... إلى أن غرقتُ في التفاصيل؛ هل عقّمت علبة الفول؟ ويا للسخرية! هل عقّمت علبة سجائري؟
استوعبت مع مرور الوقت الصدمة الأولى، ثمّ استأنفت حياتي، وتأكّدت أنّني – يا للمفارقة! - أكثر مَنْ يكتب عن الموت، وفي الحقيقة أكثر مَنْ يحبّ الحياة... الكتابة الآن مهمّتها أن تضع الخوف على الطاولة، وتقشّره كي أتناوله على مهل بالشوكة والسكّين، قطعة قطعة وليس دفعة واحدة، هكذا فقط يمكن أن أنجو وأجتاز المرحلة".
فقدان التواصل
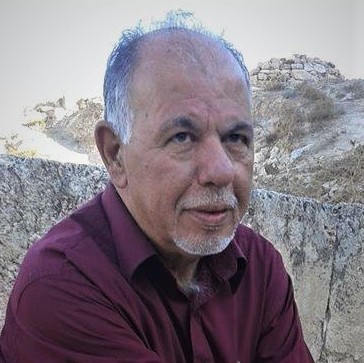
قال الروائيّ هاشم غرايبة، وآخر إصداراته رواية "البحّار" (2018): "لعلّ أحلام اليقظة المعادل الموضوعيّ للعزلة؛ الأحلام والخيال وقود الكتابة. عزلة كورونا تؤجّج المخيّلة لتصوّرات لم نفكر فيها من قبل؛ لعلّ هذا الكون ليس ما هو عليه، بل ما نتصوّره نحن عنه!
كلّما ضاقت الحال صار التواصل أكثر إلحاحًا؛ بمعنى صارت الكتابة والقراءة نافذة أوسع لرؤية الكون. رغم التطوّر العلميّ والتقنيّ الهائل في وسائل الاتّصال، إلّا أنّ التواصل الإنسانيّ الحقيقيّ حاجة ملحّة للكاتب وللكتابة؛ فحركة الجسم وتغضّن عضلات الوجه أو انبساطها أو التواؤها، وطريقة الوقوف أو الجلوس، تكاد تكون كلّها طرقًا للتعبير والتواصل، أهمّ من الهاتف النقّال والإنترنت".
الخوف على الأحلام

الهموم الجمعيّة على اختلافاتها تؤدّي بشكل ما إلى خلق قاموس لغويّ، يستخدمه الكثير ممّن يعايشون الظروف نفسها، وقد صار للعزلة الّتي نعيشها الآن ألفاظ وجُمل تقال يوميًّا في وسائل التواصل الاجتماعيّ، باعتبارها طريقة الاختلاط الوحيدة المسموح بها. كلمات مثل العزلة والحجر والصحّة والخوف وضحايا وإصابات، هي ما حلّ ضيفًا على قاموس الكتّاب، وربّما للحجْر سمة مريحة؛ لأنّه وضعنا للمرّة الأولى في ظرف، نحكي فيه مخاوفنا ونشاركها على الملأ.
قالت الشاعرة مها العتوم، الّتي صدر لها أربعة دواوين شعريّة؛ "دوائر الطين"، و"نصفها ليلك"، و"أشبه أحلامها"، و"أسفل النهر": "زرت إيطاليا مرّات عدّة، وتجوّلت في كثير من مدنها، ووقعت في غرام فينيسيا منذ اللحظة الّتي مشيت على جسورها الخشبيّة، وتجوّلت في شوارعها الساحرة، والماء أمامي وخلفي وعن يميني وعن يساري، بل إنّني حلمت أن أمتلك بيتًا سابحًا في الماء كبيوتها، يا الله! وأذهب إلى عملي بقارب خشبيّ، وأبنائي أوصلهم في طريقي إلى مدارسهم، وأذهب أنا إلى جامعتي، مكان يحمل بقايا أنفاس عربيّة كانت حارّة حين جاؤوا إلى البندقيّة قبل قرون، وتركوا فيها لمساتهم وآثارهم وملامحهم في المكان والأشياء. هل كنتُ هنا في زمن آخر؟ هل روحي الّتي تتناسل عبر الأمكنة والأزمنة؟ أأنا أم جدّتي أم جدّة جدّتي أم جدّتها؟
مررت فيها قبل سنوات حين كنت في مقتبل العمر، وفي العشرينات أعوم في أحلام يقظة تطغى على يقظتي ذاتها، حين وقفت على ’جسر التنهّدات‘ كما يسمّونه، وكدت أفعل مثل أسلافي وأُلقي بنفسي عن حافّته، لا يأسًا ولا حزنًا، بل عشقًا، حين تقف وتشعر بالحبّ وتسمع تنهّدات العاشقين والعاشقات ممّن مرّوا قبلك، وبلّلوا الخشب بدموعهم، وفرّ الحمام من تنهّداتهم، حين تقف وتظنّ أنّك تسمع كلّ هذا، وتريد أن تبلغ أقصى ما تبلغه العاشقة، في التحام الروح بالروح والمشاعر بالمشاعر والعشق بالعشق. تنهّدت كثيرًا، وأطبقت على الحلم الّذي راودني هناك بمقلتَي ذاكرتي، لا عينيّ.
هذا الصباح طالعتني وسائل التواصل الاجتماعيّ بفيديو لموكب من سيّارات الجيش، الّتي تعبر شوارع مدينة بيرغمو الإيطاليّة، تحمل جثث الموتى بفايروس كورونا، ليودّعها أصحابها من على شرفات منازلهم، يلقون نظرات الوداع الأخيرة على الأقارب والأحبّة، وهم ثاوون خلف التوابيت المحكمة الإغلاق بإشراف طبّيّ رصين، لئلّا يصاب الأطبّاء أو طاقم التمريض بالعدوى من هؤلاء الموتى حتّى بعد وفاتهم. رعب حقيقيّ، كان الموكب يبدو كأنّ حديد السيّارات ينشج ويبكي، وكأنّ ظلالًا سوداء طويلة تمتدّ على الشارع وتكتنفه من كلّ جوانبه، وأمّا الأيدي الّتي تلوح فيبدو أنّها شُلّت، وتحرّكها عصًا طويلة مثل عصا ‘السلفي‘ تدور بحركة ميكانيكيّة آليّة، ولا تظهر الوجوه وما تحمل من أثر الفجيعة والألم، في فقد حبيب أو عزيز أو صديق، فقْد مفاجئ، يكاد يُذهب بالعقل ما في الأمر من سرعة ومفاجأة وأسًى. في هذه اللحظة تحديدًا، تذكّرت حلمي الّذي أطبقت عليه خمسة عشر عامًا، فانفلت مرّة واحدة، مثل صاعقة ضربت رأسي، تذكّرته وأنا امرأة النسيان وأخته ودليله، ومرّة واحدة طار مرّة أخرى، كالوحي أو أشدّ وطأة؛ فأجهشت بالبكاء الّذي يشبه بكاء طفل ضائع، صحا على نفسه في الغابة، وقد تركه والداه دون دليل ولا زوّادة، كان نشيجًا طويلًا ومفتّت أكباد، تركني في حالة لا أُحسد عليها ولم يتركني، ولوهلة ظننتني مصابة بنوبة هلع ممّا يجري حولي، تلك النوبة الّتي صارت تعاودني دائمًا، حين أخاف من فقدان حدود ذاتي، وانفتاح ألمها وحزنها، على آلام العالم وأحزانه. حالة أعرفها جيّدًا من تكرارها حين تتسارع نبضات قلبي، وأُصاب بحرارة تملك عليّ جسدي من الرأس إلى القدم، ويستهلكني الرعب والقلق والتوتّر. أكانت نوبة هلع فعلًا، أم هلاوس مرضيّة تحتلّني شيئًا فشيئًا؟ أآذاني الموت في موكب طويل، أم البعد عن الأحبّة، وعدم القدرة على توديعهم الوداع الأخير، وضمّ ملامحهم في الذاكرة بصورة تبقى إلى آخر العمر الملاذ الدافئ من برودة الفقد؟ هواجس شتّى تملّكتني وأسلمتني إلى نوم عميق، هذا النوم تمنّيت أن يستمرّ إلى أن تنتهي الكورونا".
ما بعد كورونا

الكتابة حرفة لا قواعد لها، وأكثر ما يميّزها من حِرَف أخرى، أنّ لكلّ كاتب طريقته في الانشغال بما يخدم مشروعه، والاشتغال على تشكيل منجزه الأدبيّ. لقد عبّرت مجموعة كبيرة من الكتّاب عن عجزهم اللغويّ في هذه الفترة، والصعاب الّتي تواجههم في القراءة، ومجموعة أخرى استثمرت هذا السكون الجماعيّ والارتباك الخارجيّ لتكمل منجزها.
الكاتب عبدالله زيود، صاحب "ولم نلتق بعد" (2013) و"باولا" (2016)، قال: "مكّنتني هذه العزلة القسريّة من استكمال مشاريع أدبيّة مؤجّلة، وترتيب النصوص والقصص الّتي أنوي نشرها لاحقًا، وسنحت لي الفرصة معاودة النشاط في المشاريع الأدبيّة الصوتيّة. نعمل الآن أنا وفريق العمل على تسجيل مجموعة رسائل هاربة من ‘الإنبوكس‘، وهي مجموعة رسائل ستُنشر ضمن مجموعة قصصيّة جديدة عنوانها ’قصير القامة قلبي... رفّ الحبّ عالٍ‘".
إذًا، فنحن نكتب لأنّنا لا نعرف كيف نترك هذه الفعلة، وبما أنّ الأمل ضروريّ الآن، ليصبح بمقدورنا أن ننتظر عودة الحياة في خصامنا معها، وتعلّقنا الحقيقيّ بما تخبّئه لنا رغم جهلنا به. لا تختلف كورونا عن بقيّة المآسي الّتي عايشتها البشريّة، وطحنت كثيرين تحت عجلاتها، لكن إن ظلّ ناجٍ واحد فستكون الكتابة مهداة إليه، وإن لم يظلّ فالكتابة مهداة إلى الحياة الّتي كنّا جديرين بها.

شاعرة أردنيّة، درست نظم معلومات حاسوبيّة وعملت كاتبة ومجوّدة نصوص في "مسرح دمى العربة" في عمّان، تنشر نصوها ومقالاتها في عدد من المنابر العربيّة.







