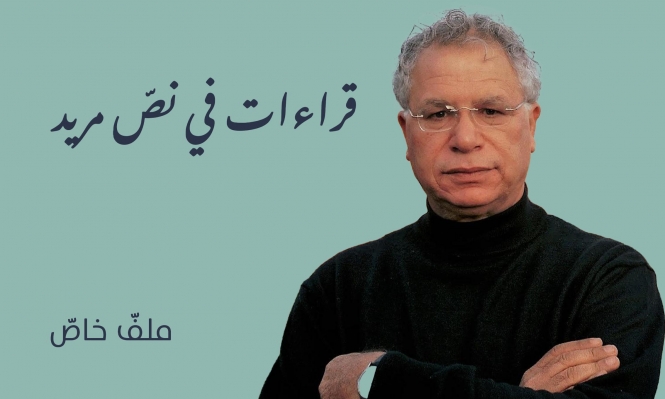ريف مريد البرغوثي

انشغلت الحركة الإبداعيّة الفلسطينيّة في كثيرٍ من تجلّياتها، منذ نكبة عام 1948، بمجابهة الاستعمار وتبعاته، وارتكزت غالبًا على صورة يمكن تقعيدها في معادلة: [العالم - فلسطين = ؟]، وقدّمت أشكالًا عدّة مقترحة في قوالب مختلفة، من قصائد وروايات ومقالات وأغانٍ ومسلسلات وأفلام، وانصبّ كلّ ذلك الجهد في صالح تأطير المعادلة المتخيّلة تلك. إلّا أنّها، وفي جهدها الكبير والممتدّ على أكثر من 72 عامًا تقريبًا، انشغلت عن مسألة قد تبدو أهمّ، وهي صورة فلسطين بدون احتلال، وبالتالي صورة المنطقة والعالم. هذا الانشغال، غيّب إلى حدّ كبير الصورة الّتي تنحاز إلى واقع فلسطين الطبيعيّ والاجتماعيّ والفنّيّ والتاريخيّ، وربّما الدينيّ، في وقت كان من شأنها أن تحافظ فيه على صورة الأرض وسكّانها، في منأًى عن الاحتلال، لخلق معادلة جديدة قد تكون [العالم + فلسطين]، ومآلات هذه الصورة الكبرى، إلّا أنّها الحرب تبلع دائمًا الصور وتتصدّر المشهد.
إلّا أنّ بعض التجارب الناضجة، لم تتخلّ عن تحميل صورة فلسطين الطبيعيّة، بما احتوت من تراث محكيّ أو ملموس، ومن سمات بيئيّة، وسلوك اجتماعيّ وجماليّ، على الشعر، دون الذهاب بها بعيدًا عن الاحتلال. والشاعر الراحل مريد البرغوثي، واحد ممّن أتقنوا هذه الصنعة، وتجلّى ذلك عبر ذهابه المستمرّ إلى الريف الفلسطينيّ الغنيّ في شعره، وعبر بنائه الشعريّ المتمثّل في غير موقع إلى الموروث الشعبيّ، وعبر حضور العائلة أيضًا في مجمل أعماله، كدلالة اجتماعيّة شرقيّة، لم يستطع التغريد خارجها.
الذهاب المستمرّ إلى القرية
في شعر مريد البرغوثي انحياز مكانيّ غريب، لا يتعلّق بأسماء المدن ومحالّها، إنّما بالصفات وما تنطوي عليه من أسرار مؤثّرة، يمكنها أن تنتحل اللغة مرّة، وترتاح في الصور مرّة أخرى، ورغم تنقّل الشاعر من مكان إلى آخر، ونزوله، كما يقول، في 45 منزلًا طوال حياته وتنقّله الّذي فرضته ظروف سياسيّة عليه، ورغم إصراره على أنّه لا يعيش في الأماكن إنّما في الزمن، إلّا أنّ القرية تغفو في حضن شاعريّته، وتستيقظ في مخيّلته كما يستيقظ الفلّاحون، ويمكن التعبير عن ذلك من خلال الإتيان على التناصّ مع الموروث الشعبيّ في شعره، وقد جاء ذلك تصريحًا وتلميحًا ومزجًا في غير موضع؛ إذ اعتمد على الأغنية الشعبيّة في تصوير الموقف، وجاءت منسجمة مع جوّ النصّ على اختلاف الأجواء تلك، فمرّة في السجن، وأخرى في عرس الشهيد، وثالثة في زفّة العرس. ووردت أغانٍ شعبيّة عدّة في نصوصه، كالميجانا والطير الأخضر وغيرهما.
ورغم تنقّل الشاعر من مكان إلى آخر، ونزوله، كما يقول، في 45 منزلًا طوال حياته وتنقّله الّذي فرضته ظروف سياسيّة عليه، ورغم إصراره على أنّه لا يعيش في الأماكن إنّما في الزمن، إلّا أنّ القرية تغفو في حضن شاعريّته...
على أنّه اشتغل بشكل أعمق على هذه المسألة من خلال أسطرة مادّة التراث، كما بنى على القصّ الشعبيّ نصوصًا عدّة، عبر أسطرة شخصيّاتها البسيطة، وإذ كان الثوب المطرّز ملمحًا واضحًا من ملامح التراث، فقد اختاره ليكتب التاريخ بخيوط الحرير الملوّنة في قصيدة «رنّة الإبرة»؛ إذ تبدأ القصيدة من الثوب، إلّا أنّها تعبر الحقل والناس والموسيقى والوعي والتاريخ الاجتماعيّ للفلسطينيّين، قبل أن تصلهم وَصْلَ عروق التطريز بأجدادهم الكنعانيّين، وتفكّ أسرار حضور المرأة التاريخيّ والدينيّ في المجتمع الكنعانيّ، ومنه إلى الفلسطينيّ، وهذا الوعي العميق كلّه، يترقرق بلغة سمحة تتّحد بالريف أيّما اتّحاد، ولا يمكن كلّ هذه التجلّيات أن تأتي إلّا في بيئة ريفيّة، أثّثها البرغوثي بكثير من الأشجار في نصوصه انحيازًا إلى بيئته الزراعيّة، وما تنطوي عليه من معانٍ تناور لتثبّت ارتباط الفلسطينيّ بالأرض كفلّاح، ممّا شكّل نقضًا لرواية العدوّ، بأنّ الفلسطينيّ طارئ على المكان.
خطّ الحنين
قد لا تكون قصيدة «الشهوات» من ديوان «رنّة الإبرة» (1993)، أولى القصائد الّتي قرأتها لمريد، لكنّها - دونما شكّ - أوّل ما غرقت فيه من نصوصه، وعجبت كيف يأخذك النصّ من منطق العلوّ الذاتيّ، والوحدة الخالصة:
كسّر البرق بلّوره في الأعالي
وأفلت من دغله نمرٌ طائش اللونِ
رنّت على ظهره فضّةُ الليل والرغبة الغامضة
كأنّ الصواعق تعدو على جسمه وهو يعدو ويعدو ويعدو
إلى آخر مطرحٍ في الماضي، بالمعنى التنازليّ:
"حَبّ الشباب ومشط السخافةِ"، "رسم الشوارب بالحِبْر فوق الشفاهِ"، "دويّ البلوغ الّذي يخلط الرعب باللّذّة المستطيلة شيئًا فشيئًا".
ثمّ العودة إلى المشهد العامّ الّذي تحفّه الأشجار أيضًا.
ولعلّ الحنين هو الإطار العامّ للقصيدة؛ فالشاعر يحنّ طوال النصّ، ويقارب بين الذكريات والأسى، ويضع بينها فواصل فلسفيّة تنقل الحنين ذاك من حيّز المجانيّة إلى الجدوى، بما يُحيل الحسرات إلى «شهوات»، ويجعل التنهيدة المستغرقة منذ أيّام العثمانيّين، مراجعة للحسابات.
وإن كانت قصيدة «الشهوات» أصبحت واحدة من نصوصه القديمة، فلنرَ ماذا فعل في ديوانه الأخير «استيقظ كي تحلم»، وتحديدًا في قصيدة «خلود صغير»:
مُفردًا، شاهقًا، شرفتي غيمة دلّلتها السماء،
أطلّ على شاطئ جنّة،
قال أخضرها كلّ أقواله هامسًا، هادرًا
فُسْتِقِيَّ الذوائب، يوشك يلمع،
أخضر يرضع، يحبو،
يكاد يشيب إلى المشمشيّ المضيء،
ويدخل في الصدئيّ الموشّى كما قشّر رمّانةً أوغلت في النضوج
وأخضر فيه الدخانيّ، يهرب من زرقةٍ خالطته
خلف أزرار هذا القميص الخفيف،
أواصل أشغال مَنْ ظلّ حيًّا:
أدفئ رضوى من البرد
يسهر عندي مجيدٌ
وتقطف أمّ منيفٍ زهور حديقتها في انتظار منيفْ...
هذان نصّان تفرق بينهما سنون طويلة، إلّا أنّ القالب نفسه؛ ففي «الشهوات» يبدأ من مشهد غامض في أعماق الذات، ثمّ ينفلت على الماضي، ويحمل معه العائلة بمفهومها الواسع: الشعب الفلسطينيّ.
أمّا في «خلود صغير»، فيبدأ من المكان ذاته، ويستعيد الموتى، فكلّ مَنْ يذكرهم بعد جملة "أواصل أشغال مَنْ ظلّ حيًّا" باستثناء ابنه تميم، كانوا ميّتين عندما كتب القصيدة، ويصادف أنّهم عائلته، بمفهومها العاديّ.
وفي الحالتين، يستخدم كلّ هذه العناصر من مكان وشخوص وزمان، من أجل غاية واحدة، هي الحنين، ليضعه نقطة انطلاق لمقولة تصف ما يعانيه في منفاه، كأنّه يريد أن يعيد المسلسل من أوّله، ليتوقّف عند الحلقة الأخيرة قبل أن يَحولَ الاحتلال بينه وبين فلسطين، أو قبل أن يَحولَ الموت بينه وبين هؤلاء الأشخاص، الّذين شكّلوا الفصول الأهمّ من حياته.
صورة العائلة
الآثار في شعر مريد البرغوثي بالغة الأهمّيّة، وربّما يتعلّق الأمر بامتداد الأسباب في روح الشاعر. العائلة مثلًا، شكّلت في شعره هاجسًا مستمرًّا، سواء جاء عليها أو لم يجِئ، فثمّة أصوات دائمًا في الخلفيّة، تعبّر عنها موسيقى نصّه، أو ميله إلى السرد داخل القصيدة، كأنّه يُحَدِّث أحدًا، أو يقصّ نبأ بتفاصيل عائليّة، حتّى أنّك تكاد تسمع طَرْقَ الصحون بالملاعق، أو قهقهات الرجال ودعاء النساء.
ولعلّ الحنين هو الإطار العامّ للقصيدة؛ فالشاعر يحنّ طوال النصّ، ويقارب بين الذكريات والأسى، ويضع بينها فواصل فلسفيّة تنقل الحنين ذاك من حيّز المجانيّة إلى الجدوى، بما يُحيل الحسرات إلى «شهوات»...
ويعبّر عن ذلك من خلال الخوض في التفصيل العائليّ دائمًا، سواء شخصيًّا كان أو عامًّا، مثل أن تدرك قصيدته خوف الأب على ابنته من الانفلات، أو فهمه لموقف الزوجة أمامه، إذ "يُحدّثها قلبها بانفلات الفتاة، ولكن تهوّن على زوجها الأمر حتّى يهون".
ولا أجد أمامي سببًا قاطعًا لورود الأصوات تلك في قصيدة البرغوثي، إلّا أنّني أرتاح لربط الأمر بانضباطه في عائلة مكوّنة منه ورضوى وتميم، تجعله أقرب إلى الأب الشاعر منه إلى الصعلوك أو المنفرد، بَيْدَ أنّ المسافات الزمانيّة والمكانيّة الّتي شتّتت هذه العائلة على مرّ سنين، وفقده للتفاصيل تلك، كانت تمنحه بعدًا اشتهائيًّا أعمق يطفو في قصائده دائمًا، يُضاف إلى ذلك امتثال مريد الشعريّ إلى العائلة الممتدّة، وقد عانى معها فقدًا طويلًا شرحه في «رأيت رام الله»، جعله على ما يبدو يعلّق الصورة العائليّة على كلّ جدار، حتّى داخل القصيدة.

شاعر وكاتب فلسطينيّ من قضاء يافا، يحمل الجنسيّة الأردنيّة ويقيم في عمّان، يكتب في الصحافة العربيّة. صدرت له مجموعتان شعريّتان؛ "بائع النبيّ" عن دار موزاييك - عمّان، و'أؤجّل موتي' عن دار فضاءات - عمّان، وترجمة 'الوطن - سيرة آل أوباما' لجورج أوباما، الأخ غير الشقيق للرئيس الأمريكيّ باراك أوباما، عن مؤسّسة العبيكان، الرياض.