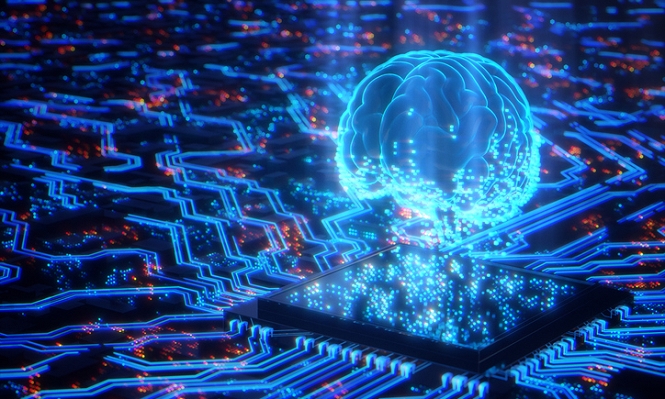انطفاء

(1)
وجدت نفسي على عتبة بيت أطرق بابه بلطف. لا أعرف كيف وصلت إلى هنا، لكنّي أدركت مباشرة أنّني في مكان آخر، وفي زمان آخر، ولم أسأل نفسي كيف وصلت إلى هنا. فتح رجل شابّ لي الباب، كان يشارف على الأربعين، ويلبس بدلة رياضيّة رماديّة، بلون شعره، وشعوره. ابتسم، ومدّ يده مرحّبًا: "تفضّل أستاذ إياد...".
"هل تعرفني؟"، سألت مستغربًا، ودخلت إلى البيت، فصدمتني الأغراض الّتي تراكمت فوق بعضها بعضًا، على الأرض، وفي الممرّات، وعلى الطاولات، وعلى الثريّات المعلّقة الكثيرة الأضواء، من أين أعرف هذه الثريّا المحاطة بقماش أبيض مشدود، مكتوبًا عليها بأحرف عربيّة "من شدّة حبّي لبلادي"، وقد انسدل منها شريط برتقاليّ؟
"أعرفك طبعًا، فأنت كاتب هذه القصّة"، أجابني بتثاقل مستغربًا مِنَ استغرابي.
أزحت بعض الأغراض من بين قدمَي، فلفتت انتباهي كرة قدم، تقسّمها خيوط دقيقة إلى اثنتي عشرة شريحة قماش مقوًّى، متناسقة برتقاليّة اللون، وطاولة زهر مفتوحة مرميّة فوقها سمّاعة أذن بنّيّة صغيرة، وكفوف ملاكم، وفحص حمل تلوّن فيه الخطّان.
"ماذا تفعل أغراض قصصي كلّها هنا عندك؟"، سألت بينما وضعت «بردقانة» تحت إبطي.
"حسنًا، القصّة هي أنّك تأتي إلى المستقبل، وتلتقي بقيّم معرض في «متحف مدينة الماضي»، سيجسّد قصصك في أغراض محسوسة، بعد موتك. «الكونْسِبْت» في المعرض أنّ الناس في مدينة المستقبل يريدون، بشكل مهووس، تحويل كلّ شيء إلى محسوس بعد أن قضت «الداتا» على مشاعرهم، وحاول النظام أن يجرّد حياتهم من العلاقة بالأشياء وبالناس. هذه فكرتك".
"فكرة جميلة، بغضّ النظر عن أنّني صاحبها"، قلت خجلًا، وبحثت عن مكان للجلوس، فوجدت كنبة جلديّة سوداء بيدين خشبيّتين. كنت أحبّ دومًا الجلوس على هذه الكنبة في بيتنا الّذي أطلّ على السور القديم".
"فعلًا ..."، أجابني، "فكرة جميلة، لكن..."، قال، وذهب إلى المطبخ. لحظة، هذا مطبخ جدّتي عِفّت، "هل تريد أن تأكل شيئًا؟ جدّتك أعدّت لك قلّاية بندورة، قبل أن تذهب إلى قطف الزيتون".
"فكرة جيّدة!"، أجبت متحمّسًا؛ إذ كنت أتضوّر جوعًا.
"أنا أيضًا لديّ أفكار جيّدة!"، قال بينما أَحضر كلّ القلّاية ووضَعها أمامي، على الطاولة الّتي كانت في صالون بيت أهلي، "لقد رأيت هذه الطاولة في كلّ صوركم الأولى!"، قال، وأشار إلى الحائط الّذي لم يظهر لونه من كثرة الصور المعلّقة عليه. "لكن ماذا؟ قلت إنّ فكرة القصّة جميلة، لكن..."، سألته، وغمّست البندورة برغيف الطابون الّذي لا بدّ من أنّ عمتي جيهان هي الّتي خبزته في «برّاكيّتها» على السطح يوم السبت.
"بصراحة، لم يعجبني كيف كنت تريد أن تصف مدينة المستقبل: الهبوط بالسيّارة الذاتيّة القيادة على سطح أخضر مزروع على أعلى برج سكنيّ استداميّ، فيه كلّ شيء، ولا داعي للخروج منه. مدينة ذكيّة لم يعد الناس يدفعون فيها بالأوراق النقديّة، وممنوع أن يقودوا فيها السيّارات، ويمتنعون عن ثاني أكسيد الكربون بكلّ طريقة ممكنة؛ لكيلا تفيض المزيد من البحار".
"هكذا تخيّلتها، هذا ما توقّعت أن تصنعه التكنولوجيا بالحيّز المدينيّ!"، قلت مدافعًا عن مخيّلتي، وقد توقّفت للحظة عن الأكل.
"وماذا عنّا؟"، قال بعتب، "تخيّل لو أنّك كتبت باقي قصصك؛ أي تلك الّتي عشتها في زمنك، بهذه الطريقة، مجرّد أنّك فكّرت في أن تضيف ‘ال‘ التعريف على كلمة المستقبل، وكلمة الماضي، هو أمر غير مقنع، هل كان هناك؟ في أيّ وقت كان؟ واقع واحد وزمن واحد؟ ليكون لنا الآن واقع واحد؟ أقصد ليكون لكم مستقبل واحد؟ ولنا ماضٍ واحد؟ ألا يعيش كلّ واحد فينا غير زمن واحد؟ ولا يكون لذات المكان أزمنة متداخلة؟ من أين امتلكت الجرأة على التفكير بهذه الطريقة أصلًا؟"، سألني، وفي صوته غصّة، وبعض الغضب النابع عن حبّ، ولامني، "لم تفكّر فينا...".
"مَنْ أنتم؟"، سألته بصدق.
"نحن الناس، ناس المستقبل إن شئت"، قال، وصمت، رفع سبّابته قليلًا ليسمع جيّدًا. "لقد استيقظَتْ!" قال فرحًا، وذهب إلى مطبخ آخر، من خشب السنديان، لا بدّ من أنّه مطبخ بيتنا الّذي كان يطلّ على أضواء الميناء وانحناءة الخليج. وضع ماء فاترًا في الزجاجة البلاستيكيّة حتّى الحدّ المطلوب، أضاف مسحوق الحليب، وحرّكها بحنان. انتبه إلى أنّني أنظر إليه، "أشعر بأنّها جائعة. لا بدّ من أنّها جائعة"، واختفى في الممرّ.
بينما انتظرته، تأمّلت في كلّ الأغراض المرميّة والصور المعلّقة في كلّ مكان. إنّها صورة الألتراساوند الأولى، وتلك في الشهر الخامس. حاولت أن أنزع الصورة لأمسكها، فاكتشفت أنّ الحائط شاشة لمس، فأخذت أقلّب كلّ تلك الصور الّتي لم ألتقطها بأيّ كاميرا، والّتي تتابعت من دون أيّ منطق.
حين وصلت إلى صور مزعجة، من الصفّ السابع، في المدرسة الجديدة عليّ، انزعجت لأنّني كنت أشعر بالوحدة والضيق آنذاك، ولأنّني كنت أعرف أنّني لست أقوى ولد في الصفّ، ولأنّني، بسبب ذلك، لم أردّ على تلك الإهانة. حاولت أن أبحث عن زرّ لمحو الصورة، لكنّي لم أجد سوى ثلاث إمكانيّات: «إنكار» و«تورّط» و«تجاوز»، فتجاوزتها.
"جمعت هذه الصور لكي أفهمك، لا تخف، لن أعلّقها، فهي ليست ملموسة. جمهور الفنون في ‘متحف مدينة الماضي‘ بمدينة المستقبل، كما حدّدت أنت بنفسك، لا يريدون سوى المعروضات الملموسة المحسوسة، كأنّهم في متحف أو معرض قديم، وليس شاشات وأضواء وزيارات افتراضيّة"، قال بصوت عالٍ، يحرّك بحاجبيه مُبْدِيًا سخرية مضبوطة؛ لأسمعه من فوق صوت بكاء ابنته الرضيعة.
"هذا قرارك، على أيّ حال، فأنت قيّم المعرض"، قلت دون اكتراث.
"أشكر لك ثقتك..." قال، وحمّلني الطفلة، "هل يمكنك أن تُسْكِتَ طفلة؟"، سأل مستفزًّا، "أنت لا بدّ أنّك تعرف أنّه يمكنني ذلك!"، أجبته، وقلبت الطفلة لتستلقي على ذراعي؛ لأُدفئ بطنها الحافل بالغازات، "نمر نائم على الشجرة اسم هذه الطريقة"، وشوشت، وهززتها، فهدأت البنت. وبعد قليل، نامت.
حاول أن يأخذها منّي، "اتركها، اشتقت إلى هذه اللحظات"، طلبت منه، "معك حقّ، على فكرة، لم أفكّر فيكم. فكّرت في الديكور، وفي الأجهزة، ولم أفكّر في الإنسان"، اعترفت بصوت منخفض ونظرةٍ إلى الأرض، الّتي تزاحمت فوقها أغراض قصصي. "سأجرّب صيغة أخرى"، وعدته. "خذها، ضعها في السرير، لقد غفت الآن، سترتاح هناك أكثر"، أمسكها، سمعته يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" بوشوشة، قبّلها على جبينها وأعادها إلى مهدها. أعرف هذا المهد.
قبل أن أخرج، أطفأت كلّ الأنوار.
(2)
بينما وقف القيّم حائرًا قرب المدخل، ونظر من بعيد إلى الجمهور المتدافع لشراء تذاكر الدخول، والحصول على كتالوج معرض «انطفاء الأجهزة»، في «متحف مدينة الماضي»، انتبه إلى رجل ستّينيّ يقف أمام جهاز تلفزيون قديم ويذرف الدموع.
عندما وصل القيّم قربه، آملًا أن يجتذبه إلى حديث ذي معنى، أحضرت امرأة شابّة عشرينيّة كرسيًّا للرجل، "اجلس يا أبي، وشاهد ما تريد"، قالت له الصبيّة، وأمسكته من كتفيه وأجلسته برقّة. لاحظت الصبيّة اهتمام القيّم فقالت: "نوبة حنين".
انسحب القيّم من المكان لكيلا يزعج الرجل الّذي بدا كأنّه انتقل إلى مكان آخر، أو زمان آخر، لكنّه بعد خطوات قليلة سمع صوتًا يناديه: "أيّها القيّم".
"هل تعرفينني؟"، سأل مستغربًا بعض الشيء.
"أعرفك طبعًا، فأنت قيّم هذا المعرض، ألست كذلك؟"، أجابته غير مقتنعة باستغرابه.
"بلى، بلى ...".
"يعطيك العافية، معرض مؤثّر فعلًا..."، قالت له منفعلة.
"أخشى أنّني لم أكن لأقصد أن يكون مؤثّرًا..."، أجاب بصراحة هذه المرّة.
"البشر كائنات غير متوقّعة، أعتقد أنّك كنت تريد معرضًا تكنولوجيًّا عن تطوّر الأجهزة واندثارها في القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، وإنجازات الثورة الصناعيّة الرابعة، لكنّه كان بمنزلة مسح الغبار عن قنديل خرج منه مارد الحنين عند الرجال... ربّما لهذا السبب اتّخذوا ذلك القرار"، قالت له واستمعت إلى رجل يقف قربها ويشرح لأحفاده كيف يعمل الهاتف القديم: أدخل إصبعه في الفراغ المدوّر، وسحب العجل إلى السنّ الفضّيّة، وأفلته ليعود إلى مكانه: "حين كنّا نخطئ في رقم كان علينا أن نعيد الكرّة من جديد كلّ مرّة"، صمت قليلًا ثمّ أضاف "ما زلت أحفظ رقم هاتف بيت أهلي حتّى الآن..."، فانهمرت دموعه، وحضن أحفاده قدميه.
"هل لديك تفسير للأمر؟"، سألها دون أن ينظر إلى عينيها.
"لقرار مجلس الإدارة؟"، ردّت بصوت مرتفع.
"لا، لحنين الرجال..."، قال لها من خلف كفّه الّتي أخفت كلماته.
"اسألهم!"، قالت له دون أن تفكّر كثيرًا، وأشارت بكفّ يده نحو الجمع.
"سأفعل ذلك، شكرًا لملاحظاتك"، قال لها، لكنّه عندما نظر في عينيها رجف قلبه، وهرب إلى زاوية أخرى من المعرض.
"كأنّني التقيت بها من قبل"، قال لنفسه، والتفت نحوها بعد خطوتين، لكنّها كانت قد عادت إلى أبيها الّذي كان يجلس أمام شاشة التلفزيون القديم المنطفئة، وقد استبدل بدموعه ابتسامة ممتنّة.
لم يكن يتوقّع هذا النجاح الفائق للمعرض، الّذي كسر كلّ البيانات الّتي حقّقتها المعارض الّتي سبقته في «متحف مدينة الماضي» والمتاحف الأخرى، ولم يكن يتوقّع التعقيبات المنفعلة الّتي تركها الزوّار، ولا زوبعة المقالات الّتي سيّسته وأغضبت مجلس الإدارة.
صحيح أنّه خطّط لتجربة فنّيّة معيشة، يستعيد فيها الأجواء الّتي صُنِعَتْ وتطوّرت وانتشرت فيها هذه الأجهزة، لكنّه لم يكن يخطّط كما كتب أحد النقّاد: "ليستعيد الماضي الّذي كنّا نبني فيه علاقة بالأجهزة والأشياء، علاقة ملموسة محسوسة بأجهزة كان دورها أن تحسّن حياتنا، قبل أن تصبح علاقة الأجهزة والأشياء ببعضها بعضًا، ودورنا أن نحسّن نحن أداءها. هذا المعرض حرّرنا من الانقطاع الّذي نعيشه مع الأشياء ومع الناس في أيّامنا. معرض «انطفاء الأجهزة» تجسيد للثورة الهيترتوبيّة السنتمنتاليّة؛ أي لتعبير الإنسان عن وعيه بحضور الأزمنة المختلفة في حيّز حياته، واحتفاله بمشاعره تجاهها، وبروحه الخلّاقة، هذه الثورة الّتي تنعكس في حقول الإبداع والفكر المختلفة في أيّامنا، الّتي يتعمّدون تجاهلها والاستهتار بها، لكنّهم في الحقيقة يخشونها. لماذا يريدون لهذا النور أن ينطفئ؟ لكي نصير روبوتات من دون ذاكرة ولا مشاعر ولا إبداع؟".
لقد أرادت إدارة المتحف من المعرض أن يسهم في تحقيق هدف المتحف: كشف بشاعة الماضي المتخلّف القاسي لإبراز ذروة اللحظة المعاصرة المتطوّرة من حياة الإنسان، لكنّ هذا المعرض وصل هذه اللحظة بالأزمنة الأخرى؛ فتدفّق تيّار المشاعر المخبّأة.
تجوّل القيّم في المتحف، متأمّلًا هذه المرّة بالناس وليس بالأشياء، بالرجال والنساء الّذين نظروا بوجوه مائلة وعيون تائهة إلى الأشياء الّتي أخذتهم إلى أزمنة أخرى، أو تحدّثوا عنها بلهفة وتأثّر لأبنائهم وأحفادهم. مرّ من زاوية الكاميرات، الّتي أخذ حجمها يصغر حتّى اختفت في الهواتف، ثمّ من زاوية أجهزة الراديو الّتي وُضِعَ كلّ واحد منها، بأحجام مختلفة، على طاولة في حيّز مختلف التصميم؛ واحد على طاولة بيت أرستقراطيّ عتيق، وآخر على طاولة مقهًى شعبيّ، واحد على طاولة صغيرة لحارس مدرسة فقيرة، وآخر أصغر حجمًا على مكتبة فتاة مراهقة. تجمّع الناس حول الراديوهات، وأخذوا يغنّون، كلّ واحد منهم يغنّي بصوته النشاز أغانيه القديمة، وآخرون يرقصون، "قال إيه جاي الزمان يداوينا؟"، غنّى أحدهم لزوجته الّتي أخذت ترقص معه، كما رقصا يوم زفافهما قبل نصف قرن، أو أقلّ قليلًا. رقصا وبكيا هما أيضًا.
حتّى في زاوية الحاسوب من المعرض، كان ثمّة أشخاص يبكون، أحدهم وقف أمام شاشة حاسوب بيضاء ضخمة، وأسلاك ثخينة ولوحة مفاتيحه كبيرة، تخرج منها أزرار الحروف والأرقام كجبال ثلجيّة مصغّرة مقطوعة الرأس، "هذا بالضبط مثل الحاسوب الأوّل الّذي اشتراه أبي لنا، كنّا عندما نتّصل بالإنترنت يخرج صوت اتّصال مزعج طويل يستيقظ منه النيام، وكان الإنترنت بطيئًا جدًّا جدًّا. الصورة في حاجة إلى ساعة كي تنزل. كنت أوّل ولد في الصفّ يملك حاسوبًا موصولًا بالإنترنت، وكلّهم صاروا يريدون أن يكونوا أصدقائي بعد أن كانوا يسخرون من نظّاراتي"، وتردّد صدى قهقهته في القاعة.
كان الناس يقتربون من الأجهزة كأنّهم يحيطون بتابوت مُسَجّى، ويرثون صديقًا قديمًا. هذا آخر يوم للمعرض، وقد لا يرون كلّ هذه الأجهزة والأشياء أمامهم، ولا بقربهم، مرّة أخرى ما تبقّى من حياتهم، ولن يكون عندهم المجال ليرثوها ويحكوا قصصهم معها، وبحضورها، لأبنائهم وأحفادهم والآخرين مرّة أخرى.
"أين ستذهبون بكلّ هذه الأجهزة بعد إغلاق المعرض؟"، تفاجأ القيّم بالسؤال؛ فالتفت حوله ليرى الرجل الّذي أبكاه التلفزيون، وابنته تقف إلى جانبه. بدا الرجل الآن مرِحًا وفي صحّة جيّدة.
"لا بدّ من أنّهم سيرمونها في المخازن!"، أجابه القيّم بنبرة غاضبة.
"سيزجّونها في الأقبية المعتمة، في سجن انفراديّ مدى الحياة"، علّق الرجل، فضحكت ابنته وأضافت: "ولن يسمحوا لأهلها بزيارتها"، فأدرك القيّم أنّها نكتة، وبدأ يضحك، وقال: "وستعلن إضرابًا عن الطعام!". كان من الصعب على القيّم أن يتوقّف عن الضحك، رغم محاولاته الجادّة لذلك. "لم... أضحك... منذ... منذ... أيّام طويلة". وضع الرجل يده على كتفه محاولًا إعانته على وقف الضحك، ونظر مستغربًا إلى ابنته، وقال لها بصوت منخفض مستغربًا بعض الشيء: "النكتة لا تستحقّ كلّ هذا الضحك!".
"أريد أن أقتني ذلك التلفزيون"، قال الرجل بجدّيّة هذه المرّة.
دعا القيّم الرجل وابنته إلى الجلوس، مشيا نحو مقهى المتحف، حيث سألته النادلة الروبوت بصوت ناعم: "مرحبًا، كاكاو من دون حليب، مثل كلّ مرة؟"، فهزّ رأسه، "ماذا يمكنني أن أقدّم لك يا سيّد؟ أنت أوّل مرّة عندنا!"، "شاي أخضر" أجابها الرجل، "ماذا يمكنني أن أقدّم لك يا سيّدة؟ أنت أوّل مرّة عندنا!"، "وأنا أيضًا، شاي أخضر، لو سمحت"، قالت ابنته. "حاضر" ردّت الروبوت الجميلة، وذهبت لتعدّ الكاكاو والشاي. حاول القيّم أن يسترق لحظة يتأمّل فيها ملامح هذه الصبيّة، الّتي شدّته إليها طاقة لم يشعر بها من قبل.
"لماذا بكيت عندما شاهدت ذلك التلفزيون؟"، فاجأ القيّم الرجل بالسؤال.
"كان عمري ثلاث سنوات عندما اشترى أبي هذا التلفزيون. كان أبي موظّفًا عاديًّا، رجلًا يحبّ الروتين، يخرج كلّ يوم من البيت الساعة السابعة إلّا ربعًا بالضبط، ويعود في الرابعة والنصف، يأكل، يشاهد الأخبار، يشتم السياسيّين والمذيعين وينام. هذا التلفزيون كان أهمّ إنجاز في حياته آنذاك. أوّل واحد من بين إخوته اشترى تلفزيونًا ملوّنًا، ليس أوّل واحد في المدينة أو في الحيّ أو في الشارع، بل من بين إخوته. يومها، كنّا بالكاد نلتقط محطّتين أو ثلاث محطّات تُغلق كلّها مبكّرًا، ونراها بعد أن نرفع هوائيّة طولها ثلاثون مترًا فوق سطح البيت. كانت برامج الأطفال كلّ عالمي، أتابع المسلسلات، وأتأثّر، أشتم الأشرار ومديرات بيوت الأيتام، كما كان أبي يشتم السياسيّين. عشر سنين بقي هذا التلفزيون عندنا، كان كلّما تعطّل نادى أبي التقنيّ، وهو ذاته صاحب محلّ الأدوات الكهربائيّة، ليصلحه، حتّى ومض ومضاته الأخيرة، وانطفأ. أذكر أنّني سألت أبي سؤالًا يومذاك: "في مسلسلات الأطفال الّتي نشاهدها، يبحث الطفل عن أمّه، لماذا لا يبحث الأطفال عن آبائهم؟"، ولم يجبني. واليوم، عندما شاهدت هذا التلفزيون اليوم تذكّرت أبي، شاهدت طفولتي البعيدة. كان هذا التلفزيون شاشتنا الوحيدة".
(3)
"ماذا ستقول أمّي عندما ندخل إلى البيت مع هذا التلفزيون العملاق؟"، سألته ابنته، وأشارت إلى التلفزيون الضخم، الّذي أجلساه بينهما في السيّارة الذاتيّة القيادة، الّتي عادا بها إلى البيت.
"هذا ما أفكّر فيه بالضبط..."، أجابها، واستمرّ في التفكير.
"سأقول لها إنّه لي، هديّة قيّمة من قيّم المعرض..."، قالت له بعد صمت قصير.
"في هذا شيء من الحقيقة..."، ردّ، فاحمرّت وجنتاها.
توقّفت السيّارة الذاتيّة القيادة فجأة، فعانقت التلفزيون الضخم كي لا يقع. نظر الرجل من شبابيك السيّارة، وفي شاشتها الّتي أضاءت نقطة بالأحمر على بعد أمتار. "كم أشتاق إلى أن أجلس خلف المقود، أُسرع وأُبطئ، أتوه وأصل، أتحكّم بالطريق، لم أكن أتوقّع أن تصير الحياة مملّة إلى هذه الدرجة".
"وصلنا"، قالت السيّارة الذاتيّة القيادة، وانطفأت.
(4)
"وصلنا إلى البيت، وضع التلفزيون في مكتبه. قلت لأمّي إنّك أهديتني إيّاه، ولم تسأل كثيرًا. انفعلت من التلفزيون، فقد تبيّن أنّه كان عندهم واحد مثله بالضبط أيضًا. نزع أبي القابس القديم، وركّب بدله قابسًا جديدًا، كان سعيدًا يغنّي ويرقص ‘اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا‘، الّتي رقص عليها مع أمّي حين دخلا القاعة يوم زفافهما. ما إن وضع القابس بالمقبس حتّى اشتعلت فيه الكهرباء. وانطفأ".

كاتب من فلسطين. درس علم الاجتماع وعلوم الإنسان والعلوم السياسيّة في جامعة تل أبيب. عمل محرّرًا لصحيفة "فصل المقال" ومديرًا لـ "جمعيّة الثقافة العربيّة" في حيفا. له مجموعة من المؤلّفات السرديّة، قصّةً وروايةً ومسرحيّة، منها: "بردقانة" (2014)، و"بين البيوت" (2008)، ومسرحيّة "الظاهر عمر" (2010).