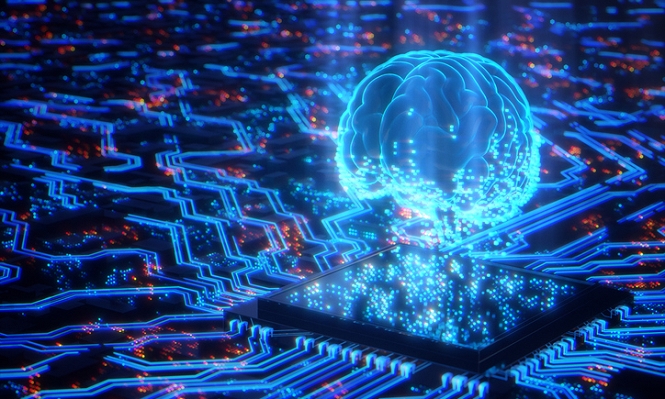دبّابة تغتال المدينة

صوت هدير في الخارج وأصوات مشوّشة، يقترب الصوت، يصبح دويّه أكثر وضوحًا، شيء يشبه ارتطام المفاصل ببعضها بعضًا، تطحن تحتها مفاصل الأسفلت، يتحوّل الشارع إلى عجينة تهرس أضلاعه، وتقلب حافّته إلى وسطه ووسطه إلى حافّته. لأوّل مرّة في حياتنا نختبر هذا النوع من الآليّات، عرفنا الجيب الكبير والصغير، عرفنا الخنزيرة، ورأينا ذات مرّة المجنزرة وحتّى طيّارات الإفّ 16 و17 و18... بتنويعاتها. كنّا نراها تحلّق بعيدًا، وتعيد تقسيم السماء وترسيمها.
أمّا الدبّابة ذات الخرطوم الطويل فلم نعرفها قبل ذلك اليوم، لأوّل مرّة نراها في قرانا، تقصّ شريط الزمن أو بالأحرى تدوس عليه. لا تهتمّ الدبّابة بالبروتوكولات الدبلوماسيّة وملاهي السياسيّين، تعبث بكلّ مؤخّرات السياسيّين بخرطومها الطويل.
ذات مرّة تكلّم مريد البرغوثي عن عبوس الدبّابة، فمن طبائع الدبّابات ألّا تبتسم. ومن وقائع السياسة وغرائبها أن يستجدي السياسيّ سنّها الضحوك، كما فعل بعض السياسيّين العرب وبعض السياسيّين الفلسطينيّين، في فترة اجتياح بيروت عام 1982، وفي فترة اجتياح المدن الفلسطينيّة عام 2002. ليس من المصادفة طبعًا أن يكون مهندس تلك الاجتياحات أريئيل شارون، الّذي يرى في إسرائيل دبّابة كبيرة أو فرّاخة دبّابات. لم يدرِ هؤلاء «المعتدلون» أنّ الابتسامة لا تليق برصانة «المِرْكافا»، وكيف تبتسم دبّابة تحمل الربّ على ظهرها؛ فللربّ بيت من دبّابات.
سكن «إيل» طويلًا على تلّات فلسطين وربوعها وسهولها، وعاش ردحًا من الزمن في بيوتها وكهوفها ومغرها وتحت زيتونها، قبل أن تُسْكِنُه إسرائيل هو وكلّ آلهة الأرض فوق دبّابتها، وتتحصّن به ويتحصّن بها.
تفرّج العالم عبر شاشات التلفاز على كرنفال الدبّابات، كرنفال من حديد وفوّهات من البراكين، مَنْ قال إنّ أطفال فلسطين لم يشاهدوا بركانًا في حياتهم؟ ومَنْ قال إنّ سياحة البراكين حكر على أطفال العالم؟ يذهب الناس ليشاهدوا بركان جبل فيزوف وحديقة ومحميّة كاتماي الوطنيّة، وحديقة البراكين الوطنيّة في ولاية هاواي.
لم يذهب أطفال فلسطين إلى سياحة البراكين تلك، ولم يقفوا مشدوهين أمام جبروت الطبيعة في فلسطين، تأتي البراكين إلى عقر دارك، وتتسلّل إلى غرف النوم، وتتجوّل في حديقة المنزل. في فلسطين تمارس الدبّابات سياحتها الخاصّة، ولم يقف أطفال فلسطين مشدوهين أمام جبروت الحديد والنار.
زحفت هذه البراكين في كلّ مكان من أمكنة الزمن الفلسطينيّ الوليد، قبل سنوات عدّة كان هذا الزمن المفتوح على وهْم الأمل، يحاول أن يصنع من خردة الأزمنة الفلسطينيّة وما تبقى منها سنغافورة القرن العشرين. لم تبتسم الدبّابة لسنغافورة، ولم تبتسم لفرط أملنا في زماننا الجديد، بل فتحت فوّهتها السحيقة وابتلعت وهْم السيادة ووهْم الأمل ووهْم الجغرافيا المحرّرة.
زحفت تلك التنانين إلى زمان من زجاج. كان سائق «مركبة الربّ» يتلذّذ بأصوات الزجاج المهروس تحت قدميه في زمن السلام المنشود. في زمن البحث عن السيادة، الّتي حاولت «منظّمة التحرير الفلسطينيّة» أن تحصل عليها تحت شروط إسرائيل وقيودها. نسي الباحثون أو تناسوا أنّ للعبة شروطها ومخاطرها، وأنّ أيّ حركة تحرّر تبدأ البحث عن سيادتها من الامتيازات ومن السيّارات الدبلوماسيّة وحقائب «السمسونايت»، هي حركة تغتال نفسها قبل أن يغتالها عدوّها.
أيّ ثقة تلك الّتي صاحبت ذلك السلام الملتبس؟ أيّ فرط من الثقة امتلكه تجّار العقارات في واجهات بناياتهم الزجاجيّة؟ هل كنّا نثبت للعالم جدارتنا ببناء دولة من زجاج؟
نفخ التنّين كلّ نار صدره، وأفرغ هناك كلّ غلّ عمره، وأعاد صهر الأشياء؛ أعاد صهر زجاج دولتنا ومكاتبها وترويسة حلمها، وأعاد ضبط إيقاعات السلام بطريقته، لعلّ ذلك الجنديّ سائق الدبّابة لم يعجبه زجاج العمارات الفارهة والأنيقة. كان يبحث عن زجاج من نوع آخر؛ زجاجٍ أكثر شرقيّة، فزجاج رام الله «الحداثيّ» يربكه ويجعله لا يطمئنّ لمخيّلته الراسخة. عن تلك المدن الشرقيّة وزجاجها الملوّن والمعتم حتّى لا ينكشف أهل البيت أمام أعين الغرباء. لكن زجاج رام الله الأنيق والمتناسق، تُسْقِطُهُ قنبلة صوت ولا يحتاج إلى هذه الأرتال من الدبّابات والمجنزرات وطائرات تملأ سماء المدينة بالصراخ. لعلّه الخوف الممزوج بفرط القوّة وطيش العضلات.
في أفنية المقاطعة وحواري رام الله التحتى، كانت المِرْكافا تختبر زمانها ورصانتها. لم تبتسم لمقهى رام الله ولا لذروة سنامها الماصيون، ولم يَعْنِها الزمن الفلسطينيّ المثبت على عمود دوّار الساعة، منذ متى يهتمّ المنتصر بزمان المهزوم؟ على شاشات التلفاز رأى العالم خراطيم و«كرابيج» دبّابات أميركيّة الصنع تُعيد تثبيت زمن السادة وزمن العبيد، كرابيج حديثة تعيد جلد الزمن الفلسطينيّ وتصويبه. سياط من نار تنهال على الأزقّة والحواري والشوارع في المدن وتقحف جلودها، سياط في السماء وسياط على الأرض.
يحضرني مشهد لإيليا سليمان من فيلمه «الزمن الباقي» عندما تستدير فوّهة الدبّابة يمينًا ويسارًا ويسارًا ويمينًا، وهي تراقب تحرّكات مراهقٍ يجري مكالمته الهاتفيّة على النقّال الّذي كان آنذاك مفخرة الدولة الوليدة، وأحد أهمّ إنجازاتها وإنجازات رأس مالها الاستهلاكيّ. يرتّب ذلك الشابّ لحفلة مع أصدقائه في ستوتز، شيء أقرب إلى المسخرة، أو بالأحرى مسخرة مركّبة؛ مسخرة تراجيديّة تُحيل إلى أنّ المأساة لا تكتمل بدون المسخرة، وأنّ للمسخرة مأساتها.
هي تراجيديا الزمن الفلسطينيّ المحشور في أنف زمن الدبّابة الإسرائيليّة. هي المسخرة الملازمة للمأساة، ولعلّ زمن «المأساة النقيّة» هو زمن ضائع أو زمن مفقود لم يتكوّن يومًا ما حتّى يعود.
المأساة أن تحيا تحت جنازير الدبّابات وهراوة الجنديّ الدائم الاستفزاز. والمسخرة أن تلتقط بشكل محموم أدنى فرص العيش، وأن تبحث من داخل المأساة عن بصيص أمل لتحياه. ترتبك الدبّابة في فيلم «الزمن الباقي» أمام طفل مراهق يبحث عن مسخرته ومسرّته الخاصّة، ويسخر من نفسه ومن الدبّابة ومن زمنها المنتصر، ومن زمن فلسطينيّ جديد يدّعي الرفاهية ويغطّيها بكومة قشّ.
ربّما لم تكن بلاغة إيليا سليمان في التقاط المأساة والمسخرة، كبلاغة فارس عودة مثلًا. لم تشفع السينما وبلاغتها لسليمان في القبض على ذروة المأساة والملهاة في زمن الانتفاضة، أو بالأحرى مرّة أخرى تقف السينما عاجزة عن مجاراة الواقع، ويستطيل الواقع على كلّ خيالات السينمائيّين وبلاغتهم.
في مشهد التقطته كاميرا إحد الصحافيّين، وإن كان ليس الوحيد، ثمّة الكثير من المشاهد أفلت من انتقائيّة الكاميرا ومزاجيّتها؛ صورة لفتى يسلب الدبّابة ضخامتها وجبروتها، ويسخر طويلًا من عبوسها، يعيد ترتيب الحكاية من جديد. ينظر سائق الدبّابة إلى فارس عودة؛ فيرى نفسه جالوت الّذي يلقمه داود الفلسطينيّ حجرًا، ويشظّي حكايته ويخرس لاهوته العسكريّ. يسخر فارس عودة من الدبّابة ومن سائقها، ومن زمن الإسرائيليّ المنتصر، ويسخر من الّذين ينتظرون من دبّابة أن تبتسم.
لم يكن فارس عودة هو الوحيد الّذي مَسْخَرَ الدبّابة وحوّلها إلى دمية من ورق وكرتون، بل في تلك القرى البعيدة والنائية من مناطق «ج»، الّتي لم يتوغّل فيها السلام ليغيّرها ويغريها. في أحداث اجتياح المدن ودراما الدبّابات الّتي لم تكن تميّز بين القرى والمدن، كان لتلك القرى نصيبها. كانت الدبّابات تسرح وتحمي جيباتها العسكريّة المذعورة من تلك القرى، الّتي كان لها طريقتها في السخرية من تلك الدبّابات، من ضربها بالحجارة إلى قناني المولوتوف وعلب الدهان «البويا»، بِمَ يشعر جنديّ يقود مركبته الجبّارة، ويتمترس خلف حصنه المنيع، عندما يسخر منه طفل، ويرمي جبروته بعلبة من دهان.
انسحبت الدبّابات الإسرائيليّة من القرى والمدن والمخيّمات الفلسطينيّة بعد أن سوّت جزءًا كبيرًا منها بالأرض، وبعد أن خلقت واقعًا جديدًا سيكون أكثر إدهاشًا من كلّ ما مضى. لكن ذاكرة دبّابتها العسكريّة لن تنسى أزقّة مخيّم جنين ولا البلدة القديمة في نابلس، ولا الجنازير المعطوبة في رام الله التحتى، ولا برجها الملطّخ بعلبة دهان والملطّخ بلعنة الدماء.

كاتب فلسطينيّ، حاصل على البكالوريوس في التاريخ والآثار، والماجستير في الدراسات العربيّة المعاصرة من جامعة بيرزيت. يعمل مدرّسًا في رام الله.