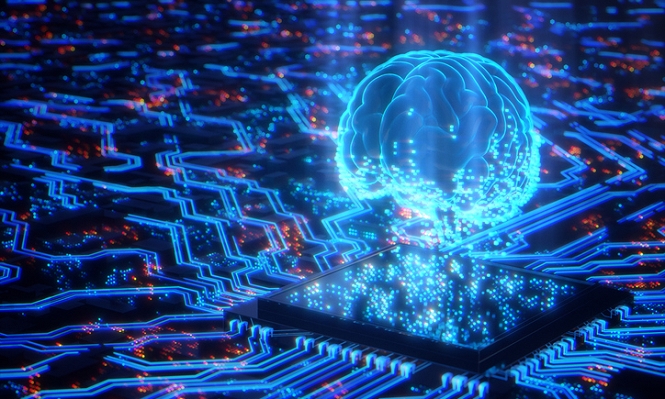تحدّيات أمام العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّات في السياق العربيّ

قُدّمت هذه المحاضرة في معهد الدوحة للدراسات العليا، لمناسبة افتتاح العام الدراسيّ 2017/ 2018، وتنشرها فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة بإذن من صاحبها.
نصّ المحاضرة:
يبدو بذل الجهد في تبيين أهمّيّة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة لجمهور اختار أن يدرُسها ويدرِّسها مستغربًا، بل مستهجنًا؛ إذ يُفترض أن يكون من اختارها موضوعًا لدراسته أو لمستقبله المهنيّ مدركًا أهمّيّتها، ولا يُفترض أن نشكّك في ذلك. لكن ربّما من المفيد أن أتناول الموضوع من زاوية مختلفة، آملًا أنّها تبرّر التكرار اللازم، مقدّمةً لهذه المداخلة.
في تجاوز الحدود بين التخصّصات
من نافلة القول أن نذكّر بأنّ الإنسان والمجتمع موضوعا العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، ويمكن التفصيل أكثر بتعديد العلاقات الاجتماعيّة وتحوّلاتها، والمؤسّسات، والتقاليد، والأعراف، والأفكار وتاريخها، والثقافة، والنفس البشريّة، وغيرها. وكان معنى لفظ studia humanitatis في القرن الخامس عشر 'دراسة الآداب الكلاسيكيّة'، واستخدمه مفكّرو النهضة في المدن الإيطاليّة في وصف الدراسات المتعلّقة بالإنسان وإنتاجه ونشاطه، في مقابل اللاهوت الذي يُعنى بالإلهيّات[1]. وانشقّت العلوم الاجتماعيّة، الواحد منها تلو الآخر، عن الفلسفة وكتابة التاريخ، بعد التحوّل إلى الرأسماليّة. ويمكن القول إنّ القرن الثامن عشر شهد إنتاجًا فكريًّا تناول الاقتصاد، والمجتمع، وبنية النفس البشريّة في كتابات المفكّر الواحد. لكنّ علم الاجتماع، بوصفه تخصّصًا، نشأ نهاية القرن التاسع عشر، وسبقه الاقتصاد، وتلاه علم النفس، وما زالت فروع هذه العلوم تتوالد حتّى يومنا.
وبعد ما ينيف على قرن من التمايز بين العلوم الاجتماعيّة، وتشعّب كلّ علم على حدة إلى اختصاصات وتطوّرها المتواصل في فهم ذاتها، من البدايات التي قلّدت فيها علوم الطبيعة حتّى التوصّل إلى مناهجها الخاصّة بها، ثمّ تشعّب المناهج ذاتها عبر التفاعل مع الفلسفة من جهة، وعلوم الإحصاء من جهة أخرى، طوال القرن الماضي، وبعد مراحل من الانقسام إلى مجالات أضيق فأضيق، بدوريّاتها، ومؤتمراتها، ورتبها الأستاذيّة المستغرقة في تبرير ذاتها، وفي صراع البقاء والتدافع الذي لا بدّ منه على الميزانيّات داخل الجامعات والمؤسّسات الأكاديميّة، تُظهر مؤشّرات كثيرة مآزق تدفع نحو إعادة إنتاج فضاء هذه العلوم من جديد، عبر تداخل العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، وهذه المرّة يُلتمس التداخل والتكامل مع التخصّصات الأخرى من داخل التخصّص ذاته، أي على أساس المعرفة العينيّة المتخصّصة وضروراتها.

وعند تأسيس 'معهد الدوحة'، قرّرنا بوعي كامل، أن نجمع العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، قناعةً منّا بأنّ العلوم الاجتماعيّة إنسانيّة، والعلوم الإنسانيّة اجتماعيّة.
وأضيف أنّها جميعها علوم تاريخيّة، وذلك ليس لمنشئها التاريخيّ فحسب، إنّما لأنّ الإنسان والمجتمع كائنات تاريخيّة أيضًا. ولا أقصد دلالة لفظ 'تاريخيّة' التي تشمل معناه الداروينيّ، الذي ينطبق على الطبيعة أيضًا، بما فيها من مناخ، وبيئة، وأجناس أو أنواع، بل أقصد التاريخ الذي تصنعه الكائنات العاقلة، ويفترض التفكير والفعل والوعي به، ما يجعله يستحقّ وصف 'ممارسة' (practice). إنّ العمل، وعلاقات الملكيّة السائدة، ونشوء المؤسّسات، وعلاقات القوّة والسيطرة، والصراع الناجم عن المصالح ومحدوديّة المصادر، وقمع الغرائز لتمكين الحياة الاجتماعيّة بوصفها شرطًا للحضارة، والتقاليد، والأعراف، والثقافة، ووجود دوافع مثل الحبّ والكره، والرضا والطموح، والغيرة والحسد، والفضيلة والرذيلة، والسعي لتحقيق السعادة؛ كلّها تصنع التاريخ الذي نقصد، مثلما تصنع موضوعات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّات.
وقد كتب ابن خلدون: 'اعلم أنّه لمّا كانت حقيقة التاريخ أنّه خبر عن الاجتماع الإنسانيّ الذي هو عُمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل التّوحّش والتأنّس والعصبيات وأصناف التغلّبات للبشر بعضهم على بعضٍ، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدّول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال'[2].
وافترضنا أيضًا، أنّ تقسيم العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة إلى تخصّصات، في حدّ ذاته، ليس حتميّة رياضيّة أو نتاج معادلة علميّة تُحتّم مثل هذا التقسيم؛ فالاقتصاد، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والأدب المقارن، والعلوم السياسيّة، والعلاقات الدوليّة، والإدارة، كلّها منتجات ثقافيّة تاريخيّة نشأت في بيئة حضاريّة معيّنة، في مراحل تاريخيّة مختلفة، والحدود بينها، في رأينا، ليست مقدّسة. وهنا يُطرح السؤال المستحقّ: ألم تنشأ الفيزياء، والكيمياء، والرياضيّات، وعلم الفلك، والبيولوجيا، أيضًا، في بيئة ثقافيّة معيّنة في مراحل تاريخيّة مختلفة؟ أليست نتاجًا ثقافيًّا تاريخيًّا أيضًا؟ فلماذا لا نشكّك في الحدود بينها، ونقصر تشكيكنا على العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة؟

سيكون هذا السؤال مشروعًا بلا شكّ، لو لم تكن العلوم الطبيعيّة أسبق إلى التشكيك في الحدود بينها، وأقلّ تقديسًا، وأكثر تجاوزًا لها من المحاولات الجارية في العلوم الاجتماعيّة لتخطّي الحواجز بين تخصّصاتها؛ فالحوار بين الفيزيائيّين، والكيميائيّين، والرياضيّين، والبيولوجيّين، حوار منظّم، وواعٍ، ومدرك، وممأسس، حتّى هو ذاته، في تخصّصات جديدة أوسع، ويساهم مساهمة أساسيّة في إنجازات كلّ علم على حدة؛ كما نشأت نطاقات منظّمة بين العلوم، وعليها تقوم الاكتشافات الحديثة كلّها، في التكنولوجيا، والهندسات على أنواعها، والطبّ، وعلوم الدماغ، وتكنولوجيا الجزيئات الصغيرة، والجينات.
نحن إذًا لا نتحامل على العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، ولا نختلق لها همومًا وتحدّيات جديدة بإلحاحنا على تداخل التخصّصات، وذلك ليس فقط في حالة الـ Liberal Arts في الشهادة الجامعيّة الأولى، بل تحديدًا في الدراسات العليا، وخلال التخصّص وبعده؛ فما يصحّ بالنسبة إلى العلوم الطبيعيّة يُفترض أن يصحّ بدرجة أكبر في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، لأنّ الحدود بينها أشدّ تعسّفًا من الحدود بين العلوم الطبيعيّة، ولا سيّما أنّ موضوعها الإنسان والمجتمع الذي يستحيل فيه فصل الاقتصاد عن العلاقات الاجتماعيّة، وعن الثقافة، وعن التاريخ؛ فهذه مجالات متشابكة في الحياة الاجتماعيّة، وفصلها ودراسة كلّ منها على حدة يُفترض أن يكون اصطلاحيًّا لتسهيل الفهم والبحث، بتناول الموضوع نفسه من زوايا مختلفة، وبإلقاء الضوء على جوانب مختلفة منه، لكنّ الفصل ليس هدفًا قائمًا بذاته. لا بدّ من استكمال الصورة في حوار بين التخصّصات المختلفة ونتائج أبحاثها، ويُفضّل أن يكون لدى الباحث المتخصّص فكرة عنه عند الشروع في بحثه، لكي لا يضع فرضيّات في علم الاجتماع تقوم على جهل كامل بتاريخ المجتمع، أو الظاهرة الاجتماعيّة قيد البحث، وفرضيّات في العلوم السياسيّة تقوم على جهل بالاقتصاد والثقافة ... إلخ.
ما يحوّل الفصل بين التخصّصات إلى هدف قائم بذاته المؤسّسةُ الأكاديميّة؛ طقوسها، وصناعتها، وقوانينها الداخليّة التي تنفصل عن موضوعها وتصبح هدفًا ومجتمعًا قائمًا بذاته، فالحدود تتمأسس ومعها حرّاس الحدود. التنافس في السمعة والشهرة في مجتمع شبه مغلق ذي ثقافة فرعيّة، والتسابق إلى الترقية والتثبيت بالنشر في الدوريّات المتخصّصة، والالتزام بقواعد النشر؛ كلّها تثمر نجاحات وإنجازات علميّة في كثير من الحالات، وتؤسّس مجتمعًا وثقافة فرعيّة يخيّل لها أنّها قائمة بذاتها أحيانًا، وتعتمل في أروقتها سياسة داخليّة، وتدور صراعات ليست لطيفة دائمًا. لكن من المهمّ الاستدراك بأنّها حروب لا يموت فيها أحد، والحقيقة أنّه من النتائج الإيجابيّة المرافقة لهذه العمليّة في الدول المتقدّمة (والنادرة في بلداننا حتّى الآن)، نشوء بيئة متّسمة بالودّ، ومجتمع أكاديميّ تسود فيه ظروف أشدّ ملاءمة للعيش الكريم، وأكثر ترحيبًا بالفرديّة، وأكثر تعدّديّة، وأقلّ تعصّبًا؛ أي، باختصار، أكثر ليبراليّة من المجتمعات الوطنيّة التي تعيش فيها، إلى درجة أنّه غالبًا ما تضيق بها وبليبراليّتها القوى السياسيّة الشعبويّة في تلك المجتمعات، وهي القوى التي تعدّ العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، والمتخصّصين بها، طفيليّات ثرثارة ومشاكسة تعيش على حساب دافعي الضرائب (سوف أجيب عن هذه التهمة بعد قليل، ولكن بعد أن أنهي نقدي لتقديس الحدود بين التخصّصات).
ليس تداخل التخصّصات المقصود والحوار بينها 'تقليعة' أو إملاء خارجيًّا عليها، بل تعبيرًا عن تداخل المجالات نفسها في المجتمع والفكر والثقافة. ولن يتّسع المجال في هذا المقام لإيراد أمثلة حول توصّل اقتصاديّين إلى نتائج خاطئة لعدم معرفة الثقافة السائدة في مجتمع ما، وتوصّل علماء اجتماع إلى نتائج خطيرة بإطلاق تعميمات من دون معرفتهم تاريخ المجتمع الذي يدرسونه، ومؤرّخين اختزلوا التاريخ في الصراعات بين الدول والسياسيّين وتعاقبهم على الحكم، وهمّشوا المجتمعات والعلاقات الاجتماعيّة والثقافيّة، وعلماء سياسة وعلاقات دوليّة لا يقدّمون لنا فهمًا أعمق لما يدور من زملائهم الصحافيّين؛ لأنّهم أهملوا الاقتصاد، والتاريخ، والثقافة عند دراستهم السياسة والعلاقات الدوليّة. كما أنّ ابتعاد هذه التخصّصات جميعها عن الحوار مع الفلاسفة أفقدها شرفات مطلّة على الأسئلة الإنسانيّة الكبرى، وفوّت عليها فرصًا لصياغة الأسئلة المتعلّقة بالبعد الأخلاقيّ للعلوم الاجتماعيّة، وزاوية نظر مختلفة، ومهارات مهمّة طوّرتها الفلسفة عبر تاريخها في شحذ المفاهيم والمصطلحات.
العلوم بوصفها أدوات والتفكير في الغايات
أعود الآن إلى سؤالي حول أهمّيّة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، والذي يُفترض أن أردّ فيه، أيضًا، على ضيق السياسيّين والتكنوقراط والبيروقراطيّين بها، مستسهلين تأليب الثقافة الشعبيّة عليها، بادّعاء أنّ مردودها الفعليّ غير واضح. فثمّة محاولات متواصلة لتجهيل المجتمعات في ما يتعلّق حتّى بالحاجة العمليّة الأداتيّة إلى هذه العلوم في الإدارة، ووضع السياسات، والتخطيط الاقتصاديّ، ومعالجة المشكلات الاجتماعيّة والنفسيّة المترتّبة على نشوء المجتمعات الجماهيريّة الحديثة.

وفي الإجابة عن تشكيك هؤلاء البيروقراطيّين بلغتهم 'العمليّة' نفسها، قد يكفي القول إنّ غالبيّة السياسيّين وموظّفي الدولة والعاملين في الإدارات، ليس في إدارة المجال الثقافيّ والأكاديميّ فحسب، بل في قطاع السياسة والإنتاج والخدمات أيضًا، هم خرّيجو العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة.
لا يمكن تصوّر أجهزة الدول، ومرافق الإنتاج، والمؤسّسات المجتمعيّة في عصرنا من دون متخرّجي العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، إضافة إلى العلوم الإداريّة، وذلك لسبب بسيط لا علاقة ضروريّة له بالتخصّص، بل لأنّ متخرّجي هذه المجالات قادرون على قراءة المعطيات، وتحليلها، والتفكير النقديّ بها، وربّما الكتابة البحثيّة بشأنها أيضًا (أو هكذا نأمل)، وهذا ما يحتاج إليه أيّ قياديّ في المستويات الدنيا والمتوسّطة والعليا، في أيّ مجال، من الصحافة حتّى الصناعة والسياسة. فلا تصدّقوا الإشاعة التي تقول إنّ متخرّجي علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والصحافة، والإعلام، والعلوم السياسيّة لا يجدون عملًا، فهم يجدون أعمالًا، لكن ليس بسبب التخصّص ذاته، إنّما بسبب المهارات techne التي يكتسبونها في القراءة، والتحليل، وطرح الأسئلة الصحيحة. كما يجدون عملًا في المجال الجامعيّ بسبب القدرة على التفكير النظريّ epistme النقديّ والإنتاج البحثيّ (أو هكذا نأمل).
وفي الحالات الأرقى التي نتطلّع إليها في تخصّصاتنا، يتمكّن المتخصّص في أحد هذه العلوم من الجمع بين المهارة الأداتيّة والتفكير النظريّ، لينتقل إلى الحكمة العمليّة phronesis[3] أو prudence، أي الحصافة (بحسب التقسيم الأرسطيّ) التي تجمع بين المهارات والمعرفة النظريّة، والتفكير في الأدوات والغايات، وهذا في حدّ ذاته ليس مؤهِّلًا للعمل في مؤسّسة من المؤسّسات المذكورة أعلاه حصريًّا، بل يمثّل أحد أهمّ العناصر في التكوين الفكريّ للمثقّف، بما يتجاوز الخبرة في استخدام الأدوات إلى التفكير في الغايات التي من أجلها تُسخَّر الخبرة وأدواتها. وهذا التفكير في الغايات الاجتماعيّة والسياسيّة التي تُسخِّر الخبرات والمهارات في سبيلها، وطرح الأسئلة حولها، هو الجسر الذي يربط المتخصّص في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة بالمجال العموميّ وقضاياه.
والمجتمع في أمسّ الحاجة إلى وجود فاعل لفئة المثقّفين الذين يتّخذون مواقف في الشأن العموميّ بنظرة شاملة إلى المجتمع وقضاياه، بما يميّزهم من المتخصّص الخبير، وهم يتّخذون المواقف بناءً على خبرة واختصاص بما يميّزهم، أيضًا، داخل فئة الناشطين السياسيّين أو المناضلين؛ فالمثقّف، كما كتبت في موضع آخر، ليس الشخص غير المتخصّص بشيء، أو الذي يعرف قليلًا من كلّ شيء، ولا يعرف الكثير عن أيّ شيء، وربّما يصلح هذا الوصف في التعريف الشعبويّ للمثقّف (بما تحمله هذه العبارة من تناقض).
إنّ الحاجة إلى المثقّفين العموميّين أصحاب الخبرة والاختصاص في قضايا المجتمع، والقادرين على الارتقاء من المهارات إلى النظريّة ثمّ إلى الغايات، واتّخاذ موقف من قضايا الفضاء العموميّ، حاجة قائمة، بغضّ النظر إن كان السياسيّون وخبراؤهم العاملون في خدمتهم يدركون هذه الحاجة أو لا يدركونها، وهم يميلون إلى إنكارها بعامّة.

وفي ما يخصّ العلاقة هذه بالسياسة والسياسيّين، نأمل أن يتخرّج في معهد الدوحة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والإدارة العامّة، طلّاب لا ينفرون من السياسة بوصفها تكثيفًا للشأن العموميّ، وينحازون إلى سقراط في مقابل ثراسيماخوس[4] في مقاربتهم للسياسيّين الحكّام[5]، أي يرفضون فكرة أنّ القوّة تصنع الحقّ، وأنّ العدالة صالح القويّ.
نلاحظ في ذلك الحوار القديم حول العدالة أنّ التوصّل إلى مفهوم للحكم يسبق الممارسة، والممارسة هي التي تحاسَب بموجبه، أي بمدى تطابقه مع المفهوم. وبغضّ النظر عن طبيعة الحكم، يُفترض أن يحاسب بموجب معيار واحد، هو: هل يعمل لمصلحة الناس أو لا؟ وليس إن كان يعمل لمصلحته هو؛ أي لمصلحة القويّ. لاحظوا معي أنّه بموجب المنهج الأفلاطونيّ، ليست العدالة، وهي 'ما يجب أن يكون عليه الحكم'، متضمّنةً في منظومة قيميّة خارج المفاهيم، أي في حكم أخلاقيّ على الحاكم، بل كامنة في مفهوم الحكم ذاته إذا جرت بلورته بصورة صحيحة ودقيقة. بموجب هذه الفرضيّة، ثمّة طاقة نقديّة في المفهوم ذاته، أي في النظريّة، إذ تجري محاسبة الحاكم بموجب مفهوم الحكم. ولقد ثَبُتَ أنّ هذا الاستغناء عمليَّا عن الحكم الأخلاقيّ، وتضمين 'ما يجب أن يكون' في المفاهيم ذاتها حين تكون في حالة 'الكمال' المثاليّة، سلاح نقديّ مهمّ، لكنّه معرّض للانقلاب بسهولة إلى سلاح أيديولوجيّ خطِر أيضًا، فالعقلانيّة المحض شكّلت في حالات مشهودة بنية نظريّة للنظام الشموليّ، وتبريرًا فكريًّا للجرائم الكبرى، وذلك خلال عمليّة ملاءمة الواقع بالقوّة للمفهوم الذي تنبته الأيديولوجيا، فـ 'ما يجب أن يكون' أصبح يُفرض على المجتمع بالقوّة، لأنّ النظام الحاكم يمتلك الحقيقة المطلقة الكامنة في أيديولوجيّتهم.
ومن ناحية أخرى، فإنّ فصل الحكم الأخلاقيّ والتفكير في الغايات عن العلم، أدّى إلى معضلات أخرى؛ ففي ما يتجاوز النقاش حول المثقّف، أذكّر، ببساطة، بفجيعة استخدام العلم بعامّة بوصفه أداة للسيطرة فحسب، واستغلال المهارات المكتسبة في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة في خدمة غايات غير عادلة، مثل الظلم، وقتل الأبرياء، وتبرير الاستبداد والفساد، والحروب العدوانيّة، وأحيانًا في مناقضة نفسه مباشرة، أي في تعميم الجهل بدل نشر المعرفة، ووسائل تعميم الجهل تتنافس في أيّامنا مع وسائل تعميم المعرفة. ولست في حاجة إلى الشروع في تعداد الأمثلة على ذلك، فقد أصبح الموضوع في أيّامنا مألوفًا مملًّا إلى درجة اصطناع الفجيعة.
ويتجلّى ضيق ذرع السياسيّين بالعلوم الاجتماعيّة، أحيانًا، من خلال تعييرها بعدم القدرة على التنبّؤ، مثلًا، بوقوع الثورة الإيرانيّة أو ثورات عام 2011 في العالم العربيّ، أو غيرها من الأحداث. والحقيقة أنّه ليست وظيفة العلوم الاجتماعيّة التنبّؤ بسلوك الجماهير لكي تسهّل على الحكام السيطرة عليها، ومن طبيعة حركة الشعوب العفويّة أن يصعب التنبّؤ بها. وعلى كلّ حال، لو كان الحكّام ومستشاروهم يقرؤون، لأدركوا أنّ دراسات اقتصاديّة، وسياسيّة، وديموغرافيّة كثيرة، حذّرت من مغبّة السياسات الاقتصاديّة النيوليبراليّة المترافقة مع الفساد، والاستبداد السياسيّ، وتغوّل أجهزة الأمن، لكن ليس من وظيفتها تحديد ساعة الصفر للانفجار كي يستعدّ الحكّام لها. وثمّة، بالتأكيد، خبراء تملّقوا الأنظمة الحاكمة واستخدموا مهاراتهم في تجميل الأوضاع وكيل المديح للسياسات، وهؤلاء يستحقّون، بالتأكيد، لوم مشغّليهم الذين طربوا لمراءاتهم، لكنّهم ليسوا ممثّلي العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّات.

هل تشتمل العلوم على ضمانة بنيويّة داخليّة ضدّ مثل هذا الاستخدام للمهارات التي تقدّمها؟ وهل تكفي دورات أخلاقيّات المهنة في مواجهتها؟ ألم تصبح بعض أخلاقيّات البحث العلميّ ومحاذيره، في حدّ ذاتها، قواعد ومهارات في كيفيّة تجنّب الخوض في الإسقاطات الأخلاقيّة للنشاط الأكاديميّ، وليس في كيفيّة التورّط فيه؟ هذا مع أنّ التورّط هدف الأخلاق، بما فيها أخلاقيات المهنة، وأقصد التورّط لمصلحة المجتمع والإنسان.
الجواب قطعيًّا 'لا'، فالضمانة في رأيي أخلاقيّة في الإنسان وليس في التخصّص. ومع تأسيس العلوم الاجتماعيّة بوصفها تخصّصات ومهنًا، منذ القرن التاسع عشر، ونتاجًا لانتقال المجتمعات إلى المجتمع الرأسماليّ والهزّات التي أحدثها هذا الانتقال، ونشوء فئة المتعلّمين ومهنهم المتعدّدة التي أفرزها، أكّد لنا آباؤها المؤسّسون إلى جانب زملائهم علماء الطبيعة، عبر عشرات المقالات والكتب، ضرورة فصل العلم عن القيم المعياريّة، سواء أكانت أخلاقيّة أم جماليّة؛ فالعلم هو value free أو werturteilfrei وفق ماكس فيبر. ويعود أحد مصادر هذا الفصل الفكريّة إلى الفلسفة الكانطيّة، التي تفصل بين حكم العقل المحض وحكم العقل العمليّ، وبين أحكام العلم وأحكام الأخلاق، في نوع من القطيعة مع المنهج المذكور أعلاه في جمهوريّة أفلاطون.
علينا إذًا، بموجب هذه الوصايا، أن ندرّس المناهج العلميّة وكيفيّة استخدامها، وكيفيّة جمع المعطيات وتحليلها، والتوصّل من هذه المعطيات إلى نتائج بأكبر قدر من الموضوعيّة العلميّة والحياديّة، سواء أكانت هذه النتائج مرغوبة أم لا، وملائمة لفرضيّاتنا المسبقة أم لا، وبهذا تنتهي مهمّة المنهج العلميّ. أمّا القيم المعياريّة، بما فيها الأخلاق والسياق الثقافيّ، فيمكن أن تتحكّم في طرح الأسئلة والموضوعات التي نختارها، كما تتحكّم في كيفيّة استخدام النتائج. ولا يمكن حصر الأحكام القيميّة هناك ببساطة، ولا التخلّص منها في عمليّة البحث باتّباع إجراءات شكليّة تُتّخَذ بناءً على النواهي والمحاذير وحدها؛ فالقيم المعياريّة قد تخرق البحث نفسه، ووعي ذلك شرط للتوتّر المستمرّ في العلاقة بها، وهو توتّر صحّيّ.
وإذا افترضنا أنّنا قد تحرّرنا منها في المنهج من جمع المعطيات، وحتّى عمليّة استخلاص النتائج، يجري على مستوى الجامعة والمؤسّسات البحثيّة في الدول المتطوّرة التي نتطلّع إليها جميعًا، بوصفها نموذجًا، ربط اختيار موضوع البحث وكيفيّة طرح الأسئلة بشأنه، بأجندات الوزارات، والمموّلين، وصناديق البحث العلميّ، وإلى حدّ بعيد أيضًا، بالمزاج السياسيّ السائد والمعبَّر عنه في الإعلام ووسائل الاتّصال على أنواعها. وينطبق هذا، أيضًا، على كيفيّة استخدام نتائج الأبحاث والغايات التي تُستخدم في خدمتها.

وفي حالات لا تثير الاحترام، تتحكّم هذه العوامل أيضًا، في كيفيّة استخلاص النتائج، وقبل ذلك في انتقاء المعطيات وقراءتها، في ممارسات من يخشى ألّا يحصل على التمويل مرّة أخرى في بعض الحالات، وفي استخدام اللغة والمصطلحات في صياغة الأسئلة والفرضيّات والنتائج أيضًا؛ فالعلم يستخدم مفردات محمّلة بحمولات معياريّة يترتّب عليها نتائج سياسيّة، ولا يمكنه تجنّبها تمامًا، ويكفي أن يعي وجودها في بحثه أحيانًا، ويأخذ تأثيرها في الاعتبار، منبّهًا القارئ إليه. وشهدنا مؤخّرًا نقاشًا حول تأثير استخدام مصطلحات مثل انقلاب، وإرهاب، وعنصريّة، وتطرّف، واستقرار، وثورة، ويسار ويمين، وحتّى 'إسلام سياسيّ'، واحتلال، وأراضٍ متنازع عليها، وهنود حمر، وسكّان أصليّين أو أصلانيّين، ومستوطنين، وزنوج وسود، وأميركيّين أفارقة، وأقلّيّات، وغيرها، حتّى بعد تعريفها لأغراض البحث.
هذه أمور معروفة تنتج توتّرًا مستمرًّا داخل المؤسّسات الأكاديميّة وبين الباحثين والسياسيّين والمموّلين، ولا تنفكّ تصدر دراسات رصينة ترفد مدوّنة العلوم الاجتماعيّة بقراءات جديدة للعوامل (دعونا نسمّيها) الأيديولوجيّة التي تحكّمت في أبحاث من سبقهم، وبقراءات جديدة للتاريخ. وهذه صيرورة مستمرّة في تطوّر العلوم الاجتماعيّة؛ فالعلم قادر على نقد ذاته، وهذا من عناصر تميّزه من الأسطورة أيضًا. ألم يميّز أحد فلاسفة الوضعيّين الجدد في القرن الماضي، العلم بأنّه يصوغ مقولاته وقوانينه، أي تعميماته المستقرأة من الحالات العينيّة، على نحو يمكّن من دحضها؟
لكنّ ثمّة عنصرًا بنيويًّا توفّره العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة قد لا يجسر الهوّة النظريّة السحيقة بين الأحكام العلميّة والقيم المعياريّة، بحسب كانط وفيبر، لكنّه يصعّب تسخير العلم أداةً في خدمة الأيديولوجيا المهيمنة. إنّه البعد النقديّ في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، الذي يتحقّق باللجوء إلى الأدوات التي تفكّك الأسطورة، والأيديولوجيا، وحتّى البنى السياسيّة والحقوقيّة القائمة، والتواريخ الرسميّة، وغيرها، ليكشف: 1- منشأ الظواهر الاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة التاريخيّ، بما يزيل عنها قناع الأبديّة. 2- علاقات القوّة والسيطرة، والمصالح الواعية وغير الواعية التي أنتجتها وأصبحت تبرّرها. 3- وظيفتها الاجتماعيّة أو الثقافيّة أو النفسيّة ... إلخ. 4- الوقائع المغيّبة والمسكوت عنها.
ليس هذا التوجّه أو المنحى النقديّ منهجًا محدّدًا، بل مثابرة علميّة بأدوات نظريّة، ويمكن أن تتوافر في كلّ منهج في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة إذا مضى إلى أقصى التحليل في المهمّات النقديّة الأربعة أعلاه وغيرها، من دون أن يتخلّى عن النظريّة. فلا يحيد النقد عن المنهج العلميّ، ومن ثمّ يبقى في إطار العلم، لكنّه يؤدّي دورًا مزعجًا للقوى المسيطرة ومضادًّا لأدواتها في تزوير الواقع، وتمويه الظلم، وتصنيم العلاقات الاجتماعيّة، وتضليل الناس.

وحكم العقل العمليّ إلى فلسفة كانط (1724 - 1804)
ثمّة إذًا وظيفة نقديّة مزعجة، بالمعنى الإيجابيّ، تقوم بها العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة إن أدرك طلّابها البعد النقديّ في النظريّة. النظريّة في هذه الحالة، في حدّ ذاتها، أداة نقد للبنى والأيديولوجيّات السائدة قبل الحكم الأخلاقيّ بشأنها أو بعده.
حول تهميش النظريّة
إنّ أحد المآزق الكبرى للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة في الدول التي ليس لديها مشروع دولة، أي مشروع بناء أمّة، بل مشروع سلطة، وهي غالبًا دول استبداديّة و/ أو دول غير متطوّرة اقتصاديًّا، لا تمتلك القدرة و/ أو الرغبة والإرادة للاحتفاظ بمؤسّسات أكاديميّة كبيرة، يتلخّص في أنّ العلوم النظريّة مهمّشة بعامّة، ولا يُستثمر فيها المال والجهد، كما أنّ المجتمع المدنيّ ضعيف ولا يقوم بأَوْدِ مثل هذه العلوم، لأنّه لا يستند إلى عمليّة إنتاج خارج قطاع الدولة.
ويرافق غياب القدرة والإرادة السياسيّة لتطويرها، أو حضور إرادة سياسيّة لقمعها، ثقافة نافرة من العلوم النظريّة، ولا أقصد العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة فقط، بل العلوم النظريّة الطبيعيّة أيضًا. فهذه الدول تكتفي باستيراد ما يلزم من هذه العلوم لأغراض تدريس مهن مثل الهندسة، والطبّ، والمحاماة، والمحاسبة، والإدارة، وهذه كلّها مهن تقوم على العلوم النظريّة، أمّا العلوم النظريّة بمراكزها البحثيّة، ومختبراتها، ودوريّاتها، ومؤتمراتها، وجوائزها، فتنمو وتزدهر في بلاد أخرى بمشاركة باحثين وعلماء مهاجرين من الدول الأولى.
يفضّل إذًا ألّا ندّعي مظلوميّة خاصّة في الشكوى من غياب الاهتمام اللازم بالفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والأدب المقارن في الدول العربيّة والكثير من دول العالم الثالث، وعدم الاستثمار في هذه العلوم؛ فالفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، والرياضيّات أيضًا، لا يُكترث بها ولا تحظى بدعم، ولا يُستثمر فيها. وحين يُشجّع بعض المتخصّصين في علم السياسة والتاريخ، فإنّما لأغراض مثل إعداد تاريخ انتقائيّ للدول الوطنيّة، كأنّ التاريخ يقود بطبيعة الأمور إلى النظام الحاكم حاليًّا بالحتميّة التي تجري فيها مياه النهر إلى مصبّه، أو لتبرير سياسة هذا النظام وصراعاته مع خصومه محلّيًّا وإقليميًا، ولكي يعدّدوا لنا مضارّ الحرّيّة، والعدالة، والكرامة، وخطرها على الصحّة، ويشرحوا لنا الكوارث التي سوف تحلّ بنا لو فكّرنا في حياة بلا طغيان، أو تجرّأنا على التفكير في المساواة أمام القانون. والأمثلة على ذلك أكثر من أن يتّسع لها المجال، ليس في محاضرة فحسب، بل حتّى في مساق جامعيّ بأكمله. وفي المقابل، لم تخل الجامعات العربيّة من جهود قام بها أفراد ومؤسّسات، وما زالوا يقومون بها، في التجديف عكس التيّار، ومن مهمّاتنا في أيّ مشروع نهضويّ الاعتراف بقيمة هذا الجهد، والبناء عليه، والتعامل باحترام مع الأبحاث العربيّة النوعيّة التي صدرت وتصدر في مثل هذه الظروف، ومنح من ينجزها ما يستحقّ من تقدير.
وتكتفي الجامعات العربيّة بعامّة بتدريس العلوم النظريّة، ومنها العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّات في نطاق محدود، لكنّها لا تنتجها أو تضيف إليها. وغالبًا ما يؤمّ أقسامها وكلّيّاتها طلّاب لم يجدوا ما يدرسونه سواها؛ ولهذا فهي أشبه بكلّيّات تدريس منها بمعاهد بحثيّة للنخبة الممتازة التي يُفترض أن تتخصّص بها، ومن النوع الذي نأمل أن يجسّده معهد متخصّص في الدراسات العليا يشدّد في رؤيته على البحث. وحتّى في التدريس نفسه، يُفترض أن يُشدّد على المكوّن البحثيّ، والتفكير النقديّ، وإكساب الطالب مهارة قراءة المصادر النظريّة، وجمع المعطيات، والتحليل، وإنتاج الأوراق البحثيّة.

معهد الدوحة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والإدارة العامّة فرصة تاريخيّة لبناء مشروع مختلف عن السائد في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والإدارة العامّة، بتوفير فرص تفرّغ للتأمّل والبحث، في أجواء من الحرّيّة الأكاديميّة، وتشجيع التفكير النقديّ، والتفاعل المثمر بين الباحثين والأساتذة والطلّاب. وآمل أن أكون قد شرحت آنفًا ما نقصده بتداخل التخصّصات؛ إذ لا يصحّ أن يتخرّج في معهد الدوحة طالب متخصّص في أيّ فرع من العلوم الاجتماعيّة، والإنسانيّات، والإدارة العامّة، من دون أن تكون لديه فكرة عن بعض القضايا الرئيسة في العلوم الاجتماعيّة على المستوى العالميّ، وتاريخ الفكر والقضايا الكبرى التي تشغل المجتمعات العربيّة.
النهضة واللغة
وغايتنا الإسهام في بناء مشروع نهضة عربيّة في عصر نبدو فيه أبعد ما نكون عن النهضة؛ فقد أصبح أقصى طموحات بعضنا التطلّع إلى قاع نرتطم به لكي يتوقّف هذا الهبوط غير الحرّ.
والنهضة في أيّ سياق ثقافيّ تتجلّى أيضًا في اللغة، إن لم تبدأ بها. الشعوب تنهض بلغتها. وكانت النهضة الأولى التي استُقي منها مصطلح 'رينيساس' في المدن الإيطاليّة قد بدأت باللغة المحلّيّة، لكن ليس من دون معرفة روّادها اللغات الأخرى، ومنها اللغة العربيّة في بعض الحالات. وينطبق هذا على النهضات الأخرى أيضًا، كالفرنسيّة، والإنكليزيّة، والألمانيّة، واليابانيّة، والصينيّة، والإيرانيّة، وغيرها.
وفي حالة ما يُسمّى العلوم الإنسانيّة، لا يمكن أصلًا التفكير في النهضة من دون نهضة اللغة، لأنّ اللغة أصلًا جزء من الإنسانيّات بتعريفها الكلاسيكيّ. أمّا في العلوم الاجتماعيّة، فيكتسب الأمر أهمّيّة يصعب الإحاطة بها في مداخلة واحدة، فالعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة إن لم تتقن لغة المجتمع والإنسان الذي تدرسه، وكانت عاجزة عن صياغة نفسها بها، تفقد جزءًا كبيرًا من أدواتها البحثيّة. أنا لا أقول إنّه ثمّة اختلاف جوهريّ بين المجتمعات، وإنّ الأدوات الرئيسة في العلوم لا تنطبق على المجتمعات العربيّة، بل أقول العكس، ومن الضروريّ أن نطّلع على إنجازات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة في كلّ مكان، وأن نتقن لغتها الرئيسة في عصرنا هذا، وهي اللغة الإنكليزيّة. لكن هل يعقل أن ننهض بالعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة في الوطن العربيّ من دون اللغة العربيّة؟
لا شكّ في أنّ الترجمة ضروريّة بوصفها نقلًا لنصوص، وإنتاجًا ثقافيًّا وعلميًا في آن معًا، ولكن هل تكفي الترجمة؟
ربّما يفيد هنا التنبيه إلى أنّ الترجمة الحرفيّة لمصطلحات العلوم الاجتماعيّة المستنبتة في سياق ثقافيّ مثل المدن الصناعيّة الأوروبيّة، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أو المجتمعات ما بعد الصناعيّة في المرحلة الراهنة (و'ما بعد' هنا تشمل ما قبلها، أي إنّ ما بعد المجتمع الصناعيّ يشمل المجتمع الصناعيّ، مثلما يشمل ما بعد الحداثةِ الحداثةَ) لا تكفي، ولا تقدّم ما يلزم لفهم البنى الاجتماعيّة والثقافيّة لمجتمعاتنا، وأنّ امتحان نشوء علوم اجتماعيّة في السياق العربيّ، ولا أقول علوم اجتماعيّة عربيّة، وتحدّي تقديم مساهمة في هذه العلوم على النطاق العالميّ، متعلّق بمدى قدرتنا على استنبات مصطلحات ومفاهيم في واقعنا، وليس فقط تَبْيِئَة مفاهيم من سياقات أخرى فيه، على أهمّيّة هذا الجهد القصوى. والمطلوب أن تُستقرأ مفاهيم وأدوات تحليل إضافيّة في السياق العربيّ، وتُستخدم في فهمه، وتُصدّر إلى سياقات ثقافيّة أخرى، ليرى الباحثون هناك إذا كان في إمكانهم أن يستعيروا منها في واقعهم. فهكذا ينشأ الحوار الحقيقيّ، حتّى لو لم يكن متكافئًا، ويجب أن نعترف أنّه غير متكافئ حاليًّا. ولا أقول غير متكافئ بين الأفراد، بل أتحدّث عن التكافؤ بين درجة تطوّر العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربيّ، وفي أوروبّا، وأميركا الشماليّة.

لوحة 'الكوميديا تضيء فلورسنا' أو 'دانتي وعالمه' لدومينيكو دي ميشيلينو (1465)
ونقرأ وجاهةً أخرى لاستخدام اللغة العربيّة في لزوم أن تكون العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة في أوضاعنا قادرة على التحاور مع مجتمعها؛ أن تخاطب مثقّفيه على الأقلّ. وهذا يعني تجاوز بضع مئات من المشاركين في دوريّة متخصّصة بعيدة عن متناول المثقّف العربيّ، والإصرار على الكتابة فقط بلغة لا يقرؤها، أو بلغة عربيّة لا يفهمها. قرأت مؤخّرًا أبحاثًا عربيّة في الأخلاق لم أفهمها أنا شخصيًّا، وفكّرت في الإنسان العربيّ المثقّف المتوسّط الذي نريده أن يفهم ما نكتبه، تحديدًا في مجال مثل علم الأخلاق، لأنّنا نعيش أزمة من أهمّ نتائجها فوضى المعايير الأخلاقيّة، والتي أصبحت من أهمّ عوامل إنتاجها.
أقول هذا وأنا أدرك أهمّيّة الدوريّات المتخصّصة، والمساهمة في المجتمع العلميّ العالميّ للمتخصّصين في موضوع معيّن، وكذلك لأغراض متعلّقة بتحديد الكفايَة العلميّة في الحالات العاديّة؛ إذ نحتاج إلى معايير متّفق عليها لكي نقيّم إنجاز الباحث والأستاذ الجامعيّ. ولكنّي أتحدّث عمّا يتجاوز الترقية إلى الغايات التي تحدّثت عنها، أي النهوض بالعلوم الاجتماعيّة بلغة مجتمعها.
عن المنهج العلميّ والموقف الأخلاقيّ
في مرحلة فشل الأنظمة العربيّة الديكتاتوريّة ونضوب مصادر شرعيّتها، ونهوض الشعوب العربيّة في كلّ مكان خلف شعارات العدالة والكرامة والحرّيّة، وردّة فعل القوى القديمة بالغة العنف ضدّها، وتبيّن مثالب العفويّة المميتة في انتكاسة الانتفاضات ضدّ الطغيان، وفي مرحلة تفكّك بعض المجتمعات إلى عناصرها الأوّليّة حال اصطدامها بالنظم الحاكمة المتشابكة مع البنى الاجتماعيّة، وإذ نكتشف أنّ عناصرها الأوّليّة ليست أفرادًا غالبًا، بل جماعات، وفي بيئة تهميش المعايير الأخلاقيّة والتعويض عنها بالأيديولوجيّات في أفضل الحالات، وبالمنفعة الانتهازيّة المباشرة، أو بلا شيء، بالخواء في أسوئها؛ علينا أن نجد أجندتنا البحثيّة بأنفسنا، أن نتوقّف عن اللهاث خلف خطوات الأكاديميّة الغربيّة التي تنطلق هناك بصفتها تجديدات وتصلنا بوصفها تقليعات، ونصيخَ السمع لإيقاع الواقع الذي نعيشه، وأن نتفحّص المختبر الكبير الذي يحيط بنا من كلّ جانب، الذي يتمنّى دخوله أيّ باحث في الغرب. من هنا تنطلق مساهمتنا العالميّة، ليس بالتفكير فيها (أي في المساهمة ذاتها)، بل بالتفكير في الظواهر العينيّة التي نريد أن نفهمها؛ فليس الحصول على اعتراف أميركيّ أو أوروبيّ هدفًا في حدّ ذاته، بل الإسهام في فهم مجتمعاتنا، وإن رافق ذلك اعتراف دوليّ، فهذا إنجاز مهمّ على مستوى بناء المؤسّسة الأكاديميّة.
وإذا كان هدفنا إنتاج المعرفة، لا يصحّ أن تكون مجتمعاتنا حالات فحسب، أو ميادين لتجربة العدّة المفهوميّة التي تصلنا من أوروبّا وأميركا الشماليّة، وغالبًا تصلنا متأخّرة. ومن ناحية أخرى، لا يجوز أن نقع في التطرّف المضادّ، بالزعم أنّ كونيّة العلم والمنطق والعقلانيّة كلّها خطاب استعماريّ غربيّ، أو شوفينيّ رجوليّ، أو مركزيّ أوروبيّ أبيض، فنبدأ بالدحض العلميّ للأيديولوجيا الكامنة في بعض النظريّات الوافدة من الغرب والنقد المشروع لها، وننتهي إلى تهويمات صوفيّة.

ولنتذكّر دائمًا أنّ نقد الحداثة في المجتمعات التي عرفتها له معنى آخر غير التقليعة، ودلالات نقد الديمقراطيّة ومآزقها في دولة ديمقراطيّة يختلف عن نقد الديمقراطيّة في مجتمع يعيش في ظلّ الطغيان.
كذلك فإنّ نقد العلم يقوم به الخطاب العلميّ بأدوات علميّة، وإلّا فهو نقد ضدّ العلم؛ فيُفترض أن نستخدم، مثلًا، أدوات علميّة في كشف البنى الكولونياليّة في بلداننا، إلى جانب المعايير الأخلاقيّة في الحكم على الاستعمار. لكنّ البعض يقلب المهمّة إلى نسج لعلم ما بعد كولونياليّ ضدّ علوم كولونياليّة، ويعتقد بذلك أنّه قام بعمل ثوريّ يغنيه عن الموقف الأخلاقيّ، فتكون النتيجة أن يخسر العلم، وفي الوقت ذاته يبرّر لنفسه عدم اتّخاذ موقف أخلاقيّ من الظلم، لأنّه يتوهّم أنّه قام بواجبه الأخلاقيّ، لا لشيء إلّا لأنّه مارس هذا العلم المزعوم.
ما من علوم سوداء وأخرى بيضاء، ولا علوم إسلاميّة ضدّ علوم استشراقيّة، ولا علوم نسويّة ضدّ أخرى ذكوريّة، لكنّ التحدّي أن نتّخذ موقفًا أخلاقيًّا ضدّ القوى التي تمارس العنصريّة على أنواعها، المذكورة أعلاه، وأن نكشف بمنهج نقديّ علميّ صارم عن تأثيرها الأيديولوجيّ، وأثر أحكامها القيميّة في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة.
وبهذه الروح نحدّد أجنداتنا بناء على حاجات المجتمع العربيّ، فنبحث في المجتمع، والدولة، ونهاية القبيلة وإعادة إنتاجها بواسطة القبليّة، ونهاية الطائفة وإعادة إنتاجها عن طريق الطائفيّة في الظرف الراهن، والطبقة، والتمدين، والاندماج الاجتماعيّ، والهجرة، والعقلانيّة، والغيبيّة، والسلفيّة، والأخلاق، وأصول الاستبداد، والتحوّل الديمقراطيّ، وتعثّر التحوّل الديمقراطيّ، وغيرها، مدركين أنّنا نعمل للنهوض في زمن الأفول. أليس هذا تعريف النهضة أصلًا؟ لقد كتب هيغل في فلسفة الحقّ، في تشديده على نهوض الفلسفة في نهايات المراحل التاريخيّة، مع أفول عصر وقبل بزوغ شمس عصر آخر: إنّ بوم المينيرفا (أي طائر الحكمة)، يفرد جناحيه ويبدأ تحليقه بعد الغروب.
[1] عزمي بشارة، الدين والعلمانيّة في سياق تاريخيّ، ج 2، مج 2، العلمانيّة ونظريّات العلمنة (الدوحة/ بيروت: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، ص 196.
[2] ابن خلدون، المقدّمة، الجزء الأوّل من تاريخ ابن خلدون (بيروت: دار الفكر، 2010)، ص 46.
[3]أنظر الفصول حول الفضائل العقليّة عند: أرسطوطاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة أحمد لطفي السيّد، الجزء الثاني، (القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 2008)، ص، 122-154. ويرجى الانتباه إلى أنّ المترجم يستخدم مصطلحات أخرى في الترجمة.
أنظر أيضًا: John W. Well, “Phronesis and the End of Liberal Arts”,
http://4humanities.org/2014/12/phronesis-and-the-end-of-the-liberal-arts/
[4] John W. Well, “Phronesis and the End of Liberal Arts”,
http://4humanities.org/2014/12/phronesis-and-the-end-of-the-liberal-arts/
[5] جمهوريّة أفلاطون، الكتاب الأوّل، الجزء الثالث، ترجمة فؤاد زكريّا (القاهرة: دار الكاتب العربيّ للطباعة والنشر، د.ت.)، ص 17–24.

مفكّر ومناضل عربيّ من مواليد الناصرة في فلسطين عام 1956. خرج من وطنه نحو منفاه بعد سنوات طويلة من العمل السياسيّ، نتيجة ملاحقة إسرائيل له بذريعة 'تقديم معلومات للعدوّ وقت الحرب'. يعمل مديرًا للمركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. له مؤلّفات بحثيّة وفكريّة عديدة، بالعربيّة والعبريّة، في مجالات مختلفة، من ضمنها: الدين والديمقراطيّة، الإسلام والديمقراطيّة، القضيّة الفلسطينيّة، المجتمع المدنيّ، قضيّة الأقلّيّة العربيّة في إسرائيل والأقلّيّات بعامّة، العرب والهولوكوسوت، وغيرها. كما له أربعة مؤلّفات أدبيّة.