في خضّم النقاش والجدل المشتعلين حول ظروف وخلفيات تحلّل السياسة الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وانحرافها عن البوصلة السياسية الوطنية - وأحدث مظاهرهما انهيار القائمة المشتركة - يغيب عن النقاش العام دور وإسقاطات ما آلت إليه الثورات العربية المجيدة في هذا التحلّل.
فقد تناولت الأبحاث السابقة والحالية المختلفة، الغزيرة والهامة، العوامل الأخرى المعروفة في تشكيل أجندة وخصوصية واقع هذا الجزء من شعب فلسطين، وتحديدًا العيش تحت المواطنة الكولونيالية، وما يترتب عن ذلك من دينامية التعاطي مع ضرورات الحياة، والتي تنتج أنماط سلوك سياسي يتسم بالخصوصية الوطنية، أو التوازن بين الوطني والمدني من جهة، وأنماط سلوك متأسرلة بسبب تأثير سياسات الاحتواء والتدجين، وكذلك القمع المباشر، من جهة أخرى.
وقد يكون المؤتمر الدراسي الهامّ، الذي عقده المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتطبيقية – "مدى الكرمل"، عام 2018، المبادرة الأكاديمية والبحثية الوحيدة اليتيمة التي حاولت تقصي آثار انتكاسة الثورات على سلوكنا السياسي، كمواطنين وأحزاب وأطر مختلفة. ورأت اللجنة الأكاديمية للمؤتمر أنّ الثورات العربية هي من الأكثر الأحداث تأثيرًا على فلسطينيي الـ48 منذ اتفاق أوسلو، في المجالات الثقافية والسياسيّة والأيدلوجيّة والاجتماعيّة، وأنها طرحت بقوة سؤال الدين والمجتمع والمجال العمومي العربي والعلاقة مع الدولة والهوية الجماعية.
وكان السؤال الأبرز الذي أراد المؤتمر معالجته، هو مدى مساهمة الانتكاسة في تعزيز الأسرلة في أوساط هذا الجزء من شعبنا، والذي تجلّى بدايةً في عقد مقارنات بين ظروف العيش تحت النظام الصهيوني وعيش أخوتهم الفلسطينيين والعرب في ظل أنظمة لا تقيم وزنًا لمواطنيها، بل تسحقهم بلا رحمة. وفي الواقع، كان العديد منّا - نشطاء سياسيين، ومثقفين، وفنانين، وأكاديميين - تنبّهوا مبكّرا إلى أنّ توحش الأنظمة العربية، سواء تلك الأنظمة المرتبطة أميركيًا، أو الأنظمة " الممانعة" ضد شعوبها وضد جموع الشباب الثائر، سيؤدي إلى تنامي النزوع نحو الأسرلة.
أصاب الإحباط من الانقسام الفلسطيني الكارثي، بين حركتي "فتح" و"حماس"، الفلسطينييّن في إسرائيل في وقت كانت إسرائيل تغيّر قواعد اللعبةِ تجاهَهم، بل تجاه الكل الفلسطيني، وتصبح أكثر عدوانيةً وتوسّعًا، منذ الانتفاضة الثانية وهبّة القدس والأقصى. ولكنَّ العدوان الصهيوني على لبنان والمقاومة اللبنانيّة عام 2006، والصمود الأسطوري لـ"حزب الله" ومن ورائه الشعب اللبناني، في وجه هذا العدوان الوحشي، أعاد التوازن وبعث الأمل في الإنسان الفلسطيني والعربي، مجدّدًا، في القدرة العربية على التصدي للمستعمر المعتدي الإسرائيلي، وكان هذا الشعور المتعاطف عارمًا، في عموم الوطن العربي. كما أضاف صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في وجه العدوان الصهيوني المتكرّر، وحصاره الوحشي المستمر، ليعزّز الثقة بالنفس عند الناس. ولكن تحويل بندقية "حزب الله" وتورّطه في الحرب الأهليّة في سورية وانفلات الأنظمة العربية الوحشي، خاصّة في مصر وسورية، ضدّ الشعبين، مضافًا إلي التدخل التخريبي والإجرامي لأنظمة خليجية في هذين البلدين، وفي اليمن وتونس وغيرها، لتخريب الثورات في عموم العالم العربي، وكذلك وصول أزمة المقاومة الفلسطينية، التي حاولت أن تطرح بديلا لخيار سلطة رام الله الاستسلامي، إلى طريق مسدود، والفشل في تقديم نموذج حكم يليق بحركة تحرّر، كل ذلك انعكس على مزاج ومواقف فلسطينيي الـ48. ومؤخرًا، دخل عامل التطبيع، والتحالف الخياني لأنظمة خليجية مع دولة الاستعمار الصهيونية، كعامل آخر في تعزيز الأسرلة.
ومثلهم مثل الشعوب العربية الثائرة أو شرائح واسعة منها، ومعهم بعض النخب، التي تحوّلت، تحت طائلة القمع الجنوني والذبح الجماعي وتلاشي آمال التغيير بالحرية، إلى البحث عن الاستقرار والتكيّف مع أنظمة الاستبداد، دخل فلسطينيو الـ48 في مسار مشابه، أي البحث عن الاستقرار واختزال طموحاتهم كجماعة قومية مضطهدة ومستعمرة في حقوق مدنية. وبدل من أن تقوم قياداتهم بلعب دور البوصلة والتوجيه القيادي، وترفع من مستوى التمسك بالمعادلة الوطنية: الربط الصحيح بين المواطنة والهوية القوميّة، سايرت التيارَ ففتحت الباب واسعًا أمام عودة الأحزاب الصهيونية، وأمام شخصيات تمثيلية عربية لتسقط في مستنقع هذه الأحزاب.
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة، الثقافية والتعليمية وبناء المؤسسات والأطر الوطنية والمهنية، التي حقّقها هذا الجزء من الشعب الفلسطيني، على مدار أكثر من سبعة عقود من العمل والاجتهاد والكفاح، إلا أنّ علاقتهم مع دولة الاستعمار ظلّت هشّة ومرهونة بالنظرة الإستراتيجية الصهيونية لمواردهم ولوجودهم ودورهم وإمكانيّات تطورهم إلى جزء فاعل في تحدي نظام الأبرتهايد الكولونيالي، وتعرية حقيقته. وقد تحققت هذه الإنجازات العظيمة بوجود قيادات وأطر سياسة أكثر تماسكًا وأكثر أخلاقية، وأقدر على خوض نضال شعبي.
إنّ ما نشهده اليوم على ساحة الأقلية الفلسطينية القومية، من انهيارات سياسية وأخلاقية، لم يأتِ دفعة واحدة، وليس حصيلة تطور خارجي فحسب، بل حصيلة تطورات داخلية أيضًا، داخل الأقلية نفسها، وفي إطار علاقات القوة بينها وبين نظام الأبرتهايد الاستعماري، الذي راح مؤخرًا، ولأسباب خاصة به، يزيد الفتات المالي للسلطات المحلية العربية، من ناحية، ويرفع مستوى التحريض على قياداتهم السياسية، بهدف إضعافها سياسيا، من ناحية أخرى. وفي هذا السياق، عاد ليجدّد سياسة فرّق تسد، وتصنيف القيادات بين معتدل وبين متطرف، بوتيرة أعلى، وعلى ما يبدو حقّق أهدافه بتفكيك القائمة المشتركة تنظيميا، التي كانت أصلا قد سقطت سياسيا بسبب عطب قياداتها.
بدت إقامة القائمة المشتركة الوحدوية لنا وللكثيرين من أبناء شعبنا في كل مكان، عشية انتخابات الكنيست عام 2015، إثر رفع نسبة عبور الحسم، استثناءً لافتًا في خريطة التشظّي والانقسام الفلسطيني والعربي، وكمحاولة طليعية لمنع انتقال وانتشار الاستقطاب المدمر الذي نجم عن قمع واغتيال الثورات العربية، أو موجتها الأولى، إلى صفوف هذا الجزء من أبناء شعبنا الذين يعيشون تحت المواطنة الكولونيالية (الاستقطاب بين علماني وديني ومذهبي، ووطني وغير وطني).
في الواقع، إنّ ما قصدناه آنذاك، نحن أبناء وبنات التيار الوطني الديمقراطي (التجمّع)، من حماستنا لإقامة هذه القائمة الوحدوية هو طموحنا أن تكون رافعة للتنظيم القومي، وبناء المؤسسات الوطنية التمثيلية المنتخبة، وتحصين وتقوية مجتمعنا، وليس في الأساس لزيادة عضوية الكنيست. وكتبتُ في مقالٍ عشية تلك الانتخابات أنّ هذه القائمة قد تكون الطلقة الأخيرة في تجربة المشاركة في انتخابات الكنيست التي كانت قد بدأت بالتآكل الحاد من حيث فائدتها السياسية، بسبب تغوّل نظام الأبرتهايد، وتفشّي ظاهرة النجومية الفارغة، والإيغوزيم المدمّر بين أعضاء الكنيست. غير أن من افتقر إلى هذا الطموح أو هذه الرؤية أو إلى عمود فقري عقائدي، إمّا حاول جعلها تابعة ليسار صهيوني ولعصابة الجنرالات، وعلى رأسهم، بيني غانتس، أو دفعها للتحالف مع حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو، دون أن يتمكّن من يمثل التيار الوطني الديمقراطي رسميًا، من الحفاظ على طليعية وتميز هذا التيار في صد الانحراف.
نحن موجودن، الآن، على عتبة حالة انزلاق نحو استقطاب خطير، قد لا يكون حول الموقف الوطني أساسًا، إنّما حول قضية استقطاب ديني وعلماني، بالمفهوم المتطرف لكلٍّ منهما، وليس حول القضية الوطنية والديمقراطية والنهضة الاجتماعية التقدمية، كما هو حاصل في العالم العربي، بعد البطش بالموجة الأولى للثورات العربية. وقد يقحم من فقد البوصلة السياسية قضية المثليين في هذه المعركة الانتخابية للكنيست الصهيوني، في حين سيجري تهميش وتصغير القضايا الكبرى.
كل ذلك يعيد التأكيد على أهميّة إعادة بناء الحركة الوطنية، وتنظيم شعبنا تحت سقف وطني جامع، من خارج الكنيست، التي باتت وبالًا علينا.
نجحت حركات وطنية صغيرة، في التسعينيّات، في إعادة بناء الحركة الوطنية وتأسيس التجمع، في ظرف اندفاع غير مسبوق نحو الأسرلة والأحزاب الصهيونية، وفي ظل استسلام القيادة الفلسطينية لإسرائيل. أطلق الحركة الوطنيّة وقادها عشرات من الناشطين والمثقفين والأكاديميّين، من ذوي الخبرة التنظيمية، والثقافة الوطنية والثورية، وتمكّنوا من فرملة طوفان الأسرلة، واستعادوا زمام الأمور، وفرضوا خطابا وطنيا متماسكًا وواقعيًا، وانصقل في مرجله عشرات الآلاف من أبناء وبنات شعبنا، من كل الأجيال. فهل يمكن إعادة بناء الحركة الوطنية في الظروف الراهنة؟ أعتقد نعم. إنّ الحركة الوطنية لديها فرصة لتجديد خطابها وصفوفها وانفتاحها على جميع الوطنيين، من خلال الأجيال الجديدة الأكثر وعيًا ومعرفة، وأوضح رؤيةً.
وإعادة البناء الجديدة تتطلّب، وبصورة أوضح وقاطعة، أن نعيد تأطير علاقتنا كجزء من الشعب الفلسطيني ومن مشروعه التحرري الوطني والديمقراطي، ليس فقط من زاوية الخطاب، بل أيضًا من زاوية الانخراط الفعلي في إعادة تشكيل هذا المشروع، هذا الأمر الأول. أمّا الأمر الثاني، فهو أن نعيد تأطير علاقتنا كجزء من الشعوب العربية، ومن حركتها الثورية، والنهضوية، ضد أنظمة الفساد والخراب والإجرام، من أجل تحقيق همومها اليومية، ومن أجل التخلص من الهيمنة الخارجية الإمبريالية.
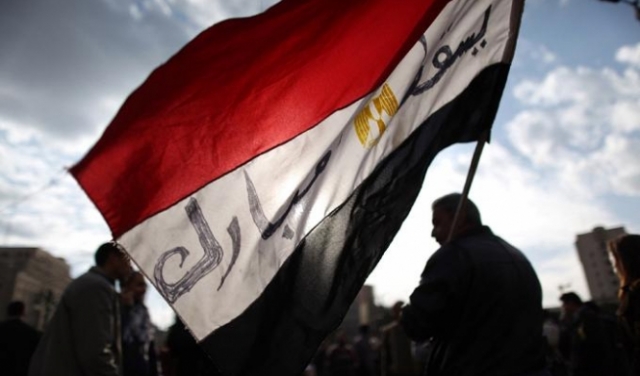

التعليقات