ترجمة خاصة: عرب 48/ أسامة غاوجي
*هذه نُسخة معدّلة من محاضرة كوامي أبياه في محاضرات ريث التي تبثّها 'بي بي سي' ، وهي الجزء الرابع من سلسلة 'الهويات الخاطئة'.
إنّ قيم الحريّة والتسامح والبحث العقلاني ليست من اجتراح ثقافة واحدة. في الحقيقة، فإنّ مفهوم 'الثقافة الغربيّة' هو ابتكار حديث.
مثل العديد من الرجال الإنجليز في القرن التاسع عشر، عاني السير إدوارد بيرنت تايلور من مرض السلّ، واتّبع نصيحة الأطباء الذين نصحوه بالسفر بحثاً عن مناطق تتمتّع بالدفء والهواء الجاف. كان تايلور ينحدر من أسرة تجاريّة مزدهرة تنتمي إلى طائفة الكويكرز، وهكذا فقد كان يمتلك الموارد اللازمة لتحمّل أعباء وتكاليف السفر الطويل. في عام 1855، عندما كان في بدايات العشرينات من عمره، غادر تايلور العالم الجديد؛ وبعد أن صادق أحد علماء الآثار من الكويكرز في أثناء ترحاله، وجد نفسه يركب صهوة الحصان متجوّلاً في الأرياف المكسيكيّة، يزور خرائب حضارة الأزتك وقرى 'الهنود الحمر'. لقد كان تايلور منبهراً مما أطلق عليه ' الدلائل على وجود تعداد سكاني هائل في الحضارة القديمة'. من هذه الرحلة إلى المكسيك، انطلق حماس تايلور ليقضي حياته كلّها في دراسة المجتمعات البعيدة؛ الحديثة والقديمة. في عام 1871، نشر كتابه الرئيسيّ، 'الثقافة البدائيّة'، والذي يُمكن القول إنه كان أوّل كتاب حديث في الأنثروبولوجيا.

لقد كان كتاب 'الثقافة البدائيّة'، من بعض الجوانب، خلافاً ونزاعاً مع كتاب آخر يحمل مفردة 'الثقافة' في عنوانه، ألا وهو كتاب ماثيو آرنولد 'الثقافة والفوضى'، وهو عبارة عن مجموعة كتابات صدرت قبل سنتين من صدور كتاب تايلور. بالنسبة لأرنولد، فإنّ الثقافة هي 'سعينا للوصول إلى كمالنا التام عبر معرفة أفضل ما تمّ قوله أو التفكير فيه عبر العالم، في المسائل التي تهمّنا أشدّ الاهتمام'. لم يكن أرنولد مهتمّاً بشيء محدود وضيّق كنمط التذوّق المتعلّق بطبقة اجتماعيّة مخصوصة: بل كان يُفكّر في المثال ideal الأخلاقي والجمالي، الذي يجد تعبيراته في الفن والأدب والموسيقى والفلسفة.
على أنّ تايلور كان يرى أن الكلمة [أي الثقافة] قد تعني شيئاً مختلفاً، وتمكّن، جزئياً لأسباب ذات طابع مؤسساتيّ، من رؤية ذلك. ذلك أنّ تايلور قد تمّ تعيينه مديراً لمتحف جامعة أكسفورد، وفي عام 1896، تمّ تعيينه كأوّل أستاذ للأنثروبولوجيا في الجامعة. إنّنا ندين بفكرة الأنثروبولوجيا باعتبارها دراسة لشيء يُدعى 'الثقافة' لتايلور على وجه الخصوص، وقد عرّف الثقافة آنذاك أنها 'الكلّ المركّب الذي يشمل المعرفة، والاعتقادات، والفنون، والأخلاق، والقانون، والأعراف، بالإضافة إلى كلّ أشكال القدرات والعادات المطلوبة من الإنسان باعتباره عضواً في المجتمع'. ومن ثمّ فإنّ الحضارة، كما فهمها أرنولد، ليست سوى صيغة من صيغ الثقافة.
اليوم، حين يتحدّث البشر عن الثقافة، فإنّهم يعنون أحد المفهومين الذين طرحهما تايلور وأرنولد. على أنّ هذين المفهومين عن الثقافة، في بعض الجوانب، متخاصمان ومتضادّان. فقط كان المثال ideal لدى أرنولد هو 'رجل الثقافة' ومن ثمّ فإنّه كان ليعتبر أن مفهوم 'الثقافة البدائيّة' مفهوم متناقض ذاتيّاً. في حين يرى تايلور أنه من السخف أن نقول إن إنساناً ما يفتقر إلى الثقافة. على أنّ هذين المفهومين المتعارضين عن الثقافة يتداخلان معاً ويقترنان في تصوّرنا عن 'الثقافة الغربيّة'، والتي يعتقد الكثير من الناس أنها المحدد الذي يُعرّف الشعب الغربيّ الحديث. لذا، اسمحوا لي هنا أن أحاول فكّ الالتباس بشأن التشوّش الحاصل في تصوّرنا عن ثقافة ما بتنا نُطلق عليه 'الغرب'، بمفهوميها [أي الثقافة] التايلوري والأرنولدي.

ذات يوم، سأل أحدهم المهاتما غاندي عن رأيه في الحضارة الغربيّة، فأجاب غاندي ' إنني أظنّ أنها ستكون فكرة جيّدة جداً'. على غرار العديد من القصّص العظيمة، مع الأسف، قد تكون هذه القصّة ملفّقة؛ ولكنّها، ككلّ القصص العظيمة، قد عاشت على ألسنة الناس لأنّها تحمل نكهة الحقيقة. ولكنّ ردّي الخاص سيكون مختلفاً عن ردّ غاندي: إنني أعتقد أن علينا التخلّي عن فكرة الحضارة الغربيّة. فهذه الفكرة، في أفضل الأحوال، مصدرٌ للتشوّش، وهي في أسوأ الأحوال عقبة تمنعنا من مواجهة بعض أهمّ التحديات السياسيّة في زماننا. كنت أودّ ألا أخالف رأي غاندي العظيم، ولكنني أؤمن أن الحضارة الغربيّة ليست فكرة جيّدة على الإطلاق، وكذلك هو الحال بالنسبة لفكرة 'الثقافة الغربيّة'.
إنّ أحد أسباب الالتباس والتشوّش النابع من مفهوم 'الثقافة الغربيّة' يتولّد من مفهوم 'الغرب' نفسه. فنحن نستعمل مصطلح 'الغرب' باستعمالات مختلفة جداً. كتب روديارد كبلينغ، شاعر الإمبراطوريّة البريطانيّة: ' أوه، الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب، ولا يجب أن يلتقي هذان الزوجان'، لقد وضع كبلينغ أوروبا وأسيا في موضع التقابل، متجاهلاً كلّ الأمكنة الأخرى ما عداهما. خلال الحرب الباردة، كان 'الغرب' على جانب من 'الستار الحديدي'، فيما كان الشرق، العدو، على الجانب الآخر. مرّة أخرى، نرى أن هذا الاستعمال لا يشمل معظم العالم أيضاً. أحياناً، بات 'الغرب' يعني، في السنوات الأخيرة، شمال الأطلسي: أوروبا، ومستعمرتها السابقة؛ أمريكا الشماليّة. أما ما يقابل الغرب بحسب هذا الاستعمال فهو إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة- وهي المناطق التي بات يُطلق عليها 'الجنوب العالمي'- على الرغم من أنّ العديد من الأشخاص في أمريكا اللاتينيّة سيدّعون اتصال تراثهم بالغرب. إنّ هذا الاستعمال يقسّم العالم بأشمله ويستوعبه، ولكنّه يصنّف مجموعة هائلة من المجتمعات المختلفة في خانة واحدة، وفي الآن ذاته، يُخاتل الجغرافيا، ويرسم خطّاً ناعماً حول استراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا البيضاء، بحيث يبدو أنّ مفهوم 'الغربي' هنا ليس إلا كناية عن الرجل الأبيض.
لا شكّ، أننا كثيراً ما نتحدّث عن الحضارة الغربيّة لا في مقابل الجنوب، وإنّما في مقابل العالم الإسلامي. وبالمقابل، فإنّ العديد من المفكّرين المسلمين يقومون بفعل الشيء نفسه؛ عبر التمييز بين دار الإسلام ودار الكفر. إنني أودّ أن أتفحّص هذا التقابل. ذلك أنّ هناك العديد من النقاشات الأوروبية والأميركية الجارية حول ما إذا كانت الثقافة الغربيّة في جوهرها مسيحيّة؛ ورّثت هويّتها المسيحيّة لأوروبا، وورّثت هذه الأخيرة هويّتها لفكرة 'الغرب'.
تعود جذور هذه الهويّة الحضاريّة إلى ما يقرب من 1300 سنة. ولكن، لكي نتمكّن من رواية القصّة الكاملة، علينا أن نعود إلى ما قبل ذلك.

بالنسبة للمؤرّخ الإغريقي في القرن الخامس قبل الميلاد، هيرودوت، فقد كان العالم مقسّماً إلى ثلاثة أجزاء. في الشرق توجد آسيا، في الجنوب هناك القارّة التي يُطلق عليها ليبيا، أما الباقي فهو أوروبا. لقد كان هيرودوت يعرف أن الأفكار والبضائع يُمكن أن تنتقل بسهولة بين القارات: فقد سافر هو نفسه عبر النيل وصولاً إلى أسوان، كما قطع مضيق الدردنيل، الحدّ التقليدي الذي يفصل أوروبا عن آسيا. لقد اعترف هيرودوت بحيرته السبب الذي يجعل 'لهذه الأرض، الواحدة، ثلاثة أسماء؛ جميعها مؤنّثة'. ولكنّ، وعلى الرغم من حيرته، فإنّ هذه القارّات الثلاثة كانت هي التقسيمات الجغرافية الرئيسيّة للعالم بالنسبة لليونان ولورثتهم الرومان.
ولكن، وهنا النقطة المهمّة، لم يخطر على بال هيرودوت أن يفكّر أن هذه الأسماء الثلاثة تُقابل ثلاثة أنواع من البشر: الأوروبيين، والآسيويين والأفارقة. فقد وُلد هيرودوت في هاليكارناسوس؛ التي تقع اليوم في بودروم- تركيا. ولكنّ ولادته في آسيا الصغرى لم تجعله آسيويّاً؛ فقد بقي إغريقياً. وبالنسبة له، كانت تبدو شعوب الكلت Celts في أقصى غرب أوروبا، أكثر غرابةً من الفرس أو المصريين، الذين كان يعرف عنهم الكثير. لم يستعمل هيرودوت لفظة 'أوروبيّ' إلا باعتباره صفة، ولم يستعملها أبداً كاسم أو علم على مجموعة من الشعوب والأقوام. وحتى بعد مرور ألف سنة من ذلك التاريخ، لم يتحدّث أحد عن الأوروبيين كشعب على الإطلاق.
على أنّ الجغرافيا التي رسمها هيرودوت قد تغيّرت بشكل جذري مع ظهور الإسلام، الذي فاض عن الجزيرة العربيّة في القرن السابع، وانتشر بسرعة مذهلة شمالاً وشرقاً وغرباً. بعد وفاة النبيّ في 623، احتاج العرب إلى ثلاثين سنة فقط لهزيمة الإمبراطوريّة الفارسيّة التي كانت تمتدّ إلى آسيا الوسطى، وصولاً إلى الهند، وتمكنوا من انتزاع مناطق واسعة من الإمبراطوريّة الرومانيّة البيزنطيّة.
تحرّكت السلالة الأمويّة، التي بدأت الحكم في 661، باتجاه الغرب نحو شمال أفريقيا، ونحو الشرق باتجاه آسيا الوسطى. في حدود عام 711، أرسل الأموييون جيشاً عبر مضيق طارق إلى إسبانيا، التي كان العرب يُطلقون عليها الأندلس، حيث قاتلوا القوط الذين كانوا يحكمون المقاطعات الرومانيّة في هسبانيا [الاسم الذي أطلقه الرومان على شبه الجزيرة الإيبيريّة] لقرنين خليا من الزمن. خلال سبع سنوات، أصبحت معظم أجزاء شبه الجزيرة الإيبيريّة تحت حكم المسلمين؛ ولم يتمكّن المسيحيّون من استعادة السيادة على شبه الجزيرة بشكل كامل إلا في عام 1492؛ أي بعد 800 سنة.
لم تكن خطّة الفاتحين/الغزاة المسلمين الوقوف عند حدود جبال البيريني [جبال البرانس]، وقد قاموا بمحاولات متكررة في السنوات الأولى للتقدّم نحو الشمال. ولكن شارل مارتل، جدّ شارلمان، قد تمكّن في عام 732 من هزيمة قوات الأندلسيين بالقرب من تورز - بواتيه [المعركة التي تُعرف في المصادر العربيّة باسم معركة بلاط الشهداء]، وبهذه المعركة انتهت محاولات العرب لغزو أوروبا الفرنجة. لقد تحدّث مؤرّخ القرن الثامن عشر، إدوارد جيبون، ببعض المبالغة، عن أنّ العرب لو انتصروا في معركة تورز، لأمكنهم الإبحار في نهر التايمز. ويُضيف قائلاً، 'ربّما... كان تفسير القرآن يُدرّس الآن في مدارس أكسفورد، وكان المختونون يقفون على منابرها ليتحدّثوا عن حُرمة وحقيقة الوحي المحمّدي'.
ما يهمّنا لأغراضنا هنا هو أنّ أوّل استعمال للفظة 'الأوروبيين'، كنوع من البشر، قد حصل في أثناء هذا الصراع، بقدر ما أعرف. في السجلات اللاتينيّة، التي كُتبت في 754 في إسبانيا، أشار المؤلّف إلى المنتصرين في معركة تورز بـ'الأوروبيين Europenes'. إذاً، وببساطة، فإنّ فكرة الأوروبيين قد ظهرت أوّل ما ظهرت لعمل مقابلة بين المسيحيين والمسلمين. (على الرغم من أنّ في هذا نوعاً من التبسيط. ذلك أنّه في منتصف القرن الثامن، لم يكن الكثير من الأوربيين مسيحيين).

حتى ذلك الوقت، لم يستعمل أحد في أوروبا العصور الوسطى لفظة 'الغربيين' لأداء هذا المعنى. فأوّلاً، كانت سواحل المغرب، موطن المورو [ وهو مصطلح أوروبي شعبي كان يُطلق على سكان المنطقة المغاربيّة ويمتدّ استعماله لوصف سكان الشمال الإفريقي أحياناً، ومنها اشتقّ لفظ المورسكيين] تمتدّ غرباً إلى إيرلندا. وثانياً، كان الحكّام المسلمون يحكمون شبه جزيرة إيبيريا – جزء من القارّة التي أطلق عليه هيرودوت أوروبا – حتى القرن السادس عشر الميلادي. لم يكن التقابل الطبيعي إذاً بين الإسلام والغرب، وإنّما بين العالم المسيحي ودار الإسلام، وكلا الطرفين كان يعتبر الآخر كافراً، ويعرّفه من خلال عدم إيمانه بالدين الحقّ.
بدءاً من القرن الرابع عشر، تمكّن الأتراك الذين أقاموا الدولة العثمانيّة، تدريجيّاً، من توسيع رقعة حكمهم في أجزاء من أوروبا: بلغاريا، اليونان، البلقان، وهنغاريا. ولم تبدأ عمليّه إعادة فتح /غزو شرق أوروبا إلى في عام 1529، مع هزيمة جيش السلطان سليمان العظيم [المعروف بسليمان القانوني] في فيينا. لقد كانت هذه العمليّة بطيئة. ولم يخسر العثمانيّون سيطرتهم على هنغاريا نهائيّاً إلا في عام 1699؛ لم تستقلّ اليونان إلا في بدايات القرن التاسع عشر، واحتاجت بلغاريا مزيداً من الوقت بعد ذلك.
هنا أصبح لدينا في تلك الحقبة حسّ وشعور واضح بـ'أوروبا المسيحيّة' –العالم المسيحي- وبات يُعرّف نفسه من خلال المقابلة مع الآخر. ولكنّ الانتقال من 'العالم المسيحي' إلى 'الثقافة الغربيّة' لم يكن انتقالاً خطياً مباشراً.
أوّلاً، لأنّ الطبقات الأوروبيّة المسيحيّة المتعلّمة قد أخذت الكثير من أفكارها من المجتمعات الوثنيّة التي سبقتها. فمع نهاية القرن الثاني عشر، كان كريتيان من تروا، الذي وُلد على بعد مئتي كيلومتر جنوب غرب باريس، يحتفي بهذه الجذور القديمة : ' لقد كان لليونان الصيت الأعظم في الفروسيّة والعلم'، يكتب كريتيان. ' ثمّ انتقلت الفروسيّة والعلم إلى روما، ووصلا أخيراً إلى فرنسا'.
تدريجيّاً، أصبحت الفكرة القائلة إن الثقافة العظيمة للإغريق قد مرّت عبر الرومان وصولاً إلى أوروبا الغربيّة، فكرة شائعة في العصور الوسطى. في الحقيقة، فإنّ لهذه العمليّة اسم وهو 'انتقال التعلّم translatio studii'. وقد كان للفكرة حضور طاغٍ ومذهل. بعد ما يزيد عن ستّة قرون، أخبر الفيلسوف الألماني الكبير جورج فريدريش هيجل تلاميذه في المدرسة العليا في نورنبرغ : ' إنّ أسس الدراسة العليا يجب أن تكون، وتبقى، الأدبيات الإغريقيّة في المقام الأوّل، ثمّ تأتي الأدبيات الرومانيّة في المقام الثاني'.
إذاً، فمنذ نهايات العصور الوسطى، كان الناس ينظرون إلى الحضارة الرومانيّة على أنّها وريثة الثقافة العظيمة للإغريق، وأنّ هذا الميراث قد مرّ من خلالها، كما تُمرّر السبيكة الذهبيّة، بعد أن حفر الإغريق الأرض تنقيباً عنها، انتقلت، عندما حكمت الإمبراطوريّة الرومانيّة بلاد الإغريق، إلى روما. ثمّ تقسّمت بين قاعات البلاط الفلورنسيّة والفينيسيّة والفلمنكيّة [نسبة إلى فلورنسا وفينيسيا واللغة الفلمنكيّة للفلاندس في شمال بلجيكا، على التوالي] في عصر النهضة، ومرّت أجزاؤه االصغرى [أي السبيكة الذهبيّة؛ الكيان الثقافي الذي بدأ مع الإغريق] عبر مدن مثل أفينيون، باريس، أمستردام، فايمار، إدنبرة، ولندن، وتمّ جمعها أخيراً – كما تُجمع شظايا الفخار اليوناني المكسور- في الأكاديميّات الأوروبيّة الأميركيّة.
هنا نجد العديد من الطرق والمحاولات لزخرفة هذه السبيكة الذهبيّة. ولكنّ المؤرّخين جميعهم واجهوا صعوبة تاريخيّة في مرادهم لجعل هذه السبيكة الذهبيّة جوهر حضارتهم في مقابل الإسلام. لأنّ الإرث الكلاسيكي الذي يحددها ويُعرّفها كان مشتركاً مع تعاليم المسلمين. ففي بغداد، حاضرة الخلافة، في القرن التاسع الميلادي، كانت مكتبة القصر تحفل بأعمال أفلاطون وأرسطو، وفيثاغورس وإقليدس، مترجمةً إلى العربيّة. في العصور التي وصفها بترارك بـالعصور المظلمة، عندما كانت مساهمة أوروبا المسيحيّة في دراسة الفلسفة الإغريقيّة الكلاسيكية تؤول إلى الصفر، وعندما ضاعت العديد من النصوص الثمينة، كان هذا المسار مزدهاً بين علماء المسلمين. إنّ الكثير من فهمنا الحديث للفلسفة الإغريقيّة الكلاسيكيّة قد تأتّى من خلال النصوص التي استعادها العلماء الأوروبيّون في عصر النهضة من العرب.

في أذهان المؤرّخين المسيحين، كما رأينا، حرّضت معركة تورز الأوروبيين ضدّ الإسلام؛ ولكنّ مسلمي الأندلس، المولعين بالقتال، لم يفكّروا أن القتال من أجل الأراضي يعني عدم مشاركة الأفكار مع الآخر. مع نهاية الألفيّة الميلاديّة الأولى، كانت مدن الخلافة في قرطبة مزدهرة بالتعايش بين اليهود والمسيحيين والمسلمين، من البربر والقوط الغربيين والسلاف ومن إثنيات أخرى لا تعدّ ولا تحصى.
بالطبع، لم يكن هناك علماء دين مسلمون في بلاط شارلمان؛ ولكن في مدن الأندلس، كان هناك أساقفة وأحبار رسميّون. فقد كان ريسموندو [المعروف في المصادر العربيّة باسم ربيع بن زيد]، على سبيل المثال، الأسقف الكاثوليكي لإلفيرا هو سفير قرطبة إلى بلاد بيزنطة والإمبراطوريّة الرومانيّة المقدّمة. ولم يكن حسداي بن شبروط، زعيم المجتمع اليهودي في منتصف القرن العاشر مجرّد عالم طبّي عظيم، بل كان مسؤولاً في مجلس الخليفة الطبّي. وعندما أرسل القيصر البيزنطي قسطنطين [السابع] إلى الخليفة نسخة من كتاب ديسقوريدوس في الأدوية المفردة [المعروف بالمقالات الخمسة]، أخذ الخليفة الأندلسي بنصيحة ابن شبروط في ترجمة الكتاب إلى العربيّة، وأصبحت قرطبة أحد أعظم مراكز المعرفة الطبيّة في أوروبا. لقد أدّت ترجمة كتابات ابن رشد، المولود في قرطبة في القرن الثاني عشر، إلى اللاتينيّة إلى إعادة اكتشاف الأوروبيين لأرسطو. وقد كان ابن رشد يُعرف في أوروبا بـ' أفيروس Averroes'، أو بـ'المعلّق /الشارح'، بسبب تعليقاته على نصوص أرسطو. إذاً، فالتقاليد الكلاسيكيّة التي يُفترض أنها تُميّز الحضارة الغربيّة عن تراث الخلفاء، كانت في الحقيقة هي صلة القرابة بينهما.
هكذا، كان لا بدّ لسرديّة 'السبيكة الذهبيّة' أن تواجه الكثير من الصعوبات. فهي تتخيّل الثقافة الغربيّة على أنّها تعبير عن جوهرٍ ما، تمّ تمريره من يد إلى يد عبر مسيرة التاريخ. ولا شكّ أن مزالق مثل هذا النوع من التعاطي الجوهراني واضحة على نطاق واسع من الحالات. فسواء أكنا نناقش الدين أو الانتماء القومي، أو العرق أو الثقافة، فإنّ البشر يفترضون غالباً أن هويّاتهم، التي حافظت على نفسها عبر الأزمنة والأمكنة، لا بدّ وأنّ لها جوهراً مشتركاً فاعلاً. ولكنّ هذا، وببساطة، خاطئ. فكيف كان شكل إنجلترا في أيّام تشوسر، أبو الأدب الإنجليزي، الذي مات قبل 600 سنة؟ لو حاولنا أن نأخذ أيّ سمة مميّزة نظنّها لإنجلترا، سواء أكانت تركيبة معيّنة من العادات، أو الأفكار، أو الأشياء الماضيّة التي تعبّر عن إنجلترا اليوم. أيّاً كان ما سنختاره لنعتبره علامة مميّزة تنتمي لإنجلترا، سنجد أنه لم يكن كذلك في ذلك الوقت. ما يحدث فعلاً، هو أنّه بمرور الوقت، يرث كلّ جيل العلامة label من الجيل السابق، ومع كلّ جيل، تصبح لهذه العلامات قيمة تراثيّة. ولكنّ، هذا الإرث يضيع أو يتمّ استبداله بشيء آخر، وتبقى العلامة مستمرّة في الحركة. ومن ثمّ، فحين تنتقل إحدى العلامات مع أحد الأجيال إلى خارج الأراضي التي كانت ترتبط بالهويّة الإنجليزيّة [نسبة لإنجلترا لا إلى الغة] – لنقل مثلاً إلى نيو إنجلاند – فإنّ العلامة يُمكن أن تسافر خارج حدود هذه الأراضي. إنّ الهويات تتشكّل وتتماسك من خلال السرديات، لا من خلال الجوهر. إننا لا نصف شيئاً ما بأنّه 'إنجليزيّ' لأنّ هناك جوهراً تعبّر عنه هذه العلامة؛ إننا إنجليزيّون لأنّ قواعدنا تحدد لنا أننا معنيّون بهذه العلامة، لأننا مرتبطون بطريقة ما بمكان اسمه إنجلترا.
إذاً، كيف ارتبط البشر الذين يقطنون شمال الأطلسي، مع بعض البشر الآخرين حول العالم، في نطاق واحد يُدعى 'الغرب'، واكتسبوا بذلك هويّة باعتبارهم جميعاً مشتركين في شيء يُدعى الثقافة الغربيّة؟
من المهمّ أن ندرك أن مصطلح 'الثقافة الغربيّة' مصطلح حديث؛ جديد أكثر حتى من اختراع الفونوغراف. لم يُشر تايلور إلى هذا المصطلح إطلاقاً. ومن المؤكّد أنّه لم يكن ثمّة مبرر للحديث عنه، لأنّه كان واعياً تماماً بالاختلافات الثقافيّة الداخلية حتى في بلده. فمثلاً، في عام 1871، تحدّث تايلور عن وجود أدلّة على السحر في سومرست الريفية [ منطقة ريفيّة تقع في جنوب غرب إنجلترا]. حيث تسبب تيّار هوائي مندفع وقوي في أحد الحانات في طيران بعض حبّات البصل المحمّر المشبوك بدبابيس من المدخنة. 'أحد هذه الحبّات' يقول تايلور، ' كانت تحمل اسم شقيقي القاضي، الذي كان الساحر؛ صاحب الحانة، يحمل تجاهه ضغينة معيّنة . . . ومن ثمّ فقد حاول التخلّص منه عبر غرز الدبابيس في البصل المحمّر، الذي يُمثّل شقيقي القاضي'. هذه ثقافة بدائيّة ولا شكّ.
إذاً، ففكرة الغرب، كاسم لتراث وكموضوع للدراسة، لم تظهر إلا في تسعينات القرن التاسع عشر، خلال الحقبة الإمبرياليّة المحتدمة، ولم يأخذ المصطلح شيوعه الحاليّ إلا في القرن العشرين. حصل ذلك في تاريخ قريب من تاريخ الحرب العالميّة الأولى، عندما كتب أوسفالد شبنجلر كتابه الشهير الذي تُرجم بـ 'انحدار الغرب' [تُرجم للعربيّة بعنوان 'تدهور الحضارة الغربيّة] – وهو الكتاب الذي قدّم فكرة الغرب للعديد من القراء- وقد كان شبنجلر يسخر من فكرة أنّ ثمّة اتصالاً بين الثقافة الغربيّة وبين العالم الكلاسيكي. خلال زيارة الكاتبة والصحفية ريبيكا ويست إلى البلقان في ثلاثينات القرن العشرين، وصفت شعورها في معرض حديثها عن حصار الأتراك لفيينا عام 1683 بالقول 'لم يكن الأمر مريحاً مؤخّراً، بسبب تلك الضربات التي كان يُمكن أن تحطّم ثقافتنا الغربيّة'.
إذا كانت فكرة 'العالم المسيحي' نتاجاً للصراع الطويل مع القوى الإسلاميّة، فإنّ فكرتنا الحديثة عن الثقافة الغربيّة قد تشكّلت، في جزئها الأكبر، خلال الحرب الباردة. في برودة تلك المعركة، اخترعنا سرديّة كبرى تبدأ بالديمقراطيّة الأثينيّة، وتمرّ عبر الماجنا كارتا [الوثيقة العظمى]، والثورة الكوبرنيكيّة، وهلمّ جرا. من أفلاطون إلى حلف الناتو Plato to Nato. هكذا افترضنا أن الثقافة الغربيّة كانت، في جوهرها، فردانيّة وديمقراطيّة ومتجهة نحو الحريّة والتسامح والتقدّم والعقلانيّة والعلميّة. على الرغم من حقيقة أنّ أوروبا في بدايات الحداثة لم تكن تمتلك أيّاً من هذه القيم والصفات، وأنّ الديمقراطيّة كانت استثناءً نادراً في أوروبا حتى القرن الماضي؛ وهي فكرة لم يتحدّث عنها بإيجابيّة، في الفكر الغربي، قبل ذلك إلا القليل من المفكّرين الشجعان. كما إنّ الفكرة القائلة إن التسامح ركيزة أساسيّة للثقافة الغربيّة، كانت لتكون فكرة مفاجئة لرجل مثل إدوارد بيرنت تايلور، الذي كان ممنوعاً، بحكم كونه منتمياً لطائفة الكويكرز، من الالتحاق بالجامعات الكبرى في إنجترا. ببساطة وصراحة: لو كانت الثقافة الغربيّة حقيقة واقعيّة، لما وجدنا الحاجة للحديث عنها مراراً وتكراراً.

من الطبيعي أنّه ما أن أصبحت الثقافة الغربيّة مصطلحاً يحظى بالتمجيد والثناء، أصبح المصطلح مرتبطاً لدى مفكّرين آخرين بالذمّ والقدح أيضاً. فقد بدأ نقّاد الثقافة الغربيّة بالتركيز على الجوانب المظلمة للعبوديّة، وإخضاع الشعوب، والعنصريّة، والنزعة الحربيّة، والإبادات الجماعيّة، وهي ظواهر مرتبطة بذات النظرة الجوهرانيّة؛ الفارق هو أنّهم لم ينظروا إلى السبيكة على أنّها من الذهب، وإنّما من الزرنيخ.
بطبيعة الحال، فإنّ الحديث عن 'الثقافة الغربيّة' كان عليه أن يُواجه الكثير من اللامعقوليّة وأن يتجاوزها. ففكرة الثقافة الغربيّة تضع في قلب الهويّة، كلّ الإنجازات الفكريّة والفنيّة الكبرى – الفلسفة، والأدب، والفن، والموسيقى- وهي أشياء كان أرنولد وعلماء الإنسانيّات يثمّنونها. ولكن، إن كانت الثقافة الغربيّة حاضرة في تروا في نهايات القرن الثاني عشر عندما كان كريتيان حيّاً، فإنّ تأثيرها [أي الثقافة الغربيّة] كان محدوداً بشكل كبير جداً بالنسبة لمعظم البشر، الذين لم يكونوا يعرفون اللاتينيّة أو الإغريقيّة، والذين لم يسمعوا قبل ذلك عن أفلاطون. اليوم أيضاً، لا يلعب التراث الكلاسيكي دوراً كبيراً في الحياة اليوميّة لمعظم الأميركيين أو البريطانيين. فهل هذه الإنجازات التي يثمّنها أرنولد هي ما يربطنا ببعضنا البعض؟ بالطبع لا. إنّ ما يربطنا، بالطبع، هو المعنى العام للثقافة، كما تحدّث عنها تايلور: أعرافنا وأنماطنا في الزيّ والتحايا، عاداتنا السلوكيّة التي تشكّل العلاقات بين الرجال والنساء، والآباء والأطفال، والشرطة والمدنيين، وبين العاملين في المحلات والمستهلكين. لدى المفكّرين في الغالب نزعة للافتراض أن الأشياء التي نهتمّ بها هي الأشياء الأكثر أهميّة. وأنا لا أعني أن هذه الأشياء ليست مهمّة. ولكنّها أهمّيتها أقلّ مما تفترضه قصّة السبيكة الذهبيّة بكثير.
إذاً، كيف علينا ردم الهوّة هنا؟ كيف استطعنا أن نقنع أنفسنا أننا الورثة الشرعيّون لأفلاطون، والأكويني، وكانط، في حين أنّ وجودنا المُعاش يتعلّق بـ بيونسي وبرجر كينغ أكثر من تعلّقه بهذه الأشياء؟ لقد حصل ذلك بدمج الصورة التايلوريّة مع الأرنولديّة، أي بدمج العالم اليوميّ بعالم المُثُل. وقد كان المفتاح لهذا الدمج حاضراً في عمل تايلور نفسه. لنتذكّر تعريفه الشهير : إنّه يبدأ بالثقافة باعتباره 'الكلّ المركّب'. إنّ ما تُفصح عنه هذه العبارة هو ما نُطلق عليه 'النظريّة العضويّة organicis. رؤية الثقافة لا باعتبارها تجمّعاً فضفاضاً لمجموعة من الشظايا المتفرّقة، وإنّما باعتبارها وحدة عضويّة، يقوم فيها كلّ مكوّن، كما في الأجسام العضويّة، بالتكيّف في موقع معيّن، ومن ثمّ فإنّ كلّ مكوّن هو أساسي وضروريّ ليتمكّن الكلّ من أداء وظيفته. وإذاً فإنّ كلّاً من مسابقة يوروفيجن للأغاني، وقواطع ماتيس، ومحاورات أفلاطون، كلّها جزء من كلّ مركّب أكبر. هكذا، يصبح كلّ هذا حاضراً في مكتبتك الثقافيّة، إن جاز التعبير، حتى لو لم تكن، كفرد، قد اطلعت عليه؛ فهو تراثك وملكك. إنّ النظريّة العضويّة، ببساطة، تشرح لنا كيف أنّ حياتنا اليوميّة ممسوحة بغبار السبيكة الذهبيّة.
حسناً، هناك عدّة أشكال من الكلّ العضوي في حياتنا الثقافيّة: الموسيقى، الكلمات، مجموعة التصاميم، ورقصات الأوبرا، ويُفترض أن تنسجم جميع هذه الأشياء معاً. إنّها بعبارة فاغنر Gesamtkunstwerk، أي عمل كلّي للفن. ولكن، ليس ثمّة كلّ واحد كبير يُوحّد كلّ هذه الأجزاء عضويّاً، ويُطلق عليه الثقافة. لقد رفضت إسبانيا، وهي في قلب 'الغرب' الديمقراطيّة الليبراليّة لجيلين كاملين بعد أن تبنتها الهند واليابان في 'الشرق'، موطن الاستبداد الشرقي ! كما إنّ تراث جفرسون – الليبراليّة الأثينيّة، والحريّة الأنجلو ساكسونيّة- لم يحمِ أميركا في من اختراع جمهوريّة العبوديّة. في الوقت نفسه، يُمكننا أن نقول إن بإمكان فرانز كافكا العيش مع مايلز ديفيس [أحد أعظم عازفي وملحني الجاز] بسهولة أكبر من إمكانيّة حضور كافكا مع مواطنه النمساوي-الهنغاري يوهان شتراوس [أحد مؤلّفي الموسيقى الكلاسيكيّة]. يُمكنك اليوم أن تجد موسيقى الهيب هوب في شوارع طوكيو. والأمر صحيح أيضاً فيما يتعلّق بالمطبخ والطعام: فقد يسعد البريطاني بالتخلّي عن وجبته من السمك والبطاطا في مقابل طبق من دجاج المسالا.
حين نتخلّى عن هذه النظرة العضويّة، يُمكننا أن نكوّن صورة أكثر كوزموبوليتانيّة، بحيث يصبح كلّ عنصر من عناصر الثقافة، بدءاً من الفلسفة، إلى المطبخ، إلى نمط حركة الجسد، عنصراً منفصلاً ومستقلّاً عن العناصر الأخرى؛ بإمكان المرء أن يمشي ويتحدّث مثل الأميركيين من أصول أفريقيّة، في حين أنّه يُفكّر مع كانط وماثيو أرنولد، أو مع مارتن لوثر كنغ ومايلز ديفيس. لا يوجد شيء اسمه جوهر للمسلمين يمنع سكان دار الإسلام من استجلاب أو التعاطي مع أيّ شيء من الحضارة الغربيّة، بما في ذلك المسيحيّة أو الديمقراطيّة. كما لا يوجد جوهر غربي يمنع صحيفة نيويوركر مثلاً من استجلاب أو التعاطي مع الإسلام.
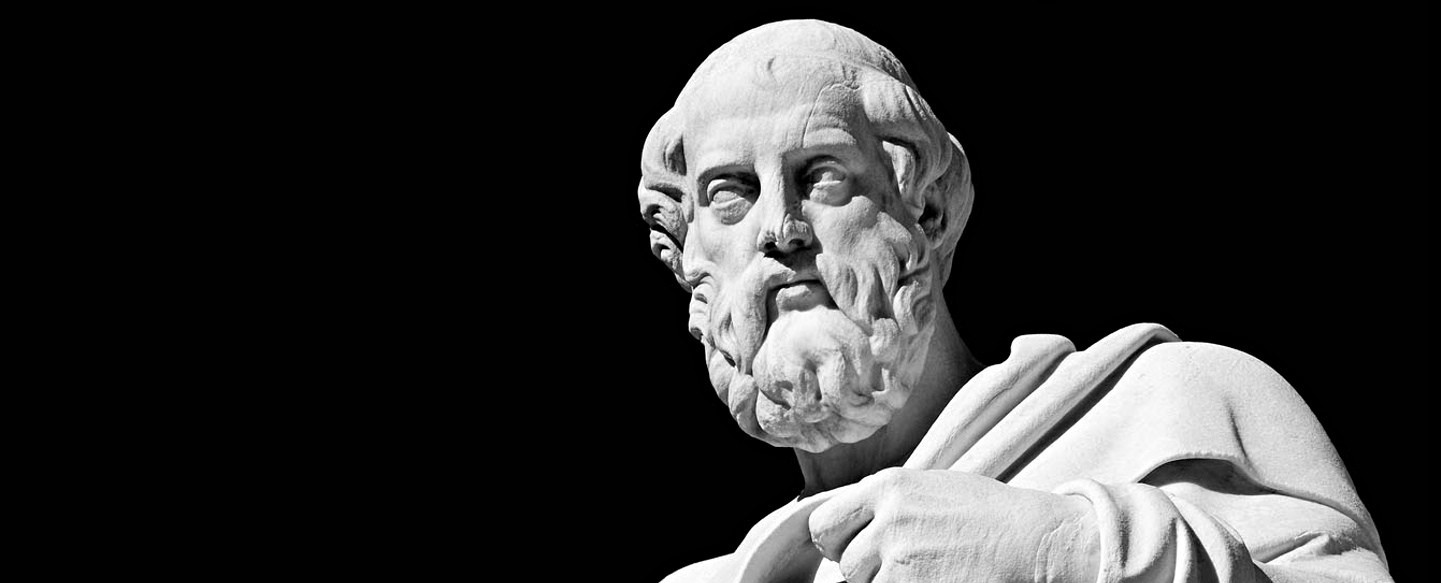
لا شكّ أن القصص التي تقول إننا مرتبطون بأفلاطون وأرسطو وشيشرون والقديس أوغسطين، وصولاً إلى الثقافة المعاصرة في شمال الأطلسي تمتلك بعض الصحّة. فنحن نمتلك وعياً ذاتيّاً بتقليد معيّن من الحجج والدراسة العلميّة. ولكنّ الوهم يكمن في الافتراض أن امتلاكنا للطرق والمنافذ الموصلة إلى هذه القيم كافٍ، كما لو أننا نشغّل قائمة أغانٍ لم نستمع إليها من قبل. إن كان هؤلاء المفكّرون جزءاً من الثقافة بمعناها الأرنولدي، فليس ثمّة ما يضمن أن أفضل ما في هذه الثقافة سيستمرّ في التأثير في أطفالنا مثلاً، بدرجة أكبر من تأثير أرسطو المركزي في الفكر الإسلامي لمئات السنين.
لا تُمتلك الأفكار بحقّ الولادة: بل علينا الحفاظ عليها والاعتناء بها. فأن تعيش في الغرب، أو تعرّف نفسك على أنّ غربي، لا يُعطيك أيّ ضمانة في أنّك تحافظ على أو تهتمّ بالحضارة الغربيّة. تنتمي قيم الإنسانيين الأوروبيين لمن يقترن بها ويأخذها بشكل أصلي، سواء أكان إفريقيّاً أو آسيويّاً أو أوروبيّاً. وبهذا المنطق، فإنّ هذه القيم لا تنتمي إلى الأوروبيين الذين لم يتكبّدوا عناء فهم هذه القيم أو تشرّبها. والعكس صحيح بالطبع. إنّ سرديّة السبيكة الذهبيّة تُشير إلى أننا لا نستطيع أن نساعد في الاهتمام بتقاليد 'الغرب' لأنّها تقاليدنا : في الحقيقة فإنّ العكس هو الصحيح. فهذه القيم تُصبح قيمنا فقط إن قمنا بالاهتمام بها. إنّ ثقافة الليبراليّة، والتسامح والبحث العقلاني أفكار عظيمة. ولكنّها تمثّل اختيارات علينا العمل عليها، وليست مساراً أزليّاً وقدراً حتميّاً للغرب.
في سنة وفاة إدوارد بيرنت تايلور، وقفت 'الحضارة الغربيّة' في مواجهة مميتة مع نفسها: ألقى الحلفاء والقوى العظمى في وسط أوروبا جثث الجنود على بعضهم البعض، دفعوا الشبان إلى موتهم في سبيل 'الدفاع عن الحضارة'. كانت آمال تايلور التقدّميّة والتطوّرية لترتعب من الحقول المنقوعة بالدمّ والخنادق المختنقة بالغاز السام، وكان المشهد متفقاً مع أسوأ مخاوف أرنولد عما تعنيه الحضارة فعلاً. كان أرنولد وتايلور ليتفقا، على الأقل، حول هذا : إنّ الثقافة ليست مربّع اختيار في استفتاء حول الإنسانيّة؛ إنّها عمليّة نشارك فيها، وحياة نعيشها مع الآخرين.
تقدّم الثقافة – كالدين والأمّة والعرق- مصدراً للهويّة للكائنات الإنسانيّة المعاصرة. ويُمكن أن تصبح، كما يُمكن أن يصبح الثلاثة، نوعاً من السجن، وأن تصبح أخطاء مفاهيميّة تبرر أخطاء أخلاقيّة. كما يُمكن لهذه الأشياء جميعاً [أي الثقافة والدين والأمّة والعرق] أن تُهب لنا ملامح حريّتنا. إنّ الهويّات الاجتماعيّة تربط المستوى الأصغر؛ حيث نعيش حياتنا مع عائلاتنا وأقربائنا، بحركات وأسباب واهتمامات أكبر. ويُمكن لهذه الهويّات أن تجعل العالم مفهوماً ومهمّاً وأكثر حيويّة لنا. ويُمكنها أن توسّع أفقنا للنظر إلى مجتمعات أكبر من المجتمع الذي نسكنه كأفراد. ولكنّ حياتنا يجب أن تكون ذات معنى، على المستويات الكبرى أيضاً. إننا نعيش في حقبة أصبحت لأفعالنا فيها، على مستوى الأيدولوجيا وعلى مستوى التكنولوجيا، تأثيرات عالميّة متزايدة. عندما يتعلّق الأمر ببوصلة اهتمامنا وتعاطفنا، فيجب أن تكون الإنسانيّة كلّها هي أفقنا.
إننا نعيش، برفقة سبعة مليارات من أخوتنا البشر على كوكب دافئ صغير. لم يعد البُعد الكوزموبوليتاني الذي ينظم إنسانيّتنا المشتركة مجرّد ترف؛ لقد أصبح ضرورة. لتلخيص هذا المبدأ، أستطيع أن أستحضر هذه الفكرة المتكررة في مسار الحضارة الغربيّة، لأنني لا أظن أنني قادر على صياغة الأمر بطريقة أفضل مما فعله المسرحيّ تيرانس: العبد السابق لروما من أفريقيا، والمترجم اللاتيني للكوميديات الإغريقيّة، والكاتب الأوروبي الكلاسيكي الذي أطلق على نفسه اسم تيرانس الأفريقي. لقد كتب 'إنني إنسان، وأعتقد أنه لا إنسان غريب عني'. وهذه هي الهويّة التي تستحقّ منا أن نحملها.
إذاً، فالحقيقة أنّ مصطلح 'الثقافة الغربيّة' مصطلح حديث؛ بل هو أكثر جدّة من اختراع الفونوغراف.
*كوامي أنطوني أبياه: أستاذ الفلسفة بجامعة 'لورنس إس روكفلر'، ويشغل منصب رئيس مركز 'بن أميركان سنتر'، وعضو في الأكاديمية الأميركيّة للفنون.

التعليقات