في ما يلي ترجمة بتصرّف، خاصّة بـ"عرب 48"؛ الكاتب: بول ستار – أستاذ علم النفس والعلاقات العامة في جامعة برينستون، ومؤلف كتاب "الترسيخ: الثروة والسلطة ودستور المجتمعات الديمقراطية".
في كتابه الكلاسيكي "التحوّل الكبير"، يسرد المؤرخ الاقتصادي، كارل بولاني، قصة الرأسمالية المعاصرة على أنها "حركة مزدوجة"، أدت إلى توسيع السوق وتقييده على حد سواء.
وخلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن الذي تلاه، أُلغيت القيود الإقطاعية القديمة على التجارة، وبدأ التعامل مع الأرض والعمل والأموال كسلع أساسية. لكن الرأسمالية غير المقيدة دمرت البيئة، وأضرت بالصحة العامة للبشر، وأدت إلى ذعر اقتصادي وكساد، وبالتزامن مع شروع بولاني بكتابة كتابه، كانت المجتمعات قد أعادت فرض قيود على السوق.
وترى الأستاذة الفخرية في كلية هارفارد للأعمال، شوشانا زوبوف، أن هناك نسخة جديدة من النصف الأول من حركة بولاني المزدوجة، والتي تعمل اليوم على ظهور "رأسمالية المراقبة"، وهي نموذج جديد للسوق ابتكرته "فيسبوك" و"جوجل".
وفي كتابها "عصر رأسمالية المراقبة"، تدعي زوبوف، أن الرأسمالية توسّع مجددا ساحة السوق، عبر الحصول هذه المرّة على "الخبرة البشرية كمادة خام مجانية للممارسات التجارية الخفية المتمثلة في الاستخراج والتنبؤ والمبيعات".
ومع ظهور "الحوسبة السائدة"، أي انتشار أجهزة الكمبيوتر في جميع مجالات الحياة، وإنترنت الأشياء، أي اتصال كل ما يفعله البشر يوميا بالإنترنت، أصبح استخراج البيانات منتشرًا. ونحن نعيش اليوم في عالم يزداد ازدحامًا بالأجهزة المتصلة بالشبكات التي تلتقط اتصالاتنا وحركاتنا وسلوكنا وعلاقاتنا، وحتى عواطفنا وحالاتنا الذهنية. وتحذر زوبوف من أن رأسمالية المراقبة نجت حتى الآن بتجاوز "الحركة المضادة" إلى حد ما، التي تبحث عنها بولاني.

إن كتاب زوبوف عبقري، حيث يوفر تحليلا مبهرا للاقتصاد الرقمي، ويمثل استغاثة لصحوة اجتماعية حول ضخامة التغييرات التي تفرضها التكنولوجيا على الحياة السياسية والاجتماعية.
ويرى معظم الأميركيين أن المخاطر التي تشكلها شركات التكنولوجيا، تتلخص في أزمة الخصوصية، لكن زوبوف توضح أن رأسمالية المراقبة، تتضمن ما هو أكثر بكثير من مجرد تجميع/مراكمة البينات الشخصية على نطاق غير مسبوق.
إن شركات التكنولوجيا وخبرائها الذين تسميهم زوبوف بجماعة "الكهنة الجديد"، تخلق أشكالًا جديدة من السلطة ووسائل التعديل السلوكي التي تعمل خارج الوعي الفردي والمساءلة العامة. وسيتطلب التدقيق في قوة هذا "الكهنوت" تحركا مضادا جديدا، تكمن وظيفته بتقييد رأسمالية المراقبة باسم الحرية الشخصية والديمقراطية.
نشأة الآلة
نشهد اليوم رد فعل ضد هيمنة صناعة التكنولوجيا، فوزارة العدل الأميركية ولجنة التجارة الفيدرالية، تُحقق في الممارسات الاحتكارية لـ"أمازون" و"آبل" و"فيسبوك" و"جوجل". وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت لجنة التجارة الفدرالية، غرامة قدرها 5 مليارات دولار على "فيسبوك" بسبب انتهاكها وعودها للمستهلكين، المتضمنة في سياساتها الداخلية، فيما يتعلق بموضوع الخصوصية (فالولايات المتحدة، على عكس الاتحاد الأوروبي، ليس لديها قانونًا عامًا يحمي الخصوصية على الإنترنت).
ويدرس الكونغرس تشريعًا للحد من استخدام شركات التكنولوجيا للبيانات واستعادة الحصانة الواسعة من المسؤولية عن المحتوى الذي أنشأه المستخدمون، والذي منح لهم بموجب قانون أخلاق الاتصالات الأميركي لعام 1996. ولا يزال تأثير هذا النقاش الوطني، غير مؤكد.
ولصعود رأسمالية المراقبة، أبعاد دولية أيضا، فلطالما سيطرت الشركات الأميركية على صناعة التكنولوجيا والإنترنت، مما أثار الشكوك والمعارضة في البلدان الأخرى. وبعد تأثر الأميركيون بتجربة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، يشعر الكثيرون منهم بالقلق إزاء مخازن البيانات الشخصية التي تقع في أيدي قوى أجنبية معادية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، انتشر رعب هائل إزاء تطبيق "فيس آب" لتعديل صور الوجوه، والذي استخدمه ملايين الأميركيين لفحص أشكالهم "المتوقعة" مستقبليا، عندما يشيخون. وسادت إشاعة حول التطبيق الذي صنعته شركة روسية، بأنه استُخدم من قبل المخابرات الروسية لجمع بيانات التعرف على الوجوه، ربما لإنتاج فيديوهات مزيفة، وهي مزاعم نفتها الشركة كليا.
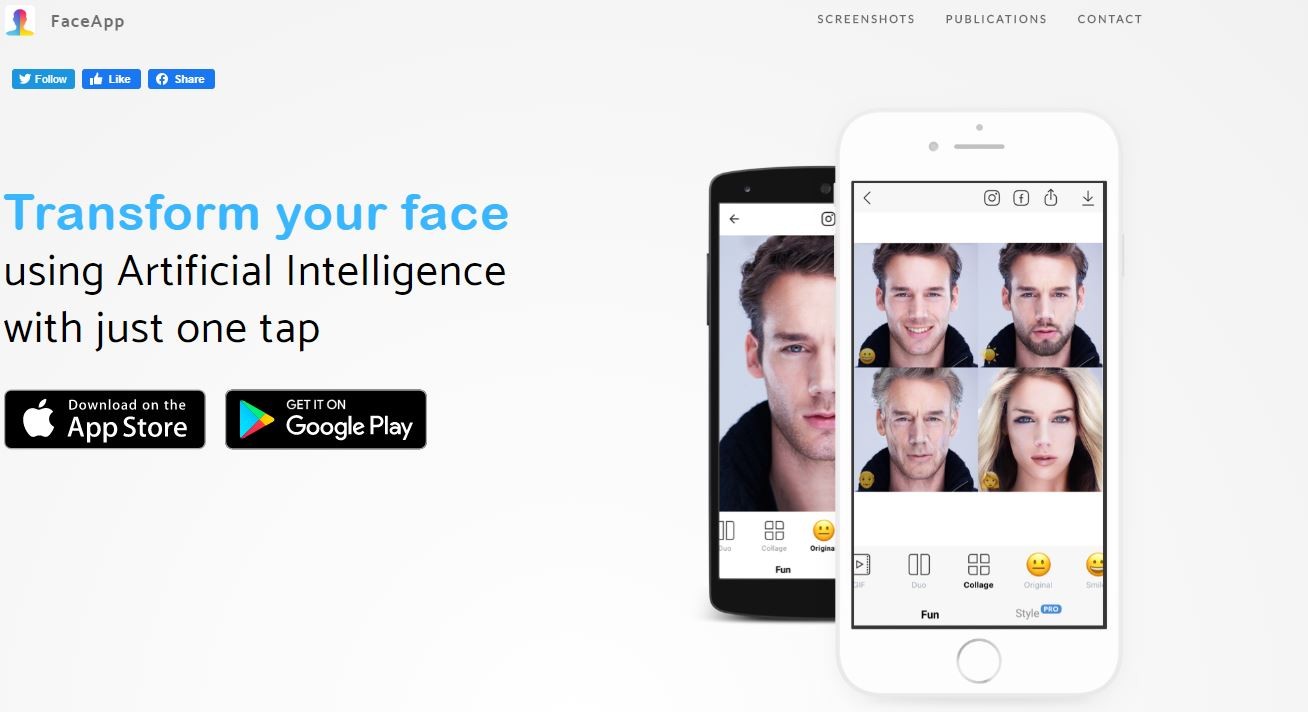
وفي وقت سابق من العام الجاري، أثار استحواذ شركة صينية على تطبيق للتعارف، مخصص للمثليين (جريندرز)، مخاوف حول احتمالية استخدام بينات التطبيق لابتزاز أفراد، وتهديد الأمن القومي الأميركي؛ وأمرت اللجنة الفيدرالية المعنية بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، الشركة الصينية، بتجنب الوصول إلى بيانات "جريندرز" وإخراج استثماراتها بالكامل من الشركة بحلول حزيران/ يونيو 2020. ويُمكننا أن نتخيل كيف يمكن أن تؤدي المنافسة المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، ليس فقط إلى "طلاق تكنولوجي" بين القوتين العظمتين، بل إلى نشأة عالمين مختلفين من المراقبة اليومية أيضا.
وبحسب زوبوف، فقد تأسست رأسمالية المراقبة أولا، عبر الاكتشافات الرائعة لشركة أميركية واحدة، وهي "جوجل"، والتي تصفها بأنها "بالنسبة لرأسمالية المراقبة، هي تماما كشركتي فورد موتورز وجنرال موتورز، بالنسبة للرأسمالية الإدارية المرتكزة على الإنتاج الشامل".
سرعان ما سيطرت "جوجل" بعد تأسيسها عام 1998، على مجال محركات البحث على الإنترنت. لكنها في البداية، لم تركز على الإعلانات كما لم تملك توجها ربحيا واضحا. لكن أهم ما كان بحوزتها، رؤية جديدة ورائدة، فالبيانات الجانبية التي استقتها/ استمدتها من عمليات البحث، عبر تحليل أرقام وأنماط الاستعلامات، وصياغتها، وأنماط نقرات الناس، وما إلى ذلك، أدت إلى تحسين نتائج بحث "جوجل"، وتوفير خدمات جديدة للمستخدمين، ما أدى إلى جذب المزيد من المستخدمين، الأمر الذي قام بدوره بتحسين محرك البحث في دورة متكررة من التعلم والتوسع.
وجاءت طفرت "جوجل" التجارية عام 2002، بعدما رأت الشركة أنها تستطيع استخدام البيانات الجانبية التي تجمعها من البحث، لتشكيل ملفات شخصية للمستخدمين، بناء على خصائصهم واهتماماتهم. ومن ثم، وبدل ملاءمة الإعلانات مع مضامين البحث، أصبحت الشركة قادرة على ملاءمتها للمستخدمين الأفراد، فالتوجيه الدقيق والناجع للإعلانات بما يلائم الأفراد، يُعد المعادلة الأنجح في مجال الإعلانات.
وتدعي زوبوف أنه بدل من أن يكون المستخدمون زبائن "جوجل"، تحولوا إلى مادة خامة للتوريد، استخرجت منهم الشركة ما تُطلق عليه وصف "الفائض السلوكي". ويتكون هذا الفائض من بيانات تتخطى ما تحتاجه "جوجل" لتحسين الخدمات التي تقدمها لمستخدميها. وبإضافة ذلك إلى قدرات الشركة الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، مكّن السيل الجارف للمعلومات، "جوجل"، من خلق ما تراه زوبوف الأساس الحقيقي لصناعة المراقبة؛ "منتجات التنبؤ" التي تتوقع ما سيفعله المستخدمون "عاجلا أم آجلا".

وتُعد القدرة على تنبؤ ما سيشتريه الناس، سرّ الإعلانات الناجح، لكن للتنبؤات السلوكية قيمة جليّة يُمكن استغلالها لأغراض أخرى، مثل التأمين، وقرارات التوظيف، والحملات السياسية.
ويُساهم تحليل زوبوف، في فهم الخدمات التي تقدمها "جوجل" وتبدو غير متعلقة بها، ومشاريعها المتنوعة واستحواذاتها الهائلة على شركات أخرى. وتدعي زوبوف أن "جيميل"، و"خرائط جوجل"، ونظام تشغيل "آندرويد"، و"يوتيوب"، وحتى السيارات ذاتية التشغيل، إضافة إلى عشرات الخدمات الأخرى في شتى المجالات، تخصصها الشركة لتوسيع أساليب "التوريد" لحصد بينات المستخدم على الإنترنت وخارجه.
لكن "جوجل" لا تتبع طلب إذن المستخدمين للحصول على هذه البيانات في نموذج عملها، فعلى سبيل المثال، عندما طورت الشركة "جوجل ستريت فيو"، وهي خاصية تقدمها من خلال خدمة الخرائط الخاصة بها، والتي تُظهر صورا لمناطق مختلفة، قامت "جوجل" بتصوير الشوارع والمنازل في دول مختلفة دون أن تسأل حتى عن أذون محلية، وتصدت لكل معارضة لخطوتها تلك. وفي مجال المراقبة، يُعد المجال غير المحمي من الحياة الاجتماعية، مُباحا.
ويعكس نمط التوسع هذا، منطقا ضمنيا للصناعة برمتها؛ وهو أنه في المنافسة على أرباح الذكاء الاصطناعي والمراقبة، تحظى الشركات التي يُمكنها الحصول على تيارات هائلة ومتنوعة من البيانات، بالأفضلية. أما الشركات الأخرى المندمجة في رأسمالية المراقبة على مستوى عال، مثل "أمازون" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت"، وعمالقة الاتصالات، فهي تواجه أيضا، ذات الضرورات التوسعية.
وبخطوة تلو الأخرى، وسعت الصناعة من نطاق المراقبة (من خلال الانتقال من الواقع الافتراضي إلى العالم الحقيقي) وعمق المراقبة (عن طريق سحب الخصوصية من حياة الأفراد وتجميع البيانات عن شخصياتهم، وحالاتهم المزاجية، وعواطفهم).
ولم تواجه صناعة المراقبة مقاومة حقيقية لأن المستخدمين يحبون المعلومات المخصصة لشخصياتهم، والتي يتلقونها عبر خدمات هذه الشركات، وخصوصا المجانية منها. بل إنهم يحبونها لدرجة أنهم يوافقون بسهولة على شروط الخدمة الفادحة من جانب واحد.
وعلى سبيل المثال، عندما انفجر الجدل حول تطبيق "فيس آب"، تفاجئ أشخاص كُثر ممن استخدموا التطبيق، من معرفة أنهم وافقوا على منح الشركة "ترخيص دائم غير قابل للإلغاء، غير حصري، خالٍ من حقوق الملكية، في جميع أنحاء العالم، مدفوع الأجر لاستخدام أو إعادة إنتاج أو تعديل أو تكييف أو نشر أو ترجمة أو إنشاء أعمال مشتقة من محتوى المستخدم الخاص وتوزيعها، وعرضها للجمهور، وعرض اسم المحتوى أو أي اسم آخر، واسم المستخدم أو تشابه يتم توفيره فيما يتعلق بمحتوى المستخدم الخاص، في جميع تنسيقات الوسائط والقنوات المعروفة الآن أو المطورة لاحقًا، دون تعويض".
لكن هذا لم يكن بمثابة صياغة روسية شريرة، فكما أشار موقع أخبار التكنولوجيا "وايرد"، فإن "فيسبوك" تملك شروط خدمة بذات المقدار من الفداحة.
وحتى إذا ما نجح الكونغرس بسنّ تشريعات تمنع الشركات من فرض مثل هذه الشروط المتطرفة، فالاحتمال بأن تتمكن هذه التشريعات من معالجة المشاكل التي تطرحها زوبوف، لا يزال منخفضًا. فمن المرجح أن يكون معظم الأشخاص على استعداد لقبول استخدام البيانات لتخصيص خدماتهم وعرض الإعلانات المتوقع أن تكون ذات أهمية لهم، ومن غير المرجح أن يوقف الكونغرس ذلك. ومع ذلك، يمكن استخدام نفس عمليات التخصيص لتعديل السلوكيات والمعتقدات. وهذا ما يشغل زوبوف في كتابها، في لبه؛ أي إنشاء نظام سري ضخم من أجل السلطة والهيمنة.
ادفعهم للرقص
من استخراج البيانات وحتى وضع التنبؤات، انتقلت شركات التكنولوجيا إلى التدخل في العالم الواقعي. فرغم كل شيء، ما الطريقة الأنجع لتحسين قدرات التنبؤ من توجيه تصرفات الناس؟
تستخدم الصناعة مصطلح "التحفيز" لوصف صياغة التصرفات. وتكتب زولوف، أن الشركات التكنولوجية، في مسعاها لتحفيز الناس، "تدفع السلوك وتناغمه، وتقوده، وتتلاعب به وتعدّله في اتجاهات محددة، من خلال تنفيذ إجراءات خفية، مثل إدخال عبارات معينة في موجز أخبار فيسبوك أو توقيت ظهور زر ‘اشتري‘ على هاتفك، أو إيقاف تشغيل محرك سيارتك عند تأخرك عن دفع رسوم التأمين".
ويظهر الدليل على قدرة الصناعة على تعديل السلوك البشري على نطاق واسع، في دراستين أجرتهما "فيسبوك". ففي انتخابات الكونغرس الأميركي عام 2010، أجرى باحثو الشركة تجربة عشوائية خاضعة للسيطرة، على 61 مليون مستخدم. ووُزّع المستخدمون إلى ثلاث مجموعات.
أظهر "فيسبوك" لمجموعتين من الثلاث، معلومات حول التصويت، مثل أماكن صناديق الاقتراع، في الجزء العلوي من موجز (نيوز فيد) الأخبار الخاص بالموقع؛ وتلقى المستخدمون في إحدى المجموعتين، رسالة اجتماعية تحتوي على ما يصل إلى ست صور لأصدقاء على "فيسبوك" قاموا بالتصويت. أما المجموعة الثالثة، فلم تحصل على معلومات خاصة حول التصويت.
ونتيجة لذلك، كان للتدخل تأثير كبير على من تلقوا الرسالة الاجتماعية، وقدّر الباحثون أن التجربة أدت إلى تصويت 340 ألف شخص إضافي عما كان سيحدث لولا التدخل.

وفي تجربة ثانية، تلاعب باحثو "فيسبوك" بالمحتوى العاطفي الذي يظهر في موجز الأخبار للمستخدمين، مقللين تارة عدد مشاركات الأصدقاء التي تعبر عن مشاعر إيجابية، ومقللين مشاركاتهم السلبية تارة أخرى. ووجدوا أن أولئك الذين شاهدوا مزيدا من المنشورات السلبية في موجز الأخبار الخاص بحساباتهم، أصبحوا ينشرون المزيد من المنشورات السلبية بأنفسهم، مما يوضح، كما أوضح عنوان المقال المنشور حول الدراسة: "العدوى العاطفية واسعة النطاق عبر الشبكات الاجتماعية".
وأظهر الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 (بريكست)، أمثلة واقعية على التضليل السري الذي عبر إلى الجمهور، عن طريق منصة "فيسبوك".
ولم تقم الشركة فقط بالسماح لشركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أنالاتيكا" بجمع البيانات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك"، بل قامت أيضا خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، بإتاحة الاستهداف المباشر للأفراد عبر "إعلانات منشورات الصفحات غير المنشورة"، المعروفة عموما باسم "المنشورات المُظلمة"، والتي كانت غير مرئية للجمهور.
ووصلت هذه المنشورات إلى المستخدمين كجزء من موجز الأخبار لديهم، بالتناسق مع المحتوى المعتاد، وعندما قام المستخدمون بإبداء إعجابهم بها بضغط "زر الإعجاب"، أو التعليق عليها، أو مشاركتها، كان أصدقاؤهم يرون الدعايات ذاتها، التي تحولت إلى استهدافهم أيضا. ولكن المنشورات المظلمة اختفت بعد ذلك دون أرشفتها على الملء مطلقًا.
ليس الاستهداف الشخصي للإعلانات، أمرا غير شرعي بطبيعته، لكن عندما تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بإيصال رسائل مماثلة خارج المجال العام، فإنها تُعيق عمل الصحافيين في ضبط الخداع، وتخلخل قدرة المعارضين السياسيين على الدفع بحجتهم مقابل الهجوم عليهم. إن تقديم معلومات مضللة خفية على أساس جماهيري، يضر بشكل أساسي بالنقاش الديمقراطي.
ومنذ ذلك الحين، قضت "فيسبوك" على المنشورات المُظلمة، وقامت ببعض التغييرات استجابة للنقد الجماهيري، لكن زوبوف لا تزال مُحقة في نقطتها المركزية: "يملك فيسبوك طُرق غير مسبوقة لتعديل السلوكيات، والتي تعمل بخفاء، وعلى نطاق واسع، وبغياب أي آلية اجتماعية أو سياسية للموافقة، والمعارضة، والتحكم بها".

وعلى سبيل المثال، لا تملك الولايات المتحدة قانونا يمنع "فيسبوك" من تكييف موجز الأخبار الخاص بمستخدم موقعها، لصالح حزب سياسي أو آخر (وفي الولايات المتحدة، قد يكون سن مثل هذا القانون غير دستوري). كما أظهرت دراسة أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2018، أن خوارزمية التوصية في "يوتيوب" كانت توصي بمقاطع فيديو للمشاهدين من مجموعات هامشية متطرفة. وتمثل هذه الخوارزمية وغيرها، مصدرا هائلا للهيمنة على المعتقدات والسلوك.
وبالنسبة لزوبوف، فإن رأسمالية المراقبة تزحزح المجتمع نحو اتجاه معادي للديمقراطية في أساسه. ومع حلول الحوسبة السائدة، فإن الصناعة تحلم في بناء أنظمة وسائل النقل، أو تشييد مدن بأكملها، باستخدام آليات مدمجة للتحكم في السلوك.
وتتصور شركة "سايدووك لابز" الفرعية المملوك من قبل شركة الأم في "جوجل"، "آلفابت"، بناء "مدينة ربحية النموذج"، باستخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات وبيانات المواقع الفعلية، والتي ستحظى في حال تشييدها بوسائل لفرض تشريعات المدينة، وأسواق ديناميكية عبر الإنترنت لتوفير خدمات المدينة.
وبحسب ما أوضحه رئيس الشركة التنفيذي، دان دوكتوروف، في حديث عام 2016، فإن النظام سيتطلب من الناس استخدام منصة الدفع الخاص بـ"سايدووك" عبر الهواتف الذكية، والسماح للشركة، بـ"استهداف الإعلانات للأشخاص القريبين، ومن ثم بمرور الوقت تعقبهم من خلال أشياء مثل الفنارات وخدمات المواقع، إضافة إلى نشاطهم التصفحي" على الإنترنت.
وقال أحد مطوري البرامج لشركة مختصة في مجال إنترنت الأشياء، لزوبوف: "نحن نتعلم كيفية كتابة الموسيقى، ثم ندع الموسيقى تدفعهم للرقص".
وتُلمح هذه التطلعات، إلى تمخض انعدام مساواة متطرف، في القوة بين الأشخاص الذين يتحكمون بأنواع "الموسيقى"، وبين الأشخاص العاديين الذين يتراقصون على "أنغامها".
وفي الجزء الأخير من الكتاب، تتقدم زوبوف في تحليلها، معرفّة الأفكار النظرية والنموذج المجتمعي العام الذي تراه متضمنا في رأسمالية المراقبة.
وتقول زوبوف إن الفكرة المحفزة لرأسمالية المراقبة هي فكرة عالم النفس بي إف سكينر، الذي اعتبر أن الاعتقاد بحرية الإنسان هو بمثابة وهم يعيق الطريق للوصول إلى عالم متناغم يخضع للسيطرة. وبحسب وجهة نظر الكاتبة، تعمل صناعة التكنولوجيا على تطوير وسائل تعديل السلوك لتنفيذ برنامج سكينر.
وتحذر زوبوف من أن نظام الهيمنة الناشئ، ليس طغيانيا؛ فلا حاجة للعنف ولا مصلحة في التطابق الأيديولوجي. بدلاً من ذلك، فما يحدث هو أن ما تطلق عليه تسمية "صحاب الأدوات"، يخدم المراقبة والتحفيز اليومي لتوجيه الناس في الاتجاهات التي يفضلها المسيطرون.
ومثال على ذلك، تعرض زولوف جهود الصين لإدخال نظام ائتماني اجتماعي يسجل نقاطا للأفراد بناء على سلوكهم، وأصدقائهم والجوانب الأخرى من حياتهم، ومن ثم استخدام هذه النتيجة لتحديد وصول كل فرد إلى الخدمات والامتيازات. ويصهر النظام الصيني قوة "صاحب الأدوات" بالدولة (وهو مهتم بالتماثل السياسي)، لكن نظيره الأميركي الناشئ قد يدمج قوة "صاحب الأدوات" بالسوق.
هل من مستقبل واعد؟
يُعد "عصر رأسمالية المراقبة" كتابا قويا وعاطفيا، وهو نتاج الانغماس العميق في كل من التكنولوجيا والأعمال التجارية، المصحوب بفهم التاريخ والالتزام بحرية الإنسان.
ومع ذلك، تبدو زوبوف عاجزة عن مقاومة الصيغ الأكثر روعة والأكثر قوة في حججها. فتقول على سبيل المثال، أن الصناعة انتقلت من "أتمتة تدفق المعلومات حولك إلى أتمتتك بشكل مباشر".
وتدعي أن إنشاء نظام "صاحب الأدوات" المعني بتعديلات السلوك، يتخطى كونه أمر محتمل، إلى حتمية لا جدال حولها، متأثرة بالمنطق الداخلي الخاص برأسمالية المراقبة، وهو: "تمامًا كما كانت الرأسمالية الصناعية مدفوعة إلى التكثيف المستمر لوسائل الإنتاج، فإن رأسماليي المراقبة هم كذلك... محبوسون اليوم في دورة التكثيف المستمر لوسائل التعديل السلوكي".
وتستحق حجة زوبوف أن تُسمع كتحذير عام، لكن الأميركيين بعيدون على أن يكونوا مجرد دمى في أيدي عمالقة "وادي السيليكون". ويكمن اللغز هنا بأن زوبوف ترفض خطاب "الحتمية"، أي "دكتاتورية اللا بدائل"، لكن كتابها لا يوفر أساسًا صغيرًا للتفكير في أنه بإمكاننا تجنب تكنولوجيات التحكم الجديدة، وليس لديها الكثير لتقوله عن بدائل محددة بنفسها.
وستجد نبوءة في كتابها أكثر بكثير مما ستجد السياسة. وهي تجادل بحق في أن تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى لن يحل المشاكل التي تثيرها في الكتاب، على الرغم من أن مكافحة الاحتكار قد تكون مبررة لأسباب أخرى. واقترح بعض المصلحين إنشاء هيكل تنظيمي للتعامل مع قوة المنصات الرقمية وتحسين "المساءلة الحسابية"، أي تحديد الأضرار الناتجة عن الخوارزميات ومعالجتها. لكن كل هذا يكمن خارج هذا الكتاب.
وكلما تمارس المنصات التكنولوجية الكبرى ذات القوة، سلطة على السياسة والمجتمع، تزداد المعارضة التي ستثيرها، وذلك ليس صحيحا في الولايات المتحدة فقط، بل في جميع أنحاء العالم أيضا. وقد يكون الانتشار العالمي لرأسمالية المراقبة الأميركية مجرد مرحلة مؤقتة. تسير القومية اليوم بخطى واثقة، وستمر بصناعة التكنولوجيا؛ فالدول التي ترغب في رسم مصيرها بنفسها لن تستمر في السماح للشركات الأميركية بالتحكم في برامجها الخاصة بالاتصال والسياسة.
وقد تؤدي المنافسة بين الشركات والأنظمة السياسية، إلى تعقيد أي جهود لإصلاح صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وهل سيكون من الجيد، على سبيل المثال، ضبط شركات التكنولوجيا الأميركية، وفتح المجال في المقابل، لمنافساتها الصينية؟
تعترف الشركات الأميركية على الأقل بالقيم الديمقراطية الليبرالية. الحيلة هي تمرير قوانين للتأكد من حفاظها على هذه القيم. وإذا كان كتاب زوبوف يساعد في إيقاظ حركة مضادة، تعمل على تحقيق هذه النتيجة، فقد نتمكن بعد من تجنب المستقبل المظلم الذي ترى أنه ولد اليوم.
اقرأ/ي أيضًا | The Great Hack: خطر الخورارزميات الرقمية على الديمقراطية
اقرأ/ي أيضًا | "اختبار شخصيّة" جديد يخترق بيانات 3 ملايين مستخدم في فيسبوك
اقرأ/ي أيضًا | تعرف على طريقة اختيار الإعلانات الظاهرة بصفحتك في "فيسبوك"

التعليقات