في ما يلي ترجمة بتصرّف، خاصّة بـ"عرب 48"، لمقالة الباحث وعالم النفس الاجتماعي، جونثان هايدت.
ترجمة: أنس سمحان.
مُقدّمة المؤلِّف:
كيف كانت الحياة في بابل[1] قبل انهيارها؟ يُخبرنا سفر التكوين بأن نسل نوح كانوا قد بنوا مدينة عظيمة على أراضي شنعار[2]. وأنهم بنوا برجًا "لتكون قمته في السماء، ليصنعوا اسمًا" لأنفسهم. وقد استاء الرب من غطرسة الإنسانية وقال: «هُوَذَا شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ، وَهذَا ابْتِدَاؤُهُمْ بِالْعَمَلِ. وَالآنَ لاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَا يَنْوُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ. هَلُمَّ نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ» (سفر التكوين – الإصحاح الحادي العشر 6-7)[3].
لا يذكر النَّص بأن الرَّب دمَّر البرج، ولكن تشير العديد من نسخ القصة المختلفة إلى أنه دمّره، ودعونا نتوقف الآن عند هذه الصورة الدرامية: أناس يتجولون فوق حُطام البرج، وغير قادرين على التواصل فيما بينهم، ومحكومون بعدم الاستيعاب المُتبادل.
قصة بابل هي أفضل استعارة وجدتها لما حدث لأميركا في 2010، وللبلد الممزق الذي نعيش فيه الآن (وللعالم أجمع). مصيبة ألمت بنا فجأة، وصرنا بعدها مرتبكين وغير قادرين على التحدث باللغة نفسها، ولم نعد قادرين على رؤية الحقيقة أمامنا أو تمييزها. عُزلنا عن بعضنا البعض وعن ماضينا وحاضرنا.
لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن أميركا الحمراء وأميركا الزرقاء أصبحتا مثل دولتين مختلفتين تطالبان بنفس المنطقة، بنسختين مختلفتين من الدستور والاقتصاد والتاريخ. لكن بابل ليست قصة عن القبلية، بل عن تجزئة كل شيء. قصة تتحدث عن تمزيق النسيج المتماسك، وتشتيت الجمع، بل تصل كونها استعارة مكتملة الأركان لما يحصل بين الأحمر والأزرق، ولما يحصل في داخل اليسار وفي داخل اليمين، ولما يحصل في داخل الجامعات والشركات والاتحادات المهنية والمتاحف، بل وحتّى العائلات.

علينا أن ننظر إلى بابل على أنها استعارة لما فعلته وسائل التواصل الاجتماعي بكل المجموعات والمؤسسات، تقريبًا، المهمة من أجل مستقبل البلد، ومن أجل الشعب (ومن أجل الثقة وأثر مواقع التواصل الاجتماعية في زيادة الشكّ الهدّام حول العالم). ولكن كيف حصل هذا؟ وبم ينذر في الحياة الأميركية (وحياة الناس في كل مكان)؟
بناء البرج الحديث
ثمة اتجاه للتاريخ وهو نحو التعاون بين البشر على مستويات أكبر، ونرى هذا الاتجاه في التطور البيولوجي، وفي سلسلة "التحولات الكبرى" التي ظهرت من خلالها الكائنات متعددة الخلايا لأول مرة، والتي طوَّرت لاحقًا علاقات تكافلية جديدة، وكما نرى ذلك في التطور الثقافي كما أوضح روبرت رايت في كتابه عام 1999 "معادلة غير صفرية: منطق المصير البشري"، حيث أظهر أن التاريخ ينطوي على سلسلة من التحولات، مدفوعة بزيادة الكثافة السكانية بالإضافة إلى التقنيات الجديدة (الكتابة والطرق والمطبعة) التي خلقت إمكانيات جديدة للتجارة والتعلم المتبادلين. كان من الأفضل النظر إلى الصراعات ذات المحصلة الصفرية، مثل الحروب الدينية التي اشتعلت مع نشر المطبعة للأفكار الهرطقية في جميع أنحاء أوروبا على أنها انتكاسات مؤقتة، وأحيانًا على أنها جزء لا يتجزأ من التقدم (وقال إن تلك الحروب الدينية جعلت الانتقال إلى الدول القومية الحديثة ممكنًا مع مواطنين أكثر اطلاعًا ووعيًا). وقد أشاد الرئيس بيل كلينتون بتصوير كتاب "معادلة غير صفرية" المتفائل لمستقبل أكثر تعاونًا بفضل التقدم التكنولوجي المستمر.
وقد مثّل الاختراع المُبكِّر للإنترنت في التسعينيات بغرف الدردشة ولوحات الرسائل والبريد الإلكتروني مثالًا على أطروحة هذا الكتاب، كما فعلت الموجة الأولى من منصات الوسائط الاجتماعية، التي انطلقت حوالي عام 2003، إذ سهّلت الشبكات مثل "ماي سبيس" و"فريندستر" و"فيسبوك" التواصل مع الأصدقاء والغرباء للتحدث عن الاهتمامات المشتركة فيما بينهم مجانًا وعلى نطاق لم يكن مُتخيلًا قبلًا. وبحلول عام 2008، برز موقع "فيسبوك" بوصفهِ المنصة المهيمنة بأكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا، وهو اليوم في طريقه إلى ما يقرب من 3 مليارات مستخدمٍ. كان الاعتقاد الشائع في العقد الأول من القرن الجديد أن وسائل التواصل الاجتماعي ستكون نعمة للديمقراطية، فكيف يمكن لأي ديكتاتور أن يفرض إرادته على مواطنين مترابطين؟ وما هو النظام الذي يمكنه بناء جدار لمنع الإنترنت؟
وبلغا ذورة التفاؤل بالديمقراطية التقنية عام 2011، وهو العام الذي بدأ مع الثورات العربية وانتهى بحركة «احتلوا»[4] العالمية. كان ذلك أيضًا عندما أصبحت خدمة الترجمة من "غوغل" متاحة على جميع الهواتف الذكية تقريبًا، لذلك يمكنك القول إن عام 2011 كان العام الذي أعادت فيه البشرية بناء برج بابل. كنا أقرب مما كنا عليه في أي وقت مضى من أن نكون "شعبًا واحدًا"، وقد تغلبنا بشكل فعال على لعنة الانقسام بسبب اللغة. بدا الأمر للمتفائلين الديمقراطيين التقنيين وكأنه مجرد بداية لما يمكن أن تفعله الإنسانية حين تجتمع.

فكّر مارك زوكربيرغ في شباط/ فبراير 2012 وبينما كان يستعد "فيسبوك" لاكتتابه العام، في خططه للموقع وفيما ينوي فعله وكتب في رسالة إلى المستثمرين "وصل مجتمعنا اليوم إلى نقطة تحول أخرى". يأمل موقع فيسبوك "في إعادة توصيل العلاقات البشرية بالطريقة التي يتوزع بها الأشخاص حول العالم وبالطريقة التي يستهلكون فيها المعلومات"، من خلال منحهم "القدرة على المشاركة"، وسيساعدهم ذلك على "تحويل العديد من مؤسساتنا وصناعاتنا الأساسية مرة أخرى".
فعل زوكربيرغ في السنوات العشر منذ ذلك الحين ما قال إنه سيفعله بالضبط. لقد أعاد توصيل العلاقات البشرية بالطريقة التي ننشر بها المعلومات ونستهلكها، لقد غيَّر مؤسساتنا ودفعنا إلى ما وراء نقطة التحول. لم يتحقق الأمر كما كان يتوقع.
الأشياء تتداعى
اعتمدت الحضارات تاريخيًا على الدم المشترك والآلهة والأعداء لمواجهة الميل إلى الانقسام مع نموها، ولكن ما الذي يجمع الديمقراطيات العلمانية الكبيرة والمتنوعة مثل الولايات المتحدة والهند أو في هذا الصدد بريطانيا وفرنسا الحديثتان؟
حدد علماء الاجتماع ثلاث عوامل رئيسة على الأقل تربط مجتمعةً الديمقراطيات الناجحة: رأس المال الاجتماعي (شبكات اجتماعية واسعة مع مستويات عالية من الثقة)، ومؤسسات قوية، وقصص مشتركة. لقد قوَّضت وسائل التواصل الاجتماعي العوامل الثلاثة. كيف؟ يجب أن نفهم كيف تغيرت وسائل التواصل الاجتماعي بمرور الوقت وخاصة في السنوات التالية لعام 2009.
كانت المنصات مثل "ماي سبيس" و"فيسبوك" في صورها الأولى غير ضارة نسبيًا، إذ سمحت للمستخدمين بإنشاء صفحات يمكن من خلالها مشاركة الصور والأخبار العائلية والروابط إلى الصفحات الثابتة في الغالب مع أصدقائهم والفرق الموسيقية المفضلة لديهم، وهي بذا كانت مجرد خطوة أخرى في التقدم الطويل للتحسينات التكنولوجية مثل خدمة البريد عبر الهاتف إلى البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتي ساعدت الناس على تحقيق الهدف الأبدي المتمثل في الحفاظ على روابطهم الاجتماعية.
ولكن أصبح مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تدريجيًا أكثر راحة في مشاركة التفاصيل الحميمة لحياتهم مع الغرباء والشركات. وكما كتبتُ في مقالة نشرتها مجلة أتلانتيك عام 2019 مع توبياس روز ستوكويل، فقد صار النَّاس أكثر مهارة في تقديم العروض وفي إدارة علامتهم التجارية الشخصية، وهي أنشطة قد تثير إعجاب الآخرين ولكنها لا تعمِّق الصداقات بالطريقة التي تؤديها أي محادثة هاتفية خاصة.
وبمجرد أن دربت منصات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت في "إنتاج المحتوى" ووقت أقل في الاتصال، كانت قد مهَّدت الطريق للتحول الكبير الذي بدأ في عام 2009: تكثيف ديناميكيات النشر الفيروسي (أو الانتشار السريع).

كان فيسبوك قبل عام 2009 قد منح المستخدمين في حساباتهم الشخصية ميزة الخط الزمني (Timeline) وهو ما عنى تدفق غير منتهٍ لمحتوى الأصدقاء والمعارف، وصنف المحتوى زمنيًا، بحيث تكون أحدث المنشورات في الأعلى والأقدم في الأسفل.
شكَّلت هذه الميزة قفزة كبيرة لفيسبوك لأن الخط الزمني كان انعكاسًا دقيقًا لما ينشره الآخرون. ولكن الأمر أخذ بالتغير في العام نفسه عندما قدم فيسبوك للمستخدمين طريقة "للإعجاب" علنًا بالمنشورات بنقرة زر واحدة. وقدّم تويتر في العام نفسه زرَّا أكثر قوة: زر "إعادة التغريد"، والذي سمح للمستخدمين بتأييد أي تغريدة علنًا مع مشاركته مع جميع متابعيهم.
وسرعان ما نسخ فيسبوك هذا الابتكار عبر زر "المشاركة" والذي أصبح متاحًا لمستخدمي الهواتف الذكية في عام 2012، وبعدها صارت أزرار "أعجبني" و"مشاركة" ميزات أساسية لمعظم شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى وغيرها من المواقع.
بعد فترة وجيزة من بدء زر "أعجبني" في إنتاج بيانات حول أفضل ما يدفع مستخدميها للتفاعل، طور فيسبوك خوارزميات لتزويد كل مستخدم بالمحتوى الذي يُرجح أن يثير "إعجابه" أو بعض التفاعلات الأخرى، بما في ذلك في النهاية "مشاركة" هذا المحتوى، وأظهر بحث لاحق أن المشاركات التي تثير المشاعر، وخاصة الغضب من المجموعات الخارجية، كانت هي الأكثر احتمالا للمشاركة.
صارت وسائل التواصل الاجتماعي بحلول عام 2013 لعبة جديدة ذات ديناميكيات مختلفة عن تلك التي ظهرت في عام 2008، وإذا كنت ماهرًا أو محظوظًا، فيمكنك إنشاء منشور "فيروسي الانتشار" ويجعلك "مشهورًا على الإنترنت" لبضعة أيام. أما إذا أخطأت، فقد تجد نفسك مدفونًا في جبالٍ من التعليقات البغيضة. تأخذك منشوراتك إلى الشهرة أو الإلغاء الاجتماعي بناءً على نقرات آلاف الغرباء، وأنت بدورك ساهمت بآلاف النقرات في هذه اللعبة.
شجعت هذه اللعبة الجديدة على عدم الأمانة وعلى خلق ديناميات غوغائية: لم يتم توجيه المستخدمين فقط من خلال تفضيلاتهم الحقيقية ولكن من خلال تجاربهم السابقة في المكافأة والعقاب، وتنبؤهم بكيفية تفاعل الآخرين مع كل إجراء جديد.
كشف أحد المهندسين في "تويتر" الذين عملوا على زر "إعادة التغريد" لاحقًا أنه يأسف لمساهمته في الزر لأنه جعل المنصَّة مكانًا أكثر شرًا. وبينما شاهد هذا المهندس العصابات الغوغائية تتشكل في تويتر، فكر في نفسه "ما فعلناه كان يشبه إعطاءنا سلاحا محشوًا لطفل ذي 4 سنوات".
رأيت هذا يحدث أيضًا بصفتي عالم نفس اجتماعي يدرس العاطفة والأخلاق والسياسة. صُمِّمَت المنصات التي عُدِّلت حديثًا بشكل مثالي تقريبًا لإبراز ذواتنا الأكثر أخلاقية والأقل تفكيرًا. كان حجم الغضب مروعًا. كان هذا النوع من الغضب المزعج والمتفجر هو ما حاول جيمس ماديسون حمايتنا منه بينما كان يصيغ الدستور الأميركي. كان واضعو الدستور علماء نفس اجتماعيين ممتازين. كانوا يعرفون أن الديمقراطية لها كعب آخيل[5] لأنها تعتمد على الحكم الجماعي للشعب، وأن المجتمعات الديمقراطية تخضع "للاضطراب وضعف المشاعر الجامحة". وعليهِ، كان المفتاح لتصميم جمهورية مستدامة هو بناء آليات تُبطئ حركة الاضطرابات، وتهدئ المشاعر، وتختار الحلول الوسط، وتعزل القادة عن جنون اللحظة مع ضمان استمرار مساءلتهم أمام الشعب بشكل دوري، في يوم الانتخابات.
جلبتنا شركات التكنولوجيا التي عززت الفيروسية من 2009 إلى 2012 إلى عمق كابوس ماديسون. يستشهد العديد من المؤلفين بتعليقاته في "الفيدرالية رقم 10" حول النزعة البشرية الفطرية نحو "الانقسام"، والذي قصد به ميلنا إلى تقسيم أنفسنا إلى فرق أو أحزاب ملتهبة "بالعداء المتبادل" لدرجة أنّها "تميل إلى مضايقة واضطهاد بعضها بدلًا من التعاون من أجل مصالحها المشتركة".
لكن تلك المقالات التي تستشهد بماديسون تتجاهل له تعليقًا آخر لا يقل أهمية حول خطر تعرض الديمقراطية للتفاهة. يلاحظ ماديسون أن لدى الناس ميلٌ للانقسام إلى درجة أنه "في حالة عدم وجود مناسبة جوهرية توحدّهم، فإن الفروق الأكثر تفاهة وخيالًا تكون كافية لإثارة مشاعرهم غير الودية وإثارة نزاعاتهم الأكثر عنفًا".
لقد ضخمت وسائل التواصل الاجتماعي التفاهة وسلَّحتها. هل ديمقراطيتنا أكثر صحة الآن بعد أن كانت لدينا مشاجرات على تويتر حول فستان ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (الذي كُتب عليه افرضوا الضرائب على الأغنياء)، في حفل (Met Gala) السنوي، وفستان ميلانيا ترامب في احتفال 11 أيلول/ سبتمبر التذكاري، والذي كان يشبه ناطحة سحاب؟ ماذا عن تغريدة السيناتور تيد كروز التي انتقدت بيغ بيرد لتغريده عن حصوله على جرعة من لقاح كوفيد-19؟
لم يعد المهم الآن أننا نفقد وقتًا ثمينًا في هذه المهاترات، ولم يعد مهمًا أن انتباهنا قد اختل تمامًا، المُهم حقًا الآن هو التمزق المستمر للثقة. يمكن للاستبداد أن ينشر الدعاية أو يستخدم الخوف لتحفيز السلوكيات التي يرغب فيها، لكن الديمقراطية تعتمد على القبول الداخلي الكبير لشرعية القواعد والمعايير والمؤسسات. لا نتحدث عن الثقة العمياء وغير القابلة للنقض في أي فرد أو منظمة معينة، ولكن عندما يفقد المواطن ثقته في القادة المنتخبين، وفي السلطات الصحية، وفي المحاكم، وفي الشرطة، وفي الجامعات، وفي نزاهة الانتخابات، يصير كل قرار محل نزاع وتصبح كل انتخابات صراع حياة أو موت لإنقاذ البلاد من الجانب الآخر.
أظهر أحدث مقياس (Edelman Trust Barometer "مقياس دولي لثقة المواطنين في الحكومة والشركات والإعلام والمنظمات غير الحكومية") أنظمة استبدادية ناجحة ومستقرة (مثل الصين والإمارات العربية المتحدة) على رأس القائمة، في حين أن الديمقراطيات كثير الجدل مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وكوريا الجنوبية كانت بالقرب من القاع (وإن كانت فوق روسيا).

تشير الدراسات الأكاديمية الحديثة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي بالفعل إلى تآكل الثقة في الحكومات ووسائل الإعلام الإخبارية والأشخاص والمؤسسات بشكل عام. وخلصت ورقة عمل تقدم مراجعة هي الأكثر شمولًا لبحث كان بقيادة عالما الاجتماع، فيليب لورينز سبرين وليزا أوزوالد، إلى أن "الغالبية العظمى من الارتباطات المُسجّلة بين استخدام الوسائط الرقمية والثقة تبدو ضارة بالديمقراطية". الأدبيات هذا الوسط معقدة، وتظهر بعض الدراسات فوائد للعالم الرقمي، لا سيما في الديمقراطيات الأقل تطورًا، لكن المراجعة وجدت بشكل متوازن أن وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من حالة الاستقطاب السياسي وتُثير الشعبوية، خاصة اليمينية الشعبوية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتشار المعلومات المضللة.
عندما يفقد الناس الثقة في المؤسسات، فإنهم يفقدون الثقة في القصص التي ترويها تلك المؤسسات، وينطبق هذا بشكل خاص على المؤسسات المكلفة بتعليم الأطفال.
غالبا ما تسببت مناهج التاريخ (التعليمية) في جدالات سياسية، لكن فيسبوك وتويتر يمكنان الآباء من الغضب كل يوم، ربما بسبب مقتطف جديد من دروس التاريخ التي يتلقاها أطفالهم، وأيضًا بسبب دروس الرياضيات والاختيارات الأدبية، وبسبب أي تحولات تربوية جديدة في أي مكان في البلاد.
أصبحت دوافع المعلمين والإداريين موضع تساؤل، ويتبع ذلك أحيانًا تجاوز القوانين أو إصلاحات المناهج الدراسية، مما يؤدي إلى إضعاف التعليم وتقليل الثقة فيه بشكل أكبر.
إحدى نتائج هذا هي أن الشباب الذين تعلموا في حقبة ما بعد بابل يكونون أقل عرضة للوصول إلى قصة متماسكة ومترابطة حول هويتهم كشعب واحد، وأقل احتمالية لمشاركة أي قصة من هذا القبيل مع أولئك الذين التحقوا بمدارس مختلفة أو الذين تلقوا تعليمهم في عقد مختلف.
تنبأ المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية، مارتن غري، بآثار هذا التمزّق في كتابه لعام 2014 "ثورة الجمهور"، وركز تحليله على التأثيرات التخريبية للنمو الأسي للمعلومات على السلطة، بدءًا من الإنترنت في التسعينيات.
نشر غري كتابه قبل عقد من الزمان تقريبًا، وتمكَّن بالفعل من رؤية قوة وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها مُذيبًا عالميًا، مما أدى إلى انهيار الروابط وإضعاف المؤسسات في كل مكان وصلت إليه.
وأشار إلى أن الشبكات الموزِّعة "يمكنها الاحتجاج والإطاحة بالحاكمين، لكنها لا تحكم أبدا". ووصف العديد من حركات الاحتجاج عام 2011 التي نظمت في الغالب على الإنترنت العدمية، مثل احتلوا وول ستريت، والتي طالبت بتدمير المؤسسات القائمة دون تقديم رؤية بديلة للمستقبل أو تقديم منظمة يمكنها تحقيق ذلك.
لا يحب غري النُّخب أو السلطة المركزية، لكنّه يشير إلى سمة بنَّاءة للعصر ما قبل العصر الرقمي: "جمهور جماهيري" واحد، يستهلك جميعه المحتوى نفسه، كما لو كانوا جميعًا ينظرون إلى مرآة عملاقة واحدة بحثًا عن انعكاس مجتمعهم. وفي تعليق له على فوكس، يتذكر غري بداية التشتت والانقسام ما بعد انهيار بابل الجديدة ويقول:
"لقد حطمت الثورة الرقمية تلك المرآة، والآن يسكن الناس تلك القطع المكسورة من زجاجها. لم يعد الجمهور جسدًا واحدًا، بل مجزأ للغاية، ومعادٍ لبعضه البعض. يصرخون فيما بينهم ويعيشون في فقاعات من نوع أو آخر لا نهاية لعددها".
لعل مارك زوكربيرغ لم يكن يتمنى وقوع أيًا من ذلك، ولكن من خلال إعادة توصيل العلاقات البشرية وبرغبته الاندفاعية المتهورة للنمو وبمعرفة ساذجة لعلم النفس البشري، وبفهم ضئيل لتعقيد المؤسسات، ولعدم اهتمامه بالتكلفة الخارجية المفروضة على المجتمع، دمّر فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وإلى جانب عدد قليل من المنصات الكبيرة الأخرى، عن غير قصد الثقة والإيمان بالمؤسسات وبالقصص المشتركة التي جمعت ديمقراطية علمانية كبيرة ومتنوعة معًا يومًا ما.
أعتقد أنه يمكننا تأريخ سقوط بابلنا إلى السنوات ما بين 2011 (السنة المحورية بالنسبة لغري للاحتجاجات "العدمية") و 2015، وهو عام تميز بـ "الصحوة الكبيرة" لدى اليسار وصعود دونالد ترامب في اليمين. لم يدمر ترامب البرج، لقد استغل سقوطه فحسب. لقد كان أول سياسي يتقن الديناميكيات الجديدة لعصر ما بعد بابل، حيث أن الغضب هو المفتاح للانتشار، وحيث يفوز الممثلون على أصحاب الكفاءات، وحيث يتغلّب تويتر على جميع الصحف في البلاد، ولا يمكن مشاركة القصص (أو على الأقل الموثوق بها) إلا على شكل قطع صغيرة بالكاد تكون متجاورة، وهو ما يخلق عالمًا لا يمكن للحقيقة فيه أن تحقق التزامًا واسع الانتشار.

اعتمد العديد من المحللين، بمن فيهم أنا، الذين جادلوا بأن ترامب لا يستطيع الفوز في الانتخابات العامة على حدس ما قبل بابل، والذي ينطوي على حقيقة إن الفضائح مثل شريط آكسس هوليوود (الذي تفاخر فيه ترامب بارتكاب اعتداء جنسي) تعد قاتلة لأي حملة انتخابات الرئاسية، ولكن بعد بابل، لم تعد تسمى الأمور بمسمياتها، على الأقل ليس بطريقة دائمة ويتفق عليها الناس اتفاقًا واسعًا.
السياسة بعد بابل
قال رجل الدولة الألماني أوتو فون بسمارك عام 1867: "السياسة هي فن الممكن". في ديمقراطية ما بعد بابل، قد لا يكون الكثير ممكنًا. من المعروف أن الحرب الثقافية الأميركية وتراجع التعاون بين الأحزاب يسبقان وصول وسائل التواصل الاجتماعي. كان منتصف القرن العشرين فترة استقطاب منخفض بشكل غير عادي في الكونغرس، والذي بدأ في العودة إلى مستوياته التاريخية في السبعينيات والثمانينيات، ولكن المسافة الأيديولوجية بين الحزبين أخذت تتزايد بشكل أسرع في التسعينيات. حولت الشبكات مثل "فوكس نيوز" و "الثورة الجمهورية"[6] عام 1994، الحزب الجمهوري إلى حزب أكثر صدامية وقتالية. فعلى سبيل المثال، دفع رئيس الكونغرس، نيوت غينغريتش، الأعضاء الجمهوريين الجدد في الكونغرس إلى عدم نقل عائلاتهم إلى واشنطن العاصمة، حيث كان من المرجح أن يشكلوا روابط اجتماعية مع الديمقراطيين وعائلاتهم.
لذا كانت العلاقات بين الأحزاب متوترة بالفعل قبل عام 2009. لكن الانتشار المعزز لوسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك جعل من الخطورة لجمهوري أن يُرى متآخٍ مع العدو أو حتى في حال فشله في مهاجمة بضراوة. ُستبدل مصطلح "RINO" (جمهوري بالاسم فقط) في عام 2015 على اليمين المصطلح الأكثر ازدراءً "cuckservative" (دمج بين كلمتي ديوث ومحافظ)، والذي شاع على تويتر في أوساط مؤيدي ترامب. أما على اليسار، قأطلقت وسائل التواصل الاجتماعي ثقافة الفضح (أو المحاسبة بالاعتماد على وجهة نظر المتلقي، وتكون عبر تسليط الضوء على أخطاء الفاعلين السياسيين والاجتماعيين) في السنوات التي أعقبت عام 2012، مع تأثيرات تحويلية على الحياة الجامعية وفيما بعد على السياسة والثقافة في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة الإنجليزية.
ما الذي تغير في 2010؟ دعونا نعيد النظر في استعارة مهندس تويتر لإعطاء مسدس محشو لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات. قد لا تقتل التغريدة الدنيئة أحدًا، ولكنها محاولة لفضح أو معاقبة شخص ما علنًا إلى جانب بث فضيلته أو تألقه أو ولاءاته القبلية. تصير أفعال ثقافة الفضح (أو المُحاسبة) في هذه الصورة بمثابة نبلة (سهم) بدلًا من رصاصة، توجع ولا تقتل. ومع ذلك، من عام 2009 إلى عام 2012، وزّع تويتر وفيسبوك حوالي مليار مُسدس سِهام على مستوى العالم، ومن يومها ونحن نرمي بعضنا البعض بالسّهام.
أعطت وسائل التواصل الاجتماعي صوتًا لبعض الأشخاص الذين لم يكن لديهم صوتًا مسموعًا قبلًا، وسهَّلت محاسبة الأشخاص الأقوياء على أفعالهم السيئة، ليس فقط في السياسة ولكن في مجال الأعمال والفنون والأوساط الأكاديمية وأماكن أخرى. كان من الممكن فضح المتحرشين جنسيًا في منشورات مدونة مجهولة قبل تويتر، ولكن من الصعب تخيل نجاح حركة "#أنا_أيضًا" بدون ميزة الانتشار الفيروسي التي قدمتها المنصات الرئيسة. ولكن لا يجب أن ننسى أن "المساءلة" المشوهة على وسائل التواصل الاجتماعي جلبت أيضًا معها الظلم والاختلال السياسي بثلاث طرق.

أولًا، تمنح وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من القوة للمتصيدين والمحرضين بينما تُسكِت المواطنين الجيدين. وجدت الأبحاث التي أجراها عالما السياسة، ألكساندر بور ومايكل بانج بيترسن، أن مجموعة فرعية صغيرة من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي يهتمون بشدة باكتساب المكانة وهم على استعداد لاستخدام العدوانية للقيام بذلك.
يعترفون بأنهم في نقاشاتهم عبر الإنترنت غالبًا ما يشتمون ويسخرون من خصومهم ويتم حظرهم من قبل مستخدمين آخرين أو يتم الإبلاغ عن تعليقاتهم غير اللائقة. من خلال ثماني دراسات، وجد بور وبيترسن أن الاتصال بالإنترنت لا يجعل معظم الناس أكثر عدوانية أو عدائية؛ بدلًا من ذلك، فإنه يسمح لعدد صغير من الأشخاص العدوانيين بمهاجمة مجموعة أكبر من الضحايا.
وجد بور وبيترسن أنه حتى عدد قليل من الحمقى كانوا قادرين على الهيمنة على منتديات المناقشة، لأنه من السهل إبعاد الأشخاص المسالمين عن المناقشات السياسية عبر الإنترنت. ووجدت أبحاث إضافية أن النساء والسود يتعرضون للمضايقات بشكل غير متناسب، وبالتالي فإن الساحة العامة الرقمية أقل ترحيبا بأصواتهم.
ثانيًا، تمنح وسائل التواصل الاجتماعي قوة أعلى وصوتًا للمتطرفين السياسيين مع التقليل من قوة وصوت الأغلبية المعتدلة. استطلعت دراسة "القبائل الخفية"، التي أجرتها المجموعة المؤيدة للديمقراطية "More in Common" حوالي 8000 أميركي في عامي 2017 و2018 وحددت سبع مجموعات تشارك المعتقدات والسلوكيات. يمثل الطرف الأبعد عن اليمين، والمعروف باسم "المحافظين المخلصين"، 6% من سكان الولايات المتحدة، وشكلت المجموعة الأبعد جهة اليسار "النشطاء التقدميون" 8% من السكان. كان النشطاء التقدميون إلى حد بعيد المجموعة الأكثر انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي: شارك 70% منهم محتوى سياسيًا خلال العام السابق، وتبعهم المحافظون المخلصون بنسبة 56%.
هاتان المجموعتان المتطرفتان متشابهتان بطرق مدهشة، فنهم الأكثر بياضًا والأكثر ثراءً من بين المجموعات السبع، مما يشير إلى أن أميركا تمزقها معركة بين مجموعتين فرعيتين من النخبة لا تمثل المجتمع الأوسع. والأدهى من ذلك، أنهما المجموعتان اللتان تُظهِران أكبر قدر من التجانس في مواقفهما الأخلاقية والسياسية. يتكهن مؤلفو الدراسة بأن هذا التناقل في الرأي ناتج عن ضبط الأفكار على وسائل التواصل الاجتماعي: "أولئك الذين يعبرون عن تعاطفهم مع آراء الجماعات المعارضة قد يتعرضون لرد فعل عنيف من جماعتهم". بعبارة أخرى، لا يكتفي المتطرفون السياسيون برمي السهام على أعدائهم، بل يفرغون كِنانتهم في استهداف المنشقين أو المفكرين غير المتطرفين من فريقهم، وبهذه الطريقة، تُعطِّل وسائل التواصل الاجتماعي أي نظام سياسي قائم ومبني على التضحية والتنازل.
أخيرًا، ومن خلال منح الجميع سلاحًا رشاشًا، تنيب وسائل التواصل الاجتماعي الجميع لتحقيق العدالة دون اتباع الإجراءات القانونية المُلزمة، وتتحول منصات مثل تويتر إلى فيلم غرب متوحش، دون وجود مساءلة للمُنتقمين عليها. يجذب الهجوم الناجح وابلًا من الإعجابات والضربات المُتلاحقة، وبالتالي تسهل منصات الانتشار المحسنة العقاب الجماعي على الجرائم الصغيرة أو المتخيلة، ويكون لهذا الأمر عواقب في العالم الحقيقي، بما فيها أن الأبرياء يفقدون وظائفهم ويجري فضحهم ودفعهم إلى الانتحار. عندما تحكم ساحتنا العامة ديناميكيات الغوغاء غير المقيدة بالإجراءات القانونية المُلزمة، فإننا لا نحصل على العدالة والشمول، بل على مجتمع يتجاهل السياق وحجم الجريمة/ الجنحة والرحمة والحقيقة.
الغباء البنيوي
أصبحت المناقشات منذ سقوط البرج من جميع الأنواع مشوشة أكثر فأكثر، وكانت (ولا تزال) العقبة الأكثر انتشارَا أمام التفكير القويم هي الانحياز التأكيدي، والتي تُشير إلى ميل الإنسان إلى البحث فقط عن الأدلة التي تؤكد معتقداته المسبقة. كانت محركات البحث، حتى قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، تشحن الانحياز التأكيدي شحنًا فائقًا، مما سهل على الناس العثور على أدلة على بعض المعتقدات السخيفة ونظريات المؤامرة، مثل الأرض مسطحة وأن الحكومة الأميركية شنت هجمات 11 سبتمبر وغيرها، إلا أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي فاقمت من رداءة الوضع.
يكمن العلاج الأكثر موثوقية للانحياز التأكيدي في التفاعل مع الأشخاص الذين لا يشاركونك معتقداتك، وذلك لإنهم يواجهونك بأدلة وحجج مضادة. قال جون ستيوارت ميل "من لا يعرف سوى جانبه من القضية، لا يعرف إلا القليل عنها"، وحثنا على البحث عن آراء متضاربة "من الأشخاص الذين يؤمنون بها بالفعل". يجعلك الأشخاص الذين يفكرون تفكيرًا مختلفًا عنك ومستعدون للتحدث معك إذا اختلفتم أكثر ذكاءً، كما لو كانوا امتدادًا لعقلك. الأشخاص الذين يحاولون إسكات منتقديهم أو ترهيبهم يجعلون أنفسهم أغبياء، كما لو كانوا يرمون عقولهم وقدراتهم العقلية بالسّهام.
يصف جوناثان راوخ في كتابه "دستور المعرفة" الاكتشاف التاريخي الكبير والذي طورت فيه المجتمعات الغربية "نظام تشغيل معرفي"، أي مجموعة من المؤسسات لتوليد المعرفة من تفاعلات الأفراد المتحيزين والمعيبين من الناحية الإدراكية. طور القانون الإنجليزي نظام الخصومة حتى يتمكن المدافعون المتحيزون من عرض جانبي القضية أمام هيئة محلفين محايدة. وتطورت الصحف المليئة بالأكاذيب إلى مؤسسات صحافية محترفة، مع معايير تتطلب البحث عن جوانب متعددة من القصة، تليها مراجعة تحريرية، تليها مراجعة للحقائق. تطورت الجامعات من مؤسسات القرون الوسطى المنعزلة إلى مراكز بحثية حيوية، مما أوجد هيكلًا يطرح فيه العلماء ادعاءات مدعومة بالأدلة مع العلم بأن العلماء الآخرين في جميع أنحاء العالم سيكونون متحمسين لكسب المكانة من خلال العثور على أدلة معاكسة.
جاء جزء من عظمة أميركا في القرن العشرين من تطويرها للشبكة الأكثر قدرة وحيوية وإنتاجية من المؤسسات المنتجة للمعرفة في كل تاريخ البشرية، والربط بين أفضل الجامعات في العالم والشركات الخاصة التي حولت التقدم العلمي إلى منتجات استهلاكية للناس، والوكالات الحكومية التي دعمت البحث العلمي وقادت التعاون الذي أرسل البشر إلى سطح القمر عام 1969.
لكن هذا الأمر كما يقول راوخ، "لا يضمن استمرارية نجاحه لوحده"، بل يعتمد على مجموعة من البيئات والتفاهمات الاجتماعية الحساسة في بعض الأحيان، ويجب فهمها وإبرازها وحمايتها". إذن ماذا يحدث عندما تُصان المؤسسة بشكل جيد ويتوقف الخلاف الداخلي، إما لأن شعبها أصبح موحدًا أيديولوجيا أو لأنهم أصبحوا خائفين من المعارضة؟
هذا، في اعتقادي، هو ما حدث للعديد من المؤسسات الأميركية الرئيسة في منتصف عام 2010 وحتى أواخره. لقد صاروا أغبياء جماعيًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي غرست في أعضائها خوفًا مزمنًا من السِّهام. كان التحول أكثر وضوحًا في الجامعات والجمعيات العلمية والصناعات الإبداعية والمنظمات السياسية على كل المستويات (الوطني والقومي والمحلي)، وصار الخوف منتشرًا لدرجة أنها أنشأت معايير سلوكية جديدة مدعومة بسياسات جديدة ظهرت بين عشية وضحاها. إذ صار يعني الوجود الكُلي والجديد لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الانتشار المعزز أن كلمة واحدة ينطق بها أستاذ أو قائد أو صحافي، حتى لو قيلت بنية إيجابية، يمكن أن تؤدي إلى عاصفة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى طرد فوري أو تحقيق طويل الأمد من قبل المؤسسة المعنية.
بدأ المشاركون في مؤسساتنا الرئيسة في ممارسة الرقابة الذاتية إلى درجة غير صحية، وكبحوا انتقادات السياسات والأفكار - حتى تلك التي قدمها طلابهم في الفصل - والتي اعتقدوا أنها غير مدعومة أو خاطئة. ولكن عندما تعاقب مؤسسة ما المعارضين الداخليين، فإنها تطلق السِّهام على نفسها.

تتم عملية فرض الغباء بشكل مختلف عند اليمين وعند اليسار لأن أجنحتهما الناشطة تشترك في روايات مختلفة ذات قيم مقدسة مختلفة. وتخبرنا دراسة "القبائل الخفية" أن "المحافظين المخلصين" حصلوا على أعلى نتيجة في المعتقدات المتعلقة بالسلطوية، فهم يتشاركون في رواية تكون فيها أميركا مهددة إلى الأبد من أعداء في الخارج ومخربين في الداخل ويرون الحياة عبارة معركة بين الوطنيين والخونة. وفقًا للعالمة السياسية كارين ستينر، التي استندت دراسة "القبائل الخفية" إلى عملها، فإنهم يختلفون نفسيًا عن المجموعة الأكبر من "المحافظين التقليديين" (19% من السكان)، الذين يؤكدون على الحاجة إلى النظام واللياقة والبطء بدلًا من التغير الجذري.
يمكن أن تكون خطابات دونالد ترامب منطقية فقط ضمن روايات المحافظين المخلصين، فمنذ الخطاب الافتتاحي المشؤوم لحملته حول "المغتصبين" المكسيكيين إلى تحذيره في 6 كانون الثاني/ يناير 2021: "إذا لم تقاتلوا حتى الموت، فلن تجدوا دولة لتعيشوا فيها لاحقًا".
العقوبة التقليدية للخيانة هي الموت، ومن هنا جاءت صرخة المعركة في 6 يناير: "اشنقوا مايك بنس". لقد أثبتت التهديدات اليمينية بالقتل، التي وردت من حسابات مجهولة المصدر، فعاليتها في إقناع المحافظين التقليديين، على سبيل المثال في طرد مسؤولي الانتخابات المحليين الذين فشلوا في "وقف السرقة". وبالمثل، دفعت موجة التهديدات الموجهة للأعضاء الجمهوريين المعارضين في الكونغرس العديد من المعتدلين الباقين إلى الاستقالة أو اختيار الصمت، مما منحنا حزبًا أكثر انفصالًا عن التقاليد المحافظة والمسؤولية الدستورية والواقع. لدينا الآن حزب جمهوري يصف الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول الأميركي بأنه "خطاب سياسي مشروع" تدعمه أو على الأقل لا تتعارض معه مجموعة من مؤسسات الفكر والرأي اليمينية والمؤسسات الإعلامية.
يتجلى غباء اليمين بشكل واضح في العديد من نظريات المؤامرة المنتشرة عبر وسائل الإعلام اليمينية والآن في الكونغرس. يعتقد أصحاب نظريات بيتزاجيت وكيو أنون بأن اللقاحات تحتوي على شرائح دقيقة، ويصدقون بأن دونالد ترامب قد فاز بإعادة الانتخاب. من الصعب تخيل أي من هذه الأفكار أو أنظمة المعتقدات المشابهة أن تصل إلى المستويات التي كانت عليها بدون فيسبوك وتويتر.
كما تضرر الديمقراطيون بشدة من الغباء البنيوي، وإن بطريقة مختلفة. ففي الحزب الديمقراطي مثلًا، الصراع بين الجناح التقدمي والفصائل الأكثر اعتدالًا مفتوحًا ومستمرًا، وغالبًا ما يفوز المعتدلون. تكمن المشكلة في أن اليسار يتحكم في الجزء الأكبر من الثقافة: الجامعات والمؤسسات الإخبارية وهوليوود والمتاحف الفنية وصناعة الإعلان وكثير من وادي السيليكون ونقابات المعلمين وكليات التدريس التي تشكل التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وفي العديد من تلك المؤسسات، تُخنق المعارضة: عندما أعطي كل الناس بنادق سهام فريدة في أوائل عام 2010، بدأت العديد من المؤسسات ذات الميول اليسارية في إطلاق النار على عقولها. ولسوء الحظ، كانت تلك الأدمغة هي التي تعلم وترشد وتسلي في معظم أنحاء البلاد.
تشارك الليبراليون في أواخر القرن العشرين مع عالم الاجتماع، كريستيان، في اعتقاده وتبنيهم لسردية "التقدم الليبرالي"، والتي تقول إن أميركا كانت غير عادلة وقمعية بشكل مروّع، ولكن بفضل كفاح النشطاء والأبطال، صنعت (ولا تزال تصنع) التقدم نحو تحقيق الوعد النبيل بتأسيسها.
تدعم هذه القصة بسهولة الوطنية الليبرالية، وكانت هي السردية المُحركة لرئاسة باراك أوباما، وهي أيضا وجهة نظر "الليبراليين التقليديين" في دراسة "القبائل الخفية" (11% من السكان)، الذين لديهم قيم إنسانية قوية، وهم أكبر سنًا من المتوسط، وهم إلى حد كبير الأشخاص الذين يقودون المؤسسات الثقافية والفكرية الأميركية.
ولكن عندما أعطت منصات وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة حديثًا للجميع سلاحًا فتَّاكًا، كان النشطاء التقدميون الأصغر سنًا هم من أطلقوا أكبر قدر من الأسهم، وكانوا يستهدفون عددًا غير متناسب من هؤلاء القادة الليبراليين الأكبر سنًا. ونادرا ما تحدى القادة، الذين كانوا يشعرون بالارتباك والخوف، النشطاء أو سرديتهم غير الليبرالية التي تكون فيها الحياة في كل مؤسسة معركة أبدية بين مجموعات الهوية حول معركة محصلتها صفرية، ويصل الناس في القمة إليها من خلال قمع الناس في القاع. تتسم الرواية الجديدة بالمساواة الصارمة وتركز على المساواة في النتائج، وليس على الحقوق أو الفرص، وهي كذلك لا تهتم بالحقوق الفردية.
إن الاتهام العام ضد الأشخاص الذين يختلفون مع هذه السردية ليس "الخيانة"، بل "العنصرية " أو رُهاب "التحول الجنسي" أو أن يصير المرء "كارين[7]" أو أنه يحمل حرفًا قرمزيًا[8] يصنف الجاني على أنه شخص يكره مجموعة مهمشة أو يؤذيها. العقوبة المناسبة لمثل هذه الجرائم ليست الإعدام وإنما العار العام والموت الاجتماعي.
يمكنك أن ترى عملية فرض الغباء بشكل أوضح عندما يشير شخص على اليسار فقط إلى البحث الذي يشكك أو يتعارض مع الاعتقاد المفضل بين النشطاء التقدميين. سيجد شخص ما على تويتر طريقة لربط زميله المُنشق بالعنصرية، وسيتراكم الآخرون مثقلين عليه بهذا الاتهام.
على سبيل المثال، في الأسبوع الأول من الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد، والتي اشتمل بعضها على العنف، غرد محلل السياسة التقدمي ديفيد شور، الذي عينته شركة "Civis Analytics" بعد ذلك، رابطًا لدراسة تظهر أن الاحتجاجات العنيفة في الستينيات أدّت إلى الانتكاسات الانتخابية للديمقراطيين في المقاطعات المجاورة. كان من الواضح أن شور كان يحاول أن يكون مفيدًا، ولكن الغضب الذي أعقب ذلك دفع بالناس لاتهامه بـ"مناهضة السود" وسرعان ما طُرد من وظيفته (أنكرت شركة Civis Analytics أن التغريدة أدت إلى طرده).
أصبحت قضية شور مشهورة، لكن أي شخص على تويتر قد شاهد بالفعل عشرات الأمثلة التي تعلم الدرس الأساسي: لا تشكك في معتقدات حزبك أو سياساته أو أفعاله، وعندما يلتزم الليبراليون التقليديون الصمت، كما فعل الكثيرون في صيف عام 2020، فإن السردية الأكثر راديكالية للنشطاء التقدميين تصبح السردية السائدة. لهذا السبب بدا أن العديد من المؤسسات المعرفية قد "استيقظت" في تتابع سريع في ذلك العام والعام الذي يليه، بدءًا بموجة من الخلافات والاستقالات في صحيفة "نيويورك تايمز" والصحف الأخرى، ووصولًا إلى تصريحات العدالة الاجتماعية التي قدمتها مجموعات من الأطباء والجمعيات الطبية (إحدى المنشورات الصادرة عن الجمعية الطبية الأميركية ورابطة الكليات الطبية الأميركية، على سبيل المثال، نصحت المهنيين الطبيين بالإشارة إلى الأحياء والمجتمعات على أنها "مضطهدة" أو "مجردة منهجيًا" بدلًا من "ضعيفة" أو "فقيرة")، والتحول السريع للمناهج في أغلى المدارس الخاصة في مدينة نيويورك.
رأينا الغباء يشعشع عند كلا الجانبين بشكل مأساوي، في حروب كوفيد - 19. لقد كان اليمين ملتزما للغاية بالتقزيم من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد لدرجة أنه حوَّل المرض إلى مرض يقتل الجمهوريين بشكل تفضيلي، والتزم اليسار التقدمي بتضخيم مخاطر الإصابة بكوفيد - 19 لدرجة أنه غالبا ما كان يتبنى إستراتيجية متطرفة عند الحديث عن اللقاحات والأقنعة والتباعد الاجتماعي، حتى فيما يتعلق بفرض الإجراءات على الأطفال.
وهذه السياسات ليست قاتلة مثل نشر المخاوف والأكاذيب بشأن اللقاحات، ولكن العديد منها كان مدمرا للصحة العقلية والتعليم للأطفال، الذين هم في أمس الحاجة إلى اللعب مع بعضهم البعض والذهاب إلى المدرسة؛ ليس لدينا سوى القليل من الأدلة الواضحة على أن إغلاق المدارس ووضع الأقنعة للأطفال الصغار يقلل من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالقصة التي أرويها هنا، فقد تعرض الآباء التقدميون الذين جادلوا ضد إغلاق المدارس في كثير من الأحيان للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي وواجهوا اتهامات يسارية في كل مكان بالعنصرية وتفوق البيض. وتعلم آخرون في المدن الزرقاء (الديمقراطية) التزام الصمت.
أصبحت السياسة الأميركية أكثر سخافة واختلالا ليس لأن الأميركيين أصبحوا أقل ذكاء، وإنما لأن المشكلة بنيوية. بفضل وسائل التواصل الاجتماعي المعززة، تتم معاقبة المعارضة داخل العديد من مؤسساتنا، مما يعني أن الأفكار السيئة صارت ترتقي لكونها سياسات رسمية.
سيزداد الأمر سوءًا
قال ستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب في مقابلة عام 2018 إن طريقة التعامل مع وسائل الإعلام هي إغراق المنطقة بالهراء". وكان يصف حينها تكتيك "ضخ الكذب" الذي ابتكرته برامج التضليل الروسية لإبقاء الأميركيين مرتبكين وغاضبين. ولكن في ذلك الوقت، في عام 2018، كان ثمة حد أعلى لكمية الهراء المتاح، لأنه كان يجب إنشاء كل ذلك المحتوى (الكاذب) على يد بشرٍ عاقلين (بخلاف بعض الامور منخفضة الجودة التي تنتجها الروبوتات).
ولكن لا يغيب عنا أن الذكاء الاصطناعي يقترب الآن من تمكين الانتشار غير المحدود للمعلومات المضللة التي يمكن تصديقها إلى حد كبير. فبرنامج الذكاء الاصطناعي "GPT-3" مُتمكِّن بالفعل بحيث يمكنك إعطاءه موضوعًا ونبرة وسوف يعطيك أكبر عدد ممكن من المقالات كما تريد، عادة بكتابة نحوية سليمة ومستوى مدهش من التماسك. في غضون عام أو عامين، عندما تتم ترقية البرنامج إلى "GPT-4"، سيصبح أكثر قدرة بكثير. في مقال نُشر في عام 2020 بعنوان "توفير المعلومات المضللة سيصبح قريبًا بلا حدود"، أوضحت رينيه ديريستا، مديرة الأبحاث في مرصد ستانفورد للإنترنت، أن نشر الأكاذيب، سواء من خلال النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو المزيفة، سيصبح سهلًا بسرعة لا يمكن تخيلها (وكانت حينها قد استخدمت GPT-3 لكتابة المقال).
لن تكون الأحزاب الأميركية هي الوحيدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء محتوى هجومي بل سيفعل أعداؤنا أيضًا. في مقال مؤرقة 2018 بعنوان "خط ماجينو الرقمي" وصفت ديريستا الوضع بصراحة.
"نحن منغمسون في صراع مستمر ومتطور: حرب عالمية إعلامية يستفيد فيها الفاعلون الحكوميون والإرهابيون والمتطرفون الأيديولوجيون من البنية التحتية الاجتماعية التي تقوم عليها الحياة اليومية لزرع الفتنة وتآكل الواقع المشترك". اعتاد السوفييت إرسال عملاء أو تربية الأميركيين المستعدين للوفاء بمطالبهم، لكن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من السهل على وكالة أبحاث الإنترنت الروسية اختراع أحداث وهمية أو تشويه أحداث حقيقية لإثارة الغضب على كل من اليسار واليمين، وغالبًا بسبب العرق. أظهرت الأبحاث اللاحقة أن حملة مكثفة بدأت على تويتر في عام 2013 ولكنها سرعان ما انتشرت إلى فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، من بين منصات أخرى. كان أحد الأهداف الرئيسة منها هو استقطاب الرأي العام الأميركي ونشر عدم الثقة لتفريقنا وضربنا عند كعب آخيل لدينا والذي حدده ماديسون مسبقًا.
نحن نعلم الآن أن الروس ليسوا وحدهم من يهاجم الديمقراطية الأميركية. كانت الصين قبل احتجاجات 2019 في هونغ كونغ تركز في الغالب على المنصات المحلية مثل "وي تشات"، لكنها تكتشف الآن مقدار ما يمكنها فعله على "تويتر" و"فيسبوك" مقابل القليل من المال في صراعها المتصاعد مع الولايات المتحدة. ونظرا للتقدم الذي أحرزته الصين في الذكاء الاصطناعي، فبوسعنا أن نتوقع أن تصبح أكثر مهارة على مدى السنوات القليلة المقبلة في زيادة تقسيم أميركا وزيادة توحيد الصين.
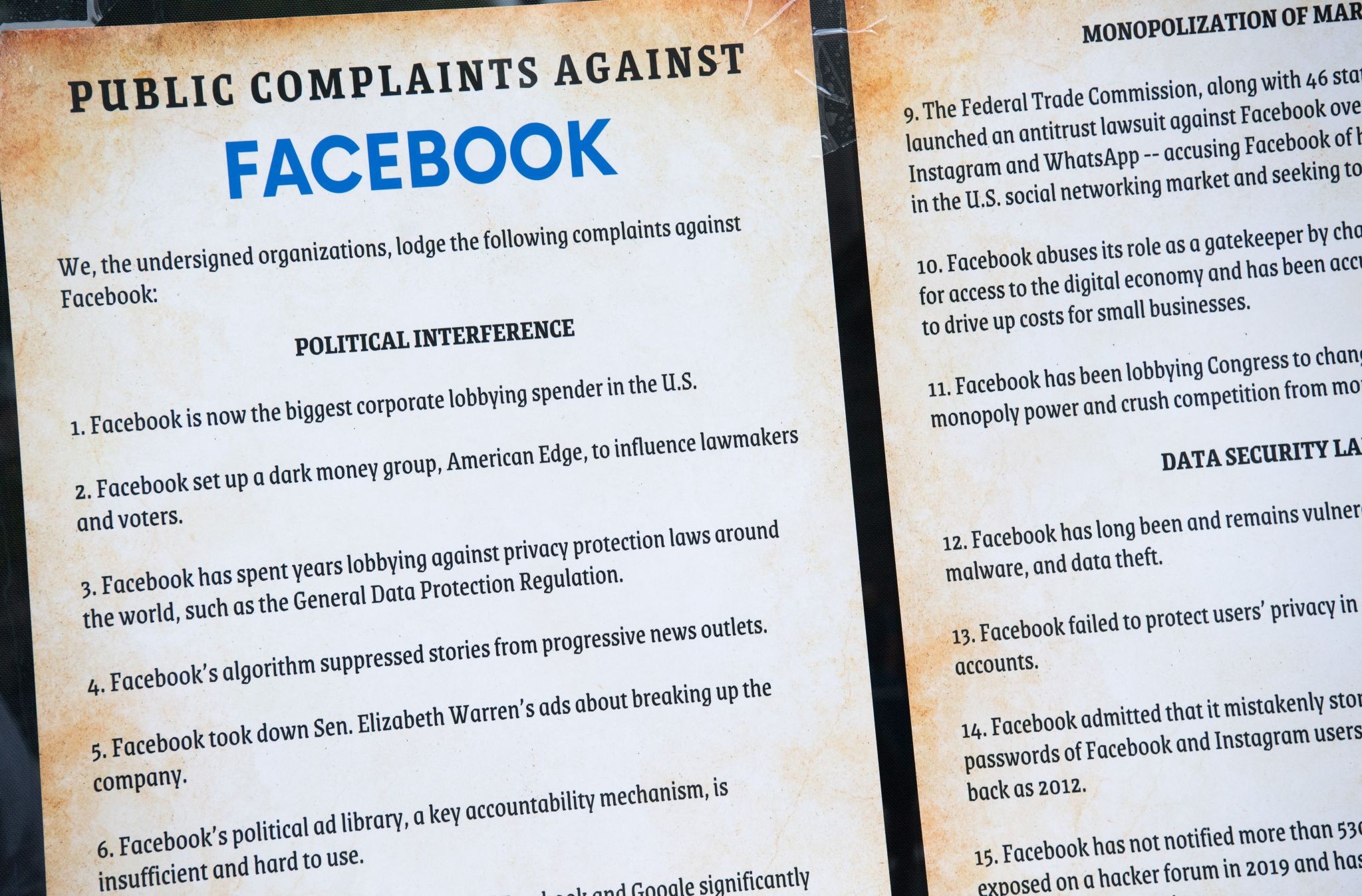
كانت الهوية المشتركة لأميركا في القرن العشرين هو أنها دولة تقود الكفاح من أجل جعل العالم آمنًا للديمقراطية وقوة قوية ساعدت في الحفاظ على الثقافة والنظام السياسي معًا. أعادت شركات التكنولوجيا الأميركية في القرن الحادي والعشرين، توصيل العلاقات البشرية حول العالم وابتكرت منتجات يبدو الآن أنها تدفع إلى تآكل الديمقراطية، وتخلق العقبات التي تحول دون التفاهم المشترك، وتدمر البرج الحديث.
الديمقراطية بعد بابل
لا يمكننا أبدا العودة إلى ما كانت عليه الأمور في عصر ما قبل العصر الرقمي. لن تعمل المعايير والمؤسسات وأشكال المشاركة السياسية التي تطورت خلال حقبة طويلة من الاتصال الجماهيري بشكل جيد الآن بعد أن جعلت التكنولوجيا كل شيء أسرع وأكثر تعددًا في الاتجاهات، وعندما يكون تجاوز حراس البوابة المحترفين أمرًا سهلًا للغاية. ومع ذلك، تعمل الديمقراطية الأميركية الآن خارج حدود استدامتها. وإذا لم نقم بإجراء تغييرات كبرى قريبًا، فقد تنهار مؤسساتنا، ونظامنا السياسي، ومجتمعنا خلال الحرب الكبرى المقبلة، أو الوباء، أو الانهيار المالي، أو الأزمة الدستورية.
ما التغييرات المطلوبة؟ إن إعادة تصميم الديمقراطية للعصر الرقمي تتجاوز قدراتي بكثير، ولكن يمكنني أن أقترح ثلاث فئات من الإصلاحات - ثلاثة أهداف يجب تحقيقها إذا كان للديمقراطية أن تظل قابلة للحياة في عصر ما بعد بابل. يجب علينا أولًا تقوية المؤسسات الديمقراطية حتى تتمكن من تحمل الغضب المزمن وعدم الثقة، وثانيًا إصلاح وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تصبح أقل تآكلا اجتماعيا، وثالثًا إعداد الجيل القادم بشكل أفضل للمواطنة الديمقراطية في هذا العصر الجديد.
تقوية المؤسسات الديمقراطية
من المرجح أن يزداد الاستقطاب السياسي في المستقبل المنظور، وبالتالي، أيا كان ما نفعله، فيتعين علينا أن نصلح المؤسسات الرئيسية حتى تتمكن من الاستمرار في العمل، حتى لو زادت مستويات الغضب والتضليل والعنف إلى ما هو أعلى كثيرا من تلك التي لدينا اليوم.
على سبيل المثال، صُمّمت السلطة التشريعية لتتطلب حلا وسطا، ومع ذلك فقد تطور الكونغرس ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الكابل الإخبارية الحزبية بشكل مشترك بحيث يوجهون جميعًا غضبهم تجاه أي مشرع جديد يحاول التغيير وخصوصًا من أبناء الطرف المتطرف من حزبه، وهذا يضر باحتمالات جمع هذا المرشح للتبرعات لحملته ويزيد من خطر ترشحها في الانتخابات التمهيدية في الدورة الانتخابية المقبلة (بالنسبة للباقي في الحزب).
يجب أن تقلل الإصلاحات من التأثير الهائل للمتطرفين الغاضبين وأن تجعل المشرعين أكثر استجابة للناخب العادي في دائرتهم. أحد الأمثلة على هذا الإصلاح هو إنهاء الانتخابات التمهيدية المغلقة للأحزاب، واستبدالها بانتخابات تمهيدية واحدة غير حزبية مفتوحة يتقدم منها المرشحون الأوائل إلى انتخابات عامة تستخدم أيضا التصويت بالاختيار المرتب. وقد تم بالفعل تنفيذ نسخة من نظام التصويت هذا في ألاسكا، ويبدو أنه أعطى السناتور، ليزا موركوفسكي، مزيدا من الحرية لمعارضة الرئيس السابق ترامب، الذي سيكون مرشحه المفضل تهديدا لموركوفسكي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية المغلقة ولكنه ليس في انتخابات مفتوحة.
وتتمثل الطريقة الثانية لتقوية المؤسسات الديمقراطية في الحد من سلطة أي من الحزبين السياسيين في التلاعب بالنظام لصالحه، على سبيل المثال عن طريق ترسيم الدوائر الانتخابية المفضلة لديهم أو اختيار المسؤولين الذين سيشرفون على الانتخابات. يجب أن تتم جميع هذه الوظائف بطريقة غير حزبية. تظهر الأبحاث حول العدالة الإجرائية أنه عندما يدرك الناس أن العملية عادلة، فمن المرجح أن يقبلوا شرعية قرار يتعارض مع مصالحهم. فكر فقط في الضرر الذي لحق بالفعل بشرعية المحكمة العليا من قبل القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ عندما منعت النظر في ميريك جارلاند للحصول على مقعد فتح قبل تسعة أشهر من انتخابات عام 2016، ثم سارعت إلى تعيين إيمي كوني باريت في عام 2020. ومن شأن الإصلاح الذي نوقش على نطاق واسع أن ينهي هذه الألاعيب السياسية من خلال جعل القضاة يخدمون فترات متداخلة مدتها 18 عاما بحيث يقوم كل رئيس بتعيين واحد كل عامين.
إصلاح وسائل التواصل الاجتماعي
لا يمكن للديمقراطية أن تحيا إذا كانت مجالاتها العامة هي الأماكن التي يخشى الناس فيها رفع أصواتهم وحيث لا يمكن التوصل إلى إجماع مستقر. يخلق تمكين وسائل التواصل الاجتماعي لليسار المتطرف واليمين المتطرف والمتصيدين المحليين والعملاء الأجانب نظاما يبدو أقل شبها بالديمقراطية وأكثر شبها بحكم "الأكثر عدوانية".
ولكن في وسعنا الحد من قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على إذابة الثقة وإثارة الغباء البنيوي. يجب أن تحد الإصلاحات من تضخيم المنصات للهوامش العدوانية مع إعطاء المزيد من الصوت لما تسميه (More in Common) بـ"الأغلبية المنهكة".
يركز أولئك الذين يعارضون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام على القلق المشروع من أن القيود المفروضة على المحتوى التي تفرضها الحكومة ستتحول عمليا إلى رقابة. لكن المشكلة الرئيسة في وسائل التواصل الاجتماعي ليست أن بعض الأشخاص ينشرون أشياء مزيفة أو سامة، بل المحتوى المزيف والمثير للغضب يمكن أن يصل الآن إلى مستوى من الوصول والتأثير لم يكن ممكنًا قبل عام 2009. تدعو فرانسيس هاوغن (التي سربت وثائق عن فيسبوك) إلى إجراء تغييرات بسيطة على بنية المنصات، بدلاً من بذل جهود ضخمة وغير مجدية في نهاية المطاف لمراقبة جميع المحتويات. على سبيل المثال، اقترحت تعديل وظيفة زر "مشاركة" على فيسبوك بحيث بعد مشاركة أي محتوى مرتين، يجب أن يأخذ الشخص الثالث في السلسلة الوقت الكافي لنسخ المحتوى ولصقه في منشور جديد. إن مثل هذه الإصلاحات ليست رقابة، بل هي إصلاحات محايدة من حيث وجهة النظر ومحايدة من حيث المحتوى، وتعمل بشكل على قدم المساواة في جميع اللغات؛ فهي لا تمنع أي شخص من قول أي شيء، بل إنها تبطئ فقط من انتشار المحتوى الذي يكون، في المتوسط، أقل احتمالًا لأن يكون صحيحًا .
ربما يكون أكبر تغيير منفرد من شأنه أن يقلل من سُمّيّة المنصات الحالية هو التحقق من المستخدم كشرط مسبق لاكتساب التضخيم الحسابي الذي توفره وسائل التواصل الاجتماعي.
لدى البنوك والصناعات الأخرى قواعد "اعرف عميلك" بحيث لا يمكنها التعامل مع عملاء مجهولين يغسلون الأموال من المؤسسات الإجرامية. يجب أن يطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة أن تفعل الشيء نفسه. هذا لا يعني أنه سيتعين على المستخدمين النشر بأسمائهم الحقيقية، بل سيبقى بإمكانهم النشر بأسماء مستعارة. هذا يعني فقط أنه قبل أن تنشر المنصة كلماتك إلى ملايين الأشخاص، يقع على عاتقها التزام بالتحقق (ربما من خلال طرف ثالث أو منظمة غير ربحية) من أنك إنسان حقيقي، في بلد معين، وأنك كبير بما يكفي لاستخدام المنصة. سيؤدي هذا التغيير الوحيد إلى القضاء على مئات الملايين من الروبوتات والحسابات المزيفة التي تلوث حاليًا المنصات الرئيسية. ومن المرجح أيضا أن يقلل من وتيرة التهديدات بالقتل، وتهديدات الاغتصاب، والبشاعة العنصرية، والتصيد بشكل عام. تظهر الأبحاث أن السلوك المعادي للمجتمع يصبح أكثر شيوعا عبر الإنترنت عندما يشعر الناس أن هويتهم غير معروفة ولا يمكن تعقبها.
وعلى أية حال، فإن الأدلة المتزايدة على أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالديمقراطية كافية لتبرير قدر أكبر من الرقابة من قبل هيئة تنظيمية، مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية أو لجنة التجارة الفيدرالية. يجب أن يكون أحد الأوامر الأولى للأعمال هو إجبار المنصات على مشاركة بياناتها وخوارزمياتها مع الباحثين الأكاديميين.
إعداد الجيل القادم
إن أبناء الجيل Z (المولودون في عام 1997 وبعده) لا يتحملون أي لوم عن الفوضى التي نحن فيها، لكنهم سيرثونها، والعلامات الأولية هي أن الأجيال الأكبر سنًا منعتهم من تعلم كيفية التعامل معها.
أصبحت الطفولة مقيدة بشكل أكثر إحكاما في الأجيال الأخيرة، مع وجود فرصة أقل للعب المجاني غير المنظم (غير الممنهج والموجّه) وصار لديهم وقت أقل غير خاضع للإشراف في الخارج (غير مُراقب)، وأسموا يقضون وقتًا أكثر على الإنترنت. وأيًا كانت آثار هذه التحولات، فمن المرجح أنها أعاقت تطوير القدرات اللازمة للحكم الذاتي الفعال لدى العديد من الشباب. اللعب الحر غير الخاضع للإشراف (والمراقبة) يعد طريقة الطبيعة في تعليم الثديّات الصغيرة المهارات التي يحتاجونها كبالغين، والتي تشمل بالنسبة للبشر القدرة على التعاون ووضع القواعد وإنفاذها، والتنازل، والفصل في النزاعات، وقبول الهزيمة.

جادل مقال رائع كتبه الاقتصادي ستيفن هورويتز في عام 2015 بأن اللعب الحر يعد الأطفال لـ"فن الارتباط" الذي قال أليكسيس دي توكفيل إنه مفتاح حيوية الديمقراطية الأميركية. كما جادل بأن خسارتها تشكل "تهديدا خطيرا للمجتمعات الليبرالية". وحذر هورويتز من أن جيلا ممنوعا من تعلم هذه المهارات الاجتماعية سيناشد السلطات عادة لحل النزاعات وسيعاني من "خشونة التفاعل الاجتماعي" الذي من شأنه أن "يخلق عالما يحوي صراعات وعنف أكثر".
وبينما قوضت وسائل التواصل الاجتماعي فن تكوين الجمعيات/ الاتحادات في كل مفاصل المجتمع، فقد تكون تركت آثارها العميقة والأكثر ديمومة على المراهقين. بدأت زيادة معدلات القلق والاكتئاب وإيذاء الذات بين المراهقين الأميركيين فجأة في أوائل عام 2010. (حدث نفس الشيء للمراهقين الكنديين والبريطانيين، الوقت نفسه). السبب غير معروف، لكن التوقيت يشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مساهمًا كبيرًا فيها، إذ بدأت الطفرة في الوقت الذي أصبحت فيه الغالبية العظمى من المراهقين الأميركيين مستخدمين يوميًا للمنصات الرئيسة. تدعم الدراسات الارتباطية والتجريبية الصلة بالاكتئاب والقلق، كما تفعل التقارير الواردة من الشباب أنفسهم، ومن أبحاث فيسبوك الخاصة، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
يقلل الاكتئاب من رغبة الناس في التعامل مع أشخاص وأفكار وتجارب جديدة. ويجعل القلق الأشياء الجديدة تبدو أكثر تهديدًا. ومع ارتفاع هذه الظروف وتأخر الدروس المستفادة من السلوك الاجتماعي الدقيق من خلال اللعب الحر، تضاءل التسامح مع وجهات النظر المتنوعة والقدرة على حل النزاعات بين العديد من الشباب. على سبيل المثال، يمكن القول إن المجتمعات الجامعية التي يمكن أن تتسامح مع مجموعة من المتحدثين في الآونة الأخيرة في عام 2010 بدأت تفقد هذه القدرة في السنوات اللاحقة، حيث بدأ الجيل Z في الوصول إلى الحرم الجامعي، وارتفعت محاولات إلغاء دعوة المتحدثين الزائرين.
ولم يكتف الطلاب بالقول إنهم لا يتفقون مع المتحدثين الزائرين؛ بل قالوا بعضهم إن تلك المحاضرات ستكون خطيرة ومدمرة عاطفيًا وشكلا من أشكال العنف، ونظرًا لاستمرار معدلات الاكتئاب والقلق لدى المراهقين في الارتفاع حتى عام 2020، يجب أن نتوقع استمرار هذه الآراء في الأجيال التالية، بل وأن تصبح أكثر حدة بالفعل.
أهم تغيير يمكننا إجراؤه للحد من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال هو تأخير دخولهم إليها حتى يتجاوزوا سن البلوغ. وينبغي للكونغرس أن يحدث قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، الذي حدد بشكل غير حكيم سن ما يسمى بمرحلة البلوغ على الإنترنت (السن التي يمكن فيها للشركات جمع المعلومات الشخصية من الأطفال دون موافقة الوالدين) بـ13 عاما في عام 1998، مع عدم النص إلا على القليل من الإنفاذ الفعال. يجب رفع السن إلى 16 عاما على الأقل، ويجب تحميل الشركات مسؤولية تطبيقه.
وبشكل أعم، لإعداد أعضاء الجيل القادم لديمقراطية ما بعد بابل، ربما يكون أهم شيء يمكننا القيام به هو السماح لهم بالخروج للعب وترك الإنترنت. لنتوقف عن تجويع الأطفال من التجارب التي هم في أمس الحاجة إليها ليصبحوا مواطنين صالحين: اللعب الحر في فئات عمرية مختلطة من الأطفال مع الحد الأدنى من إشراف البالغين. يجب على كل ولاية أن تحذو حذو ولاية يوتا وأوكلاهوما وتكساس وأن تمرر نسخة من قانون الأبوة والأمومة الحر الذي يساعد على طمأنة الآباء بأنهم لن يتم التحقيق معهم بتهمة الإهمال إذا ما تم رصد أطفالهم البالغين من العمر 8 أو 9 سنوات وهم يلعبون في حديقة.
ومع وجود مثل هذه القوانين، يتعين على المدارس والمعلمين وسلطات الصحة العامة أن تشجع الآباء على السماح لأطفالهم بالمشي إلى المدرسة واللعب في مجموعات في الخارج، تماما كما اعتاد المزيد من الأطفال على القيام بذلك.
الأمل بعد بابل
القصة التي رويتها قاتمة، وهناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن أميركا ستعود إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية والاستقرار في السنوات الخمس أو الـ10 المقبلة. أي جانب سيصبح تصالحيا؟ ما احتمال أن يسن الكونغرس إصلاحات كبرى تعزز المؤسسات الديمقراطية أو تزيل السموم من وسائل التواصل الاجتماعي؟
ومع ذلك، عندما ننظر بعيدا عن حكومتنا الفيدرالية المختلة وظيفيا، وننفصل عن وسائل التواصل الاجتماعي، ونتحدث مع جيراننا مباشرة، تبدو الأمور أكثر تفاؤلا. معظم الأميركيين في تقرير "More in Common" هم أعضاء في "الأغلبية المنهكة"، التي سئمت من القتال ومستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر وتقديم تنازلات. يرى معظم الأميركيين الآن أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على البلاد، وأصبحوا أكثر وعيًا بآثارها الضارة على الأطفال.
هل سنفعل أي شيء حيال ذلك؟
عندما قام توكفيل بجولة في الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن التاسع عشر أعجب بالعادة الأميركية المتمثلة في تشكيل جمعيات تطوعية لإصلاح المشاكل المحلية، بدلا من انتظار الملوك أو النبلاء للتصرف كما يفعل الأوروبيون.
ولا تزال تلك العادة معنا حتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أنشأ الأميركيون مئات المجموعات والمنظمات المكرسة لبناء الثقة والصداقة عبر الانقسام السياسي، بما في ذلك "بريدج يو إس إيه"، و"برافر أنجلز" (التي أخدم في مجلس إدارتها)، والعديد من المنظمات الأخرى المدرجة في (BridgeAlliance.us). لا يمكننا أن نتوقع من الكونغرس وشركات التكنولوجيا إنقاذنا. يجب أن نغير أنفسنا ومجتمعاتنا.
كيف كانت الحياة في بابل تمامًا قبل انهيارها؟ صرنا نعرف الآن. عاش أهلها في حيرة وحسرة. ولكن معنا وقتٌ للتفكير والاستماع والبناء.
[1] تعد أسطورة برج بابل من الأساطير الأكثر رواجًا حول تعدد الألسنة واللغات وتتحدث عن أن البشر بعد طوفان نوحٍ أرادوا أن يعيشوا في منطقة واحدة وأن يتجمعوا معًا في سهل شنعار كي لا يتبددوا، وتذكر الأسطورة أيضًا أن الرب لم يكن معنيًا بتجمع البشر في بقعة واحدة وإنما بتعمير الأرض كاملة، ولذلك وعندما حاول البشر بناء برجٍ يصل إلى السماء، عُوقب البشر بـ بلبلة ألسنتهم، وقد جاء الفعل من كلمة «بلبل» بالعربية ومن الكلمة العبرية القريبة منها «بلل»، وبسبب هذا التشتت في الألسنة والتضاريس واختلاف طرق المعيشة تكونت لغات البشر المختلفة – المُترجم.
[2] منطقة غير مُحددة من بلاد الرافدين جاء ذكرها في التوراة العبرية حوالي 8 مرات ويعود وصفها إلى مدينة بابل وأوروك – المُترجم.
[3] التكملة في الإصحاح نفسه (8-9): «فَبَدَّدَهُمُ الرَّبُّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ، فَكَفُّوا عَنْ بُنْيَانِ الْمَدِينَةِ، 9لِذلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا «بَابِلَ» لأَنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ كُلِّ الأَرْضِ. وَمِنْ هُنَاكَ بَدَّدَهُمُ الرَّبُّ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ».
[4] حركة احتجاجات عالمية بدأت على شكل حركة احتلوا وول ستريت في شهر سبتمبر 2011، وتوسعت تدريجيًا لتشمل الولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة إلى أن صارت حركة عالمية بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه – المُترجم.
[5] يُشير تعبير «كعب آخيل» إلى نقطة ضعف قاتلة لدى أي نظام أو إنسان، وهي إشارة إلى آخيل من الإلياذة والأوديسا، والذي كان بطلًا قويًا لا يقدر عليهِ أحد، والذي كان قد تُنبئ أنه سيموت مقتولًا، فأخذته أمه طفلًا رضيعًا إلى نهر ستيكس وغطسته فيه، حيث عُرف عن النهر أنه يمنح القوة القاهرة لمن يغطسون فيه، وقد أمسكته أمه لحظتها من كعبه كيلا يغرق، وبذا كان كعبه هو المنطقة الوحيدة من جسمه التي لم تكتسب القوة – المُترجم.
[6] يشير مصطلح الثورة الجمهورية أو ثورة 1994 أو ثورة غينغريتش إلى نجاح الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأميركية عام 1994، والتي نتج عنها سيطرتهم على 54 مقعدًا في الكونغرس وثمانية مقاعد في مجلس الشيوخ، واعتبرت ثورة لأنها كانت المرة الأولى خلال أكثر من 40 عامًا يصل فيها الحزب الجمهوري إلى أغلبية في الكونغرس ومجلس لشيوخ. وتشير الانتخابات النصفية في أميركا إلى النتخابات العامة التي تجرى بالولايات المتحدة في منتصف كل ولاية رئاسية ويجدد خلالها الناخبون جزء من أعضاء الكونغرس وحكام بعض الولايات ومسؤولين محليين، وهي فرصة كذلك لاقتراح مشاريع قوانين محلية.
[7] مُصلح عامي أميركي يُشير إلى المرأة البيضاء الحقّانية والتي تعتقد أن لها حقوقًا أكثر من حقوق الناس الآخرين وغالبًا ما يُوظَّف المصطلح في الميمات التي تصور النساء البيض اللائي يستخدمن امتيازهن لتحقيق ما يردن كما يردن، وقد يتضمن تصوير هاته النساء على شكل مطالبتهم من موظفي الكاشير بالمولات بالتحدث إلى مدرائهم أو في عنصريتهن أو في طريقة تسريحة شعرهن – المُترجم.
[8] في إشارة إلى رواية الحرف القرمزي للكاتب ناثانيال هاوثورن، والتي تضطر فيها المرأة الزَّانية إلى ارتداء حرف A أحمر لدى خروجها من المنزل ليعرف الناس فعلتها وهي اختصار لكلمة "Adulterer".

التعليقات