ملامح سوسيولوجيّة عن يوم "سحجت" فيه شفاعمرو للبرازيل
"لمن سنرفع صراخ الحماسة والمتعة ودبابيس الدم، بعدما وجدنا فيه بطلنا المنشود، وأجَّج فينا عطش الحاجة إلى بطل... بطل نصفق له، وندعو له بالنصر، ونعلّق له تميمة، ونخاف عليه وعلى أملنا فيه من الانكسار؟ يا مارادونا، يا مارادونا، ماذا فعلت بالساعة؟ ماذا صنعت بالمواعيد؟".
بهذه الكلمات التي لم تخفِ خجل التأثّر، أعلن محمود درويش انضمامه إلى "ألتراس" الأرجنتين، وصاغ عواطفه تجاه "ريتا كرة القدم" لديه، دييغو مارادونا. كان ينتظره بصبر المشجّع على المدرجات، ورائحة العرق المتصبّب من لاعبه المفضّل، انتظره وإن "أقبل قبل موعده". أعلن درويش انضمامه إلى جمهور مشجّعي المستديرة الذي يربو على المليار إنسان في العالم، فتطير الكرة، وتحطّ الكرة من أمام عدسة الشاعر، لكننا لم نعرف إن كان قد أحبَّها حتّى التعب!
ما السِّحر الذي تكوي به كرة القدم جماهيرها؟ وكيف تتربّع على عرش الرياضة في التاريخ الحديث دون منازع؟ كيف فرّقت بين الشعوب تارةً وأعلنت التصالح بينهم في أخرى؟ أسئلة ما انفكّت عن طرْق أبواب المحللين الرياضيين والاستوديوهات الرياضية، لكنها لم تبقَ حبيسة هذه الأوساط، بل إنها تسلّلت إلى أدراج بحثِ علماء الاجتماع والنفس والإنسان حتى الفلسفة، وتحوّلت إلى عناوين لأبحاثهم وكتبهم.

لا يمكن النظر إلى ظاهرة المستديرة وديناميّاتها، إلا بوصفها ظاهرة اجتماعية تتجاوز حدود العُشب الأخضر واللاعبين ودكّة الاحتياط. كيف لا تكون كذلك وهي لا تكتمل أركانها إلا بوجود الجمهور والألتراس؟ (بخلاف رياضات أخرى كالشطرنج مثلًا). الجمهور هو ركنها الأساسي، وهو الحكَم الخامس، والعارضة الرابعة للمرمى، وكم من دموع حزن انهمرت على عُشب الملاعب؟ وكم ارتوى هذا العُشب بقطرات عرق اللاعبين ممزوجةً بدموع فرح الجماهير؟ وكم من القلوب تلوّعت أمام الشاشات ونبضت مع صافرة النهاية ونفاد وقت المباراة؟
الكرة حين تمرّدت على صانعيها الإنجليز
يرى كثيرون ممّن تتبّعوا مسار لعبة الكرة وحبل تطوّراتها، أنها مرّت بمسار تحديث مستمر، حيث طوَّعت الحداثة كرة القدم وصاغت ملامحها وحدودها، بعد أن كانت معتمدة كليًّا على المهارة الفردية والعشوائية إلى أن قنّنتها عالميًّا بداية القرن العشرين، بمبادرة روبرت غيران بقوانين محدّدة للجميع. قبل ذلك ارتبطت المستديرة بطبقة النخبة الإنجليزية، التي احتكرتها حتى منتصف القرن التاسع عشر.
بدأت الكرة تعلن تمرّدها على الاحتكار الإنجليزي منذ نهاية القرن ذاته، بعد أن رُكلت خارج الملاعب الإنجليزية، ومنها إلى عقول وأرجل الطبقات الشعبية في أوروبا وخارجها. تلقّفتها الشعوب وعلى رأسها الجنوب أميركية. وبدأت تتسارع شهرتها منذ عام 1920، وبخاصة بعد استقلال اللعبة عن اللجنة الأولمبية، وتأسيس الاتحاد العالمي لكرة القدم ("فيفا")، الذي طوّر فكرة تنظيم بطولة كأس العالم، بمبادرة رئيس الاتحاد الفرنسي جول ريميه.
لم يستسغ الإنجليز هذا التمرّد، ووصل بهم الرفض حدّ مقاطعة بطولة العالم في نسخها الثلاث الأولى، وحينما قرّروا العودة في بطولة عام 1950، بعد أن تيقّنوا أن الكرة تنسلّ من بين أرجلهم وتحطّ في صدور ورؤوس غيرهم، كان الأوان قد فات، ولا سيّما بعد أن بدأت البرازيل وغيرها يتسيّدون المستديرة.

مع الإيغال بالتشجيع واتّساع شعبيّة كرة القدم، اتّسمت علاقة رياضة الكرة والمفكرين، وبخاصة الماركسيين، بكثير من الجفاء، إذ تعامل بعضهم معها بكثير من الاستخفاف والازدراء، كإريك هوبسمام ومدرسة فرانكفورت، وهو ما اختلف معه غرامشي، عادًّا إيّاها "مملكة الولاء والإخلاص الإنسانيّ"[1]. كما لم يكبت جورج أورويل وغيره نفورهم من الكرة والتشجيع، وبخاصة بعد أن تسلَّل العنف إلى الملاعب، وكان قاسيًا عليها في نصّه؛ "الروح الرياضيّة"، حينما وصفها بـ"ينبوع عداوة لا ينضب".
حمّل هؤلاء -ككثيرين اليوم- الكرة أكثر ممّا تحتمل من تنظير وحمولة سياسيّة - ثقافيّة فائضة، ففي نهاية المطاف، ليست الكرة هي صانعة الحدث، بل هي إحدى الصخور التي يتكسّر على صخرتها الحدث، ويُظهر لنا هوامش إضافية له، ربّما غابت عنا خارج الملعب. هي كما يقولون، مرآة تعكس صورة الواقع بدون أن تنتجه بالضرورة، أو بتعبير إدوارد غاليانو البليغ: "الدموع لا تأتي من المناديل".
على النقيض من هؤلاء، وقف ألبير كامو مدافعًا شرسًا عن رياضة كرة القدم إلى درجة أنه عدَّ نفسه مدينًا لها بكل ما عرفه عن الأخلاق، كيف لا وهو الأديب الذي كسب "نوبل" وحراسة المرمى في الوقت ذاته، بعد أن مارس لعبة الكرة في شبابه في الجزائر. تموضع كامو في موقع صدّ الكرات الراغبة ببلوغ الهدف، وشكّلت الكرة لديه علاقة درامية يتحرّك فيها الجسد بوصفه يقدّم لوحات فنيّة. وكما أورد غاليانو عن تجربة كامو في كتابه إذ تعلّم منها "كيف يفوز دون أن يعتريه الشعور بأنه قوّة خارقة، وأن يخسر دون أن ينتابه الإحساس بأنه قمامة"[2].
العرب والبرازيل... الإصرار على ربط السِّحر بالعالم
استقرّت كرة القدم في شِباك قلوب الملايين، مُفجّرةً مشاعر من استهوى مشاهدتها، وبخاصة بعد أن وجدت الطبقات الشعبية فيها ضالّتها، وفضاء التعبير عن أحلامها بإنجاز السعادة. ويرى مارادونا أن ملامسة العشب هو بمثابة "ملامسة السماء بكلتا اليدين"، قبل أن تلامس يده شباك المرمى الإنجليزي في بطولة 1986، مسجّلًا أحد أشهر الأهداف وأكثرها خلودًا. كم سيكون الأمر بائسًا لو كان الهدف المذكور قد سقط من ذاكرة الرياضة بمساعدة تقنيّة "VAR" (التحكيم بمساعدة الفيديو).

أما سرديّة التشجيع القائمة بين العرب والبرازيل، فيعود خيطها الأول على ما يبدو، إلى حقبةٍ كان للفنيّات والمهارة الفردية سطوة في الملعب، وصلت ذروتها في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. عشِق العرب والفلسطينيّون سِحر الكرة البرازيلية لما تشكّله من إصرارٍ على سطوة فنّ الإمتاع، حتى لو على حساب الخسارة.
كانت منطقة الشام العربيّ من أكثر هذه الشعوب ارتباطًا بمنتخبات جنوب أميركا (البرازيل والأرجنتين تحديدًا)، وقد شكّل تاريخ الهجرات الكبيرة من المنطقة إلى هذه البلدان، سببًا مضافًا لهذا الارتباط بالذاكرة الكروية، رغم أن الشام وبخلاف مناطق شمال إفريقيا العربية، لم تعرف ذاكرة كروية لافتة، أو إنجازات كروية مرتبطة بأنديتها أو منتخباتها الوطنية.
أما حالة فلسطينيي مناطق 48، فهي مستثناة بعض الشيء من هذه الحالة، وكان منسوب الشغف بالكرة العالمية والمحلية أعلى لديهم، إذ تشكّلت علاقتهم المحلية بالأندية في إطار واقعهم الإسرائيلي، وعرفت مدن وقرى الداخل ذاكرة كروية مرتبطة محليًّا بفِرق الـ"هبوعيل" والـ"مكابي" العربية، في كل بلدة وأخرى، لم تكن تخلو من التنافُس والتناحُر الذي اشتبك في كثير من الأحيان مع تنافس انتخابات السلطات المحلية. وأما قطريًّا فقد شكّلت الكرة مسارًا متّصلًا بكفاح الجماعة في الداخل ومناهضة السياسات الإسرائيلية، وكانت تجربة اتحاد أبناء سخنين وإنجازاته، أبرز هذه التجارب. كما تحوّلت لقاءات سخنين أمام فريق "بيتار القدس" العنصريّ إلى حيّز يتكثّف فيه الصراع السياسيّ في الداخل.

شكّلت "واقعة ساريا" التي استضافت مباراة البرازيل وإيطاليا عام 1982، صدمة مسترخية في ذاكرة مشجّعي البرازيل عمومًا وفي الداخل الفلسطيني. تمامًا كما كانت بمثابة البطاقة الحمراء لأسلوب مميّز في كرة القدم، فكما قال سقراط، لاعب الوسط البرازيلي والناشط الديمقراطي: في هذا اليوم ماتت كرة القدم التي نعرفها، وكثيرون شاطروا سقراط الرأي.
دخلت البرازيل هذه البطولة مدفوعةً بكل ما أوتيت من سِحر وفنيّات ومهارة بأسلوب لعب لامس الغمام، منتميًا بحسب تعبير البعض إلى ما هو خارج هذا الكوكب، إلّا أن سحر سقراط وزيكو وغيرهم تمنّع أمام حصن الطليان الدفاعيّ، ولم يستطع قلب النتيجة، بعد أن لعبت إيطاليا بأسلوب دفاعي أوروبي، وشكّلت حاجزًا تكسّرت على أسواره أحلام البرازيليين. خرج فريق الأحلام البرازيلي من كأس العالم في مباراة لا ينساها أي مشجع برازيليّ عاصر تلك الحقبة، وهي الحقبة التي وصل فيها حب العرب للبرازيل إلى منتهاه.

كانت هذه المباراة إغلاقًا لفصلٍ في لعبة الكرة، وإعلانًا لفجر جديد لا يُكتب بحروف السحر والمهارة وحدها، بل يكتبه منطق التكتيك والتنظيم الجماعي، وحُسن استغلال المرتدات والأخطاء، حتى وإن على حساب منطق المتعة. أحدثت هذه "الكارثة الكروية" بدايات التغيير في عقلية اللعب البرازيليّ لمواجهة ماكينات التكتيك الأوروبي، التي بدأت سطوته تظهر بقوة منذ نهاية الثمانينيات، وكان مونديال عام 1990 إيذانًا بهذه الحقبة، حيث تلقّت شباك منتخباته المشارِكة، أقل عدد من الأهداف في تاريخ البطولات كلها. في موازاة هذه البطولات، كان العالم يسدل الستار على أحد قطبيه ويعلن مرحلة القطب الواحد، ويعلن فوكوياما "نهاية التاريخ". وفي كرة القدم كان المونديال في عامي 1990 و1994 يعلن نهاية تاريخ الكرة التقليديّ.
حاولت البرازيل مقاومة التغييرات السريعة، واتخذت موقفًا وسطيًّا يحاول المزج بين المدرستين، إلا أن جماهير البرازيل لم ترحم المدربين الجدد من سهامها، وأمطرتهم هجومًا ونقدا منذ بطولة 1990، لما اعتبرته تغييرا في النمط البرازيلي لصالح أسلوب اللعب الأوروبي، بيد أن هذا التحوّل في المدرسة البرازيلية لم يكن كاملًا وشاملًا، فقد حاولت البرازيل الموازنة والمساومة بين مجاراة التغييرات السريعة التي طرأت على كرة القدم من جهة، والحفاظ على الرونق الجماليّ الخاص بالبرازيل، وهو ما امتدّ لعقد من الزمن بين 1994 - 2004. لم يدرك الكثيرون من مشجعي البرازيل أن هذه لم تكن سوى مرحلة انتقالية وسطى، كان يمتلك فيها المنتخب البرازيلي منظومة هجومية ساحرة من مهاجمين كرونالدو وريفالدو ورونالدينيو، استطاعوا فكّ الاشتباك دومًا أمام المنتخبات الأوروبية، وكان وجودهم هو نقطة التوازن التي أبقت البرازيل على عرش الكرة، حتى مع التغييرات الحاصلة. وأما بعدها فعلى ما يبدو ستجد البرازيل نفسها أمام مأزقٍ حقيقيّ، لن يكون فيه من بدّ إلا بمزيد من التغييرات الفنيّة، وهو ما وصل إلى حدّ مطالبة البعض بالاستعانة بمدربين أوروبيين لتدريب المنتخب البرازيلي.
رسْمَلة الكرة
تعود هذه التغييرات إلى تغييرات اقتصاديّة - سياسيّة أكبر، إذ تدّفقت مياه كثيرة في وادي الكرة منذ الثمانينيات، ومرّت بعملية رسْمَلة ولَبرَلة عميقة، بعد أن صار للمال حضور مهيمن فيها، محوّلا إياها إلى صناعة، وأصبحت اللعبة التي تجذب ملايين المشجعين محطّ أنظار السوق والاقتصاد. كان "قانون بوسمان" وقرار محكمة العدل الأوروبية عام 1995، وفقًا لجون كود ميشا، ذروة التحوّل الليبرالي في الكرة، وهو القرار الذي حرّر قيودًا كانت مفروضة على انتقال اللاعبين بين الأندية.
أصبحت الأكاديميات ومدارس الأندية، المغذّي الرئيسي للنجوم الذين باتوا أشبه بأسهم شركات واستثمارات تدرّ الموارد الهائلة للفريق والمالكين إلى درجة دخل فيه قاموس الاستثمار والشركات العابرة للجنسيات لغة الفرق، وهو ما لم يخفه رئيس نادي ريال مدريد، إذ قال عن فريقه، إنه "الشركة العالمية لكرة القدم".

فتحت مركزية الاقتصاد والسوق الطريق على مصراعيه لمركزية مقابلة في عالم الأندية والنجوم، حتى بات عدد قليل من الأندية يحتكر الغالبية الساحقة من النجوم على مستوى العالم، وكان تشكيل هذه الأندية منذ بداية الألفية إطارًا سمي "رابطة الـ14"، إعلانًا لهذه المركزية، وهو إطار يضمّ أشهَر الأندية الأوروبية، ليشكل صوتًا موحّدًا في فرض سطوته أمام منظمات "فيفا" و"ويفا".
شكّلت هذه التحولات معضلة الكرة الأساسية، وهو التناقض بين منطق الفنّ والمهارة من جهة، والاحتراف والتكتيك من الجهة المقابلة، بين هدف الإمتاع من جهة وإغراءات المكاسب من جهة أخرى، وهو ما دعا الكاتب باسكال بونيفاس إلى أن يتساءل بغضب: "من يريد أن يشاهد كرة قدم تحكمها ميزانية النادي؟"[3].
بات الهدف من اللعب هو تجنّب الخسارة، بدلًا من التفكير في الفوز والإمتاع، فكما يقول إدوار غاليانو: كلما تحوّلت هذه الرياضة إلى صناعة، كلما نُزع عنها سحرها، وكم نحن في أمسّ الحاجة إلى قليل من السِّحر، في عالم يعبث بنا بروتينه، وهوَس الضبط، وتقليص هامش اللايقين.
لا يعني ذلك خلوَّ رياضة الكرة من الفنّ والمهارة الفردية تمامًا، فما تزال الجماهير تستمتع بهذه المهارة، وما تزال الملاعب تطرح علينا أسماء لاعبين يتقنون الارتجال من حيث لا نتوقّع، واللعب الفردي بمهارة عالية، لكن ذلك لا يمكن أن يتمّ، إلا في إطار جماعيّ، وهي الموازنة بين البصمة الفردية في حدود اللعب الجماعي.

هذا ما دعا عالِم الاجتماع، سيمون كريتشلي، إلى مقاربة لعبة الكرة بموسيقى الجاز التي يحكمها نسَق معيّن من القواعد التي تضبط اللحن، لكن فجأة يأتي فكّ الرتابة بحركة ارتجالية ساحرة. إن أفضل اللاعبين يرتجلون وفق ما يتخيّلونه من حركات سابقة ولاحقة لفريقهم، يفهمون الفضاء المحيط بهم، ويبحثون عن مساحتهم الفردية، ويرتجلون باللعب ويقدمون مهاراتهم[4].
بقيت بطولة كأس العالم، البطولة الأقل تأثّرًا بهذه التغييرات، فهي تعتمد على المنتخبات الوطنية، وثمّة قيود تضبط حرية تنقّل اللاعبين، حيث لا يمكنك اللعب مع منتخب إلا إذا انتميت له بالجنسية، وهذا ما يضفي على بطولة كأس العالم بُعدا مميّزا، لا يمثّل فيه اللاعب ناديًا، بل منتخبًا وطنيًّا وطموحَ شعبٍ. وتعجّ البطولة بهذه المشاهد، بدءًا من الأعلام الوطنية وارتداء الأزياء الفلكلورية التقليدية، وهزّ الجسد على أنغام الرقصات الشعبية الخاصة، وافتتاح المباريات بالنشيد الوطني، وغيرها.
شفاعمرو والبرازيل... حينما التقى الزجَل بـ"السامبا"
يبقى التشجيع والجمهور ركنَ كرة القدم الأبرز، بخلاف كثير من أنواع الرياضة، رغم أن اللعب بحد ذاته لا يحدث في رؤوسنا بل خارجها، كما يقول كريتشلي في كتابه. تطوّرت ظاهرة التشجيع مع الوقت في هيئة وصيغة "ألتراس"، أي جماعة مشجعي فريق أو نادٍ ضمن شعار ولون وأغنية مميّزة، وتحوّلت الملاعب إلى فضاء يعبَّر فيه ليس عن هواجس كروية فحسب، بل سياسية واجتماعية كذلك، ورأى فيه آصف بيات جزءًا مما يسميه "الحركات الاجتماعية". ويكفي أن نرى هوس نظام السيسي بقمع "الألتراس" وملاحقته وضبطه، بعد أن رأت الثورة المضادة مدى تداخله وحركة الشارع. يتحوّل التشجيع بصورة غريبة وفائقة إلى جزء من الانتماء لجماعة اجتماعية، وإن كانت حدودها رياضية وأحيانًا افتراضية، حتى أن قاموس المشجعين يشير إلى التشجيع بنَسْب الشخص إلى البلد، فأنت لا تشجع البرازيل، بل أنت "برازيلي"، أو "ألماني" في الكرة.
كانت تجربة شفاعمرو كغيرها من بلدات الداخل لافتة مع كرة القدم، فقد شبكت علاقتها مع شِباك كرة القدم في إطارٍ من قتل الفضاء السياسي والاجتماعي، حتى تحوّلت الملاعب، كما الأعراس أيام الحكم العسكري، إلى فضاءٍ للتجمّع والتجمّهر في عدة بلدات. وكان التشجيع والانضمام إلى جماعة "المشجعين"، يجري في سياق ضُبط فيه حقّ الداخل في الاشتباك الطبيعي والحضاري مع شعبه الفلسطيني وجماعته الوطنية.
كان التفاعل مع مباريات كأس العالم وأجوائها لافتًا بعدد اللافتات التي زيّنت شُرفات وأسطح المنازل، وكان من الصعب أن تجد بيتًا خاليًا من هويّة منتخب العائلة في بطولة 1998. في الوقت التي تمتلئ مدرجات المباراة بالمشجعين كانت تفرغ شوارعنا من الناس والمارة، فالجميع متسمّر أمام الشاشة. وصلت المبالغة ببعض مشجعي البرازيل من البلدة إلى وقوفهم أثناء غناء النشيد الوطني أمام الشاشة بيد مبسوطة على الصدر ومسترخية فوق حدود القلب. يجري كل ذلك في سياق لا يجد فيه هؤلاء المشجعين فضاءً لعزف وإنشاد نشيدهم الوطني الفلسطيني في الحيّز العام، فهم الجماعة التي عاشت العتبة بين انتمائها لشعبها الفلسطيني، وبين ظروف المواطَنة الإسرائيلية العنصرية.
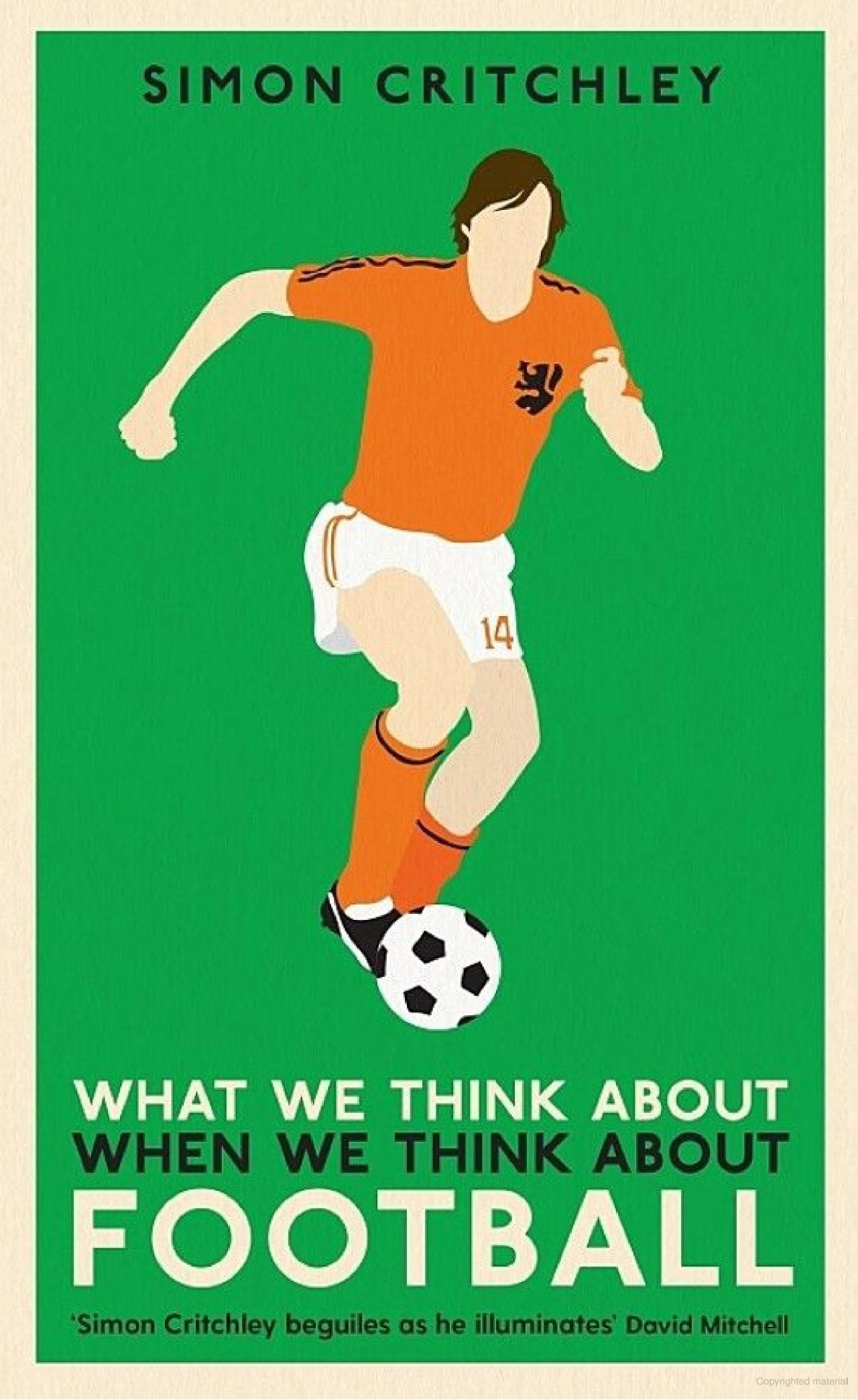
وما إن يطلق الحكم صافرة النهاية، حتى تُطلق شفاعمرو صافراتها ومفرقعاتها (في حال فوز البرازيل طبعًا). تحوّلت ساحة باب الدير تاريخيًّا إلى فضاء اجتماعي لمشجعي المنتخبات، وبخاصة البرازيلي. في ومضة يتحوّل باب الدير إلى زقاق في ريو دي جانيرو، بعد أن يتزيّن بالأعلام المرفرفة على أنغام الإيقاع وحناجر الهاتفين.
تحوّل باب الدير عام 2002 إلى كرنفال، وإن لم تحضر فيه رقصة السامبا البرازيليّة، فقد حضرت فيه السحجة الفلسطينيّة والزجل الشعبي المحلي. هزّ رونالدو حينها شباك أوليفر كان بهدفين، فاهتزت معها حنجرة الزجّال الفلسطيني، وباحت بـ"طير وهدي يا حمام" وبأبيات الزجل التي تقول:
"رونالدو هي يا بطل... خفيف من شكل الحجل
رونالدو سجّل جولين... عالشمال وعاليمين
رونالدو مثل الصاروخ... والألمان منه بدوخ
يا عيني عَ الألماني...روّحت الخسراني"[5]
بيد أن المنافسة المركزيّة في الذاكرة الكروية لشفاعمرو استقرّت بين جمهور البرازيل والطليان، وكانت بطولة العام 1994 نقطة فارقة في هذه المعركة، إذ وصل حينها المنتخبان، متوّجيْن بثلاث نجمات لكل منهما، قبل أن تهدي أقدام روبيرتو باجيو النجمة الرابعة للبرازيل، بعد تسديدته الشهيرة التي أضاع فيها الكرة عاليًا.
أرسل باجيو كرته الشهيرة التي حلّقت عاليًا من على مرمى حارس المرمى البرازيلي تفاريل إلى خارج الملعب، ثمّ إلى شفاعمرو لتتلقّفها قلوب مشجعي البرازيل فرحًا وغبطةً؛ منذئذ تحوّلت المنافسة الرئيسية بين جماهير البرازيل وإيطاليا، إلى منافسة لا تخلو من أبعادٍ اجتماعية - طبقية، دون الادعاء طبعًا بوجود تطابق بين الفئة الاجتماعية وبين هويّة المنتخب المفضل، فالتشجيع قاطع وعابر للانتماءات الاجتماعية والطبقية على أية حال.
عندما تسأل مشجعي البرازيل عن سبب حبهم وتشجيعهم للبرازيل، يعجّ قاموس إجاباتهم بمصطلحات من قبيل؛ "السِّحر"، و"الجمال"، و"اللعب من أجل المتعة" وغيرها. إنهم يشجعون النوستالجيا التي يعرفونها عمّا يحبّون أن تكون عليه كرة القدم، بعيدًا عن التقنيات الحديثة وسطوة الأسلوب التكتيكي الأوروبي، كما لو أن تشجيع البرازيل هامش للتمرُّد على القائم، وعلى مسار لَبْرَلَة ورَسْمَلة الكرة وتحوّلاتها السريعة؛ هو انحياز للحصن الأخير الذي لا يريدون له أن يهوي، كما الشوق للبدايات، والخوف من إعلان النهايات... نهاية الأسطورة.
مونديال قطر: التعبير كرويًّا عن السياسيّ
ثمّة شيء ما تغيّر في هذه النسخة، ففضلًا عن تنظيمها في بلد عربيّ، فقد حضر الوجدان السياسي العربي بصورة تجاوزت التشجيع التقليدي للمنتخبات الكبيرة، أو المشاهدة العابرة للمونديال. بلد عربيّ ينظّم البطولة وبلد عربيّ آخر يصل المربع الذهبي فيها، فما أوسع المساحة لأن يحطّ فيها الوجدان العربي، وينفجر تعبيرًا عن هواجسه العروبية، وفي قلبها انحيازه لمسألة فلسطين.

لا تعبّر الجماهير العربية عن تضامنها مع فلسطين في المونديال، بل تعبّر عن هويّتها العربية من خلال فلسطين، بعد أن باتت قضية فلسطين مركّبًا عضويًّا في الهويّة العروبيّة ذاتها، وقد أكّدت الجماهير العربية أن حناجر هتافها لمنتخباتها، لا يمكن أن يمرّ إلا من خلال فلسطين، رمز وحدتهم ووحدة مصيرهم.
ردّت فلسطين الدين للمنتخبات العربية في فرحة انفجرت في شوارع كل بلداتها وقراها في الداخل ومناطق الضفة الغربية والقطاع، كما في كل العواصم العربية، في مشهد تعبيريّ عن انتماء الأمة الحضاري والثقافي والسياسي، بعد عقدٍ دامٍ تكسّرت فيه أحلام الثورات العربية، وانتصرت فيه "الثورة المضادة".
إنه هامش الفرحة التي تعطيه الكرة في إطار واقع عربي نخرت فيه الهزائم عظام ولحم أولاده وبناته، وسقطت منه الوعود والآمال. إنه التعبير كرويًّا عن هاجسٍ سياسيّ وحضاريّ انسدّت في وجهه كل الأفُق، وفتحت له ملاعب المونديال الأخير أدراجها، لتعبّر وتفيض بها، ليتجدّد لدينا الحلم، فكما يقول ألبير كامو عن تجربته: "تعلّمت أن كرة القدم لا تأتي مطلقًا نحو أحدنا من الجهة التي ينتظرها منها". لقد علّمنا هذا المونديال كيف تأتي الفرحة والأمل من الهامش والجهة التي لم ننتظرها.
[1] جون كلود ميشا، "بعض الأقوال حول كرة القدم"، مجلّة الدوحة، العدد 80، نوفمبر 2022، ص 33.
[2] إدوارد غاليانو، كرة القدم في الشمس والظل، ترجمة صالح علماني، طوى للنشر والإعلام: دون تاريخ نشر. ص 153.
[3] باسكال بونيفاس، "عولمة كرة القدم تعزّز الانفتاح"، مجلة الدوحة، العدد 180، تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. ص 54.
[4] سيمون كريتشلي، "عندما نفكّر في كرة القدم"، مجلة الدوحة، العدد 180، تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ص 48.
[5] الكلام للزجّال الشفاعمري فتح حمادي.

التعليقات