الشيخ مؤنس... وجهان لمقبرة واحدة
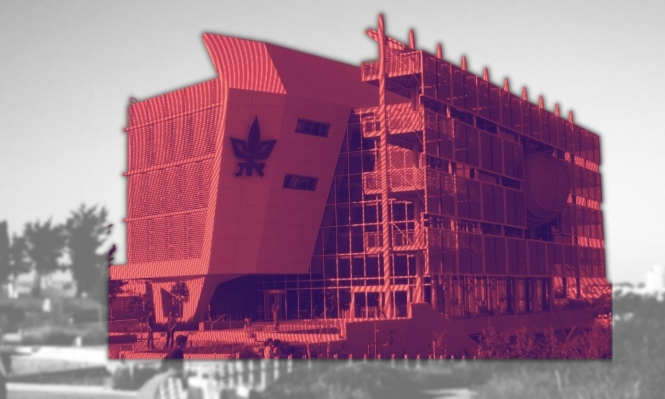
عند الحديث عن الذكريات الّتي تسكننا وتأبى الانسلاخ عنّا، لا بدّ من استرجاع ذلك اليوم كأنّه الأمس، حين سجّلت لقرعة الانتساب إلى مساكن الطلبة ’بروشيم‘، بعد حصولي على رسوم القبول للدراسة في «جامعة تل أبيب - الشيخ مونّس». لم تكن أمنيتي آنذاك إلّا الحصول على شقّة من تلك الّتي تعتبر الأحدث، والأكثر خصوصيّة و’رفاهية‘، من بين المساكن المتوفّرة في محيط الجامعة، ولم أدرك قطّ الجحيم الّذي سوف تخلّفه لي هذه الأمنية بعد فترة معلومة.
كيف كان لي أن أدرك أنّ هذه البقعة الجغرافيّة، ستتمكّن من انتزاع تلك الفتاة منّي، الّتي تقضي غالبيّة وقتها بعزف ألحانها الشرقيّة الهادئة على كمانها، واستبدال تلك الّتي تستمع بغزارة طيلة يومها إلى الموسيقى الكلاسيكيّة الرماديّة، وموسيقى ’ألهيفي ميتال‘ الصاخبة المظلمة، راسمة وجوهًا سوداويّة صارخة مخوّلة أن تقودك إلى الجنون عندما تنظر إليها؟ نعم، كنت دائمًا محاطة بتلك السوداويّة المجهولة، وبشكل دائم في ذلك المكان، ألمح وجوه الطلبة الفلسطينيّين والفلسطينيّات شاحبة وحزينة، حتّى أدركت أنّ تلك المقبرة المقدّسة أو اللعينة القابعة تحتنا، والقابعات نحن فوقها، هي السبب وراء ذلك.
مقبرة الشيخ مؤنّس
تقع مقبرة الشيخ مؤنّس جنوب شرق قرية الشيخ مؤنّس المهجّرة، كانت مساحتها قبل النكبة نحو 80 دونمًا، ومن ضمن هذه المساحة كان مسجد القرية - قرية الشيخ مونّس. بالإضافة إلى بيدر طحن القمح، كانت المقبرة ضمن أراضي الوقف الإسلاميّ، وقد دُفن فيها أهل القرية وأقاربهم من عائلات البيدس، ودحنوس، والحج كحيل، وريان، والزبات، وغيرها، وأيضًا قلّة قليلة من عائلات القرى المجاورة كالصوميل وسيّدنا عليّ.
في عام 2010، بدأت شركة «شيكون في بينوي» الإسرائيليّة، بالشراكة مع «جامعة تل أبيب»، مشروع بناء مساكن الطلبة ’بروشيم‘ على مساحة مقبرة الشيخ مؤنّس المهجّرة...
في عام 2010، بدأت شركة «شيكون في بينوي» الإسرائيليّة، بالشراكة مع «جامعة تل أبيب»، مشروع بناء مساكن الطلبة ’بروشيم‘ على مساحة المقبرة؛ لتبدأ الحفريّات الضخمة في المنطقة عام 2012، الّتي أدّت بدورها إلى جرف القبور ونبشها؛ بهدف تهيئة الموقع لبناء الشقق السكّانيّة، مركز تجاريّ، وتوسيع مصفّات السيّارات. يُذكَر أنّ بقايا من شواهد القبور في الموقع تناثرت خلال عمليّة الحفر، وأجزاء من هياكل وجماجم لم تفلت من نفي المحتلّ لها، ولا يُعلم حتّى الآن مصيرها، وإلى أين أُخذت. هنا، أودّ الاستشهاد بقول ممدوح عدوان في كتابه «حيونة الإنسان»: "إنّ أبشع الجرائم والمجرمين هم الّذين يحفرون المقابر ويعبثون في الجثث"؛ لتأكيد حيونة الاحتلال الإسرائيليّ، والتشديد على تجرّده من الإنسانيّة وتخطّيه الحدود الإنسانيّة.
سياسات المحو الاستعماريّة
عند دخولي للمرّة الأولى بعدما قُبِلت إلى الشقّة، أو الجحر اللعين إن صحّ الوصف، لم أكن على دراية بهذه المعلومات عن المساكن والمقبرة، لكن بعدما سُكبت عليّ على حين غرّة، أصبحت كلّ خطوة من خطواتي نحوها مثقلة بها، وشعور مرهق ومرعب يعتريني بشكل دائم. لم يكن كما توقّعت، لم يكن أكثر المساكن رفاهية ولا راحة كما رُوّج، بل منذ لحظاتي الأولى في ذلك المكان أحسست كأنّ وحشًا أسود عظيمًا استلبسني وأصبح يرافقني في كلّ تفصيلة صغيرة وكبيرة، خلال فترة سكني هناك. كان هذا الوحش بمنزلة ظلّ من ظلال الاستعمار الوحشيّ الّذي نعيش تحته، ونواجهه يوميًّا في أطر ومرافق مختلفة، وبشكل خاصّ، طلّاب «جامعة تل أبيب»، وسكّان تل أبيب الفلسطينيّون الّذين تستهدفهم سياسات الاستعمار الإسرائيليّ على مدار الساعة، محاوِلةً لجم أفكارهم المتصوّرة عن أصل محيطهم؛ بذريعة ’ليبراليّة تل أبيب‘.
تبحث هذه المقالة في السياسات القمعيّة الّتي مُورِسَت على المجتمع الفلسطينيّ في الأراضي المحتلّة عام 1948، وبشكل خاصّ، المجتمع الفلسطينيّ في تل أبيب، الّذي مورِسَتْ عليه أخطر السياسات مثل سياسات الترغيب، والتعزيز، وغسل الدماغ، بحيث حاولت السياسات الاستعماريّة بشكلٍ دائم جذب الشباب الفلسطينيّ بشكل متواصل إلى رفاهيّة – ونقاهة - فقاعة تل أبيب الورديّة الليبراليّة ذات البيئة المتقبّلة، السلميّة والمؤيّدة لوهْم السلام والعيش المشترك، ’بعكس‘ قرانا وبلداتنا العربيّة، وليس ذلك إلّا وهم يحاول الجلّاد ترسيخه سيكولوجيًّا للنيل من ذواتنا ومن كلّ ما يكمن داخلنا من طاقة أو قدرة على التحمّل.
حاولت السياسات الاستعماريّة بشكلٍ دائم جذب الشباب الفلسطينيّ بشكل متواصل إلى رفاهيّة – ونقاهة - فقاعة تل أبيب الورديّة الليبراليّة ذات البيئة المتقبّلة، السلميّة والمؤيّدة لوهْم السلام والعيش المشترك...
قد يكون ممكنًا ربط هذه السياسات بآليّة ’الإعجاب بالجلّاد‘، الّتي حدّثنا عنها د. مصطفى حجازي في كتابه «الإنسان المهدور»، وهي آليّة نفسيّة تحتّم على الضحيّة الإعجاب بجلّادها من غير وعي؛ فترى الضحيّة أنّ المثاليّة أو الأفضليّة مزروعة بجلّادها. يضيف د. حجازي في شرح آليّة ’الإعجاب بالجلّاد‘ أنّه: "يتمّ تمثُّل خصائص المعتدي، وسلوكاته وتفضيلاته ومعاييره، باعتبارها الحالة المثلى أو الفضلى في نوع من التحوّل الوجدانيّ والمعرفيّ والعفويّ، والخارج عن الإرادة؛ ففي التماهي يتمثّل المرء جوّانيًّا النموذج الخارجيّ، بحيث يعيش ذاته على أنّه النموذج، وكلّ ذلك بشكل غير مقصود، هنا يصل غسيل الدماغ غايته من النجاح، وهو ما يشاهَد تاريخيًّا عند البعض من تماهٍ بالمعتدي أو المحتلّ أو الغاصب، ليس من باب المسايرة بقصد المنفعة الذاتيّة، بل من باب استبدال جلد بجلد، وهويّة بهويّة لذاتهما، وانطلاقًا من حالة الإعجاب الحميم بالمعتدي الّذي يتّخذ طابع القيمة الكلّيّة".
إضافة إلى ذلك، من خلال هذه السياسات السيكولوجيّة، يحاول الاحتلال بشكل واضح مكننة المجتمع الطلّابيّ الفلسطينيّ، وتجريده من المشاعر. يمكن هنا أن نرى أيضًا محاولة تطبيق آليّة ’الإعجاب بالجلّاد‘ أو ’التماهي بالمعتدي‘. فكنت قد ذكرت سابقًا حيونة الاستعمار الإسرائيليّ وتجرّده من المشاعر؛ ليحاول صنع - أو خلق - نسخة فلسطينيّة ’تل أبيبيّة‘ منه، خاصّة الطلّاب الّذين يسكنون في مساكن الطلبة ’بروشيم‘، عن طريق تطبيع وجودنا، وسكننا فوق قبور أجدادنا وقبور سكّان قرية الشيخ مؤنّس المهجّرة، والقرى المجاورة في اللاوعي الخاصّ لنا.
مقاومة المحو وبناء الذاكرة
لكن يمكننا أن نرى أنّ السياسات الاستعماريّة قد باءت بالفشل نوعًا ما، فقد كنت أجريت حديثًا مرّة مع الزميل كريم محمّد يحيى، الّذي دُفِنَ أجداده في مقبرة الشيخ مؤنّس. سألته عن شعوره تجاه سكنه فوق قبور أناس تربطه بهم صلة بيولوجيّة، فأجابني: "في الفترة الأولى، لم أكن أشعر بالراحة قطّ، وكنت دائمًا أشعر بأنّ بالفعل ثمّة أرواحًا حولي كلّ الوقت، وحتّى الآن أشعر بوجود عائلة جدّتي حولي غالبيّة الوقت، حتّى قالت لي جدّتي إنّها تشعر بالغبطة والسعادة أنّ من يسكن هناك الآن هم طلّاب فلسطينيّون، وأنّ سكّان القرية المهجّرة سابقًا سيشعرون بهذه السعادة ما دام يسكنها الآن فلسطينيّون، خاصّة أنّ المساكن الآن تُعَدّ قرية طلّابيّة فلسطينيّة". تابع يحيى: "جدّتي كانت دائمًا تسرد لي المكان؛ فأصبحت أنّى أنظر أرَ القرية كما هي مرسّخة في ذاكرة جدّتي، وذلك الشعور بالذنب والحزن قد تحوّل إلى شعور بالمسؤوليّة، وأنّه واجب عليّ زرع هذه المشاهد الّتي ورثتها عن ذاكرة جدّتي في ذاكرة الطلبة الفلسطينيّين الموجودين في هذا المكان".
يعمل يحيى الآن على مشروع «متحف الشيخ مؤنّس»، والهدف من هذا المشروع هو إعادة إحياء قرية الشيخ مؤنّس. لا يرتكز المشروع على إعادة إحياء الدمار الّذي حدث بعد النكبة فقط، إنّما إحياء المخيّلة والذاكرة الجماعيّة للثقافة، والعلاقات الاجتماعيّة، وأسلوب حياة الفلسطينيّين في الشيخ مؤنّس سابقًا. سوف يُطبَّق المشروع على مراحل وصور عدّة، منها مجسّمات ثلاثيّة الأبعاد للقرية، وأبحاث علم اجتماعيّة تبحث الشيخ مؤنّس في فترة ما قبل النكبة، الّتي تعكس جوانب عديدة من الحضارة والثقافة للحياة اليوميّة الّتي عاشها سكّان الشيخ مؤنّس سابقًا. سيحاول المشروع أن يكون أداة تذكير ووسيلة لنشر الوعي حول المكان الّذي بُنيَت فيه «جامعة تل أبيب»، وترسيخ التاريخ في ذاكرتنا. يشدّد يحيى على أنّ الهدف الأساسيّ من المشروع هو تصوير مفهوم جديد للذاكرة الجماعيّة، واسترجاع الذاكرة الخاصّة بالشيخ مؤنّس.
الحراك الطلّابيّ
مثال آخر لمقاومة السياسات الاستعماريّة النفسيّة القمعيّة للطلبة الفلسطينيّين، هو الحراك الطلّابيّ في الشيخ مؤنّس، خاصّة «منتدى إدوارد سعيد»، الّذي عمل منذ تأسيسه على إعادة توطين المكان والمعرفة. بحث أعضاء المنتدى قرية الشيخ مؤنّس تاريخيًّا وجغرافيًّا، ودوّنوا كلّ ما نتج عن هذا البحث للأجيال القادمة للجامعة؛ لتكون أوّل معلومات يكسبونها هي تاريخ المكان الّذي هم فيه، لبناء وعي كافٍ لدى الطلبة، مخوّل أن يمنعهم من الوقوع في فخّ الجلّاد. أمّا على مستوى الحراك الطلّابيّ كاملًا؛ فقد عمل دائمًا على نشر الوعي الفلسطينيّ للطلبة الفلسطينيّين في الجامعة؛ من خلال نشاطات عديدة، كالندوات والحواريّات والفعاليّات، وقد اهتمّ أيضًا بالتظاهر والاحتجاج على العديد من القضايا الوطنيّة؛ حيث حرص على أنّ العلم الفلسطينيّ يرفرف عاليًا في سماء الشيخ مؤنّس في كلّ محفل ومناسبة وطنيّة، لتأكيد استمراريّة وجودنا ونشاطنا في هذا المكان.
بالرغم من كوننا من الجيل الثالث للنكبة الفلسطينيّة، إلّا أنّ التجارب التراجيديّة والصادمة الّتي عاشها أجدادنا وجدّاتنا قبل عشرات السنين، ما زالت تترسّخ بشكل استمراريّ في اللاوعي المشترك لنا فلسطينيّاتٍ وفلسطينيّين...
نظريّة أفلاطون الّتي تتحدّث عن خلود النفس، «في خلود النفس»، يلخّصها فيقول: "إنّ الإنسان مركّب من جسد ونفس أي الروح، وأنّ النفس وحدها هي جوهر مستقلّ عن الجسد، وأنّ الجسد ما هو إلّا محلّ مؤقّت للنفس لتحلّ فيه، وعندما يفنى الجسد تبقى النفس لتكون خالدة إلى أبد الآبدين". وقد كان شيء واحد يخطر لي خلال فترة مكوثي في مساكن الطلبة ’بروشيم‘، وهو مشاركة أرواح أجدادنا - الّتي لم يسمح لها الاحتلال أن ترقد بسلام – غرفنا، وأنّ أرواحهم بالفعل تكون حولنا كلّ الوقت. يضيف أفلاطون أيضًا: "أنّ أرواحنا الخالدة تتجسّد في الكثير من الأشياء، مثل النباتات وأجساد الحيوانات والجماد أيضًا"، فكنت أرى هذه الأرواح تتجسّد في الكثير من الأغراض الموجودة في غرفتي، وأصبحت أخاطب نباتاتي كالمجنونة؛ فكنت - وربّما ما زلت - على ثقة تامّة بأنّ أرواحهم معنا، وكأنّها تصرّ على تذكيري ولفت انتباهي إليها.
بالرغم من كوننا من الجيل الثالث للنكبة الفلسطينيّة، إلّا أنّ التجارب التراجيديّة والصادمة الّتي عاشها أجدادنا وجدّاتنا قبل عشرات السنين، ما زالت تترسّخ بشكل استمراريّ في اللاوعي المشترك لنا فلسطينيّاتٍ وفلسطينيّين، في ما كلّ ما عاشوه يترسّخ في ذاكرتنا.
في كلّ مرّة كنت أجلس لتبادل الحديث مع بعض الأصدقاء الّذين هم أيضًا من سكّان ’بروشيم‘، كلّ ما كان سمعي يفيض به هو تجاربهم الخاصّة في هذه المساكن، ولا يمكنني عدّ كم من المرّات كنت قد سمعت عن نوبات الهلع الّتي تصيب الطلبة في ذلك المكان؛ عن الاكتئاب الّذي كان يرافقهم؛ عن الكمّ الهائل من المشاعر السلبيّة والأفكار المحبطة والسوداويّة؛ الأمر الّذي جعلني أفكّر مليًّا في سبب هذه التراجيديا، ولم أصل إلى نتيجة غير أنّ هذه المباني الحديثة والمريحة كانت قد بُنيت فوق ضرائح أجدادنا، لم تكن يومًا، ولا يمكن أن تكون مأوًى لنا، وإن كانت مأوًى لأجسادنا فهي ما زالت مقبرة لأرواحنا.

طالبة للقب الأوّل في «الفلسفة والدراسات النسويّة والجندريّة» في «جامعة تل أبيب – الشيخ مؤنّس»، وعضوة في «منتدى إدوارد سعيد للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة».





