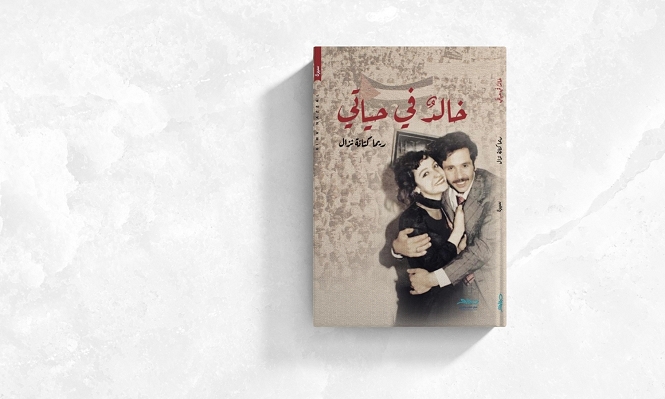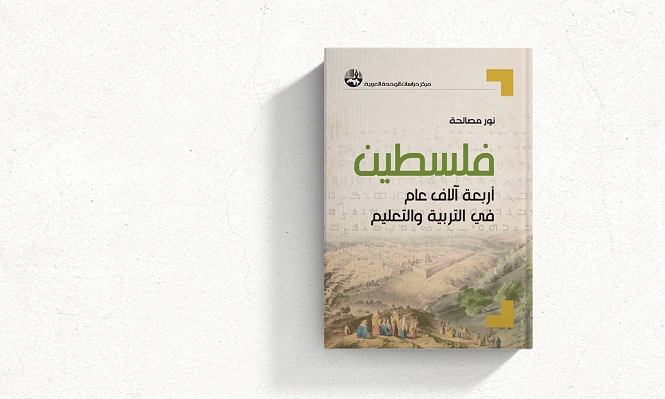ثلاث مقدّمات: حجر لم يُقلب

صدرت عن مبادرة "فناء الشعر" والدار الأهليّة للنشر والتوزيع، وبالتعاون مع دار "فيرلاغ هانس شيلر" الألمانيّة للنشر، أنطولوجيا شعريّة بعنوان "حجرٌ لم يقلب" (2017). وهي الأنطولوجيا الأولى التي تصدر عن مبادرة "فناء الشعر" التي أسّستها الشاعرة أسماء عزايزة، والتي دعت فيها ثمانية شعراء وشاعرات من فلسطين وألمانيا للكتابة حول الهويّة، وهم: أوليانا وولف، توماس كوهن، جمانة مصطفى، سيّا رينيه، عامر بدران، غياث المدهون ونورا بوسونغ.
وقد شارك في التحرير وعمل على نقل النصوص الألمانيّة إلى العربيّة والعربيّة إلى الألمانيّة، المترجم إبراهيم مرازقة.
تنشر فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، ثلاث مقدّمات، أو نصوص افتتاحيّة، وردت في الأنطولوجيا، بإذن من الجهة المصدرة.
***
اقلبوا هذا الحجر | أسماء عزايزة

خلال إقامتي في أكاديميّة الثقافة التي يقيمها معهد غوته في برلين، تكوّنت ملامح هذه الأنطولوجيا. الآن تكتمل، لكنّها زائغة. زائغة مثل برلين؛ تلك المدينة التي أودى بها زمانها ومكانها إلى أن تكون مدنًا كثيرة في الوقت نفسه، أن تكون أزمنة كثيرة في الجغرافيا نفسها. زائغة مثل كلمة "هويّة" في القرن الواحد والعشرين، وهي الكلمة التي لوّحت بها لأدعو ثمانية شعراء وشاعرات من فلسطين وألمانيا للكتابة حولها. وعلى الرغم من ارتباطها الواعي وغير الواعي، لديّ، بالتجربة السياسيّة بعامّة، وتلك الفلسطينيّة بخاصّة، إلّا أنّي لم أعد أراها إلّا زائغة، ومرنة، ومفتوحة على التعدّد، كما لم أُرد لثيمة هذه الأنطولوجيا أن تكون غير ذلك، أن تكون واضحة وتشير بأصابعها إلى منابت شعرائها وخلفيّاتهم. هذه الكلمة، التي ارتبطت بحبل سرّة كتلة بشريّة متلاحمة اسمها الشعب، نجدها الآن وقد أصبحت ميناءً، يرخي وثاق هذا الحبل عن بوّابات القلعة المحصّنة التي أغلقت الجمعيّ على نفسه وتركت الأفراد خارج البوّابات. تنطبق هذه الصّورة على التاريخ والعرق والجغرافيا، والشعر.
ثمانية شعراء يقلبون الحجارة التي وضعتها أدمغتهم، قلوبهم، سفرهم، مدنهم المدمّرة أو العامرة، عشّاقهم وعشيقاتهم، لعنتهم على العالم، تفاؤلهم، عدميّتهم... انحزت لهم بسبب شعرهم لا العكس،
أنحاز الآن لهذه الفوضى الخلّابة التي تحدثها هويّاتهم الشخصيّة والعاطفيّة والسيّاسيّة والوجوديّة، والشعريّة أيضًا.
إنّه زوغان يثير متعة ما، حين لن يجد القارئ أنطولوجيا "عن الهويّة"، حين سيقرأ هذا التنوّع في مضمون النصوص، بعضها عقلانيّ وتفكيكيّ، بعضها دمويّ، غاضب، وبعضها متأمّل ورهيف وهشّ. ويصطدم بهذا التعدّد الأسلوبيّ اللافت، مرّة في نصوص عالية النثريّة، مرّة في موسيقى صادحة، واحد ينتصر للّفظة، آخر للمشهد، وآخر للاستعارة. ولعلّ هذه الأنطولوجيا، كونها طمعت بنعمة الترجمة لتكون ثنائيّة اللغة، تضع مدماكًا صغيرًا في بيت وسيع اسمه الشعر، في شارع بعيد الأطراف اسمه العالم، في عالم رحب اسمه الفرد. أنتم. فاقلبوا هذه الصفحة، التي لن يكون عنوان الكتاب بعدها صالحًا!
.....
الشعر واقعًا، الشعر حلمًا | أمجد ناصر
I

قرأت أجزاء من "الديوان الشرقيّ للمؤلّف الغربيّ" لغوته، ترجمة الموسوعيّ المصريّ عبد الرحمن بدوي، الذي تصدّى لنقل آثار عالميّة من لغاتها الأصليّة إلى العربيّة. في زمن غوته كان ما يشبه الهوس بالشرق، وكانت الإمبراطوريّات الغربيّة (الفرنسيّة والبريطانيّة تحديدًا) تحوّل الشرق إلى أرض لممارسة القوّة والنهب، وإن لم يكن قد بزغ، بعد، عهدهما الإمبرياليّ بصفته "أعلى مراحل الرأسماليّة".
لكنّ اهتمام غوته بالآثار الأدبيّة الشرقيّة (هنديّة، وفارسيّة، وعربيّة) لم يصدر من الارتباط بما نسمّيه "الاستشراق"، الذي سفّهه إدوارد سعيد إلى حدّ أنّه لم يتمكّن من استعادة اعتباره قطّ. يمكن فهم اهتمام غوته بالشرق انطلاقًا ممّا أشاعته الرومانسيّة من مفاهيم "روحيّة"، وخلق نوع من "العالميّة" القائمة على مُثُل مضادّة لضجيج العصر الصناعيّ. هل كان غوته يهرب من استحقاقات زمانه الدمويّة التي أثارتها النزعة الإمبراطوريّة النابوليونيّة في غزواتها الأوروبيّة؟
هو يؤكّد على أنّ الاهتمام بـ "الشرق" يساوي عنده: الهروب من الواقع الأوروبيّ. كأنّ الواقع أوروبّا، المتقاتلة، بينما "الشرق" الحلم المأمول، ودائمًا، عبر الإبداع الأدبيّ بعامّة، والشعر قلبه النابض. لكنّ غوته يحلم، في الوقت نفسه، بأدب عالميّ يتجاوز الهويّة التي ترسيها الهويّات القوميّة، وبالتأكيد ضدّ الهويّة القائمة على الدين. كان غوته أوروبيًّا قبل بروز هذه الهويّة، وهذا قد يفسّر لنا إعجابه بنابليون. لكنّه، بعدما أحدثته النابوليونيّة من دم ودمار في أوروبّا، صار يرغب بأن يكون خارج هذه القيود الضيّقة، ولا شيء يمكن أن يطلق جناحي روحه الحبيسة إلّا الشعر، إلّا الإبداع الأدبيّ، فهو قادر على تخطّي الحواجز "الهويّاتيّة" ومعانقة المشترك الإنسانيّ.
هذا كلام يعرفه الألمان، قرّاء هذه الأنطولوجيا، وقد لا يعرفه كثير من القرّاء العرب. واختياري الشاعر العظيم غوته لأبدأ به مقدّمة هذا الكتاب، ليس لأنّه ألمانيّ، فلو كانت هذه المختارات ستصدر بلغة أخرى، حتّى لو كانت على تماسّ عنيف مع "الشرق"، كالإنجليزيّة والفرنسيّة، لما وجدت أفضل من غوته مثالًا غربيًّا على الجسر الإنسانيّ الذي يربط بين "الشرق" و"الغرب"، ويعبر الهوّة التي عملت الأيديولوجيّات المؤمنة بأزليّة الصراع، بين ضفّتي المتوسّط، على تعميقها وملئها بالأشباح.
II
لا ينشغل الشعر الفلسطينيّ (ولا الألمانيّ على الأغلب) بـ "أحلام عالميّة"؛ فالشعر ما بعد الأيديولوجيا (وهي عالميّة بمعنًى ما من المعاني) ارتدّ إلى النقطة التي ينبت منها: الفرد، وربّما، أيضًا: وجوده في زمان ومكان متناهي المحدوديّة. وأيّ "عالميّة" قد ينطوي عليها هذا النتاج تكمن، فقط، في "جوهر" الشعر.

لأسباب شخصيّة ومهنيّة أتابع المشهد الشعريّ العربيّ نحو أربعة عقود، منها عقدان، على الأقلّ، في منبر صحافيّ يوميّ لم يكن يملّ من متابعة الشعر ونشره، ولا سيّما الجديد منه، أو لأقل بدقّة أكثر: ما ينتجه الجيل الجديد، إذ ليس كلّ ما تسطّره الأقلام الشابّة جديدًا بالمعنى الإبداعيّ للكلمة.
III
من بين الشعريّات العربيّة التي تابعت كتابتها، عن كثب، الشعريّة الفلسطينيّة، التي قدّمت، في نصف القرن الماضي، عددًا من أبرز أصوات الشعر العربيّ الحديث، حتّى كادت المدوّنة الشعريّة الفلسطينيّة أن تطغى على أيّ مدوّنة أدبيّة فلسطينيّة أخرى، الرواية والقصّة مثلًا. ولهذا الأمر (كثرة الشعر على ما عداه) أسباب تكشف عن ارتباط القصيدة بـ "القضايا" بعامّة (والفلسطينيّة بخاصّة) خلال عقدي الخمسينات والستّينات، وصولًا إلى السبعينات، أي في الفترة التي يمكن أن توصف بـ "الذهبيّة" في الشعر الفلسطينيّ. غير أنّ الأمر لم يكن كذلك في عقدي الثمانينات والتسعينات، حيث تراجع، في رأيي، حضور الشعر الفلسطينيّ في المشهد الشعريّ العربيّ. بقيت أسماؤه الكبيرة حاضرة، بطبيعة الحال، لكنّه لم يعد يتوافر على اقتراحات جماليّة جديدة، ولا على "قوّة دفع" داخليّة أو خارجيّة، وتحوّل إلى ما يشبه النمط الذي يقولب الإبداع في خانات لا يغامر بالخروج منها.
IV
قيّض لي، على امتداد العقد الماضي، أن أكون مُحكِّما مرّتين في جائزة للشعر الفلسطينيّ، الأمر الذي مكّنني من الوقوف على سطح المشهد الشعريّ الفلسطينيّ وأعماقه، من خلال المجموعات الشعريّة المتسابقة التي وصلت إلى هيئة الجائزة، هذا فضلًا عن عملي محرّرًا أدبيًّا على مدار ثلاثة عقود.
يمكن القول إنّ "المرحلة الذهبيّة" للشعر الفلسطينيّ انتهت بعد خروج منظّمة التحرير الفلسطينيّ من بيروت عام 1982. بعدها سيبدأ الشعر الفلسطينيّ، تدريجيًّا، في الانكفاء على الذات الجريحة بصوت خافت غادر، نهائيًّا "النبرة البطوليّة" العالية التي أزعم أنّها نمّطت "الشعر الفلسطينيّ" وحبسته في تصوّر "تقليديّ" لعلاقة القصيدة بـ الوطن، والقضيّة، وهما، هنا، فلسطين تاريخًا وواقعًا وحلمًا. لقد استقرّ، في الذائقة الفلسطينيّة والعربيّة، "نمط" شعريّ يكاد يكون خاصًّا بالقضيّة الفلسطينيّة، حتّى صار بالوسع، أمام استفحال هذا النمط وتمكّنه، استعارة قولة محمود درويش الشهيرة (معكوسةً هذه المرّة): أنقذونا من هذا الشعر!
ولا يمكن، بالطبع، فصل القصيدة الفلسطينيّة عن القصيدة العربيّة من حيث ما تعرفه من "هموم" تطال الموضوع والشكل، ولعلّ استجابة القصيدة الفلسطينيّة (بل مبادرتها في بعض الأحيان) لتبنّي أشكال تجريبيّة، خير دليل على تراجع القصيدة – النمط لصالح القصيدة التي تخوض في شؤون الحياة اليوميّة، بما هي عليه من استحقاقات تتعلّق بقضيّة الوطن أو بالحياة الفرديّة، بلا شعارات موجّهة أو أيديولوجيا مسبقة. لقد صارت الحياة اليوميّة، ووجود الفرد فيها، على خلفيّة خافتة للجرح الوطنيّ، مختبر القصيدة الفلسطينيّة الجديدة، كما هي الحال في ما يخصّ نظيرتها على الصعيد العربيّ، وهذا لا يعني، بالتأكيد، قطيعة بين القصيدة الجديدة والقضايا الكبرى (بما فيها قضيّة الوطن والاحتلال)، بل يحدوني الاعتقاد أنّ ثمّة مقاربة أخرى (بمعجم ورؤى مختلفة) للصراعات الأساسيّة التي يعيشها مواطنون يحاصرهم الاحتلال من كلّ جانب.
V
جيّد أن تتقابل نماذج من الشعر الفلسطينيّ، الذي يكتبه الجيل الأجدّ، اليوم، مع الشعر الألمانيّ. لا تمثيل وطنيًّا هنا بالطبع، فلن يعزف النشيدان الوطنيّان الفلسطينيّ والألمانيّ في مدخل هذه الأنطولوجيا، لأنّ لا تمثيل تدّعيه هذه القصائد، مهما بدت درجة تقاربها لغةً، وجيلًا، وهمومًا، وأمكنة. فهذا التمثيل لم يكن موجودًا في الشعر الألمانيّ (إلّا ربّما في فترات الصراعات الكبرى وتهديد الحروب مصير الأفراد والشعوب)، ولا هو موجود في الشعر الفلسطينيّ الآن. هذا شعر أصوات فرديّة. لا تدّعي النهوض بعبء "وطنيّ"، ولا حتّى جماليّ. فهذا ادّعاء باهظ لا يستطيعه بشر ما بعد كلّ شيء: الحداثة، والتكنولوجيا، والقوميّات، وما شابه. ومن يرغب في "فهم" القضيّة الفلسطينيّة من هذه الأصوات الشعريّة (وربّما غيرها أيضًا) سيصاب بخيبة أمل؛ فالشعر الفلسطينيّ، اليوم، لم يعد صالحًا لأن يكون "خريطة طريق" سياسيّة. الشعر أقرب إلى السير في "حديقة" متشعّبة، وفق اقتباس لأحد عناوين قصص بورخيس الفذّة. طرق متشعّبة صحيحة، لكنّها تدّل، بخفوت، وأحيانًا بصمت، على هسيس الجرح. حتّى عدم ذكر الجرح قد يكون تأكيدًا عليه. حتّى الهروب من "القضيّة" قد يشير إليها بنحو أو بآخر. فلم تبرح الذات الفلسطينيّة تحت الاحتلال الإسرائيليّ، في المخيّمات، في "الدياسبورا"، عابرة الكون، أرض الجرح. قد يكون هذا الجرح مكشوفًا، ينزف، حينًا، وقد يتوارى تحت الجلد حينًا آخر، غير أنّه لا يزول... إلّا بزوال أسبابه.
ما هو مهمّ في هذا التقابل الشعريّ/ شرق/ غرب/ ما بعد الاستشراق، أنّه يتمحور حول الشعر الذي عَدّ العرب سطره "بيتًا". بهذا انفردت العربيّة في إعطاء السطر الشعريّ مرتبة المكان الذي يأوي إليه الإنسان، وتحلم به "الذات الجمعيّة" الفلسطينيّة التي طوّقت عنقها برمز المفتاح؛ فإذا كان البيت في اللغة سطرنا الشعريّ (لم يعد كذلك الآن مع قصيدة النثر!)، فإنّه في الواقع مقرون بالفلسطينيّ الذي تحوّل من صاحب بيت إلى مترحّل (كبدويّ في عصر الحدود وجوازات السفر) عابر للبيوت، عابر للبيوت، عابر للبيوت.
في مدخل كلّ شاعر يمثّل نفسه فقط، على أبعد تقدير...
.....
مقدّمة | إبراهيم مرازقة

يقول محمود درويش عن تجربة الشاعر في آخر قصيدة كتبها، "لاعب النرد":
مَنْ أَنا لأقول لكم ما أقول لكم؟
وأنا لم أكن حجرًا صقلته المياه
فأصبح وجهًا
ولا قصبًا ثقبته الرياح
فأصبح نايًا...
هذه الأبيات لا تتحدّث، فقط، عن إشكاليّة محمود درويش، الفرد الذي ينتفض ضدّ التصوّر النمطيّ له شاعرًا، وأيقونةً، وشاعرًا وطنيًّا، بل إنّها تخاطب، كذلك، إحدى الإشكاليّات الجذريّة في الشعر الحداثيّ، أو مكانة الشاعر في الحداثة. فهيئة الشاعر لا تتكوّن من خلال الشروط الموضوعيّة (للجغرافيا، والمناخ، والطبيعة التي تحيط به) والتاريخيّة الحضاريّة للجماعة اللغويّة، أو الجماعة السياسيّة التي ينتمي إليها؛ فهو ليس الناي للّحن أو الوزن الجماعيّ، وشعره ليس وجهًا أو هويّة تموضعا أمام الجماعة لكي تدرك ذاتها، والشاعر لم يعد الوسيلة أو المتوسّط لإدراك الذات الجماعيّة. السؤال، إذًا، من أيّ مكانة وموقع في الجماعة يلقي الشاعر شعره؟ وما هي وظيفة الشعر حين يتحوّل "وجه" الشاعر إلى صورة فرد بدلًا من الهويّة الجمعيّة للجماعة التي ينتمي إليها؟
تشكّل قصيدة عامر بدران، بشكل أو بآخر، لغة استمراريّة لهذه التساؤلات، حين يستعير الحجر للتأمّل في لغة الشاعر (بدلًا من كيانه ومكانته)، فهو يقول:
لغتي حجرٌ مهمل
لم تنطحه المطرقة ولم يركله الإزميل
لم يقلبه فضول البنّائين، ولا سكك الحرّاثين.
لغتي حجرٌ لم يُقلبْ
مثلما انكسر الترابط العضويّ بين الشاعر والجماعة، ومثلما انفصل وجه الشاعر الفرد عن وجهه كهويّة الجماعة عند درويش، فإنّ لغة الشعر انفصلت عن اللغة اليوميّة وهمومها عند بدران؛ فهي حجر يُصقل بالشعر فقط، حجر يوظّفه الشاعر، بينما يكمن ارتكاز اللغة اليوميّة على ما يفيد المعنى، والمعنى يُستفاد منه بالاستعمال اليوميّ للألفاظ. فالبنّاء لا يعير هذا الحجر اهتمامًا ("فضول البنّائين")، مثلما لا تكترث الحياة اليوميّة للغة الشعر. والحرّاث لا يدخل، في الأساس، الأرض التي تُرك فيها هذا الحجر وحيدًا، فالحرّاث والبنّاء يكترثان لما يُعرّف من خلال المنفعة (مثل الأدوات؛ الإزميل والسكّة)، وإن كان في الشعر منفعة، لكنّ هيئة وجوده لا تتطابق مع المنفعيّة.
اللغة الشّعريّة
لقد علّم يوهان فولفغانغ فون غوته شيئًا من هذا، وهو الذي كتب في "الديوان الشرقيّ للمؤلّف الغربيّ": "فمن حوسب على ثلاثة آلاف عام ولم يأتِ بحسابها، فسيبقى جاهلًا في الظلمات، وإن عاش من يوم إلى يوم".[1] وقد كتب في موضع آخر:
"يمكننا التدبّر في الحياة العاديّة مع اللغة بشكل مشروط ومؤقّت، لأنّنا نتعامل فيها مع علاقات وأحوال سطحيّة. لكن في اللحظة التي نبدأ فيها بالتعامل مع أحوال ضاربة بالعمق، فتظهر حينها لغة أخرى، ألا وهي اللغة الشعريّة".[2]
إذًا، إن كانت اللغة الشعريّة تختلف جذريًّا عن اليوميّة، والعلاقات التي تُعنى بها لا تتطابق مع هموم الحياة اليوميّة، ولا تستشفّ معانيها من الاستعمال والمنفعة، فمن أيّ مصدر تستشفّ معانيها؟ وما هي الأحوال والعلاقات التي نتحدّث عنها في هذا السياق؟ أودّ الإجابة عن هذه الأسئلة ليس بعامّة، لكن في سياق هذه المجموعة الشعريّة، وعبر النصوص الشعريّة المجمّعة فيها. لعلّ الإجابة عنها تكون مدخلًا إلى المسلك الرئيس الذي تجتمع حوله، فإنّ هذه القصائد تترتّب حول هذا المسلك وتتشعّب منه، وهو شكل من الوحدة والترتيب قد ظنّ غوته أنّه سمة من سمات الشعر الشرقيّ. فإنّه يقول في ملاحظات ومقالات لفهم أفضل "للديوان الغربيّ – شرقيّ":
السمة الأرقى لفنّ الشعر الشرقيّ، وهو ما ندعوه، نحن الألمان، الروح [Geist]، وهو وجود موجّه أعلى؛ ففيه تجتمع وتتّحد كلّ الصفات الأخرى، دون أن تتقدّم إحداها على الأخرى بالظهور. فكلّ الأشياء حاضرة في قريحة الشعراء [الشرقيّين، أ.م.]، وهم يبرعون في ربطها ببعضها بكلّ سلاسة.[3]
ثمّ يمثّل على هذا المبدأ بمثال من الشعر الألمانيّ ليشرح قصده، فيمدح الشاعر الألمانيّ المعاصر له، شون بول ( 1763-1825)، كونه أقرب من كتب الشعر الألمانيّ بحسب هذا الأسلوب وبهذه الطريقة، ويعدّه استثناءً خاصًّا.
ينظر [شون بول، أ.م.] من خلال روحه الموهوبة، بصورة شرقيّة أصيلة، إلى العالم من حوله بكلّ شجاعة ويقظة، فيخلق العلاقات الأغرب [بين الأشياء]؛ يربط بين ما لا يجتمع، لكنّه يفعل ذلك بصورة تُنْشِئ مسلكًا سرّيًّا وخلقيًّا، يوجّه كلّ الأشياء لتكوّن وحدة واحدة مترابطة.[4]
بالنقيض لحالة شون بول، فإنّ الوحدة التي نشأت في هذه المجموعة ليست تعبيرًا عن روح أو طبيعة شاعر معيّن، لكنّها وحدة تتكوّن من خلال الاطّلاع والتأمّل في ما بعد فعل الفعل، أي أنّها تنشأ كما تنشأ المعرفة المدركة للفعل بعد وقوعه. إذًا، ما هو هذا المسلك الذي يجمع بين الصفات والنواحي والاعتبارات المختلفة في هذه المجموعة؟
القصيدة والتاريخ
لاحظت من خلال القراءة الممعنة لهذه النصوص - وهي قراءة بعيون المترجم - أنّ تدخّل التاريخ واللحظة التاريخيّة الراهنة في الشعر والقصيدة من جهة، وفي حياة الأفراد والشعراء أفرادًا من جهة أخرى، يشكّل ذلك المسلك الرئيس؛ تتشعّب منه مسالك كثيرة فتتعدّد في القصائد الأوصاف، والأبحاث، والتصوّرات، والمشاهد، والروايات، والأساليب حول هذه الإشكالية، لكنّها تشكّل "همًّا" مركزيًّا في جميعها. وبما أنّ الفاعل الرئيسيّ (أو الفُعلاء الرئيسيّين) على خشبة التاريخ كانت وما زالت الجماعات (السياسيّة أو الحضاريّة) المنظّمة، وإن كانت خاضعة باستمرار إلى حالات التشكّل والتحوّل، فإنّ الهويّات الجماعيّة عبارة عن المتوسّط الذي يصل الفرد بحركة التاريخ. لهذا، فإنّه من المنطقيّ أن يظهر التاريخ واللحظة التاريخيّة الراهنة وتدخّلهما في مجالات الشعر والحياة، حينما نسأل ونتساءل عن الهويّة أو الهويّات المتعدّدة.
يدخل ويتدخّل التاريخ في نصوص الشعراء على نحو مختلف. وسأستعرض فيما يلي، باقتضاب شديد، هذه الصور المختلفة. هذا الاستعراض، بطبيعة الحال، لا يدّعي استيفاء نقاش تفاصيل النصوص كلّها، فهي غنيّة بالكثير الذي لا يمكن التطرّق إليه في هذه المقدّمة.
"قراءات" عامر بدران في أرشيف الهويّة الثقافيّة للمنطقة، تكشف المصدر الذي تستشفّ منه اللغة الشعريّة معانيها، بل إنّ التاريخ، بما يحمله من نصوص مكتوبة ومنقولة عنه، من شروط الشعر. تفشل محاولة الأنا الشعريّة في هذه القصيدة، في اكتشاف أو مَوْضَعَةِ ذاتها ضمن هذه الهويّة الثقافيّة، لكي تُحصِّل، بالنتيجة، فردانيّتها. ما يتبقّى من هذه المحاولة كذلك، التأمّل واستعراض الشرطيّة التاريخيّة للشعر.
"اسمي الثلاثيّ" لجمانة مصطفى يشير إلى ثلاثة أجيال فلسطينيّة تتعامل مع تدخّل التاريخ الجماعيّ في تاريخها العائليّ. هذا النصّ الذي يلي قصيدتها "القدريّة"، يوحي إلى أنّ تاريخ هذه العائلة يشبه القدر الذي لم يكن مفرّ منه ولا دافع له؛ فالنبرة التي تستعرض بها التاريخ العائليّ نبرة غير بطوليّة، بعيدة عن الاستعراضيّة، ولا توحي بالتضحية. بل على العكس، إنّ هذه القصيدة تسعى إلى نبش وتفكيك الأسطورة الوطنيّة حول الإنسان، والأرض، والعلاقة الدمويّة بينهما، لتكون هذه العلاقة سببًا في المأساة وبابًا للسؤال عن الذنب والمسؤوليّة.
لا يروي غياث المدهون في "الحليب الأسود" التاريخ (شعرًا، كما حذّر درويش)، ولا ينقله كما لدى جمانة مصطفى؛ فالتاريخ يتدخّل بصورة جسديّة عنيفة لتجزئة الجسد. والجسد الذي بترته الحرب السوريّة في غرفة الإنعاش، يحاول تجميع شذراته من موادّ عضويّة وشعريّة، ونتاجها صرخة خافته تلعن عالمًا لم يتعب من تحويل حليبه إلى سمّ.
تعثر أوليانا ڤولف في نصوصها المأخوذة من مجموعتها الشعريّة "على طريق بابل"، على لغة كونيّة تتجسّد في الأصوات التي يصدرها الرضّع، والتي سرعان ما ينسونها عند تعلّم لغتهم الأمّ. نسمع في الخلفيّة التباسًا وبلبلة لغويّين يصدران من فنّانة ثنائيّة اللغة، فتختلط الألمانيّة والإنجليزيّة لتكوين ألفاظ وجمل ذات طابع فردانيّ. أمّا في وادي التاريخ السحيق، فيرتدّ صدى التباس لغويّ آخر؛ فقد شخّص الشاعر والمسرحيّ العظيم، هاينر مولر، هذه التراوما الأوّليّة للحضارة الغربيّة، عندما قال منطلقًا من التحليل الفلسفيّ لهذه الحضارة، الذي عبّر عنه تيئدور أدورنو، وماكس هوركهايمر، بمفهوم ديالكتيك التنوير:[5]
"كان هدف التنوير بناء برج بابل جديد لتوحيد كلّ اللغات تحت لغة العقلانيّة، وهو بمثابة كبت اللغات الأخرى، لأنّ الالتباس اللغويّ وعدم وجود لغة جامعة للقارّة الأوروبيّة وشعوبها، هو بحكم التراوما البدائيّة لهذه الحضارة".[6]
ڤولف تعود إلى طريق بابل لتقترح بناءه من جديد، ليس على أساس العقلانيّة، إنّما الالتباس اللغويّ ذاته.
يسود الالتباس اللغويّ في نصوص سيّا رينه كذلك، وهي تسير على خطى المخرج الروسيّ أندريه تاركوڤسكي، لتجتهد في تقديم تخيّل وتصوّر لحياة بشريّة تتماشى مع نظام الكون. تكتب شعرها بعدّة لغات، وبذلك تشكّل حالة تعكس سيرتها الذاتيّة، وهويّة أوروبيّة ما زالت قيد التطوّر، لا تتحمّل التحدّث والتواصل بلغة واحدة فقط، فتنتقل من تفكيك اسمها إلى تأمّلات حول اللغة والزمكان، إلى أن تصل إلى تاركوڤسكي، لتكوّن ذاتًا جديدة، واسمًا جديدًا لهذه الذات.
يظهر الحاضر ولحظته التاريخيّة في قصائد نورا بوسونغ وداليا طه، أكثر من غيرها من النصوص، وهي اللحظة التاريخيّة ذاتها التي شخّصها هاينر مولر وتنبّأ بتطوّرها. وقد رأى أنّ طبيعة هذه التطوّرات هي ما يحرّك ملايين البشر، فعندما سُئل قبل عقدين عن مستقبل عالم تديره البيروقراطيّة على نحو شموليّ، أجاب قائلًا:
هذه التحليلات هي الوجه المتشائم للأمل في أن تبقى القلعة أوروبّا صامدة. لكن هذه التحليلات لا تعدّ العالم الثالث قوّة يحتسب لها. هذا العالم الذي نعيش على حسابه لن يقف مكتوف الأيدي إلى الأبد، مشاهدًا استغلالنا له. وهذا العالم لا يحتاج إلى القوّة العسكريّة الاقتصاديّة. كلّ ما في الأمر أن يبدأ ملايين البؤساء بالتحرّك.[7]
يلتقي في نصوص نورا بوسونغ عالم البيروقراطيّة الإداريّة المتعب والمكلّف بواجبات تفوق طاقاته، بكتل بشريّة لا تراها العيون الأوروبيّة إلّا كتلًا جسديّة: قطعان ماعز أو حشرات. تنقص اللغة والاستعارة المناسبتان لاستيعابهم، فتطغى الحيوانيّة على المشهد: تلتهم قطعان من الماعز ملفّات البيروقراطيّين؛ يوقف ملّاحون الحشرات ليفتّشوها قبل وصول قوى مكافحة الحشرات؛ وتُختزل اللغة في مسامع الأوروبيّين لتصبح أزيز حشرات. يخرج من الساحل المقابل للمتوسّط الكثير من الغضب، والقليل من الأمل، من خلال قصيدة دالية طه: كولاج انطباعيّ من شذرات شعريّة لمشهد حاضرنا الـمُعَوْلَم.
[1]. انظر: Johann Wolfgang von Goethe. „West-östlicher Divan.“ Divan-Jahre 1814-1819, hrsg. Karl Richter et al., Münchner Ausgabe, Bd. 11.1.2, München: Hanser, 1998, S. 54.
[2]. انظر: Ders.: „Symbolik.“ Naturwissenschaftliche Schriften. Weimarer Ausgabe, Abt. II, Bd. 11. Weimar: Herman Böhlaus 1893. S. 167f
[3]. انظر: Johann Wolfgang von Goethe. „Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des west-östlichen Divans.“ Divan-Jahre 1814–1819. Hrsg. Karl Richter. Münchner Ausgabe, Bd. 11.1.2. München: Hanser 1998، ص 170.
[4]. المصدر نفسه، ص 190.
[5]. انظر: Theodor Adorno und Max Horkheimer. Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2007.
[6] انظر Heiner Müller und Frank Raddatz: „Die Reflexion ist am Ende, die Zukunft gehört der Kunst.“ Gespräche 3. Hrsg. Frank Hörnigk. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2008. S. 14.
[7]المصدر نفسه، ص 12.