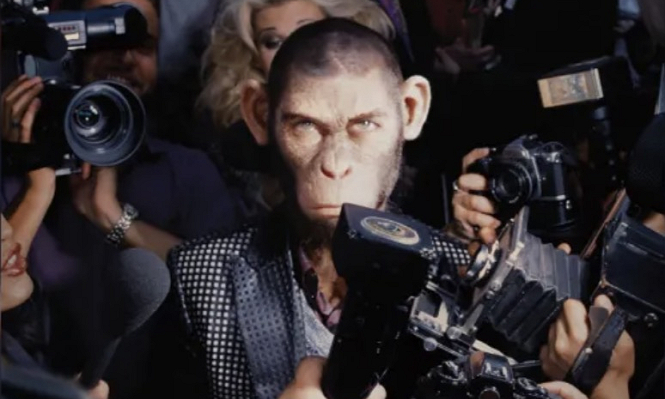الصراع في ضوء الهبّة: الرواية والزمن والتدويل

رافقت الذكرى الـ 73 للنكبة احتجاجات انطلقت من حيّ الشيخ جرّاح والمسجد الأقصى، ليتبعها اشتباك عسكريّ بين «حَماس» والاحتلال الإسرائيليّ لمدّة 11 يومًا. أظهرت هذه الاحتجاجات حيويّة شعبنا وقدرته على الصمود والمواجهة.
بالنسبة إلى احتجاجات الشيخ جرّاح، فهي احتجاجات ضدّ طرد الفلسطينيّين مجدّدًا من بيوتهم وديارهم. حتّى لو كانت هذه البيوت «ملكيّة يهوديّة» اشتُريت في القرن التاسع عشر كما يُدّعى إسرائيليًّا، فقد اعتبرت بعد عام 1948 أنّها أملاك عدوّ على يد دولة الأردنّ، الّتي في اتّفاق مع «الأونروا» (1956) منحت هذه البيوت للاجئين فلسطينيّين، خسروا بيوتهم في غرب القدس أو في يافا أو حيفا. بعد 1967 واحتلال القدس على يد إسرائيل، خضعت القدس مثلها مثل جميع الأراضي الفلسطينيّة والعربيّة المحتلّة للقانون الدوليّ الإنسانيّ، الّذي يدعم عدم التصرّف بهذه الأملاك، وإعادتها إلى أصحابها ما دام الاحتلال مستمرًّا، وما دام لا يوجد هناك أيّ اتّفاقيّة سلام تُنْهي الاحتلال.
حتّى لو كانت هذه البيوت «ملكيّة يهوديّة» اشتُريت في القرن التاسع عشر كما يُدّعى إسرائيليًّا، فقد اعتبرت بعد عام 1948 أنّها أملاك عدوّ على يد دولة الأردنّ...
تتجاوز الاحتجاجات مسألة الأملاك واحترام القانون الدوليّ الإنسانيّ، إلى ما يحمله قرار الطرد من مساس بحقوق الإنسان الفلسطينيّ، الّذي يتعرّض للتمييز السلبيّ والعنصريّ، في حالة إعادة أملاك يهوديّة دون أن يكون في المقابل إعادة لأملاك اللاجئين الفلسطينيّين، في غرب القدس ويافا وحيفا.
في رأيي، تشير احتجاجات الشيخ جرّاح، وبقوّة، إلى أنّ الرواية في ما يخصّ الصراع هي رواية المصادرة والسيطرة، كما أنّها تأتي في ظروف يمكن فهمها من خلال التمييز بين الزمن المحلّيّ والعربيّ والزمن العالميّ للحركات الاجتماعيّة. أخيرًا، أرى من الضروريّ العمل على تدويل الصراع؛ إذ أصبحت الدولة مصدر تهديد لمواطنيها من فلسطينيّي أراضي 48.
رواية المصادرة والسيطرة
بالطبع، تدفع الاحتجاجات في المسجد الأقصى، وكذلك المواجهة بين «حَماس» وإسرائيل لمدّة 11 يومًا، إلى اعتبار أنّ الصراع كأنّه صراع دينيّ أيديولوجيّ. دون تخفيف من أهمّيّة الدين في التعبئة والحشد، إلّا أنّ الصراع في جوهره صراع على الأرض، وحتّى على كلّ بيت وبيت. هذا ما يجري في القدس، لكن أيضًا في مدن أخرى مثل اللدّ ويافا، الّتي توصف إسرائيليًّا بـ «المختلطة». إنّ احتجاجات الشيخ جرّاح تعيدنا إلى حقيقة أنّ الصراع بالأساس صراع استعماريّ استيطانيّ؛ هدفه مصادرة الأراضي والسيطرة على الموارد والأملاك.
إذن، ليس بالغريب أن يعود بعض المراقبين بنا إلى أحداث سابقة، مثل أوّل أيّار (مايو) 1921 في يافا، حين اعتبر شعبنا أنّه مستهدف في أرضه ووطنه، من خلال «وعد بلفور»، وإدماجه في صكّ الانتداب. لكن أيضًا للإشارة إلى أنّ الاحتجاجات الأخيرة تميّزت بأنّها انفجرت في جبهات: القدس وأراضي 48 والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. إنّ مبادرة «حَماس» للاشتباك مع الاحتلال لم تكن نقطة البداية، كما أنّ انتهاء الاشتباك العسكريّ لم يُنْهِ استمراريّة الاعتقالات والمداهمات، في القدس والضفّة وأراضي 48. لقد وحّدت هذه الاحتجاجات، الّتي انطلقت من الشيخ جرّاح، الصفّ الفلسطينيّ، وأسقطت تقسيمات الاحتلال الّتي تستخدم اليوم ذات الأدوات القانونيّة والقمعيّة: إدخال قوّات من الشرطة ومن حرس الحدود إلى «المدن المختلطة» وفق الوصف الإسرائيليّ، وحتّى إعلان حالة الطوارئ في مدينة اللدّ، وممارسة الاعتقال الإداريّ ضدّ المقدسيّين وضدّ فلسطينيّي أراضي 48 الّذين هم مواطنو الدولة. ما يحصل هو استخدام العنف المفرط، الّذي في هدفه الأوّل والأخير إخماد المطالبة بالحقوق وبالكرامة من قِبَل الفلسطينيّين وإلغائها.
زمن الاحتجاجات محلّيًّا وعربيًّا وعالميًّا
من جهة، تأتي هذه الاحتجاجات في زمن محلّيّ مخيّب للآمال؛ بمعنى انسداد المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، وتحديدًا في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، وبمعنى قرارات من قِبَل القيادة لا تُظْهِر أيّ احترام للمؤسّسات الفلسطينيّة. فإلغاء الانتخابات مثلًا يصبّ في نهاية المطاف بما طلبه رئيس «الشاباك» الإسرائيليّ من الرئيس محمود عبّاس، وليس بما جاء في قرار «المحكمة الدستوريّة الفلسطينيّة»، بضرورة عقد انتخابات تشريعيّة خلال ستّة أشهر من القرار، الّذي اتّخذته في ما يخصّ حلّ «المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ». كما أنّه في أراضي 48، أصبحت شرعيّة الأحزاب العربيّة لا تستند على مشاركتها في الانتخابات، بل على موقف اليمين الإسرائيليّ منها. لقد ارتبطت أزمة النظام الإسرائيليّ الداخليّ بعدم جهوزيّة النخبة الإسرائيليّة والمجتمع الإسرائيليّ، تجاه أن يكون للأحزاب العربيّة أيّ تأثير في القرار الجماعيّ.
في ما يخصّ الزمن العربيّ، فقد أتت هذه الاحتجاجات في محيط تسود فيه موجة اللادمقرطة، والثورة المضادّة بعد موجة الدمقرطة الّتي مثّلتها أحداث الربيع العربيّ.
في ما يخصّ الزمن العربيّ، فقد أتت هذه الاحتجاجات في محيط تسود فيه موجة اللادمقرطة، والثورة المضادّة بعد موجة الدمقرطة الّتي مثّلتها أحداث الربيع العربيّ. ولا شكّ في أنّ خطاب الإدارة الأميركيّة الجديدة حول «عودة الغرب»، بمعنى خطاب الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أحرج مجموعة من الدول العربيّة المؤثّرة في القرار الإقليميّ.
من جهة أخرى، تلتحق هذه الاحتجاجات بزمن عالميّ طرحته الاحتجاجات ضدّ العنصريّة، الّتي اجتاحت مدن العالم، وتحديدًا الأميركيّة والأوروبّيّة، بعد القتل خارج القانون لفلويد جورج على يد شرطة مدينة مينيابوليس. إنّ القضيّة الفلسطينيّة الّتي وصفها المقرّر السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، والفقيه الجنوب أفريقيّ John Dugard، بأنّها حالة احتلال واستعمار وأبارتهايد، لا يمكن إلّا أن تكون قضيّة كلّ مناضل ضدّ العنصريّة، ومن أجل العدالة في النظام الدوليّ. وكأنّنا نتحدّث عن ذات القمع والاستبداد النتن وذات العنصريّة. هذا ما يشير إليه بيرني ساندرز، صوت تقدّميّ بارز في الحزب الديمقراطيّ، عندما يتحدّث عن Palestinien Rights Matter على غرار Black Lives Matter في مقالته في «نيويورك تايمز». ثمّة تغيّر في موقف الرأي العامّ الأمريكيّ تجاه القضيّة الفلسطينيّة، لا يمكن فهمه دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيّر الّذي أحدثته الاحتجاجات ضدّ العنصريّة.
تدويل الصراع
ربّما أبرزت الأحداث الأخيرة واقع الدولة الواحدة، لكن في الوضع الفلسطينيّ أرى أنّه من الصعب التخلّي عن رمزيّة الدولة وعن ضرورتها (الدولة ليست سلطة وأجهزة أمنيّة، الدولة أُنْشِئت على الأرض الأوروبّيّة في القرن السادس عشر؛ لتكوّن سيادة وحقوقًا أو مؤسّسات مستقلّة تحمي هذه الحقوق).
ربّما بعد عمليّة سلام حقيقيّة وإنهاء الاحتلال، بالإمكان بناء دولة واحدة. ما أودّ الإشارة إليه هنا أنّ الصراع له مركزيّة وقوّة جاذبيّة لا يمكن تجاهلهما كما ظنّ البعض. لقد أعادت الأحداث الأخيرة توزيع الأوراق في العلاقات الإقليميّة الشرق الأوسطيّة؛ إذ نرى صعود محور الشام – مصر، أو المشرق الجديد الّذي يضمّ العراق والأردنّ ومصر، بالإضافة إلى رغبة أطرافه في انضمام سوريا ولبنان. وأتّفق مع الأصوات الّتي تنادي بأهمّيّة هذا المحور للقضيّة الفلسطينيّة، مثل الإعلاميّ الأردنيّ فهد الخيطان. كما أنّه من الصعب عزل الداخل الإسرائيليّ عن الصراع في القدس أو الضفّة أو في غزّة.
لا بدّ من التنبيه إلى أنّ العمليّة السلميّة، الّتي بدأت في «مؤتمر مدريد» (1991)، رافقها على الصعيد الداخليّ في إسرائيل ثورة دستوريّة، نسبة إلى «قانون حرّيّة الإنسان وكرامته» (1992). بالطبع هذا القانون لم يقدّم مقاربة تأخذ بعين الاعتبار وفي آن، الحقوق الفرديّة والجماعيّة لفلسطينيّي أراضي 48. في رأيي، تتطلّب قراءة «قانون حرّيّة الإنسان وكرامته»، من خلال النتائج الّتي توصّلت إليها «لجنة أور» بخصوص أسباب «هبّة أكتوبر 2000»، في ما يخصّ أصلانيّة الأقلّيّة الفلسطينيّة؛ بمعنى وجودها قبل قيام دولة إسرائيل، وبمعنى أنّها تملك هويّة وطنيّة، وتشكّل امتدادًا لمحيط عربيّ وإسلاميّ. كما نعلم، لم تؤخذ نتائج هذه اللجنة بعين الاعتبار؛ بسبب سيطرة اليمين المتطرّف في الحياة السياسيّة الإسرائيليّة.
الهجمة الشرسة الّتي يتعرّض لها أبناء شعبنا في الفترة الأخيرة؛ من مداهمات واعتقالات وأفعال مُحِطَّة بالكرامة الإنسانيّة، هي النقيض التامّ لما تحمله تطوّرات النظام القانونيّ الدوليّ منذ سنوات التسعينات، ولا سيّما في ما يتعلّق بإخضاع سيادة الدولة لسيادة الفرد...
إنّ الهجمة الشرسة الّتي يتعرّض لها أبناء شعبنا في الفترة الأخيرة؛ من مداهمات واعتقالات وأفعال مُحِطَّة بالكرامة الإنسانيّة، هي النقيض التامّ لما تحمله تطوّرات النظام القانونيّ الدوليّ منذ سنوات التسعينات، ولا سيّما في ما يتعلّق بإخضاع سيادة الدولة لسيادة الفرد (كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتّحدة)، وفق مبدأ مسؤوليّة الحماية والتدخّل من قِبَل المجتمع الدوليّ في حالة اعتداء دولة على مواطنيها.
المطالبة بتدويل الصراع هنا يعني تبنّي المعايير الدوليّة كبوصلة أخلاقيّة ونقديّة في مواجهة سياسات عنصريّة وأبارتهايد. هذا يعني أن يهتمّ فلسطينيّو أراضي 48 بالأدوات المؤسّساتيّة مثل «مجلس حقوق الإنسان»، وبالأدوات المعاهداتيّة مثل لجان حقوق الإنسان، الّتي انبثقت من اتّفاقيّات حقوق الإنسان مثل «العهدين» (1966)، ولجان خاصّة بـ «اتّفاقيّة منع الأبارتهايد» (1965)، وبـ «اتّفاقيّة منع التعذيب والمعاملة القاسية» (1984). إضافة إلى اتّفاقيّات خاصّة بالأقلّيّات (1992)، وبالشعوب الأصلانيّة (1994)، ولا سيّما أنّ جزءًا من موادّها عرفيّ وملزم.
كما أنّ التدويل يعني دفع الدول الثالثة، ولا سيّما تلك الّتي لها تأثير في القرار الدوليّ، مثل دول الاتّحاد الأوروبّيّ، إلى العمل على التزام إسرائيل بحقوق الإنسان؛ وهذا من خلال برامج تخصّ حسن الجوار، واتّفاقيّة الشراكة الّتي تتضمّن مبدأ الشَّرْطِيَّة؛ أي تشترط الاتّفاقيّة أنّ التعاون الاقتصاديّ والعلميّ يجب أن يخضع لاحترام القانون الدوليّ لحقوق الإنسان. يجب ألّا ننسى أنّ الاتّحاد الأوروبّيّ لا يمثّل فقط الشريك الاقتصاديّ والتجاريّ لإسرائيل، بل يمثّل أيضًا من الناحية الجيوسياسيّة «إقليمًا خلفيًّا وغير مرئيّ» (Hinterland)، داعمًا لها.

أستاذ مساعد في كلّيّة الحقوق في جامعة النجاح الوطنيّة - نابلس، ويشغل حاليًّا منصب مدير مركز كرسي اليونسكو للديموقراطيّة وحقوق الإنسان.