من نافذةٍ تطلّ على الكورونا

خاصّ فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة
وجوه مرئيّة
تبدو الوجوه القليلة الّتي تمشي بين الحين والآخر في الشارع الداخليّ في الحيّ شاحبة، وربّما النفسيّة هي الشاحبة؛ نفسيّة أصحاب الوجوه أو نفسيّة المُشاهد من نافذته الواسعة المطلّة مباشرة على الشارع.
غدت سيّارة تمرّ في الشارع مشهدًا يلفت النظر، تحتار العينان وتبحلقان كي تريا مَنْ يقودها ومَنْ يركب معه، ولماذا؟ وماذا مع الوباء؟ وهل سيعود سالمًا؟ وهل هو حقًّا سالم؟ وهل يدري ما وضعه من الوباء؟ ربّما هي أسئلة تعكس تخوّفاتي تجاه نفسي وتجاه أسرتي، ونحن نعيش الإغلاق الّذي فرضته التعليمات، وهو أيضًا إغلاق طوعيّ إسهامًا في حماية الذات، وفي التخلّص الجماعيّ من الوباء الّذي نرى أجواءه، ونعيش سطوته دون أن نراه.
عادات لم تكن فينا، غدونا بين ليلة وضحاها فيها، لا ننظر كثيرًا في مرايانا كي لا نرى مدى التغيّر الحاصل، أو كي نهرب منه، وربّما نفضّل أن ننظر إلى الآخرين من المارّة القلائل لا إلى ذواتنا.
عادات لم تكن فينا، غدونا بين ليلة وضحاها فيها، لا ننظر كثيرًا في مرايانا كي لا نرى مدى التغيّر الحاصل، أو كي نهرب منه، وربّما نفضّل أن ننظر إلى الآخرين من المارّة القلائل لا إلى ذواتنا. وربّما بعد قليل حين أخرج إلى الشارع، سأكون في موقع المارّة، ويجلس جار آخر في بيته بجانب النافذة الواسعة، ويرى بي ما لا يراه في نفسه وما لا أراه في نفسي. كلّنا مرايا كلّنا.
في عالم ما قبل الوباء، كانت الحياة سريعة وتتسارع سرعتها باستمرار، لا أحد يلتفت إلى أحد. أحد مشاهدها كان المشي السريع والركض على شاطئ بحر حيفا الجنوبيّ. الجميع يركض ولا يتوقّف أحد لإلقاء السلام على معارفه، يلوّح بيده من بُعد، ويواصل باتّجاهه المعاكس لوجهة مَنْ ألقى عليه السلام السريع.
توقّف الطابور؛ فالوباء يحبّ كثافة شاطئ البحر، وينتعش في اكتظاظ الشارع والسوق. هكذا قالت لنا الأوامر، والأوامر أوامر، وتبعث على الخوف ممّا أتت به.
زوجان في جيل الكهولة يمشيان بالسرعة الّتي يسمح بها تثاقل جسديهما، ويتحدّثان بصوت عالٍ لافت للنظر، ربّما لمشكلة في السمع، وبلغة غريبة بالنسبة إلى جالس النافذة، واللافت أنّهما يتحدّثان بذات النبرة يوميًّا، وصدى الكلام ذاته، وكذا طقوسه ذاتها، وربّما يكرّران ما قالاه في الأمس؛ فلا مواضيع في الوباء سوى الوباء، يتجوّلان كلّ صباح، في التاسعة والربع، ولا يظهران حتّى اليوم التالي.
جار في العشرينات يتجوّل مع طفلته الصغيرة، وهي تتربّع على عربة الطفولة، ولا تأبه للكورونا ولا لشحوب الوجوه. في النهار يمرّ الجار والجار والجارة. أنزل وأمشي في الشارع، وإذا صادفت أحدًا يمشي أتحاشى الاقتراب منه؛ فمعيار اللمس والمصافحة ولغة العيون والجسد متران على الأقلّ.
إنّني ملتزم كما غيري بتعليمات "وزارة الصحّة الإسرائيليّة" وأوامر بنيامين نتنياهو. أفكّر في هذه المشهديّة الغريبة، فأجدني أنصاع للتعليمات؛ لا بسبب خوفهم عليّ إنّما خوفهم من العدوى، وربّما منّي فأنا أنتمي إلى اللايهود، وحسب عقيدة العرق فإنّ الأغيار أكثر عرضة لتلقّي العدوى ونقلها
تبدّلت الابتسامات المتعارف عليها في الشارع الصغير، غابت سلاستها وحلّت مكانها الابتسامات الخائفة المحكومة بلغة العيون، الّتي تحرص على المسافة الفاصلة، ابتسامة من بعيد ونهرب كلٌّ في اتّجاهه لنُخفي علامات الودّ الّذي استسلم لمتطلّبات النفور. لم نعُد نخجل من حرج الموقف، ولا نحاسب أنفسنا؛ فلا أحد يحاسبنا على ذلك. هكذا في الوباء، وكم كان دقيقًا جوزيه ساراماغو، في وضعنا أمام ما حدث لسكّان روايته "العمى"!
***
إنّني ملتزم كما غيري بتعليمات "وزارة الصحّة الإسرائيليّة" وأوامر بنيامين نتنياهو. أفكّر في هذه المشهديّة الغريبة، فأجدني أنصاع للتعليمات؛ لا بسبب خوفهم عليّ إنّما خوفهم من العدوى، وربّما منّي فأنا أنتمي إلى اللايهود، وحسب عقيدة العرق فإنّ الأغيار أكثر عرضة لتلقّي العدوى ونقلها. أمّا أنا فأنصاع لسطوة جائحة العولمة الجديدة العابرة للقارّات، وبتسارع يفوق تسارع حرّيّة التجارة العالميّة ومداها، لكن بِمَ يهمّني شأن العالم الآن؟ ففي كلّ مكان يتّهمون الآخر بنشر العدوى، وويل للآخَر أينما كان، ولو بيننا!
العدوى في مكاننا ثنائيّة القوميّة، والكورونا تعمل حسب قانونها، لا حسب قوانين الحروب البيولوجيّة الّتي تجري فيها هندسة الأوبئة القاتلة؛ كي تطال مجموعة سكّانيّة قوميّة أو عرقيّة محدّدة، بل من شأنها أن تنبّهنا بشأن الترسانات الرهيبة في أنحاء العالم، الّتي قد تودي بالبشريّة جمعاء. هذا الأمر أيضًا يمكن تأجيل الانشغال فيه؛ فنحن مشغولون بالحيّز الّذي يُخرجنا من أيّ حيّز، ويبقينا مشغولين في قياس مسافة المترين بين ذواتنا، وفي معقّمات السوق السوداء الّتي تعيش على الويلات، وبالخوف من اللمس، وبالقطيعة عن كلّ واحد.
يتقلّص عالمنا إلى مسافة المترين المقدّسة، ليصبح محمولًا في جهاز الهاتف الّذي أمقته؛ لأنّه - وبعد انقراض الهاتف البيتيّ القديم الأسود أو الأبيض إيّاه - أصبحنا مستعبَدين له، يدلّنا على كلّ شيء يريده، ويدلّ كلّ مَنْ يريد علينا، ونغدو نحن الأدوات لا الجهاز؛ ففيه تُخَزَّن شخصيّتنا الفرديّة والجماعيّة، لتكون في خدمة مَنْ وراء الهاتف، من قوى السوق العظمى وأجهزة استخبارات العولمة، وكلّما اتّسعت سطوتهم على أرواحنا تمسّكنا أكثر بهذا الجهاز.
***
يلعب ولدان أخَوان بالكرة عند مدخل المدرسة المحاذية، الّتي كانت تعجّ بصخب الأطفال، بينما اليوم يطغى صخب الصمت منها. الشارع ملعب لهما وكذا البوّابة، يمضيان نصف ساعة باللعب ويعودان إلى البيت.
يمرّ جار في أوائل السبعينات من عمره يبدو شحوبه أكثر حضورًا، شعره قد طال فلا حلّاقين في الزمن الموبوء، وإن عملوا فلا زبائن اعتادت أن تسلّمهم رؤوسها، كما كان يقول لي الحلّاق من وادي النسناس. تسليم الرأس للحلّاق يعني في هذه الأيّام "سأحمل روحي على رأسي وأمضي بها في مهاوي الوباء". أرى جارنا يبدو القلق ورهبة العدوى على محيّاه؛ فأخاف أن ينقل إليّ دون علمه عدوى النفسيّة، أتذكّر المرآة فأسارع نحوها كي أرى حالي، ربّما كنت كما حاله.
الرياضة البيتيّة على جهازَي الدرّاجة والركض الموضعيّ تحمي من العدوى، لكنّها تمنع نور الشمس؛ لهذا السبب فإنّ الدعايات والإعلانات التجاريّة لفيتامين "دي"، قد ارتفعت أسهمها مع ارتفاع أسهم الكورونا، ومع تغييب الشمس استجابةً لأنظمة الطوارئ
المشكلة أنّ حالي يعجبني على الدوام، ربّما غرور، وربّما هكذا حال الدنيا، نُدمن فيها النظر إلى عيوب الجار؛ فلا أرى التحوّلات الخلقيّة، لكنّي اكتشفت رغم ذلك أنّ شعري قد طال، وأنّ وجهي قد شحب قليلًا، إذ إنّ الرياضة البيتيّة على جهازَي الدرّاجة والركض الموضعيّ تحمي من العدوى، لكنّها تمنع نور الشمس؛ لهذا السبب فإنّ الدعايات والإعلانات التجاريّة لفيتامين "دي"، قد ارتفعت أسهمها مع ارتفاع أسهم الكورونا، ومع تغييب الشمس استجابةً لأنظمة الطوارئ؛ فلا أحد يراقب الأسعار في الصيدليّات والحوانيت إلّا ضمير صاحبها أو صاحبتها، وللحقيقة فإنّ أصحاب الضمير كثر، لكن ثمّة قلّة من نفسيّة أغنياء الكورونا.
وجوه غير مرئيّة
الكورونا حرب، حالة طوارئ، نُحِّيَتْ وزارة لا موظّف ولا حتّى وزير، بل وزارة، إنّها "وزارة الصحّة"، ودخلت الدولة بشُرطتها وجيشها واستخباراتها لتقود وضع الطوارئ والحرب. منْع التجوال والإغلاقات أسياد الموقف. وفي الطوارئ تُخلي الصحّة مكانها للأمن كي يتسيّد الموقف.
لقد باغت الوباء "جيش الدفاع الإسرائيليّ" المعظّم، والاستخبارات الداخليّة والخارجيّة، وسوف يُكْتَب في كتاب لجنة التحقيق أنّ العدوّ قد دمّر العقيدة العسكريّة الإسرائيليّة وإستراتيجيّاتها، القائلة إنّ الحرب - أيّ حرب - يجب أن تُدار على أرض العدوّ، لكن الحرب الحاليّة في عقر دارهم، والعدوّ هو غير المرئيّ، وليس جهاز "الشاباك" الّذي يتفاخر بشعاره "يحمي ولا يُرى"؛ فهو مرئيّ أمام العدوّ الجديد ولا يَرى. لكن، تعويضًا عن فقدانه حسّ السيطرة، تلجأ إليه الدولة كي يرى سلوكيّات الناس، ويتعقّب أماكن وجودها ولقاءاتها، ليغدو وصيًّا على استدامة حالة الطوارئ، والزعيم الواحد والوحيد، يظهر في كلّ يوم ويلقي خطبته وتعليماته المفيدة للناس، لكن المفيد له أكثر.
في "ألعاب الجوع"، كانت المروحيّة تأتي وتهبط من السماء، محمّلةً بالترهيب والأوامر والعلاج المُسْعِف معًا، ولا يستطيع الضحايا البقاء من دون أوامرها وتعليماتها. يريد الأسياد لتنافس الجوع والموت أن يكون طويلًا وبوتيرة بطيئة؛ لأنّهم يلعبون بأبطالهم، ضحاياهم، واللعبة ليست في نهاياتها، بل في إطالة أمد الموت البطيء المؤكّد؛ إذ إنّ اللعبة كلّها مبنيّة على مشهد اللابقاء.
لقد باغت الوباء "جيش الدفاع الإسرائيليّ" المعظّم، والاستخبارات الداخليّة والخارجيّة، وسوف يُكْتَب في كتاب لجنة التحقيق أنّ العدوّ قد دمّر العقيدة العسكريّة الإسرائيليّة وإستراتيجيّاتها، القائلة إنّ الحرب - أيّ حرب - يجب أن تُدار على أرض العدوّ
هكذا في حالتنا، يهبط الإعلام العبريّ، الّذي يحافظ على الثوابت ويبقى حربيًّا في زمن الحرب، ويشكّل مساحة لمروحيّة الزعيم كي يُمطر الناس بالخوف والترهيب والأوامر ووضع الطوارئ، وكي يقنعنا بضرورة بقائه في موقعه في وحدته القوميّة؛ كي ينتصر على الوباء لصالح شعب الله المختار. أمّا نحن "غير اليهود" فلا اعتبارات بشأننا، لكن إذا ما أُنْقِذَ شعب الله وشعب نتنياهو فهذا ضمان لأن نبقى.
***
المسرح مفتوح ليل نهار، ويتواصل المشهد بلا انقطاع ولا حتّى استراحة؛ فالوضع طوارئ، وفي الطوارئ يُسمح فقط للخدمات الحيويّة. المسرح مجال حيويّ، إلى درجة أنّه حين أُدخل الزعيم إلى الحجر الصحّيّ، أدخلوا المسرح أيضًا إلى الحجر الصحّيّ، كي يبقى معه.
وفي الفصل المُكمَل ثمّة خروج عن النصّ؛ إذ يُكْتَب سيناريو جديد، وهو وإن كانت الحرب وجوديّة، فإنّ الترسانة النوويّة والبيولوجيّة والكيماويّة لا تنفع، حتّى لو كانت هندستها مُتقَنة؛ إذ إنّه لا ضمانة في ألّا ترتدّ على أصحابها وإليهم. قد يفكّر في جدار يصل إلى السماء لا يدخله أيّ وباء، لكنّ ذلك يحتاج إلى وقت، في حين أنّ العدوّ قد اخترق كلّ جدرانه واستحكاماته.
جاءته فكرة تقول إنّه في الحرب كما في الحرب، وإنّه يحتاج إلى خدع أكثر تعقيدًا وأعمق أثرًا؛ ومَنْ يُجيد الخدعة مثلما يُجيدها مَنْ حدّد شعاره "لولا الاحتيال لانهارَ الشعب"؟ إنّه البطل الّذي لا يُرى، ولا يترك بصماته، إلّا بقدر ما يريد أو إذا أخفق، وهو الّذي ترهبه الأمم. قرّر الزعيم استخدام نفوذ "الموساد" ليكون لاعبًا في ألعاب الجوع الّتي لديه؛ كي يستحضر موادّ طبّيّة وعقاقير وأدوات فحص العدوى من دول لا تُقيم إسرائيل معها علاقات، وجرى التلميح كثيرًا بأنّها دول الخليج العربيّ، وقد عاد الجهاز القويّ بكمٍّ هائل من الأجهزة. لكن دول الخليج موبوءة؛ فكيف يمكن المشهد أن يكون مترابطًا وهي بحاجة إلى الأجهزة الطبّيّة؟ وكان جهاز الصحّة الإسرائيليّ قد أدلى بمعلومات متضاربة، قبل الحدث وبعده، في أمر مخزونه من الأجهزة التنفّسيّة. ثمّ إنّه إذا كان الموضوع شراء وبيعًا حتّى من دول كتلك، فليس هذا دور "الموساد" بل الحكومة؛ بعقد صفقات سرّيّة ثمّ تُسَرَّب إلى الإعلام؛ لأنّ الكشف مفيد للزعيم.
لقد تزامن ذلك مع ما تحدّثت به الأنباء، عن سطو إيطاليا على سفينة محمَّلة بالمعقّمات، كانت في طريقها إلى تونس من الصين. وهكذا، وكي يصبح للمشهد معنًى، فلا بدّ من دخول اللاعب الجديد، لأنّه "من دون الخُدَع يسقط الشعب"؛ فتُحدّثنا وسائل الإعلام بلغة التلميح والتفاخر غير المُعْلَن، بصدد معلومات عن قرصنة دوليّة لموادّ طبّيّة بكمّيّات غير مسبوقة، كانت ألمانيا قد امتلكتها من مصدر بقي طيّ الكتمان، وكانت في مطار العاصمة الكينيّة نيروبي، في طريقها إلى برلين، وفجأة اختفت، وهذا المشهد كان في ألعاب الجوع، حين جرى السطو على مستودعات الغذاء والأدوية، ومشهد آخر عن المدينة المدمَّرة والمُبادة، وتقول قواعد لعبة الموت: "أنا، ومن بعدي الطوفان".
لمّا ينجح الزعيم بعدُ في التقاط صورة انتصار؛ فالعدوّ غير مرئيّ، لا ضاحية مدمّرة ولا غزّة مشتعلة، ولا ضبّاطه على بوّابات القدس؛ فما العمل؟ استبدل ساحرنا المهرّج بالمشهد مشهدًا آخر، وإن لم تكن صورة انتصار فلتكن صورة استسلام خصومه وهم يزحفون إلى وكر حكومة الطوارئ
وإذا كانت الغاية تبرّر الوسيلة، فكم بالحريّ والغاية هي سلامة الشعب المختار! أمّا شعوب العالم الثالث فمَنْ يهتمّ بتعدادها على مذبح إحصاءات الموت؟ وما حاجتها إلى الداء؟ أو بالأحرى مَنْ يحقّ له فيها الحياة إذا وضعنا في كفّة الميزان الأخرى شعب الله وزعيمه الأوحد ومسرحه، في مساحات حالة الطوارئ؟
العالم الأوّل أوّلًا هو الأبيض، وإذا لم يكن كذلك فما مبرّر تسميته بالعالم الأوّل؟ وحتّى العالم الأوّل فيه مَنْ هو أبيض أكثر وأبيض أقلّ، لكن كيف نعرف مَنْ هو الأبيض أكثر، إذا كانت الوجوه كلّها شاحبة في الشارع وفي البيت؟ فهل نبدأ من جديد بتقفّي أثر خليل أحمد، ووليد جابر، وإلياس خوري، و"الوجوه البيضاء"، ووليد وباء طائفيّ ضرب لبنان، وأحال كلّ الوجوه إلى شاحبة، وكثُرت السيناريوهات، وضاعت هويّة صاحب الوجه في البياض الّذي يملأ أرض الرواية ومسرح أحداثها، لتنتهي بلا نهاية.
***
لمّا ينجح الزعيم بعدُ في التقاط صورة انتصار؛ فالعدوّ غير مرئيّ، لا ضاحية مدمّرة ولا غزّة مشتعلة، ولا ضبّاطه على بوّابات القدس؛ فما العمل؟ استبدل ساحرنا المهرّج بالمشهد مشهدًا آخر، وإن لم تكن صورة انتصار فلتكن صورة استسلام خصومه وهم يزحفون إلى وكر حكومة الطوارئ، واستبدل بـ "تحرير" القدس تحريره من محاكمته أمام جهازه القضائيّ؛ وإذ لا يكتفي بذلك فإنّ صور الخوف تُسعفه، وللخوف الحاليّ صور ووجوه، وفي مشاع الخوف كلّ شيء مباح... إلّا الحركة والكلام، وهما حكر على صاحب صورة الانتصار المأمولة، وهو لا يتعطّل حتّى من داخل الحجر؛ فالحرب سجال، إذ نجح غير المرئيّ في دفعه هو وكبار جنرالاته إلى الحجر.
يمرّ رجل خماسينيّ أو هكذا يبدو من النافذة، يبدو عليه التعب وقد اختفى وراء كمّامة خضراء على وجهه فغابت الملامح؛ فالتعليمات الأخيرة تتحدّث عن استخدام الكمّامات في الحيّز العامّ. يمضي حاملًا بعض الأغراض لبيته، وربّما هي ملامح أغراض.
بعد قليل سيظهر الزعيم في بيان خاصّ عن الكورونا، وربّما فيه من جديد، وربّما عن حكومة طوارئ.
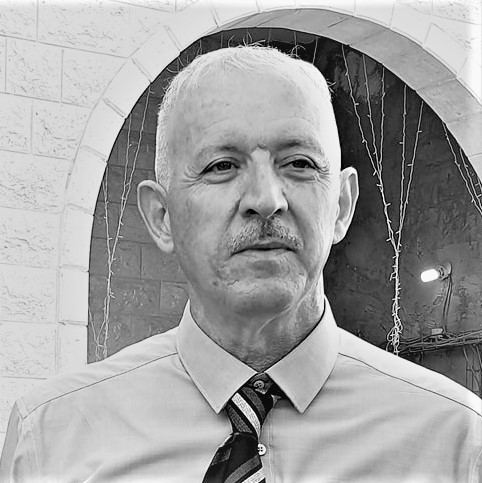
أسير سياسيّ محرّر. عمل قبل اعتقاله في السجون الإسرائيليّة مديرًا لـ "اتّجاه - اتّحاد الجمعيّات الأهليّة"، كما شغل منصب رئيس لجنة الحرّيّات المنبثقة عن لجنة المتابعة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948.





