عِلم بلا حوافّ: في إشكاليّة الفصل بين العلوم وأشباهها (2/2)
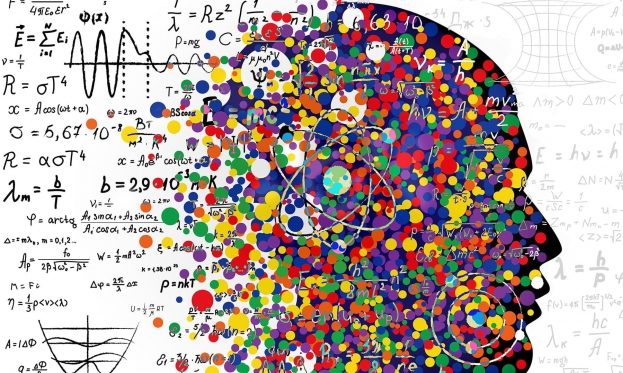
خاصّ فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة
"الحكمة الرياضيّة: فيها حقّ من صنائع هندسيّة وحساب، وفيها أباطيل من التنجيم وما أشبهه، وباطلها يُردي المرء في دينه وفضيلته".
شمس الدين الذهبيّ[1].
حمى الجدران
يُقال إنّ البشر اخترعوا العلم في القرن السابع عشر[2]، ورغم المظهر التاريخيّ لهذا الادّعاء فإنّه أحيانًا جغرافيّ بامتياز؛ فما يقوله عمليًّا أنّ العلم ظاهرة أوروبّيّة، لكنّه يخبّئ الكلام عن المكان بالكلام عن الزمان. ومهما يكن، فإنّه يبقى لهذا الميلاد المُدَّعى قدر من الصحّة، إذا ما حُدِّدَ العلم بقدر من العناية، ورُبِطَ الأمر بالحداثة الّتي بلغها العلم قبل الفلسفة[3]. إنّ ما يجعل القرن السابع عشر لحظة فارقة لا يتعلّق بالثورة العلميّة، إنّما باستيقاظ وعي للعلوم تجاه نفسها، وبتشييد أوّل جدار بين الطبيعة وما وراءها؛ بين العلم التجريبيّ وفلسفة الإغريق. وبهذا؛ فإنّ الميلاد المزعوم للعلم لم يكن ميلادًا لجديد، بل انقسامًا لقديم. لقد تصدّى فرانسس بيكون لهذه المهمّة، وتكفّل بتشييد حائط الفصل المعرفيّ الأوّل. منذ ذلك الوقت، أصبح للممارسة العلميّة حاجة مستمرّة إلى الجدران، ليس مع الخارج فحسب بل في داخلها أيضًا. وبدأ الباحث المختصّ يزاحم الموسوعيّ الشامل، وذوى زمن معرفة شيء عن كلّ شيء، وحلّ مكانه زهد بالاتّساع، ونهم بالعمق والتخصّص.
لمَنْ كان واقفًا على حوافّ المعرفة البشريّة، كما كان هايزنبرغ، ويحاول أن يتحسّس طريقًا في الظلام، فإنّ اليقين التجريبيّ الّذي طلبه الوضعيّون كان أرسطيّة مقلوبة؛ تكبيل للمخيّلة العلميّة...
حتّى برحيل أرسطو ومبادئه الأولى عن المخيّلة الطبيعيّة، لم يتوقّف ترسيم الحدود، وانتقل العمل من جبهة التصدّي للميتافيزيقا نحو الدين. كانت معركة التمايز هنا مختلفة تمامًا، ولا تتعلّق بتخليص العلم من شيء يخالطه بقدر ما كانت تحريرًا للعلم من شيء يحاصره. هنا، حصل عكس ما جرى مع الميتافيزيقا؛ إذ دُفِعَت الجدران إلى الأمام، وسُوِّرَتْ مناطق كانت محرّمة على الممارسة العلميّة[4]. وفي البحر الزمنيّ الفاصل بين غاليليو وداروين، اكتمل الجدار وتحصّنت دفاعاته. كان التطوّر الطبيعيّ لهذا التقدّم الكاسح أن يذهب أنصار الممارسة العلميّة أبعد من أيّ وقت مضى. هنا أتى مفكّرو الوضعيّة المنطقيّة أوائل القرن الماضي، وحوّلوا معركة الإقصاء الّتي افتتحها بيكون إلى حرب إلغاء. لم يعد كافيًا أن يُقصى ما هو غير علميّ من داخل العلوم، بل يجب الإقرار باحتكار الإنتاج المعرفيّ ومعنى الحقيقة لداخل جدران المؤسّسة العلميّة، وأن تُحْكَم المنهجيّة العلميّة بصرامة برهانيّة وحسم تجريبيّ. وتصاعَدَ الخلاف من داخل المجال العلميّ نفسه حول شرعيّة هذه الحدود الجديدة، وكتب فرنر هايزنبرغ، أحد ألمع الفيزيائيّين الألمان أوائل القرن الماضي، واصفًا الوضعيّة المنطقيّة بالعبث، وقائلًا بأنّ إقصاء الغموض واشتراط اليقين لا يتركان في العلم سوى حشوٍ تافه[5].
لمَنْ كان واقفًا على حوافّ المعرفة البشريّة، كما كان هايزنبرغ، ويحاول أن يتحسّس طريقًا في الظلام، فإنّ اليقين التجريبيّ الّذي طلبه الوضعيّون كان أرسطيّة مقلوبة؛ تكبيل للمخيّلة العلميّة، لا بالميتافيزيقا هذه المرّة، إنّما بنقيض حسّيّ متطرّف لها.
لم يتوقّف الأمر عند خلافات الفهم الفلسفيّ؛ فالسياسة أيضًا تلاعبت بحدود الممارسة العلميّة. في ألمانيا النازيّة، عاشت فيزياء الكمّ سنوات صعبة بوصفها فيزياء يهوديّة[6]، وصار التفوّق العرقيّ ميدانًا للبحث العلميّ الجادّ. وفي روسيا الستالينيّة، تداخل الفكر الاشتراكيّ بالعلم الطبيعيّ، وصعد نجم لايشنكو الّذي رفض علم الوراثة القائم بوصفه "شبه علم برجوازيّ"[7]، وقاد حملة تطهير وظيفيّ لكلّ المتمسّكين بالمندليّة الوراثيّة. وبعد وفاة ستالين وتعثّر مشروع لايشنكو الزراعيّ، رجع السوفييت تدريجيًّا إلى علم الوراثة المندليّ، وتبادل الزيف والحقّ أماكنهما من جديد، وعادت جدران العلم الوراثيّ إلى وضعها الأوّل[8].
عن التناظر المختلّ
يبدو في التوتّر التاريخيّ بين العلوم وأشباهها تناظر مكسور: كثير ممّا كان يُصَنَّف علومًا مقدّرة تمخّض لاحقًا عن أشباه علوم. كان غاليليو يتكسّب من تحليل الأبراج وقراءة طالع الأثرياء، وقبله كتب بطليموس مطوّلًا في الموضوع. وعندما بدأ الطبّ التجانسيّ، كانت منطلقاته تجريبيّة، وتوافرت مؤشّرات عديدة على نجاح إكلينيكيّ في تطبيقه. ومع الوقت، فقدت هذه العلوم علميّتها، واصطفّت مع مثيلاتها في طابور أشباه العلوم. لكنّ العكس لا يبدو بنفس الجلاء؛ أي في صيرورة أشباه العلوم إلى علوم حقّة. في أغلبه، هذا خداع بصريّ؛ فالطريق الواصل بين الظاهرتين، بين العلوم وأشباهها، يشهد زحمة في الاتّجاهين، لكن مسرب الذهاب مختلف جدًّا عن مسرب الإياب.
كثير من كتابات التاريخ العلميّ ينزع إلى تصوير العلوم الصلبة بأيّامنا وكأنّها شريفة الأنساب، وليس هذا ممكنًا لولا أنّ رواية الماضي تُعاد صياغتها ليبدو العلم علمًا من مهده ويومه الأوّل...
لا تتحوّل العلوم إلى أشباه علوم بسبب تغيّر مفاهيميّ يطرأ عليها، بل لتعثّر نبوءاتها وفشلها التجريبيّ. بهذا؛ فهي تخرج من أسوار الممارسة العلميّة بهيئتها الأصليّة، وجثّتُها معلومة الهويّة ساعة التأبين. الأمر مختلف تمامًا في الاتّجاه المعاكس، فأشباه العلوم لا تلج المؤسّسة العلميّة إلّا بعد تغيّرات تلحق بها، أو عبر اندماجها بسواها، أو بتخليص عنصر منها وتوظيفه في سياق مستجدّ. وهكذا لا يبدو للعلم الناشئ صلة بشبه العلم القديم. كان لشغف إسحق نيوتن بالخيمياء والظواهر "الملغّزة"، على سبيل المثال، دور مُرَجَّح في مفهوم الجاذبيّة الّذي طوّره. كيف يمكن جُرْمًا أن يشدّ جُرْمًا آخر دون أن يكون بينهما وسط محسوس؟ بمزيج من قناعاته في الخيمياء والفلسفة الهرمزيّة، كان لنيوتن فرصة عالية كي يجترح القفزة الذهنيّة اللازمة لتخيّل هذا الأثر "السحريّ" أو يتجاوز حتّى الحاجة إلى تبريره[9]. ولأنّهم لا يشاطرونه الإيمان بالخيمياء والظواهر الملغّزة، كان صعبًا على الديكارتيّين أن يقبلوا نظريّته في وقتها[10].
بالمثل، أربكت ظاهرة المدّ والجزر عددًا ممَّنْ حاولوا تفسيرها، وقد نسبها غاليليو خطأً إلى دوران الأرض. لكن قبل غاليليو ببضع سنوات، كتب كيبلر عن المدّ والجزر، ناسبًا الظاهرة – بحقّ – إلى القمر وأثره. ولم يكن كيبلر أوّل مَنْ أدرك العلاقة المستترة، فقبله بقرون كتب بطليموس رابطًا بين الأمرين. إنّ التنجيم والإيمان بالأبراج (وهو مجال كان محلّ قبول عند المذكورين الثلاثة) أدّى دورًا مشجّعًا هنا لهذا الاستنتاج الصحيح؛ فالاقتناع بقدرة أجرام السماء على التأثير في مجريات الأرض، هو مركّب ذهنيّ لازم لرسم الاستنتاج العلميّ الصحيح في مسألة المدّ البحريّ. وكان لكارل بوبر من الجرأة أن يكتب يومًا بأنّه ما من نظريّة علميّة في عالمنا، لا تدين في ميلادها لخرافةٍ ما[11].
يبقى عنصر أخير يستحقّ الذكر في انكسار التناظر بين العالَمين، وهو نابع من النحو الّذي ننظر فيه إلى الماضي، وليس من طبيعة الماضي نفسه؛ فكثير من كتابات التاريخ العلميّ ينزع إلى تصوير العلوم الصلبة بأيّامنا وكأنّها شريفة الأنساب، وليس هذا ممكنًا لولا أنّ رواية الماضي تُعاد صياغتها ليبدو العلم علمًا من مهده ويومه الأوّل، ويُعطَى تدرّجيّة منطقيّة تُفضي على نحو أنيق إلى اللحظة الراهنة بوصفها الحقيقة العلميّة الناجزة[12].
عن دوافع أشباه العلوم
في محاولة فهم منشأ أشباه العلوم، يصعب فكّ الاشتباك بين الذاتيّ المتعلّق بالإنسان والموضوعيّ المتعلّق بالظاهرة الطبيعيّة. على كلّ جبهة يعاني فيها البحث العلميّ تعثّرًا أو ارتباكًا، يبدو أنّ "علمًا كاذبًا" يفرك يديه ويتحفّز إلى الدخول، وفي كلّ فراغ يتركه العلم أمام ظاهرة طبيعيّة، ثمّة اندفاعة لأشباه العلوم. يقدّم المرض أمثلة بغير عدّ في هذا المضمار، وتُحرّك حتميّة الموت كلّ صنوف التجاوزات لجوهر الممارسة العلميّة، بحثًا عن خلاص ما. صعدت الأدوية التجانسيّة أمام دمويّة العمل الجراحيّ في القرن التاسع عشر، ورغم تراكم أدلّة شتّى مع الوقت على فشلها الطبّيّ، فإنّها مستمرّة إلى اليوم باستمرار المعاناة الّتي خلقتها[13]، تمامًا كما تحوّلت الأخطاء الصيدلانيّة التاريخيّة ذخيرةً حيّة لحركات رفض اللقاحات الحديثة.
منذ أوائل القرن الماضي، وفي الولايات المتّحدة بالتحديد، ظهر العلم صنوًا للمؤسّسة العسكريّة وابنًا مدلّلًا لها، وبلغت هذه العلاقة أوجها في الحرب العالميّة الثانية، عندما اجترحت العسكريّة الأمريكيّة واحدًا من أكبر المشاريع العلميّة في التاريخ، "مشروع مانهاتن"...
ليس الفشل أو الارتباك وحدهما ما يسمح لهذه الأنماط من أشباه العلوم بالتقدّم، فأحيانًا يؤدّي العكس تمامًا ذلك الدور. منذ أوائل القرن الماضي، وفي الولايات المتّحدة بالتحديد، ظهر العلم صنوًا للمؤسّسة العسكريّة وابنًا مدلّلًا لها، وبلغت هذه العلاقة أوجها في الحرب العالميّة الثانية، عندما اجترحت العسكريّة الأمريكيّة واحدًا من أكبر المشاريع العلميّة في التاريخ، "مشروع مانهاتن"، وتوّجته بقنبلة نوويّة ومئة ألف قتيل. كان ذلك تدشينًا لاستحواذ متصاعد على الميدان العلميّ من قِبَل الشركات العملاقة ومؤسّسات الدولة وقطاعها العسكريّ. لم يعد العلم ناسكًا في صومعة، وانتهى زمن العبقريّة الفرديّة خارج حظيرة رأس المال المنظّم وموازنات الجيوش، وتوسّع شرخ الشكّ في انكشاف تلاعب شركات كبرى بمنشورات علميّة، وشرائها لولاءات علماء وتمويلهم سرًّا لحماية مصالحها الماليّة، وكان لشركات التبغ الأمريكيّة بخاصّة دور مهمّ في عمليّات التلاعب هذه، لنفي الضرر الصحّيّ لمنتجاتها[14]. عبر هذا الشقّ في جدار الثقة تنفذ كثير من أشباه العلوم، ولأنّ علومًا كثيرة تصبح امتدادًا للسلطة القائمة وأداةً لها، يصبح التمرّد على الثانية بابًا مغريًا للتمرّد على الأولى[15]، وتختلط الثوريّة السياسيّة بارتباك الموقف من العلوم الطبيعيّة.
لهذه الأسباب؛ فإنّ أكثر نظريّات أشباه العلم تبدو واقرةً في فكرة تآمريّة ما. لا تتّضح أهمّيّة هذا العنصر إلّا بالعودة خطوتين إلى الوراء، والإطلال على مشهد أوسع في تاريخ الفكر العلميّ. لقد توزّع كثير من المفكّرين بين قطبين متعاكسين في مقاربتهم للمسألة المعرفيّة: الأوّل كان قطبًا للتشاؤم المعرفيّ، لا يرى إمكانيّة للقبض على جوهر الحقيقة الطبيعيّة، ويعتبر الإنسانَ حبيسًا مؤبّدًا لحدوده الذاتيّة. والثاني كان تفاؤلًا معاكسًا لا ينكر عوائق الإدراك، لكنّه يروّج إمكانيّة التغلّب عليها، ويقول بإمكانيّة التقدّم[16]. يبدو كثير من أشباه العلوم بُعْدًا ثالثًا بين هذين المزاجين. لا توسُّط هنا، إنّما دفع إلى التفاؤل والتشاؤم معًا صوب حدودها القصوى، ليتقاطع اعتقاد بتآمر واسع ومنهجيّ لإخفاء الحقيقة، مع قناعة بإمكانيّة كشفها عبر جهد فرديّ خارج الاختصاص. وهكذا يُؤْخَذ التشاؤم المعرفيّ إلى حدود الهوس، قبل أن يُدْفَع التفاؤل إلى حدود السذاجة. ويبدو أنّ المزاج الذهنيّ لأشباه علوم كثيرة يتركّب غالبًا من هذا المزيج المتوتّر.
ملاحظات على حاشية الوباء
من بين الفرضيّات العديدة الّتي راجت في أعقاب جائحة كورونا (Covid-19)، عصفت فكرة شبكات الجيل الخمس (5G) ودورها في ظهور المرض وانتشاره أكثر من سواها. وارتكزت الفكرة غالبًا على تزامن ظهور أوبئة الإنفلونزا الكبرى تاريخيًّا، مع صعود أنظمة الاتّصال اللاسلكيّ ومجمل التطبيقات الإشعاعيّة.
الأطروحة العلميّة أَطْلَقَت رواية محتملة بدت كأنّها من عالم الأساطير: رجل في أقاصيّ العالَم يُوْلِم على طائر غريب تعجّل في طبخه، لتبدأ أكبر جائحة عرفها البشر منذ مئة عام...
ورغم غياب جواب علميّ حاسم عن منشأ الفيروس، بات معلومًا أنّ أرجح النظريّات القائلة بانتقاله من حيوان ما. لا يحتاج الأمر إلى تأمّل طويل لندرك المفارقة الكامنة، وهي أنّ الأطروحة العلميّة أَطْلَقَت رواية محتملة بدت كأنّها من عالم الأساطير: رجل في أقاصيّ العالَم يُوْلِم على طائر غريب تعجّل في طبخه، لتبدأ أكبر جائحة عرفها البشر منذ مئة عام. مقابل هذه الأسطوريّة الشكليّة، تبدو أطروحة أبراج الاتّصال أقلّ جموحًا؛ فهي تتناول هوائيّات تزامن بدء نشرها مع انتشار الوباء، وهي تتعلّق أيضًا بإشعاعات كانت دومًا محطّ ارتياب صحّيّ. للإنصاف، تبدو رواية برج الإرسال أكثر رصانة في الحدّ الأدنى.
لكنّ الرصانة وحدها ليست ميزان الفرضيّات في النهاية. ارتقت الفرضيّة الإشعاعيّة سريعًا إلى مصافّ الحقيقة، وارتسم مشهد غرائبيّ بُعِثَتْ فيه القرون الوسطى في قلب الحداثة، وعومِلَتْ أبراج البثّ كأولئك المتّهمين بمزاولة السحر في الأزمنة القديمة، وأُضْرِمَتْ فيها النار وسط صيحات الغضب والتشفّي. إنّ التوازي بين حرق السحرة في العصر الوسيط وحرق أبراج البثّ في أيّامنا ليس توازيًا عرَضيًّا؛ فالمشهدان ينبعان من بنية تكاد تكون واحدة: اتّهام مهزوز لطرف لم يخضع لمحاكمة دقيقة بالمسؤوليّة عن كارثة طبيعيّة. كلّ ذلك في خضمّ حمّى جماعيّة أقرب إلى الهوس. ثمّة خيط مغزول للسلوك البشريّ بين الحالتين، وإذا كان قَطْعُه غير ممكن بالكامل، فإنّ فَهْم الظروف الّتي تحيكه مسألة مهمّة.
كيف استطاعت فرضيّة برج الإرسال أن تسوّق نفسها بهذا النجاح؟ من الواجب إقرار أنّها سُبِكَتْ باحتراف، وأنّ سابكيها منحوها هيئة علميّة؛ فاختاروا حقائق ومشاهدات بعينها (أوبئة سابقة وتزامناتها)، واستقرؤوا منها استنتاجًا عامًّا (تَسَبَّب الإشعاع في ظهور الفايروسات)، ثمّ استنبطوا نتيجتها الخاصّة بالوباء المستجدّ. لا يبدو شيء وسط كلّ هذا ممّا يرتعد له فرانسس بيكون في قبره؛ فهذا – في ظاهره - منهجه الاستقرائيّ، أو يكاد. ومرّة أخرى فليس في الفرضيّة ذاتها ما يستأهل اتّهامات الزيف وأشباه العلوم، لكنّ الزيف يظهر تحديدًا في اختلال كَفَّتَي الثقة والبرهان عند أنصارها؛ في المزاج اليقينيّ الّذي واكب الفرضيّة، وفي التعلّق الانفعاليّ بها. ما من حجّة تنفي الفرضيّة الإشعاعيّة قطعًا وفورًا، وأقصى ما يمكن السعي إليه مراكمة الأدلّة والتِماس البراهين. لكنّ الوقت اللازم لهذه المراكمة، والغموض الّذي يواكبها، والتعقيد المتجذّر بالظاهرة الطبيعيّة، هي تحديدًا ما يسمح بتصعيد فرضيّات – كهذه - من شكلها الخامّ صوب مراتب الحقيقة، دفعةً واحدة. هنا يكمن جوهر الموضوع في رأينا: أنّ مشكلتنا المعاصرة ليست في ماهيّة شبه العلم بل في كيفيّته؛ وليست في ما يقول بل في علاقته بما يقول، وليست في محتوى الادّعاء بل في مزاج المُدّعي ونيّته المتكشّفة.
ليست الهيئة العلميّة لفرضيّة أبراج الإرسال، وحدها، ما يجعلها مقنعة لكثيرين؛ فقدرتها على منح معنًى للمأساة دفعت بها إلى الأمام أيضًا، وجعلها ملجأ لمن أعيتهم عبثيّة الرواية العلميّة...
علاوةً على ما تقدّم، فليست الهيئة العلميّة لفرضيّة أبراج الإرسال، وحدها، ما يجعلها مقنعة لكثيرين؛ فقدرتها على منح معنًى للمأساة دفعت بها إلى الأمام أيضًا، وجعلها ملجأ لمن أعيتهم عبثيّة الرواية العلميّة. كيف يمكن كلّ هذا الموت أن ينبع من حدث تافه يتعلّق باتّصال إنسان بحيوان. إنّ المأساة تصبح مفهومة – ومحتملة - عندما يكون مجرموها شركات اتّصال عالميّة، يملكها أفحش أثرياء العالم، وتريد أن تربح المليارات وهي تلهو بصحّة الناس، وتسرقهم في وضح النهار. لكن، وبشيء يشبه العدوى، انتقل المزاج اليقينيّ عند أنصار الفرضيّة إلى خصومها، وأُعيد إنتاج الخطيئة المعرفيّة في شكل معاكس، وبدلًا من إعادة الحقيقة المدّعاة حول أبراج البثّ إلى منزلة الفرضيّة، اتُّهِمت بأنّها – في ذاتها - من أشباه العلوم. وتوسّعت حدّة الردّ لتشمل إغلاق مواقع وحسابات روّجت الفكرة المذكورة. إنّ في هذا النمط من الاستجابة - الّذي يتضمّن إسكاتًا محفوفًا بالازدراء - تعزيزًا لمظلوميّة يتمنّاها أنصار هذه القضايا. ودون أن يتعمّد أحد الأمر، تنفرد خشبة مسرح يقف عليها أصحاب الفرضيّة الشاذّة كأنّهم أحفاد غاليليو، في ما أنصار المؤسّسة العلميّة يأخذون مكان سلطة كنسيّة في القرن السابع عشر. هذا التوزيع المتخيّل للأدوار زائف بالكامل، لكنّه يوفّر لأنصار هذه الفرضيّات دفعًا معنويًّا لا يُستهان به.
عن موقف مغاير من أشباه العلوم
في سبعينات القرن الماضي، كتب النمساويّ فايربند أطروحة مهمّة لـم يتساءل فيها عن جدوى التسوير والفصل بين علم وأشباهه، وإنّما ليدافع عن هدم الأسوار ويروّج فتح الحدود. أمام فرضيّة نراها مثيرة للازدراء فإنّ دورنا - كما يرى فايربند - هو أن نحاول تطويرها، لا وأدها، وأن نرمّم ما يبدو غير علميّ فيها[17]. مضى نصف قرن منذ كتب فايربند كتابه، ولا تبدو الأسوار الّتي حرّض عليها اليوم إلّا أكثر علوًّا. لقد تعمّقت الطبيعة الباهظة للبحث العلميّ، وأصبح التواشج بين مؤسّساته (حتّى الأكاديميّة منها) والشركات التجاريّة هدفًا أسمى، وصار غائرًا أكثر من أيّ وقت مضى في بنية الدولة، ومتعلّقًا بمخصّصاتها.
إنّ الأثر الحتميّ لكلّ هذا كان تغليظًا للجدار المحيط، وتعزيزًا لشعور الاغتراب عند القابعين خارجه. ليس هذا بلوغًا أو رشدًا للممارسة العلميّة بالضرورة؛ فهو ينطوي على مخاطر شتّى، أوّلها تحويل أجندة البحث الرسميّة إلى معيار العلميّة وانعدامها. إنّ تسليح مسمّى أشباه العلوم في مواجهة الخارجين عن التوافق العلميّ، هو تهديد للعلوم وليس لأشباهها. وإذا كان هدم السور الّذي نادى به فايربند غير ممكن، فإنّ إزاحته جديرة بالمحاولة؛ بتحويله إلى فاصل بين كيفيّات لا فرضيّات؛ باستخدامه لرسم حدّ بين أمزجة في المقاربة العلميّة، وليس بين أفكارٍ بعينها. بهذه المقاربة لمعنى الفصل والتمايز؛ فإنّ في داخل المؤسّسة العلميّة الرسميّة أشباه أبحاث (وأشباه باحثين) يستوجبون العزل، تمامًا كما أنّ في خارجها ما قد يستحقّ الاستماع.
لقد تعمّقت الطبيعة الباهظة للبحث العلميّ، وأصبح التواشج بين مؤسّساته (حتّى الأكاديميّة منها) والشركات التجاريّة هدفًا أسمى، وصار غائرًا أكثر من أيّ وقت مضى في بنية الدولة...
لا يتعلّق الأمر برِهان على كسب التآمريّين وأنصار أشباه العلوم للصفّ العلميّ، بل من قناعة بأنّ الغربلة العلميّة للأفكار الخارجة على الإجماع قد تُنْتِج علمًا بحقّ. حتّى أولئك المؤمنون بتسطيح الأرض، والكافرون بحفظ الطاقة، والشاكّون في ثبات سرعة الضوء، كلّهم يوفّرون فرصًا متجدّدة للتأمّل في المسلَّمات، واسترجاع ما جعلها مسلَّمات في المقام الأوّل. في صياغة ردّ علميّ على هذه الطروحات، يكتشف المرء أنّ أعتى تحدٍّ ذهنيّ في المحاكمة العلميّة، هو تفنيد وازن لخطأ يبدو أفدح من أن يحتاج إلى تفنيد.
قد يصحّ قول إنّ المشكلة تنبع أيضًا من انعزاليّة المجال العلميّ واستغلاق أدبيّاته أمام القارئ العامّ، وإنّ هذا الطلاق المعرفيّ بين المختصّ والفضاء العموميّ سيترك الثاني عرضة لغوايات شتّى. ليست هذه مشكلة جديدة؛ فمنذ القرن الثامن عشر، كانت "الجمعيّة الملكيّة" في بريطانيا تقدّم عروضًا علميّة لغير المختصّين، بقصد بناء جسور بين المختبر المغلق والمدينة الممتدّة. وتَضاعف الأمر مع الوقت وتعمّم هذا النمط إعلاميًّا، وبلغنا مرحلة تزدحم فيها الشاشات بموادّ لا تنتهي "تفكّ أسرار العلوم"، وتقرّبها إلى الجماهير. هذه مخاطبة تقوم على ردم فاحش للتفاصيل وإثارة بصريّة، وقد تحوّلت عمليًّا إلى شكل معاصر للترفيه. كم من جوهر الممارسة العلميّة يصل حقًّا عبر هذه الأقنية؟ إنّ خطورة هذا النمط أنّه لا يجسّر ضفّتين بالضرورة، بل ينتهي إلى خلق عِلم فريد من نوعه، لا استعصاء فيه ولا تعقيد، ويبدو فوق ذلك مشرَّع الأبواب ويرحّب بالجميع. وهكذا تنعقد خيوط المعضلة: أنّ محاولة التغلّب على انعزاليّة العلوم تنتهي إلى خلق صورة مزيّفة عنها، لا تقرّب أحدًا منها بل تشجّع على انخراط في شبيه طفوليّ لها. هنا ينمحل الفارق المعرفيّ مجدّدًا بين حدود التفاؤل وتخوم السذاجة، وتنفتح بذلك نافذة للرداءة العلميّة بعد أن ظنّ المروّج العلميّ أنّه يغلق بابًا عليها. ويبقى التوازن الممكن بين استغلاق العلوم ومحاولات فتحها مشكلةً عضويّة في الممارسة العلميّة، وتوتّرًا مزمنًا لا نملك إلّا أن نعيش معه.
إنّ تصوير العلم الطبيعيّ، بوصفه قهرًا للغموض ودربًا مفضيًا إلى اليقين، يحمل تضليلًا مركّبًا، وهو يغذّي مزاجًا معرفيًّا قلقًا لا يحتمل التعقيد والانتظار، ويجعل أنصاره عرضة لخداع أفّاقين كثر يمنحون يقينًا سريعًا وبالمجّان.
إنّ تصوير العلم الطبيعيّ، بوصفه قهرًا للغموض ودربًا مفضيًا إلى اليقين، يحمل تضليلًا مركّبًا، وهو يغذّي مزاجًا معرفيًّا قلقًا لا يحتمل التعقيد والانتظار...
في القصّة التراثيّة الشهيرة، يُسْأَل أبو تمّام: "لماذا تقول ما لا يُفْهَم؟"، فيجيب: "ولماذا لا تفهم ما يُقال؟". قد لا يملك المختصّ العلميّ أن يردّ بهذا الجواب على مَنْ يحتجّون على استغلاق العلوم وعسرها، ولا هو يملك أيضًا أن يبسّط العلم، أكثر ممّا كان أبو تمّام قادرًا على تبسيط القصيدة، لكنّه قادر لربّما على ما هو أفضل: أن يحوّل مقولة أبي تمّام من سؤال استنكار إلى سؤال استفهام، وأن يجيب الناسَ عنه؛ أن يخبرهم لماذا يَصْعُبُ عليهم أن يفهموا ما يُقال، وأن يصارحهم بإشكالات السؤال العلميّ وعُسْرِ إجابته وغموض حوافّه. ليس في وسع علم أن يفضي إلى اليقين، لكنّه يبقى أفضل ما عرفنا في مُعارَكَة الشكّ.
..........
إحالات:
[1] شمس الدين الذهبيّ، بيان زَغَل العِلم (دمشق: دار الميمنة، 2013)، ص89.
[2] David Wootton, The Invention of Science: A New History of the Scientific Revolution (UK: Penguin Random House, 2016), p. 1; Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science (US: The Free Press, 1997), p. 187-202.
يمنح هربرت بترفيلد في المرجع السابق تمايزًا تاريخيًّا خاصًّا لما حصل في القرن السابع عشر، مع تأكيده الخطر الكامن في كلّ تحقيبات التاريخ.
[3] عزمي بشارة، الدين والعلمانيّة في سياق تاريخيّ، ج 1-2 (بيروت: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص 383.
[4] لا ينفي هذا الطبيعة المركّبة لتفاعل المجال العلميّ مع الدينيّ، والإفادة الواسعة الّتي حظيت بها علوم بعينها من داخل المؤسّسة الدينيّة.
[5] Werner Heisenberg, "Positivism, Metaphysics and Religion," in: Ruth Nanshen (ed.), Werner Heisenberg - Physics and Beyond - Encounters and Conversations (New York: Harper & Row, 1971), p. 213.
[6] تطوّرت فكرة "الفيزياء الآريّة" بوصفها نقيضًا "لفيزياء يهوديّة" بعد الحرب العالميّة الأولى، ثمّ أخذت منعطفات مختلفة بوصول هتلر إلى الحكم. انظر:
Philip Ball, "Science and Ideology: The Case of Physics in Nazi Germany", Mètode Science Studies Journal, vol. 7 (2017), pp. 71-73.
[7] Michael Gordin, The Pseudoscience Wars: Immanuel Velikovsky and the Birth of the Modern Fringe (Chicago: University of Chicago Press, 2012), p. 81.
[8] Michale Gordin, "Lysenko Unemployed: Soviet Genetics After the Aftermath,” Isis, vol. 109, no. 1 (2018), pp. 56-78.
[9] B.J.T. Dobbs, “Newton’s Alchemy and his ‘Active Principle’ of Gravitation,” In: Scheurer P.B., Debrock G. (eds), Newton’s Scientific and Philosophical Legacy, vol. 123 (Dordrecht: Springer, 1988), pp. 55-80.
[10] لم يرفض الديكارتيّون تجاوز ما هو محسوس في الظاهرة، لكنّهم رفضوا تجاوز ما هو مفهوم في علّتها، وهذا التجاوز الأخير سمة أساسيّة في مقاربة نيوتن للمسألة العلميّة. انظر:
Keith Hutchison, "What happened to Occult Qualities in the Scientific Revolution," Isis, Vol. 73, No. 2 )Jun. 1982(, pp. 233-253.
[11] Karl Popper, Conjectures and Refutations (Basic Books, 1962), p. 38.
[12] Joseph Agassi, Science and its History: A Reassessment of the Historiography of Science (Netherlands: Springer, 2008), pp. 191-242.
[13] لم توقف المملكة المتّحدة تمويلها لأدوية الطبّ التجانسيّ حتّى عام 2018.
[14] Naomi Oreskes and Erik Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming (New York: Bloomsbury, 2010), pp. 136-168.
[15] بسبب الضرر الناجم عن تداخل السياسيّ بالعلميّ، فقد كتب فايربند عن أهمّيّة فصل العلم عن الدولة كتتمّة علمانيّة لفصل الدين عنها. انظر:
Paul Feyerabend, Against Method, 4th Ed. (US: Verso,2010), pp. 250-264.
[16] تتفاوت حدّة التفاؤل والتشاؤم بين فيلسوف وآخر، لكنّ فرانسس بيكون يمثّل حتمًا مثالًا متقدّمًا على التفاؤل المعرفيّ، في ما يقدّم جون لوك مثالًا على النقيض التشاؤميّ. وقد توسّع بوبر في هذه الثنائيّة التصنيفيّة ليُخْضِعَ أرسطو وكانط للتصنيف التشاؤميّ، قبل أن يترك أفلاطون وديكارت في الضفّة التفاؤليّة.
[17] Paul Feyerabend, pp. 14-16.
لقراءة الجزء الأوّل من عِلم بلا حوافّ: في إشكاليّة الفصل بين العلوم وأشباهها (2/1).

كاتب مهتمّ بتاريخ العلوم وفلسفتها، العربيّة منها على وجه الخصوص. مختصّ بالكهروديناميكا التطبيقيّة من جامعة بيرمنغهام بالمملكة المتحدة، وله كتابات عدّة في مجموعة صحف ومواقع عربيّة حول مسائل ثقافيّة مختلفة.





