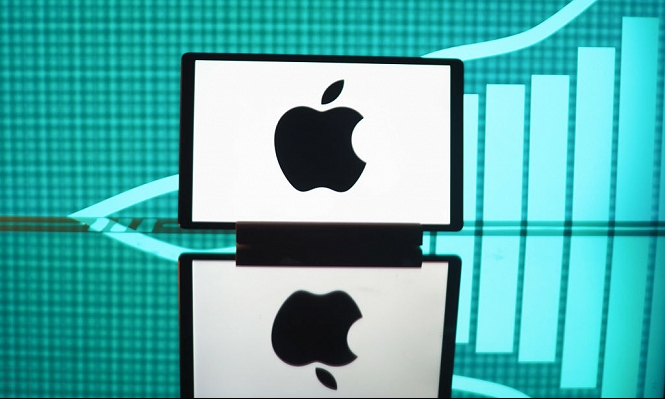إبراهيم نصر الله: اكتُبْ بقلبك كلّه، تُقْرَأُ بقلبٍ كامل | حوار

* الرواية المستقبليّة رواية تاريخيّة، لكنّه تاريخ عكسيّ.
* فتح مشروع «الملهاة» أبواب الذاكرةالفلسطينيّة للجيل الجديد.
* كلّ مشروع روائيّ اختبار لمناطق جديدة في العقل.
* كلّ ما أتمنّاه أن أقدّم شيئًا جميلًا للحياة ولشعبي.
* التغيير ليس من مهامّ الروائيّ، لكنّ القارئ هو مَنْ يثور.
في عام 1985، كتب الروائيّ الفلسطينيّ إبراهيم نصر الله روايته الأولى «براري الحمّى»، لتكون لاحقًا إحدى الروايات المؤلِّفة لمشروعه الأدبيّ «الشرفات»، الموازي واللّاحق على مشروعه الأدبيّ الأكثر انتشارًا وحضورًا في الرواية العربيّة، وهو مشروع «الملهاة الفلسطينيّة».
ما بين الرواية، والشعر، والسيرة الذاتيّة، والصورة الفوتوغرافيّة، والعمل الثقافيّ والمعرفيّ، أمكن نصر الله تشكيل حالة ثقافيّة فريدة، قد تكون أهمّ سماتها المزج والموازاة ما بين القضيّة الفلسطينيّة بآلامها وطموحاتها وماضيها وحاضرها في مشروع «الملهاة الفلسطينيّة»، وما بين الواقع العربيّ المتأزّم في مشروع «الشرفات».
نتحدّث مع نصر الله، في الحوار الّذي تجريه فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، عن بداياته الروائيّة، وعن مشروع الذاكرة الجمعيّة الفلسطينيّة، وعن مهنة الرّوائيّ، وعن الشخصيّة التاريخيّة الروائيّة وتلك المتخيّلة، وعن الجائزة الأدبيّة العربيّة وموقعها من خطاب حركة المقاطعة اليوم.
فُسْحَة: يُعَدّ مشروع «الملهاة الفلسطينيّة» جزءًا أساسيًّا من مشروع «الذاكرة الجمعيّة الفلسطينيّة» عند إبراهيم نصر الله، وهو يبدأ من نهايات القرن السابع عشر حتّى اليوم من الصراع الفلسطينيّ الصهيونيّ. لكلّ آليّة تذكّر ثمّة آليّة نسيان؛ ثمّة عناصر هويّاتيّة وتاريخيّة يُشَدَّدُ عليها، وأخرى تُهْمَلُ أو تُنْسى قصدًا، لتثبيت حقائق أو هويّات على حساب أخرى. فما الّذي يتذكّره مشروع «الملهاة»، وما الّذي ينساه أو يهمله؟
إبراهيم: تعرف أنّ مشروع «الملهاة الفلسطينيّة» مشروع كبير وواسع، فلو سألتني هذا السؤال قبل عشرين عامًا مثلًا، وكان ثمّة رواية أو اثنتان، لقلت إنّ ثمّة الكثير من الأشياء الّتي يجب أن يقولها المشروع. أمّا الآن، فقد وصل عدد الروايات المؤلِّفة للمشروع إلى اثني عشر رواية، وثمّة أخرى قادمة في ظنّي العامّ المقبل. نحن نتحدّث عن ثلاث عشرة رواية، يُضاف إليها كتب أخرى ليست مُدْرَجَة تحت عنوان «الملهاة الفلسطينيّة»؛ فكتاب مثل «السيرة الطائرة» (2006)، يُدْرَج تحت «الملهاة الفلسطينيّة». وفي ظنّي أنّ مشروعي الشعريّ في جزء كبير منه يدرج ضمن «الملهاة الفلسطينيّة». في النهاية، أعتقد أنّ ثمّة ثلاث عشرة رواية إضافة إلى أعمال شعريّة مثل «مرايا الملائكة» (2001)، وهو سيرة متخيّلة للشهيدة الطفلة إيمان حجّو، و«بسم الأمّ والابن» (1999)، وهو سيرة أمّي، تشكّل جزءًا من المشروع. لكن، في ظنّي دائمًا أنّ الإنسان لا يستطيع أن يقول كلّ شيء لوحده، أنت لا تستطيع كتابة كلّ شيء مهما امتلكت من قدرات؛ لذلك أدرك أنّ الطاقات متفاوتة دائمًا، وكلّ كاتب فلسطينيّ يحاول بقدر استطاعته أن يقدّم ما لديه. في ما يتعلّق بمشروع «الملهاة الفلسطينيّة»، أنا سعيد لأنّني أمضيت العمر في العمل عليه دون أن يذهب العمر والعمل هباءً؛ بمعنى أنّه كان مؤثّرًا، وفتح مجالًا واسعًا للقرّاء الشباب، وجذب القارئات والقرّاء في فلسطين وفي كلّ أنحاء العالم، بصورة أعتقد أنّها كانت استثنائيّة. لقد فتح هذا المشروع أبواب الذاكرة ليطلّ هذا الجيل منها على فلسطين وقضيّتها، وأن يتورّط عاطفيًا في فلسطين وتفاصيلها، إضافة إلى العديد من الدراسات الأكاديميّة حوله من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه في كلّ أنحاء العالم. ولذلك، حينما يتوازن العمل في أعين النقّاد والقرّاء والأكاديميّين في الآن ذاته، فمعنى ذلك أنّه يشقّ أكثر من طريق نحو الصورة الأجمل والأروع لفلسطين الّتي نتمنّاها. لكن، هل عبّر المشروع عن كلّ شيء؟ بالتأكيد لا، فالرواية القادمة تقول شيئًا مختلفًا عن الروايات السابقة؛ «ثلاثية الأجراس» (2019) تناولت التجربة الثقافيّة والنضاليّة المسيحيّة الفلسطينيّة، والّتي لم تكن قد تناولتها «قناديل ملك الجليل» (2012) أو «زمن الخيول البيضاء» (2007). مشروع «الملهاة» بانوراما واسعة للقضيّة الفلسطينيّة، وآمل أن تكون ثمّة مساحة من الزمن كافية لأعبّر عمّا لم أعبّر عنه من قبل.
فُسْحَة: من بين العائلة، الأفراد، الجماعة؛ ما هي العناصر الحاملة للسرديّة الفلسطينيّة في مشروع «الملهاة»؟
إبراهيم: أعتقد جميعهم؛ فعندما ذهبتْ رواية مثل «قناديل ملك الجليل» إلى القرن الثامن عشر وعبّرت عن هذا القرن، ذهبتْ إلى منطقة للأسف مهملة في الكتابة الفلسطينيّة، وقدّمت ذلك المشروع الّذي يغطّي حوالي خمسة وثمانين عامًا لتجربة فلسطينيّة رائدة ومذهلة، ومن المحزن أنّنا، الفلسطينيّين، قفزنا عنها لزمن طويل جدًّا. حينما كنت أفكّر في أواسط الثمانينيّات في كتابة «زمن الخيول البيضاء»، كنت مشغولًا قبل كتابتها قارئًا، بالبحث عن رواية تقول لي ما الّذي حدث في فلسطين فعلًا، كيف ضاعت وكيف احْتُلَّتْ وسُلِبَتْ، ولم أجد هذه الرواية، فذهبت وكتبتها لحاجتي إليها قارئًا أوّلًا، ومن حسن الحظّ أنّها حقّقت ذلك المدى الاستثنائيّ، سواءً على صعيد الترجمة أو عدد طبعاتها النادر في الكتابة العربيّة (25 طبعة حتّى الآن). وحينما ذهبت إلى مشروع «ثلاثيّة الأجراس»، كنت أتطرّق إلى موضوع مختلف لم يُلتَفَتْ إليه كما يجب في الكتابة الفلسطينيّة، وهو الدور المسيحيّ نضاليًّا ووطنيًّا، وأيضًا إلى شخصيّة فلسطينيّة مذهلة ومهملة بطريقة أو بأخرى، هي كريمة عبّود (أوّل مصوّرة فوتوغرافيّة عربيّة). تذهب أوّلًا عندما تشعر بأنّك تستطيع التعبير بصورة جيّدة عن شيء تحبّه؛ فحين ذهبت إلى كريمة عبّود، ذهبت لأنّني متورّط في التصوير أيضًا، فقد أقمت أربعة معارض من قبل، ولديّ تجربة واسعة مع الصورة، ولذلك كانت رواية «سيرة عين» (2019) مساحة كبرى لتأمّل ذاتي وتجربتي في التصوير، وللإفادة من هذه التجربة أدبيًّا. كلّ مشروع روائيّ اختبار لمناطق جديدة في العقل لم يسبق اختبارها، وذلك أمر في منتهى الأهميّة بالنسبة إليّ؛ أنت تذهب لتقدّم اقتراحك الفنّيّ في هذا المشروع أو ذاك المشروع، وتذهب لتقدّم فكرة وتخترع شكلًا فنّيًّا، وتقدّم مساهمة أو تحاول تقديم مساهمة في الرواية التاريخيّة والنفسيّة مثلًا، وتلك مساحات تسعدك كاتبًا، وتهمّك إنسانًا قبل إرسال الكتاب إلى المطبعة. أنت تعرف أنّ الأساس أن تحبّ كتابك، وإذا لم تستطع أن تحبّه وتتأثّر به لن تستطيع أن يؤثّر في الناس؛ فالمشاهد الّتي أثّرت بي بقوّة أثناء الكتابة هي نفسها المشاهد الّتي كانت قارئاتي وقرّائي يحدّثونني عنها. دائمًا أقول: اكْتُبْ بنصف قلبك، ستُقرَأُ بنصف قلب، واكتُبْ بقلبك كلّه، ستُقرَأُ بقلب كامل. هذا هو التحدِّي؛ أن تذهب للتنوّع وأن تحرص في مشروع كهذا على ألّا تتكرّر، ومشروع القضيّة الفلسطينيّة يوحي أحيانًا بأنّه مؤطّر وثابت تمامًا، وفي هذا الإطار ثمّة منطقة صغيرة يمكن للكاتب التحرّك فيها وإدارة شخوصه داخلها. القضيّة الفلسطينيّة قضيّة شعب له تجاربه، وفي كلّ منطقة من مناطق عيشه ومنافيه ثمّة تجارب مختلفة، وهذا التنوّع يفرض عليك أن تكون متنوّعًا؛ فثمّة التاريخ، بناء الشخصيّات، العلاقات الاجتماعيّة والأبعاد النفسيّة. وكما تعرف، فإنّ من المسائل المؤرّقة في الكتابة العربيّة عمومًا أنّه يتحتّم عليك قبل الشروع في الكتابة التاريخيّة مثلًا، أن تكون المؤرّخ الّذي يعرف، والقادر على قراءة هذا التاريخ من خلال نصّك الروائيّ، وتقديم رؤية ما فيه. وعليك أن تكون الباحث في الهندسة، الأسلحة، الطبوغرافيا، الصحافة والحركة العمّاليّة وكلّ شيءٍ آخر. في عالم آخر ثمّة مَنْ يُقَدِّمُ هذه الخدمات للروائيّ، الخدمات الّتي تستنزف الزمن وتجعل وقت الكتابة مضاعفًا مرّات ومرّات. لك أن تتخيّل أنّ رواية مثل «زمن الخيول البيضاء» بدأ الإعداد لها عام 1985 وصدرت عام 2007، «ثلاثية الأجراس» بدأت العمل عليها عام 1990 وصدرت عام 2019، و«قناديل ملك الجليل» في عام 1998 وصدرت عام 2012، فما من رواية كتبتها لم يستغرق التحضير لها على الأقلّ خمس سنوات.
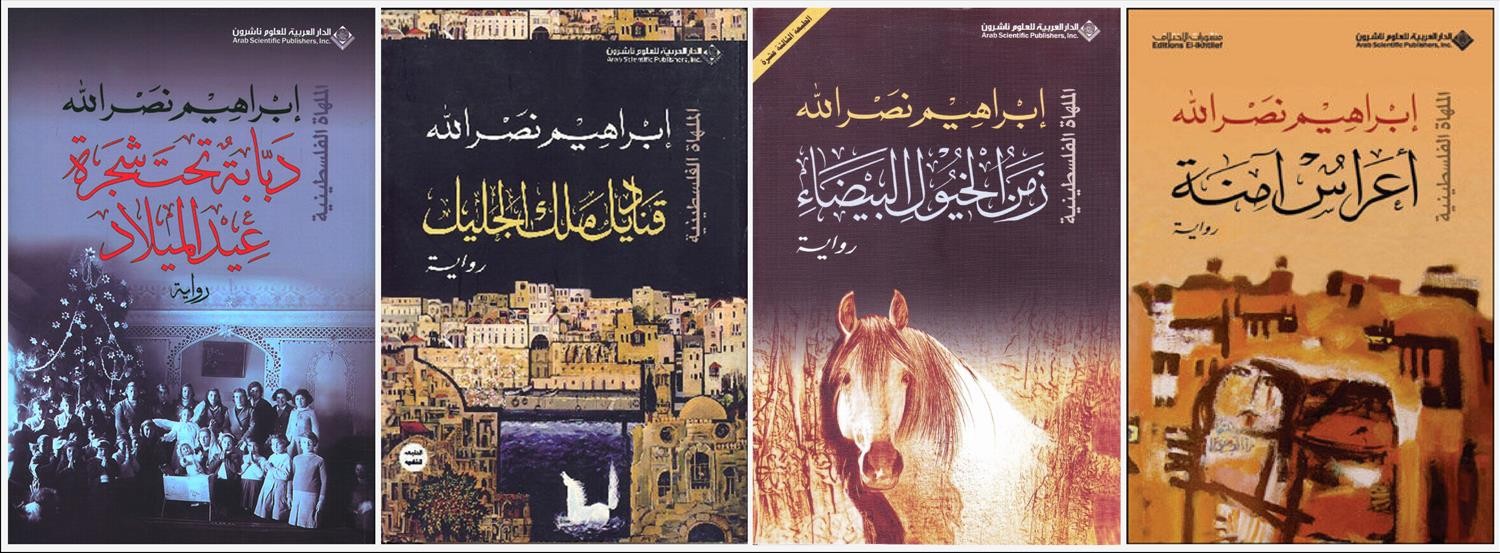
فُسْحَة: ما الفرق بين بناء الشخصيّة التاريخيّة وتلك المتخيّلة؟
إبراهيم: من المؤكّد أنّه عند الذهاب إلى شخصيّة تاريخيّة، فإنّ لها حدودها المعروفة والواقعيّة الّتي رسمها التاريخ، أو الواقع، أو الذاكرة، لكنّ المسألة كيف تذهب إليها وتخرجها من هذا الإطار لتوسّع مداها وترى الإنسانيّ داخلها، ذلك الإنسانيّ الّذي أَهْمَلَهُ التاريخ بالمطلق؛ فالتاريخ لم يذهب إلى ذاكرتها، أو أحاسيسها، بل إلى أفعالها والمعارك الّتي خاضتها. ثمّة دائمًا إطار للشخصيّة التاريخيّة يتوجّب عليك عند الذهاب إليها أن تحرّرها منه، أو يمكن القول إنّك تذهب إليها كهيكل عظميّ مسبوك بصلابة، وعليك العمل على أن يكون لها لحم وفكر وقلب وأحاسيس وطموحات لا يرينا التاريخ إيّاها، وهو ما تفعله مع الشخصيّة المتخيّلة في الوقت نفسه. لكنّك كثيرًا ما تذهب إلى التاريخ وتكتشف أنّك كنت مخدوعًا بشخصيّة تاريخيّة ما، ودائمًا أضرب المثل بشخصيّة فوزي القاوقجي في رواية «زمن الخيول البيضاء». عندما ذهبت إلى شخصيّة القاوقجي، ذهبت إليه بوصفه قائدًا وطنيًّا؛ أي أنّني ذهبت إلى صورة جاهزة، لكن، عندما بدأت بالقراءة والبحث وتتبّع مساره منذ بداياته في الحرب العالميّة الأولى ضابطًا في الجيش العثمانيّ، حتّى قيادته لجيوش الإنقاذ عام 1948، كتبت عنه بصفته شخصيّةً متآمرة، وإحدى القيادات العربيّة الّتي ساهمت في ضياع فلسطين وتتحمّل جزءًا كبيرًا من نكبتنا. الكتابة عن شخصيّة مثل هذه، متّفق عليها، تحتاج إلى جرأة كبيرة، ولو لم أكتب عنها بتلك الطريقة لأخفَقَتْ «زمن الخيول البيضاء» إخفاقًا مذهلًا؛ لأنّ أيّ اهتزاز في أيّ عنصر من عناصر العمل الإبداعيّ سينسحب على العمل بأكمله. لذلك حينما تذهب إلى التاريخ أو الحاضر الّذي سيصبح تاريخًا، أو حتّى المستقبل الّذي سيصبح جزءًا من التاريخ أيضًا، تذهب لا لتحكي الخراريف، فالخراريف لا تقول شيئًا، بل تذهب لتقول شيئًا عبر تلك الحكايات والقصص، وإن لم تقل شيئًا في التاريخ وفي شخصيّاته، متخيّلة كانت أم حقيقيّة، ففي ظنّي أنّ عملك لن يقول أيّ شيء.
فُسْحَة: بالتوازي مع مشروع «الملهاة»، ثمّة مشروع «الشرفات»، الّذي بدأ برواية «شرفة الهذيان» (2005) والآن يُسْتَكْمَلُ بــ «مأساة كاتب القصّة القصيرة» (2021)، وعادة ما يُقرَأُ المشروع على أنّه نوع من أنواع أدب السخرية المتمحور حول الشعور بالعبث إزاء أزمات الواقع العربيّ؛ فهل هو العبث اللامبالي والغارق باللاجدوى، أم هو العبث المحدق المحفّز على التغيير، مع أنّ مهمّة الرّوائي، في رأيي، ليست التغيير بالدرجة الأولى، بل الكتابة؟
إبراهيم: ذلك صحيح، الثورة، أو التغيير ليست من مهامّ الروائيّ، لكنّ مَنْ يقرأ هو مَنْ يثور. مهمّة الكاتب التأثير، وإذا لم يؤثّر فنحن نتحدّث عن ثورات جاهلة، وأيّ ثورة جاهلة ستُبْتَلعُ بسهولة. ربّما هذه إحدى المشاكل الّتي تواجهنا اليوم في العالم العربيّ وفي العالم بأكمله. نحن اليوم في فلسطين، إذا أردنا الحديث عن «هبّة القدس»، فهي هبّة شباب وشابّات يقرأون جيّدًا، ومن حسن حظّي أنّني أعرف الكثير منهم وعلى اتّصال معهم. هؤلاء يقرأون، يتأثّرون، وهؤلاء يستطيعون رؤية ما وراء أفعالهم، ومن دون ذلك ما كان ممكنًا أن يقوموا بما قاموا به. وهنا يأتي دور القراءة الّتي تزرع الوعي، والّتي لو لم تكن جزءًا منّي، لما كنت سأجلس أمامك الآن؛ لأنّني محصّلة كلّ الكتابات الرائعة الّتي تأثّرت بها من قبل. أمّا بالنسبة لمشروع «الشرفات»، فبالتأكيد ثمّة بعض الروايات الّتي تحمل حسّ العبث، وشخصيًّا لست من الكتّاب الّذين يعتبرون العبث النتيجة والحصاد الّذي أريده في كتابتي. أنت تكتب عن العبث وما يبدو لك وللبشر عبثيًّا لتغيّر الصورة وتهزّ الواقع الّذي تعيش فيه. مشروع «الشرفات» سبع روايات، ولفرط ما سُئِلْتُ من الأكاديميّين بشكل أساسيّ، ومن الباحثين، عن رواية «حارس المدينة الضائعة» (2006)، ورواية «براري الحمّى» (1985)، ورواية «عَوْ» (1990)؛ لماذا لا تكون ضمن المشروع مع أنّها في صلبه؟ بدأت أفكّر بها جزءًا من هذا المشروع، وسأضمّها إليه. وغير ذلك، أنا أعيش في عمّان، وأعاني في عمّان مع كلّ البشر في الأردنّ، ومصر، وسوريا، والسعوديّة، وفي أيّ مكان عربيّ آخر، وليست مصادفة أنّ أوّل رواية كتبتها كانت عن عذابات البشر في تلك الصحراء السعوديّة المليئة بالملاريا والسلّ، وكلّ تلك الأمراض المرعبة. وقد عبّرت روائيًّا عن تلك المعاناة قبل أن أكتب عن القضيّة الفلسطينيّة، ولا أعتبر ذلك مصادفة؛ لأنّ مَنْ يفهم ويعي عذابه، سيعي عذاب الآخرين بصورة أفضل وأعمق وأكثر إنسانيّة. أيّ إنسان يتعذّب جزء منّي، أيّ إنسان لديه قضيّة حقيقيّة جزء منّي. وهكذا يتحرّك مشروع «الشرفات» من جرائم الشرف في «شرفة العار» (2010)، إلى تلك الطامّة الكبرى الّتي ألمّت بنا في «شرفة الهذيان» المتمثّلة في احتلال بغداد وتدمير العراق، إلى ذلك الخوف من المستقبل الّذي أصابني على مستوى وجوديّ وإنسانيّ، وكاتبًا، في «حرب الكلب الثانية» (2016)؛ تلك المصائب والحروب الّتي اندلعت في العالم العربيّ والموت المجّانيّ، والتطرّف المرعب الّذي جعلك غير قادر على تعرّف صديقك من قاتلك، كلّ ذلك كان يؤرّقني وكان السؤال: إذا واصلنا في هذه الطريق فإلى أين سنصل؟ فجاءت «حرب الكلب الثانية» لتتحدّث عن المستقبل. ومع ذلك، حتّى الرواية المستقبليّة أعتبرها رواية تاريخيّة، لكنّه تاريخ عكسيّ. ثمّة مساحات واسعة تؤرّقني في العالم العربيّ، لذلك فمشروع «الشرفات» هو الوجه الآخر لمشروع «الملهاة»، وفي ظنّي، كان من الصعب أن يكون مشروع «الملهاة» وحيدًا، لأنّه لو كان وحيدًا لصار لديّ نوع من الفصام، كنهر بضفّة واحدة وذلك أمر مستحيل. نحن كفلسطينيين، في اعتقادي، لنا ضفاف كثيرة، ونهرنا بضفاف كثيرة، وعلينا أن نعي هذا التعدد ونعي هذا المأزق الّذي يلمّ بنا سواءً من أعدائنا المتناسلين من رحم عدوّنا وهمجيّته أو من رحم أصدقائنا الّذين يتكاثرون بصورة رائعة في العالم.
فُسْحَة: ما بين المشروعين ثمّة شخصيّتان؛ ثمّة شخصيّة فلسطينيّة في «الملهاة» متأزّمة، لكنّ شعورها بالأزمة محكوم بمعنى واضح، وثمّة شخصيّة مشروع «الشرفات»، الّتي في بعضها هي فلسطينيّة أيضًا، لكنّها تحمل شعورها بالعبث في ظلّ شعورها بالانسحاق سياسيًّا واجتماعيًّا؛ فما الفرق بين شخصيّة «الملهاة» وشخصيّة «الشرفات»؟
إبراهيم: أعتقد أنّ ثمّة تعدّد في نمط شخصيّات «الشرفات» وأنواعها، وثمّة تعدّد في شخصيّات «الملهاة» أيضًا، وإلّا سنقول إنّ كلّ شخصيّات «زمن الخيول البيضاء» هي شخصيّة الحجّ خالد، وذلك غير صحيح؛ لأنّ ثمّة شخصيّات أخرى متآمرة، وأخرى لا تعيش حياة تستحقّ العيش كالحجّ خالد، وأخرى متمرّدة، وأخرى تسعى إلى التغيير، حتّى الكائنات الحيوانيّة في رواياتي أعتبرها شخصيّات حقيقيّة ومؤثّرة، ويندر أن يكون ثمّة رواية بلا كائن حيوانيّ مركزيّ كالحصان، أو الكلب، أو الذئب، أو الطيور. مشروع «الشرفات» كذلك، فشخصيّاته متنوّعة. وثمّة مسألة أخرى هي أنّ الشخصيّات الفاعلة في «الملهاة» هي الشخصيّات الرئيسيّة عمومًا، لكنّ الشخصيّات الفاعلة في «الشرفات» هي الشخصيّات الثانويّة والهامشيّة، وهذه مفارقة تحتاج إلى تأمّل. لكن، في العموم، لا أستطيع القول إنّ ثمّة شخصيّة ثانويّة في أيّ من رواياتي، فما دمت تضعها في الرواية فهي إذن شخصيّة ضروريّة، وما دامت شخصيّة ضروريّة فهي إذن شخصيّة رئيسيّة؛ لذلك أحبّ شخصيّاتي «الثانويّة» جدًّا، وقد تستغرب أنّني قد أحبّها أكثر بكثير من الشخصيّات الرئيسيّة. كلّ ذلك في «الملهاة» و«الشرفات» يحتّم عليك تنوّعًا واسعًا في أنماط الشخصيّات، لكن ربّما تكون المساحات الّتي يمكن تناولها في «الشرفات» أوسع على مستويات متعدّدة، كالمستقبل مثلًا الّذي ذهبت إليه في «حرب الكلب الثانيّة» ولم أذهب إليه بعد في مشروع «الملهاة الفلسطينيّة». ما يهمّني وما يؤرّقني في أيّ كتابة شعريّة أو روائيّة هو ذلك التنوّع؛ التنوّع الفنّيّ، والتنوّع في أنماط الشخصيّات، وكذلك في الفترات الزمنيّة.
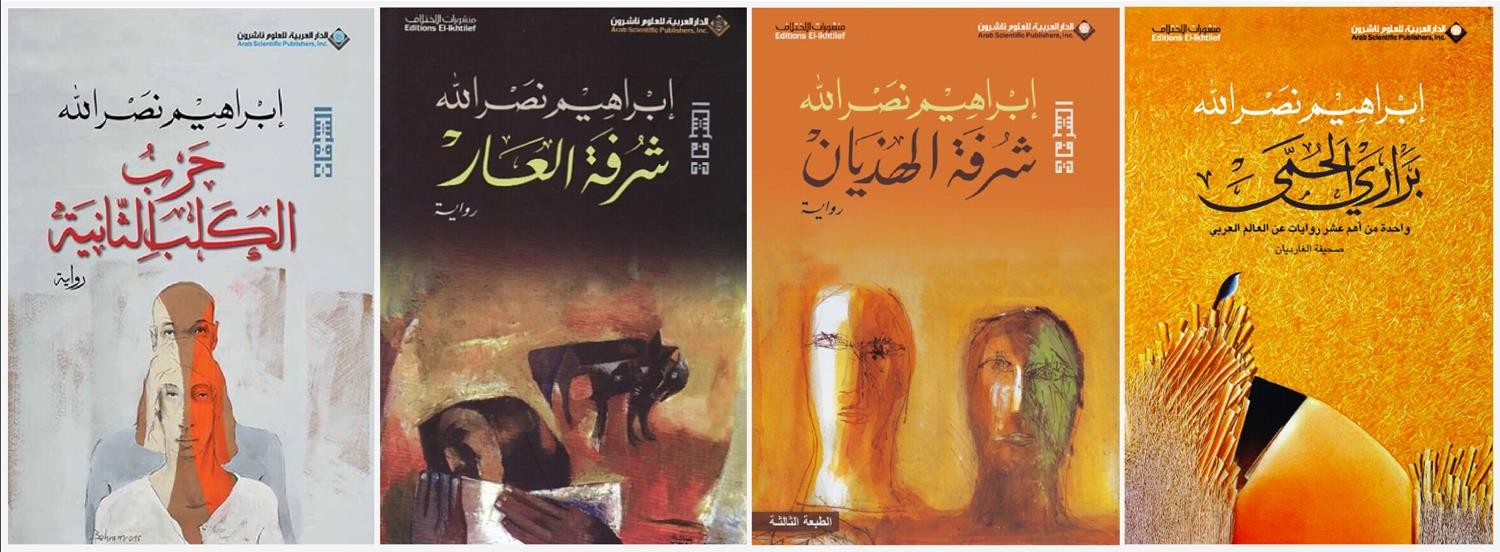
فُسْحَة: تتقاطع إجابتك مع سؤالي الآتي، حول إذا ما كان يشكّل العمل داخل مشروع أدبيّ، مثل «الشرفات» أو «الملهاة»، تقييدًا وضغطًا على مخيّلة الروائيّ؟
إبراهيم: كان أوّل ما فكّرت فيه عندما بدأت مشروع «الملهاة الفلسطينيّة» التحرّر من فكرة الرباعيّات، والخماسيّات والثلاثيّات، فلو كان مشروع «الملهاة» مكوّنًا من رواية واحدة من اثنيّ عشر جزءًا، فذلك سيكون كارثة على القارئ وعليّ شخصيًا. لماذا؟ لأنّك تكون قد وضعت لنفسك بناءً فنّيًّا مسبقًا ومُحاصَرًا، وعليك أن تسكنه طوال هذه السنوات. لقد منحني قراري بأن يكون لكلّ رواية جوهرها وبناؤها الفنّيّ الخاصّ وشخصيّاتها الخاصّة، منحني إمكانيّة التجدّد والتجديد بين الرواية والأخرى والقدرة على التنويع الفنّيّ، وذلك أكثر ما يسعدني في الكتابة، أن تكون قادرًا على تقديم أشكال فنّيّة متنوّعة في كلّ رواية، لأنّ ذلك يمنح القارئ حرّيّة أيضًا في قراءة مشروعك الأدبيّ؛ فقد يقرأ هذه الرواية أو الأخرى، ولن تحبسه في رواية مكوّنة من اثنيّ عشر جزءًا، وذلك كان وعيًا مبكّرًا لديّ في أن يكون التنوّع أساس هذا المسار الطويل للمشروعين.
فُسْحَة: مَنْ الكتّاب الّذين أثّروا فيك روائيًّا وشعريًّا؟
إبراهيم: الحقيقة أنّ السينما هي الّتي أثّرت فيّ في بداياتي، وهي الّتي فتحت عينيّ على الكتابة، بمعنى أنّني بدأت ألاحظ الأفلام المقتبسة عن روايات معيّنة فأذهب لقراءتها. عادة ما كنت أذهب خلال الفترة الإعداديّة من دراستي من مخيّم الوحدات إلى وسط البلد في عمّان، سيرًا على قدميّ، لأقرأ الكتب داخل مكتبة أمانة العاصمة؛ فلأنّني كنت صغيرًا بلا بطاقة هويّة لم يكن مسموحًا لي استعارة الكتب وكان عليّ قراءتها داخل المكتبة. من بين الأعمال الّتي أثّرت بي إلى حدّ كبير كانت رواية «الأرض» للروائيّ الفرنسيّ إميل زولا (1840-1902)، وكذلك روايته «التحفة»، وأعترف أنّ تأثير الروايات العالميّة جاء أوّلًا، من كتّاب مثل تشارلز ديكنز (1812-1870)، وكتب مثل «آلام فارتر» ليوهان غوته (1749-1832)، ومجموعة «الجدار» القصصيّة لجان بول سارتر (1905-1980)، ورواية «الجوع» للروائيّ النرويجيّ كنوت همسون (1859-1952)، والأخيرة كان لها تأثير كبير جدًّا عليّ إلى درجة أنّني لا زلت أحتفظ بنسختي القديمة منها حتّى اليوم. كذلك تأثّرت بأعمال الأميركيّ راي برادبري (1920-2012) مؤلّف رواية «451 فهرنهايت». لكنّ أوّل هزّة كبرى كانت عندما قرأت مجلّدات غسّان كنفاني (1936-1972) وأنا أُدَرِّسُ في السعوديّة؛ فعندما قرأت «رجال في الشمس»، أحسست أنّني كنت في الخزّان، ولسبب ما رفضت البقاء فيه ودُرْتُ حول مركز الحدود ونجوت، نجوت لكنّني وجدت نفسي في الصحراء مصابًا بالملاريا وعلى وشك الموت. حينما تقرأ الكتاب في مكانه، أو «رجال في الشمس» تحت الشمس فعلًا، وأنت مصاب بالمرض فعلًا، وتشعر أنّك على وشك الموت، يتغيّر المعنى تمامًا، كأيّ شخص يقرأ رواية عن الحرّيّة وهو في السجن.
شعريًّا، تأثّرت وأنا في المدرسة وافْتُتِنْتُ بإبراهيم طوقان (1905-1941)، افْتُتِنْتُ به لأنّ كثيرًا من قصائده تنطوي على قصّة، دائمًا ثمّة سرد في قصائده، وذلك أثّر بي إلى حدّ كبير جدًّا وانسحب التأثير على نتاجي الشعريّ، بحيث يكاد لا يكون ثمّة قصيدة من قصائدي لا تحتوي على شكل من أشكال السرد. أعتقد أنّ هؤلاء مَنْ أثّروا فيّ بشكل عامّ، وبالمناسبة، إبراهيم طوقان هو السبب الأساسيّ في كتابة روايتي القادمة، والّتي تضمّ تجربتي مع إبراهيم طوقان ومعرفتي ولقائي لاحقًا بفدوى طوقان (1917-2003).
فُسْحَة: هل الرواية عنهما؟
إبراهيم: هم جزء أساسيّ منها باعتبارهم محرّضين على الجمال، الشعر والوطنيّة، وعن العلاقة الاستثنائيّة أيضًا الّتي جمعت بيني وفدوى طوقان؛ لأنّ الرواية تستند كثيرًا على سيرتي الذاتيّة.
فُسْحَة: ومَنْ هي الشخصيّة الروائيّة الهاجس، أو الّتي غَلَبتْكَ روائيًّا ولازمتك لوقت طويل؟
إبراهيم: ثمّة شخصيّات تغلبني دائمًا، والرواية تغلب أيضًا، فأحيانًا تحضّر للرواية بنسبة 200%، لكن حينما تبدأ الكتابة تكتشف أنّك استخدمتَ فقط 20% ممّا حضّرت؛ لأنّ العمل الإبداعيّ يأخذ مساره خارج الإطار الّذي كنتَ قد فكّرتَ فيه من قبل. بمعنى أنّه يبدأ حياته الحقيقيّة وتبدأ الشخصيّات بالتوالد؛ ففي «دبّابة تحت شجرة عيد الميلاد» (2019)، لم أكن قد فكّرت في شخصيّة سلامة، لكنّه ظهر في لحظة ما وكان كالولد ‘الْغَلَباويّ‘ الّذي لم أستطع السيطرة عليه بالمطلق، ورغم أنّه شخصيّة ثانويّة، إلّا أنّني شعرت أنّه ابتلع بقيّة الشخصيّات الأخرى. في الرواية الجديدة ثمّة شخصيّة «العمّة» الّتي تظهر وتبتلع المساحات من حولها، ودائمًا ما يحدث هذا؛ أي أنّ الشخصيّات تتحرّك ضمن منطقها الخاصّ، وإذا لم تفعل ذلك فلن تصل بصفتك كاتبًا إلى النتيجة المرجوّة منها.
فُسْحَة: اعتاد الروائيّ الفرنسيّ غوستاف فلوبير (1821-1880) القول إنّ رواية «مدام بوفاري» قتلت رواياته الأخرى لشهرتها الواسعة؛ فما الرواية الّتي تعتقد أنّها تغلّبت وقتلت أخواتها؟
إبراهيم: إنّها مشكلة كبيرة أن تكون بلا رواية قاتلة.
فُسْحَة: ومشكلة أن تكون برواية قاتلة؟
إبراهيم: ومشكلة أن تكون، هذه هي المفارقة الرهيبة، أن تعيش حياتك كاتبًا دون علامة فارقة مشكلة، وأن تكون لك علامة فارقة تبتلع بقيّة الأعمال مشكلة أيضًا؛ ففي هذا بعض الحزن والغبن. لكن، ربّما تكون «زمن الخيول البيضاء» قد نالت مدًى واسعًا، لكنّي دائمًا ما أُرْجِعُ ذلك إلى الفترة الزمنيّة الطويلة منذ نشرها، وعندما جاءت «قناديل ملك الجليل»، أخذت تتحرّك بسرعة لا تقلّ عن سرعة «زمن الخيول البيضاء»، وشعرت أنّها حقّقت ما حقّقته الأولى. «ثلاثيّة الأجراس» أيضًا حديثة الصدور عام 2019، وأراها تتقدّم بصورة استثنائيّة. حتّى الرواية الأولى، «براري الحمّى»، ونحن نتحدّث عن رواية كُتِبَت منذ ما يزيد على واحد وأربعين عامًا، لكنّها لا تزال حاضرة على مستوى الدراسات والتقدير العالميّ لها. أيضًا «طيور الحذر»، و «أعراس آمنة»، رغم صغر حجمها، لكنّ حجم تقديرها لافت؛ فقد صدرت في 15 طبعة شرعيّة حتّى الآن، غير الطبعات المزوّرة والإلكترونيّة. بشكل عامّ، من المؤكّد أنّ «الملهاة» حقّقت مدًى أوسع من مشروع «الشرفات» بالنظر إلى مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة منذ ما يزيد على مئة عام، لكنّ مشروع «الشرفات» حاضر أيضًا على مستوى الانتشار والدراسات الأكاديميّة والتقدير الكبير. بالنسبة لي، أنا راضٍ بما حدث حتّى الآن؛ أن يكون ثمّة أكثر من رواية مركزيّة، فلن تكون كلّ الروايات مركزيّة لأيّ كاتب في العالم. من الجميل أن يكون لديك مجموعة من الأعمال المركزيّة، وإذا كان لديك عمل واحد فأنت محظوظ للغاية، وإن كانت لديك مجموعة فأنت محظوظ أكثر وأكثر، وإذا كان الناس ينتظرون عملًا جديدًا منك باستمرار فأنت أكثر حظًّا. ليس ثمّة رواية بإمكانها قول كلّ شيء وليس ثمّة كاتب قادر على قول كلّ شيء. كما أشرت في البداية، كلّ واحد منّا يعمل ضمن طاقته، وثقافته، وموهبته وتجربته أيضًا، فتجاربنا مختلفة كتّابًا، ومنسوب الحياة في داخلنا، ووعينا الفنّيّ بما حولنا يختلف بين الكاتب والآخر. كلّ ما أتمنّاه أن أقدّم شيئًا جميلًا للحياة ولشعبي، وللأدب، شيئًا راسخًا قادرًا على العيش بعدنا، ويكون الزمن ناقده الأهمّ، وهو أصعب النقّاد وأقساهم؛ فعندما يستطيع أيّ عمل فنّيّ الصمود أمام الزمن، على كاتبه أن يكون سعيدًا بذلك.
فُسْحَة: لقد حصلت من قبل على عدد من الجوائز الأدبيّة العربيّة المهمّة، ومن بينها جائزة «البوكر» عام 2018 عن رواية «حرب الكلب الثانية»، وجائزة «كتارا» عاميّ 2016 عن رواية «أرواح كليمنجارو»، و2020 عن رواية «ثلاثيّة الأجراس: دبابة تحت شجرة عيد الميلاد»، إضافة إلى جوائز أخرى. لكنّ حَدَثَ التطبيع الإماراتيّ الصهيونيّ عام 2020 شكّل لحظة فارقة في تاريخ جائزة «البوكر»، الّتي دَعَتْ عديدُ الجهات والشخصيّات الفلسطينيّة والعربيّة إلى مقاطعتها، بعد إعلان اتّفاقيّات التطبيع وتصاعد حدّة العداء الإماراتيّ الرسميّ وغير الرسميّ للشعب الفلسطينيّ ولقضيّته؛ فما تقييمك لتجربة الجائزة الأدبيّة عربيًّا، وما هو الموقف الآن من جائزة «البوكر »الإماراتيّة؟
إبراهيم: أعتقد أنّ الجائزة الأدبيّة أضرّت بكلّ كاتب كتب عملًا وفي ذهنه الجائزة ومعاييرها، لكنّ الكاتب الّذي كتب ما يريد متمرّدًا، وقدّرتْ هذه الجائزة أو لجنة التحكيم كتابته، فذلك يُعدّ تقديرًا لعمله أيًّا كان محتواه. لقد بدأت التحضير لرواية «دبّابة تحت شجرة عيد الميلاد» قبل عشرين أو خمسة وعشرين عامًا من إنشاء جائزة «كتارا»، لكن حدث أنّها قُدِّرَت، وأنا سعيد أن تُقَدَّر هذه الرواية الفلسطينيّة من بين 930 رواية تقدّمت لهذه الجائزة عام 2020؛ فهذا رقم مهول جدًّا. كذلك كنت سعيدًا بفوز «أرواح كليمنجارو» وأن تكون من بين ثلاث روايات فلسطينيّة أو عن فلسطين تفوز بهذه الجائزة عام 2016. ذلك إنجاز يُنْتَزَع للشعب الفلسطينيّ الّذي من حقّه أن يُقَدَّر، ومن حقّ الأدب الفلسطينيّ أن يكون قادرًا على إثبات الوجود؛ فالكتابة، بالنسبة إلينا، فعل وجود بالدرجة الأولى. اعتادت غولدا مائير القول: لو كان الفلسطينيّون شعبًا لكان لهم أدب. ونحن لنا أدبنا، وسينمانا، وفنوننا المتنوّعة، ونصل إلى المهرجانات العالميّة كمهرجان «كان» وحفل «الأوسكار».
لقد كنت سعيدًا بفوزي بجائزة «البوكر»، وأنّ «حركة المقاطعة» كانت أوّل من هنّأني بالجائزة. لكن، حينما تطلب «حركة المقاطعة» من الكتّاب والكاتبات في الدورة الأخيرة مقاطعة الجائزة، وسأكون صريحًا هنا، ومع ذلك يذهب بعضهم ويستلم الجائزة، فذلك عيب وعيب كبير. أنت تكتب لتعبّر عن نفسك وقضيّتك بشكل أساسيّ، لكنّني ضدّ أيّ جائزة تمنحها دولة معادية لطموحات الشعب الفلسطينيّ؛ ولذلك وقّعنا البيان الّذي شارك في صياغته وتوقيعه عدد من الفائزين بالجائزة وأعضاء لجان تحكيم سابقين، حتّى أعضاء إدارة سابقين في الجائزة، والّذي طالبنا فيه بتحرير «البوكر» من التمويل الإماراتيّ، لأنّ ما تفعله هذه الدولة شيء مرعب ولم تجرؤ أيّ دولة عربيّة على فعله، حتّى تلك الّتي وقّعت اتّفاقيّات سلام من قبل. من المستحيل أن يقبل أيّ كاتب، إذا كان فعلًا كاتبًا مخلصًا لضميره ومبادئه ولنفسه أن يذهب ويأخذ جائزة إماراتيّة اليوم. في زمن ما كان من الممكن استلام الجائزة، ومن قبل فاز محمود درويش بجائزة «سلطان العويس»، وفاز بها جبرا إبراهيم جبرا، وفدوى طوقان، وإدوارد سعيد، وغيرهم، وفزت بها أيضًا عام 1998. هذه الإنجازات، أعتبرها، ليست فرديّة أو شخصيّة بل هي إنجازات جمعيّة؛ فما يحقّقه كاتب، مبدع، مدرّس، فنّان فلسطينيّ، في أيّ مكان في العالم، هو دلالة على أنّ ثمّة شعب حيّ قادر على انتزاع تقدير العالم به وبشعبه. لكن حينما يكون ثمّة دولة معادية للشعب الفلسطينيّ وتتفوّق أو تكاد تتفوّق في عدائها للشعب الفلسطينيّ على العدوّ الصهيونيّ، فعليك أن تقف وتقول لا، وأن تكتب أيضًا ضدّها، وبوضوح شديد.

كاتب وباحث ومترجم. حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسيّة، والماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيليّة من جامعة بير زيت. ينشر مقالاته في عدّة منابر محلّيّة وعربيّة، في الأدب والسينما والسياسة.