** كتاب "طروحات عن النهضة المعاقة" للمفكر العربي عزمي بشارة صدر عام 2003، ونُشر كسلسلة مقالات في صحيفة "فصل المقال"، يجمعها همّ عرض وتحليل المعوقات التي تقف في وجه النهوض بالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني نحو التحديث، ويلتقي فيها البعد النظري بالاجتماعي والسياسي. نُعيد في موقع "عرب48" نشْرَ هذه المقالات لأهميّتها وراهنيّتها.
_____________________________________________________________________________
حول أهمية المكانة ومكانة الأهمية
يقول المثل الشعبي: "الكبرة ولو على خازوق". ولا بد أن يلتفت النظر إلى النزعة العمرانية لدى الطبقة الوسطى العليا العربية الجديدة، بعد أن اضمحلت الطبقة الوسطى أو كادت تختفي، ورجال الأعمال المتوسطين أو الكبار من الأغنياء الجدد "النوفو ريش" لبناء القصور على مساحة أرض تصلح لبيوت عادية، وإلى رفض المليونير استثمار أمواله في مرفق إنتاجي قبل أن يظهرها نحو الخارج على شكل حجارة كأنه فرعون يبني الأهرام أثناء حياته آملاً أن يفرغ منه قبل انتقاله إلى العالم الآخر. وقد درج بعض الفلسطينيين العائدين من الخليج – لأنهم لا يستطيعون البقاء في الخليج، حتى بعد عقود من العمل، وانعدام قوانين التجنيس أو العمل بها ظاهرة لا تميز دول الخليج وحدها بل كل الدول العربية – أن يبنوا بيوتًا بمعظم ثروتهم، أو بنصفها على الأقل، إثباتًا للوجود على الأرض ونفيًا لحالة اللجوء. ولا يمكن تجنب رؤية العلاقة بين هذه الواقعة التي تميز العمارة الفلسطينية، وبين اللجوء، وبين فقدان البيت في الصغر، وتضخيم البيت عند المقدرة. لكن سياق اللجوء غير قائم في كل مكان يتم فيه التظاهر بالأهمية بتكلفة باهظة.
ليست العمارة الكبيرة والجميلة دائمًا دليل بحث عن المنزلة محكوم بعقدة النقص. ومن النخب ذات المكانة status في المجتمع العربي من حقق نجاحًا حقيقيًا في المجال الاقتصادي، أو في مجالات الإبداع المختلفة. ومنهم من تسود حياته الاجتماعية والعائلية قيم متنورة. ونحن نرى في أبناء "العائدين" من دول الخليج أو المهاجرين العرب الآخرين معالم نهضة حقيقية لا تتجلى للأسف في بلادهم، بل في جامعات أميركا وكندا حيث هرب أهلهم بعد التقاعد من دون التخلي عن الهوية العربية. هؤلاء إثبات حي على أنه لا عطب جوهريًا في الفرد العربي القادر على الانطلاق في الظروف الاجتماعية الملائمة، حتى أثناء بحثه عن معنى. وبطبيعة الحال فإن المستوى التعليمي والثقافي لدى النخبة أعلى منه في المجتمع بشكل عام. كما أن القيم السائدة لدى الطبقات العليا في البلاد العربية أكثر تسامحًا وانفتاحًا وليبرالية من أحياء الفقر. نقول ذلك قبل أن نتهم بالتعميم لدى الاستمرار بالقراءة، فليس التعميم هو هدف هذه الأطروحات، ولا توزيع العلامات في التنوير على القوى الاجتماعية المختلفة مجالها. وإنما نحن نتناول الظواهر التي نعتبرها من عوائق النهضة.
المنزلة هنا تعني prestige. وأهميتها ليست عقلانية إطلاقًا في المجتمع العربي، ولا في مجتمع الأميركين الأفارقة – حيث يتناسب طول السيارة عكسيًا مع ارتفاع المكانة الاجتماعية – ولا في أي مجتمع آخر. ولا شك أن دافع الرغبة في أن تكون محبوبًا، دافع الرغبة في الحصول على اعتراف recognition الآخرين بالفرد هو من أهم دوافع السلوك الإنساني بشكل عام. وقد اعتبر فلاسفة التنوير الإسكتلندي، فيرغسون بشكل خاص، هذا الدافع من أهم عناصر التماسك الاجتماعي والحفاظ على وحدة المجتمع. وإذا كان هذا الدافع إنسانيًا عامًا برأي فلاسفة التنوير فما المشكلة إذاً؟
يُشعر الحصول على الاعتراف، نتيجة العمل والإنجاز، الإنسان بأهمية ذاته. لكن ما نتحدث عنه كعائق هو الرغبة في الاعتراف بالأهمية، بغض النظر عما إذا كان قد سبق ذلك جهد مفيد مبذول، وبمعايير المظهر أساسًا: ومن هنا الاستخدام المنتشر لمصطلح "التمثيل" و"الفرجة"، والـ"show off" ومفهوم "الحقيقي" أو "غير الحقيقي" في وصف البضائع الاستهلاكية، واستخدام مفاهيم "الأصلي" أو "غير الأصلي" في العامية في وصف البضائع الاستهلاكية، أي في غير سياقاتها، إنه التظاهر بالأهمية والمكانة.
وأقصر الطرق إلى ذلك هو الإحتكاك بذوي الأهمية: "المهمّين"، فهو بحد ذاته يكسب الإنسان أهمية. بهذا المعنى فإن: "فلان صديقي" عبارة محببة، مع أنا قد تورط قائلها بأن يطلب الناس منه التوسط لهم عند صديقه (الوزير أو المدير أو الخفير أو الأمير أو السفير، وغيرهم على هذا الوزن المحبب إلى قلوب محب الأهمية، الشغوف بالمكانة حتى لو أدت به أن يصبح "شوفير" لدى المهمين وأولادهم). وينشأ نظام كامل من التقرب من مصادر الجاه والسلطة أو الثروة بواسطة صديق صديق قريب شخص تُدّعى صداقته، ويصبح البلد كله "بيت ضيق متسع لألف صديق". إنهم لا يبغون من التقرب فائدة لأنفسهم بالضرورة، بل غالبًا ما يريدون شعورًا بالأهمية. وقد تتوفر له ترجمة مصلحية عملية، يكلفهم مقابلها خدمات عبر نظام كامل من الزبائنية clientalism والتراتبية في أهمية "الصداقات" و"الأصدقاء" وكيفية توظيفها.
وقلما يجيب أحد من هذه الطبقة عن عمله أو عمل قريب له هكذا من دون تعليق حول أهمية ما يقوم به من نوع "إن ابن عمي يعمل في السوبر ماركت". ثم لا بد أن يأتي الاستدراك: "لكنه مسؤول عن عشرة موظفين" أو "مدير قسم". وقس على هذا المنوال: غياب تام للإجابات حول المهنة من دون استدراك حول أهميتها، أو اعتذار عن عدم أهميتها. لذلك لا يوجد عندنا بواب بل مدير دائرة الباب. وبهذا المعنى أيضاً كثرت فئة المديرين والمديرين العامين في عهد السلطة الفلسطينية مثلًا بشكل أثار الخيال الشعبي الفلسطيني أيما إثارة.
وهذه ليست أول ولا آخر مظاهر الشعور بالأهمية. فهي تؤدي إلى التضحية بخصوصية، أو حتى فردية، الإنسان لحساب فردانيته. فهي غالبًا ما تؤدي إلى التقليد المكلف. فإذا كان فلان يملك بيتًا بمساحة كذا، وسيارة من طراز كذا، بتكلفة تترك السامع مشدوهًا محتارًا أيدهش من طولها أم من سعرها، فإن الراغب في الشعور بنفس الأهمية وإثارة نفس التعابير على وجوه المعجبين بالناجحين يصر على أن يملك نفس الأشياء، أو أن يبزّ أقرانه في هذا المجال.
والمعجبون بـ"الناجحين" يشكلون بحد ذاتهم ثقافة اجتماعية خاصة تتمحور حول متابعة "الناجحين" وتعداد وحفظ مثابر ومجتهد عن ظهر قلب، لمقادير ثرواتهم ونجاحاتهم واخفاقاتهم، وآخر صفقة وآخر خسارة لهم، وكم كلف فلانًا حفل زفاف ابنته، وثمن سيارته. وهم يفخرون بامتلاكهم هذا الكم من المعلومات العامة "حول من ربحوا المليون" بطرق مشروعة وغير مشروعة، من دون أن يؤثر فقدان الشروعية على الإعجاب.
وصاحبنا الراغب أن يصبح موضوع حديث المعجبين بالناجحين قد ينجز ذلك على حساب برامجه المتعلقة بالاستثمار، أو بضمان الشيخوخة، أو أمن العائلة المعيشي، ولو بالقروض والديون، أو الاختلاس في الحالات المتطرفة. ولا شك إطلاقًا بوجود علاقة بين الفساد والاختلاس وبين ضغط الطبقة الاجتماعية، ضغط المكانة والمنزلة الذي يبدأ في الفئة الاجتماعية التي ينبغي تقليدها. هذا الضغط الذي ينتقل إلى داخل العائلة أولاً عبر الزوج ثم عبر الزوجة (في حالة قبول المرأة أحد أسس دونيتها وعوائق تحررها، أي وظيفة الزوجة الجميلة المستهلكة، التي غالبًا ما تُشكّل كثر طلباتها مصدر فخر واعتزاز للزوج. كأن الزوجة يخت فاخر يتطلب الاحتفاظ به كمًّا هائلًا من مصاريف الصيانة. في هذه الحالة تحاول المرأة استثمار دونيتها، لكن عبر تكريس هذه الدونية، في الوقت ذاته، من خلال نفس الفعل) والأبناء والبنات الذين قد يبدعون في مجال الطلبات عبر الفراغ القيمي والثقافة الاستهلاكية التي تميّز العلاقات الاجتماعية والثقافة السائدة لدى أوساط واسعة من هذه الفئة.
لاحظ أن المرأة في هذه الحالة تتحول إلى أداة. أي أن المرأة الجميلة هي من أدوات المكانة. والخطر هو في تذوُّقها لهذا الدور حتى تتحول إلى دمية "باربي" مكبّرة، خصوصًا إذا سبق أن تربّت على احتضان وحب نموذج "باربي" منذ الطفولة. وعندما تصبح المرأة "باربي" فإنها تُصمد داخل العائلة، أو في مراكز التنحيف والرياضة والداييت الغذائي والأساطير المختلفة حول دور قشور الفواكه والخضار في تنعيم الجلد، أو دور قشور الحياة عمومًا: من قشور النجوم والفنانين إلى سخافات الأساطير والأبراج، وما تؤدي إليه من تثخين العقل وتبليد الإحساس. وقد يُخترع لها نوع خاص استهلاكي من التديّن بمبشرين واعظين دعاة شباب دجالين يعرضون عليها دينًا مسهّلًا استهلاكيّا لتصميم آخر مختلف لأوقات الفراغ.
وعندما تصبح المرأة "باربي" داخل العائلة فإنها قد تواجه خطر أن تصبح خارجها أداة للغرائز الجنسية في نوع من "الباربي الخليعة" التي لم يُسعف الزمن روث هاندلر فتوفيت قبل أن تخترعها، والتي قد تتحول إلى أداة للمكانة والبريستيج أيضًا لدى فئات منحلة أخلاقيًا توضع فيها الفتيات التي نجح الرجل بمضاجعتهن مثل نجوم على كتف الرجل الـ"ماتشو" لتشير إلى درجة رجولته. وقد تتقمص المرأة هذا الدور بشكل مقلوب ليصبح عدد الرجال مقياسًا لدى أنوثتها – ولتستثمر هي في عملية استخدامها كأداة. المرأة مرة أخرى أداة. ولا تكون المرأة كيانًا قائمًا بذاته، ولا حتى عندما تطرح ثالثًا كأم وكوطن، أي كرمز للانتماء والخصوبة في الصور البيتية والملصق السياسي.
لا توجد أمة في الدنيا تشغّل فئاتها الميسورة هذا العدد من الخدم المستوردين في تربية الأطفال، من دون أن يرافق ذلك، أو يترتب عليه، تحرر أو تقدم ملحوظ في مكانة المرأة. إنه ليس تحرر المرأة على حساب عبودية غيرها، بل عبودية من طرازٍ فاخر على حساب عبودية من نوع رديء. وربما حررت عبودية المشغّلة، نتيجة لعبودية الشغّالة، حيزًا أكبر من الوقت للثرثرة لدى هذه الفئة الاجتماعية التي تتولى فيها "الخادمات" أو "الشغالات" (أو السريلانكيات وهو إسم "الفيرما" الأولى ويطلق على كافة أنواعها مثل "الهوفر و"الكلينكس") عملية منح الحنان للأطفال معظم ساعات اليوم. ويتعلم هؤلاء الأطفال، في سياق التعامل مع الشغالين والشغالات أن هنالك بشرًا "خدّامون" يأمرهم مشغلوهم بجفاف وبوجه خالٍ من التعابير، وبلغة عربية ركيكة، أو بلغة إنكليزية أكثر ركاكة، كأنهم روبوت بشري لا يتوقع من أحد إلا أن يعطي الأوامر بدرجات مختلفة من اللطافة أو القسوة. تعيش الشغالات في البيت مع العائلة وهنّ خارجها، ويُصطحبن حتى وقت السفر لرعاية الأطفال في غرفة الفندق.
وقد حدّثني صديق ومحاضر جامعي، ووطني فلسطيني تقدمي من النوع الذي أمضى العشرين سنة الأخيرة في محاولة لربط القضية الفلسطينية بكل ما هو تقدمي وتحرري وضد كل ما هو محافظ ورجعي، وضد سياسة الولايات المتحدة، حدثني أنه عاد مع زوجته من الولايات المتحدة إلى رام الله بعد اتفاقيات أوسلو، مع أنه من بلد قرب يافا، ليساهم في بناء إحدى المؤسسات الثقافية. لكن زوجته، المحاضرة الجامعية من هاواي، بدت بالنسبة لعنصريينا التافهين، الشاعرين بالأهمية والشغوفين بالمكانة بلا سبب واضح، على أنها سريلانكية أو فيليبينية، أو من سكان جزر المحيط الهادئ. والأمر سيان بنظرهم، مثلما أن كل العرب محمد، وكلهم سُمر بشارب في نظر الصهيوني المتوسط. وما أن خرجت السيدة الدكتورة إلى شوارع رام الله للتسوق حتى لاحظت أنهم يعاملونها بفظاظة في السوبرماركت. أكثر من ذلك فقد حاول بعض الشباب التحرش بها. لم تفهم كيف أن شعبّا تحت الاحتلال قد يحمل مثل هذه الآراء العنصرية المسبقة. لقد فوجئت بأنها تعامل مثل "خادمة سريلانكية"، كما فوجئت بوجود خادمات من الشرق الأقصى لدى فئات، ولو قليلة، من نخب الشعب الواقع تحت الإحتلال. وكانت هذه من أولى ثمار أوسلو: أخيراً صار لدى النخبة الفلسطينية خادمات. كم هي معبرة هذه الظاهرة عن وظيفة اتفاقيات أوسلو!
هنالك خطر دائم ونزعة دفينة في المجتمع العربي للتعالي على الشعوب الأخرى غير الغربية (ما عدا تلك التي يتخيلها أصحاب العقلية التي نعالجها قصص نجاح مثل اليابان والصين) بنفس درجة الشعور بالنقص أمام الغرب ومحاولة إثارة إعجاب الغربيين. هذه مأساة ثقافة "نصف بيضاء" يلاطف حاملوها البيض ويعتبرون البياض صفاءً والسواد تلوثًا واتساخًا، والسمرة، أو اللون القمحي، أصالة مظلومة تحتاج لمن يكتشف كم هي بيضاء في الواقع. إنها ثقافة متعالية على غير البيض وتحمل مشاعر النقص أمام البيض. صحيح أن العرب كانوا مستعمرين (بفتح الميم)، وناضلوا ضد الاستعمار، وطوروا في مرحلة من المراحل علاقة تضامن مع الشعوب الأخرى الواقعة تحت الاستعمار، في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وهذا يؤسس لتراث تحرري. لكن بعض العرب كان في الماضي يتاجر بالعبيد من أواسط أفريقيا مع المستعمرين. ولم تلغ العبودية في بعض الأقطار العربية إلا قبل عقود، وهذا يؤسس لتراث من نوع آخر.
في بعض البلدان العربية يستخدم الناس كلمة "العبيد" أو "العبد" عند الحديث عن الأفارقة أو الأميركيين الأفارقة أو العرب من السودان وغيرها. وكثيرًا ما يقال بالعامية "عبد أسود" للتدليل على الوضاعة: "لو أني عبد أسود كانوا احترموني أكثر من هيك"، "ولو ما بدهم يزوجوني إياها؟ بحسبوني عبد أسود!". وهي أسوأ حتى من كلمة negroes، الزنوج، التي يعتبرها الأفارقة عنصرية. فكلمة عبيد تعني مباشرة ومن دون لف أو دوران slaves، أي أنه يتم إلصاق وصفة العبودية بمجموعة بشرية كاملة ذات لون جلد معين. وهم يقومون بذلك بدرجة من اللاوعي لا تخفف من الذنب بل تجعله متجذرًا في الوعي التاريخي مثل ورم خبيث، يحتاج إلى حفريات لاستئصاله والتخلص منه. لذلك يُقال: "العبيد في أميركا"، و"هو أسود مثل العبد".
وعندما يتم التصحيح وينتبه الفرد إلى الخطأ تحاول عبثًا إقناعه باستخدام كلمة "السود" مثلاً، فالسواد لون واقعي وهو لون الجلد، وكما يوجد أبيض يوجد أسود. لكن اللون ليس محايدًا في نظرهم. فهم يعتقدون أن صفة السواد صفة سلبية، وأنك في الواقع تحاول الإيقاع بهم. فـ"العمل الأسود" هو كناية عن العمل المحتقر، وكذلك "سواد الوجه" كناية عن الإحراج والخيبة على وزن "ما أجانا منك غير سواد الوجه"، وهكذا "السوق السوداء" أيضًا. يفيد السواد في الحالات جميعها السلبية والشر والسوء وغيرها. هذا عدا خيارات الشؤم المرتبطة بالحداد، وهذا سياق آخر لا علاقة له برأينا بموقف عنصري من اللون وما يمثّل. ولا ينتبه أبطالنا، الذين استعبدوا الناس في كلامهم، أن استخدام السواد بهذا المعنى غالبًا ما يكون ذا أصول عنصرية تحقيرية. إنه لخطر داهم أن نتشبه بالغرب عبر التعالي على شعوب نعتبرها أقل تطورًا.
طبعًا هنالك دائمًا خطر الوقوع في الرومانسية المعاكسة، أي الإعجاب بالشعوب المضطهدة واعتبار الجهل في أوساط هذه الشعوب بساطة وحتى أصالة وحكمة، واعتبار انتشار الجريمة نوعًا من المقاومة ضد نظام الاستعمار أو الأبارتهايد، كما اُعتبر في حينه بعض الرومانسيين من مؤيدي النضال ضد الأبارتهايد انتشار الجريمة المفزع في أوساط الأفارقة السود، واعتبار إهمال وتلويث الحيز العام نوعًا من الاحتجاج ضد القانون السائد وضد النظافة الاستعمارية... وغيرها من إبداعات الرومانسية. وقد تكلم بعضنا في حينه عن "طيبة الشعب السوفياتي" و"تواضع الفيتناميين". وهذا التصميم غير المفهوم هو الصورة المقلوبة في المرآة العاكسة للموقف العنصري، نقول ذلك رغم أنه أكثر أخلاقية من الموقف المتعالي والعنصري.
لا العرب ولا غيرهم طيبون أو متواضعون هكذا بطبيعة الحال. إنهم باختصار شعب، ومن حق أفراد هذا الشعب ألا يُشملوا بأية تعميمات قيمية الطابع، وألا يحكم عليهم بموجب آراء مسبقة. ليس المضطهدون هم الطيبون، وليست شعوب الدول الإستعمارية مؤلفة من الأشرار. ويكمن التحدي في اعتبار الاضطهاد شرًا والنضال ضده خيرًا. هذا لا يعني أن يعتبر المناضلون أنفسهم شركاء في الخير كأفراد من دون أن يتطلب منهم ذلك سلوكًا إنسانيًا خيرًا، وكأن هالة من القداسة قد أحاطت بهم موضوعيًا ومن دون جهد أو قرار فردي، أو كأنهم شاركوا في فكرة الخير أو القداسة بالاقتراب منها على النمط الأفلاطوني. إن البحث عن الأهمية بالتزلف إلى الثقافة العنصرية هو دليل على عقدة نقص تجعل المرء يتظاهر بالأهمية. وصورتها المقلوبة هي البحث عن التقرب من الخير الكامن في المقموعين والمضطهدين. وهذا دليل تأنيب ضمير ورومانسية حالمة لا علاقة لها بالنضال من أجل الخير بل بعقدة البحث عن معنى لذاته.
ومن مآثر بعض النخب العربية أن الشعور بالأهمية لا يتم فقط بالتعالي على الشعوب الأخرى بحثًا عن المشترك مع الإنسان الأبيض، وإنما حتى بالبحث عن مثل هذه الأهمية حتى داخل "بلاد البيض" ذاتها من خلال الإحتكاك المباشر بالقوى المحافظة والعنصرية في العديد من الحالات. هؤلاء لا يعتبرون ضحايا العنصرية في الغرب حلفاء لهم، رغم أنه غالبًا ما يكون العنصريون ضد السود واليهود هم أنفسهم العنصريون ضد العرب. لكن حتى عندما يتحالف اليمين الأميركي، مثلًا، بالكامل مع إسرائيل تجد هذه العناصر من النخب العربية صعوبة في التحرر من التودد لليمين الأميركي. وحتى المناضل الفلسطيني، على الأقل من حيث اللقب، يعتقد في العديد من الحالات أن العمل مع حركات السلام في الشارع، أو مع كنائس السود يحط من قدره ولا يفيد بقدر ما يفيد اللقاء المباشر مع أعضاء من الكونغرس يعتبرون مجرد الجلوس معه تنازلًا لا بد أن يعوضوا أصدقاءهم الإسرائيليين عنه بما هو أكثر بكثير من جلسة.
وقد بلغت بنا الرغبة في إثبات الأهمية مبلغًا جعلت بعضنا يشعر بالأهمية من العلاقة المباشرة مع المستعمِر المباشر واعتبار صداقته المدّعاة ومخاطبته بإسمه الأول انتصارًا سياسيًا في عقر دار الصهيونية التي اعترفت بأهميته. فالممتلئ من نفسه ومن أهميته يعتقد أن مخاطبة من هذا النوع لا بد أن تجري بعد بحث في الحكومة الإسرائيلية، و"هذه ليست بسيطة. هذه قضية لها أبعادها، ولا يمر عليها مر الكرام". لا شك أن هنالك صداقات شخصية حقيقية بين الناس بغض النظر عن الانتماء والطبقة الاجتماعية والأصول، لكننا نقصد ادّعاء الصداقة الذي لا أساس له، كما نقصد هذه الصداقة التي يعتقد من يشعر بعقدة النقص أن "المتفوق" يكنها له.
وكما يعرف الزعماء السياسيون وقادة الدول كيف يُشعرون فلانًا بأهميته، معتبرين ذلك إحدى آليات السيطرة على النخب "المشاغبة"، كذلك تُتقن الأوساط الإسرائيلية والأميركية، ذات المصالح في بلادنا، إشعارنا بالأهمية أفرادًا يستفرد بهم للقيام بتكبير ونفخ "الإيغو" خاصتهم. وقد تنكسر رقبة ويُدَقُّ عنق بقفزة من "الإيغو" إلى الـ "آي كيو" لشدة ارتفاع الأول وانخفاض الثاني.
ويكثر الباحثون عن الأهمية بشكل خاص لدى الانشغال بالسياسة والإعلام والنجومية الفنية، لما فيها من معدات الأهمية الاستعراضية، خصوصًا إمكانية مخاطبة الجمهور مباشرة بشكل لا يبزّه إلا الاستعراض المسرحي كمهنة. ولا يستطيع المرء إلا أن يرى في الرغبة الاستعراضية المبالغ فيها نوعًا من الانحراف يذكر بالانحراف المعروف بالاستعراضية الجنسية exhibitionism.
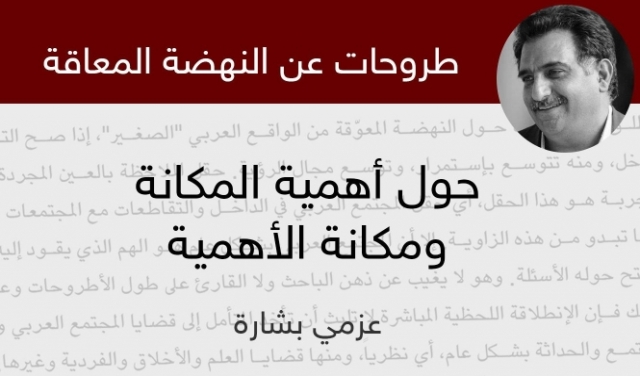
التعليقات