** كتاب "طروحات عن النهضة المعاقة" للمفكر العربي عزمي بشارة صدر عام 2003، ونُشر كسلسلة مقالات في صحيفة "فصل المقال"، يجمعها همّ عرض وتحليل المعوقات التي تقف في وجه النهوض بالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني نحو التحديث، ويلتقي فيها البعد النظري بالاجتماعي والسياسي. نُعيد في موقع "عرب48" نشْرَ هذه المقالات لأهميّتها وراهنيّتها.
______________________________________________________________________________
التحول الديموقراطي، التدين الشعبي، نمط التدين الجماهيري
يستقبل العالم العربي الديموقراطية جاهزة بعناصرها المكونة الأساسية وذلك بعد أن ارتبطت، أو تصالحت، مع الليبرالية، وبعد أن أنشأت مفهوم المواطنة الشاملة (Universal Citizenship) الذي يُجسّد تقاطع الديموقراطية والليبرالية في آخر تجلياته لأنه يتضمن الحقوق الليبرالية الممنوحة لمن له الحق أيضًا بالمشاركة الديموقراطية ويشمل عملية تنظيم العلاقات الحقوقية بين الأفراد، ومحور علاقة الفرد بالدولة وانتمائه لها. وقد دامت عملية تطور النظرية الديموقراطية الليبرالية وممارستها ما يقارب القرنين من الزمن. ولم تكن الديموقراطية حيث مورست، كحكم ممثلي الأغلبية ليبرالية بالضرورة، لا من حيث القيم التي مثلها ممثلو الأغلبية في البرلمان، ولا من حيث القيم الاجتماعية أو الأعراف أو الضرورات والحاجات كما عُرّفت اجتماعيا لتشتق منها عملية التشريع. ونذهب أبعد من ذلك حين ندعي أنه غالبًا ما لم تحترم الأغلبية قيمًا ليبرالية مثل الحريات الفردية، والتمييز بين الحيزين، الخاص والعام. أما الليبرالية كفكرة وكحركة حقوقية وسياسية، فقد كانت في الماضي تمثل نخبة تنطلق أساسًا من ضرورة عدم تدخل الدولة في الاقتاصد، الأمر الذي يتعارض مع تطلعات غالبية الناس بحكم تعريف الغالبية كجماهير ترنو إلى تدخل الدولة والقانون ومؤسسات الرفاه في الاقتاصد للدفاع عن مصالحها، أو لتحسين أوضاعها المعيشية على الأقل.
اشتقت "الليبرالية" كفكرة مستقلة عن الديموقراطية التي تعني حكم الأغلبية، واشتقت قيمها القائلة بالحقوق والحريات الفردية عن قيمة الملكية الخاصة، والدفاع عن المواطن الفرد (الرجل المالك الأبيض في البداية إلى أن تعمم المواطن مع تعميم حق الاقتراع) كذات حقوقية مستقلة قادرة على التعاقد بحرية وفاعلة في عملية التبادل الاقتاصدي ضمن اقتصاد السوق. ولكن قيم الليبرالية نمت وأنشأت ديناميكية تطورها مع تجسيدها في قوانين وتشريعات، ثم بشكل خاص عندما كسرت احتكار النخبة والتقت مع حكم الأغلبية.
لقد اعتبر الليبراليون بشكل عام أغلبية الشعب رعاعًا وبالتالي تحتاج إلى وصاية من النخبة التي أنعم عليها الله مع الملكية بالعقل وبالمسؤولية الاجتماعية. واستمرت فترة التلاقح بين ثقافة الأغلبية السياسية والقيم الليبرالية فترة طويلة تخللتها أزمات دموية. وما كان لها أن تنجح أو تحقق ما حققته من أنظمة دستورية وتوسيع حق الاقتراع والحريات الفردية، واحترام الحيز العام وحيز الآخر الخاص، لولا التوسع المستمر للطبقة الوسطى وتخطي الراسمالية لحالة الإفقار التي رافقت التراكم الراسمالي الأولي، ولولا الزيادة المستمرة بنسب التعليم لدى فئات واسعة من الشعب.
ولم تكن الدولة المتحررة من الاستعمار في العالم الثالث طرفًا مباشرًا في هذه العملية التاريخية إلا بشكل سلبين أي عن طريق لعب دور الآخر (the other) والخارج تجاه أوروبا، أي برؤية جانب هذه العملية المظلم من ناحية المستعمرات. لقد تعاملت حركات التحرر الوطني، بشكل عام، مع الديموقراطية بشكل أداتي (instrumental) من أجل المحاججة والإقناع بحقوق شعوبها لدى الرأي العام الغربي. ولا شك أن هذا النوع من تبني الخطاب الديموقراطي لغرض السجال مع الثقافة الاستعمارية، وفضح تناقضها، وإحراجها عند رأيها العام نفسه، قد حقق تطورًا في الفكر الديموقراطي الغربي نفسه باتجاهات نقد الديموقراطية الليبرالية لذاتها ولحدودها، عبر مدارس نقدية عديدة اتخذت من التجربة الكولونيالية منصة انطلاق لنقد الديموقراطية الليبرالية ومسلماتها وحدودها. ولكنه لم يحقق تقدمًا في الفكر السياسي في المستعمَرات، ذلك لأن المحاججة بالحجج الديموقراطية بقيت قائمة ضد الآخر على أساس تحصين الذات منها. فقد نفذت الفكرة الديموقراطية في المستعمرات إلى أوساط معينة من ملاك الأراضي وأبنائهم الذين تأثروا بالديموقراطية الليبرالية عبر التعليم والاحتكاك المباشر بالثقافة الاستعمارية وإلى أوساط من البرجوازية النامية في بداياتها وبعض الأوساط التي سنحت لها الفرصة بالدراسة في المدارس التبشيرية ومنها البعثة إلى جامعات أوروبية. ولكنها لم تصل إلى المجتمع المستعمَر ذاته، وانتشرت فيه سلبيًا على شكل كشف "لزيف الديموقراطية الغربية"، أي على شكل موقف سلبي منها.
ثم ما لبثت نفس القوى، التي استخدمت السجال المستمد من لغة الحقوق الليبرالية في الدفاع عن حقوق الإنسان في المستعمرات وسيادة القانون وحق تقرير المصير، أن تناولته كثقافة غربية عند محاولة تأصيل وتجذير الثقافة الوطنية بعد الاستقلال. وقد درج على التعامل مع الديموقراطية، في أوساط اليسار في العالم الثالث بعد الاستقلال، باعتبارها ديكتاتورية البرجوازية وثقافتها. وقد كان هذا اليسار قد تفاعل مع الاشتراكية، أيضًا، كمفهوم جاهز جامد من صنع أوروبا الشرقية، إذ لم يطّلع حتى اليسار ومنظّروه الحزبيون بشكل خاص في الدول المتحررة حديثًا على جذور الاشتراكية في الصراعات من أجل الديموقراطية في أوروبا القرن التاسع عشر. لقد أدى انجذاب أوساط من النخب المثقفة والحديثة في المستعمرات لفكر اليسار بشكله السوفياتي من خلال العداء للاستعمار إلى إجهاض لعملية طبيعية كان من المفترض أن تمر بها النخب الحديثة والمثقفة في المستعمرات، ألا وهي عملية تبني الديموقراطية السياسية كترجمة لمفهوم حكم الشعب والاستقلال الوطني الذي تبنته إبّان صراعها مع الاستعمار.
لقد أدى تحالف هذه النخب الطبيعي مع الاتحاد السوفياتي ضد الدول الاستعمارية التقليدية إلى انجذاب نحو نمط تفكير أوروبي حديث، ولكنه غير ديموقراطي وغير حداثي. وقد تعرّض التيار القومي لعملية مشابهة إذ دفعه كرهه لبريطانيا وفرنسا (في حالة المستعمرات البريطانية والفرنسية) إلى الإعجاب بنماذج قومية متأخرة ورومانسية غير ديموقراطية في ألمانيا وإيطاليا. ولكن التيار القومي لم ينضوِ تحت لواء "كنيسة" عالمية تمثل هذه الأيديولوجيا إذا صح التعبير.
ولن أخوض في المرحلة المبكرة من تبني الأفكار الديموقراطية في عالمنا العربي، في بداية القرن وما بين الحربين على الأقل. ففي تلك المرحلة نشأت فئة من المثقفين الذين حاولوا، بالأدوات المتوفرة لديهم في حينه، خلق علاقة متوازنة ومتنورة بين الثقافة الوطنية الناشئة والديموقراطية الغربية، تختلف عن العلاقة المتوفرة القائمة حاليًا بعد انتشار ثقافات معادية للتحول الديموقراطي في أوساط النخب السياسية والاقتاصدية والعسكرية سلطة ومعارضة بعد مرحلة الاستقلال وبداية مرحلة الانقلابات العسكرية، ثم في أوساط واسعة من الشعب. ونحن نشهد عودة لإعادة الاعتبار إلى مثقفي تلك المرحلة الواعدة والممتدة حتى الحرب العالمية الثانية وانصباب جهود بحثية فردية عديدة على الاستمرار في ما بدأه ألبرت حوراني في "الفكر العربي في العصر الليبرالي".
وبالإمكان القول بإيجاز شديد أن المجال الذي نخوض فيه عند البحث في العلاقة بين إشكاليات التحول الديموقراطي وأنماط التدين السائدة هو مجال العلاقة بين الثقافة السائدة وبين إمكانية الديموقراطية كنظام حكم. ولكننا قد حسمنا موضوع البحث وأعدناه إلى حقل معروف ومحروث جيدًا، وهو حقل الثقافة السياسية، شعبية كانت أم نخبوية، اختصارًا للجهد ولوقت القارئ. ولا بد من العودة إلى ذلك في بحث تفصيلي. كما أسقطنا عدة ملفات وسطية مثل:
إثبات العلاقة بين أنماط التدين والقيم الدينية المنتشرة وبين الثقافة السياسية، أي مدى تأثير شكل الإيمان الديني على الموقف من قضايا مثل: الدولة، الأغلبية والأقلية، حقوق المواطن، استقلال القضاء، احترام الحيز العام، احترام سيادة القانون وغيرها. لقد افترضنا أن لنمط التدين إسقاطات على ثقافة الفرد (والأهم من ذلك الجماعة) السياسية. ولكننا لم نحدد درجة التأثير.
لم نبحث العلاقة بين البيئة الاجتماعية والموقع الطبقي ودرجة التعليم وبين نمط التدين، كما لم نبحث العلاقة بين نمط التدين والثقافة السياسية في ظل الموقع الاقتاصدي – الاجتماعي.
والحقيقة أنه عند الخوض في أي حديث عن دور الثقافة السياسية السائدة في تعزيز، أو إعاقة، عملية التحول الديموقراطي باستخدام مقاييس لمعايير ثقافية مثل: التسامح، توفر مفهوم للحيز العام، احترام أتونوميا الفرد، احترام الأغلبية، وغير ذلك من المقاييس، سيكون علينا أن نحمّل ثقافة النخب مسؤولية أكبر من ثقافة الشعب وذلك لفاعليتها الأعظم في عملية التحول الديموقراطي وفي طرح البرامج الديموقراطية وقدرتها على التأثير باستخدام الأدوات الحديثة ومن ضمنها الدولة الحديثة.
في الحالة الأوروبية التي تطورت فيها الديموقراطية تدريجيًا، وتوسعت فيها المشاركة بالتدريج لتعمم على فئات أوسع فأوسع من السكان: الأجيرين، النساء... إلخ، لا تحتاج الأهمية التاريخية لثقافة النخب في البداية إلى برهان، إذ أن العملية الديموقراطية اقتصرت على النخبة، عمليًا، ثم تعمقت بالتدريج عبر ارتباط المطالب النقابية والطبقية والنسوية بالمطالب الديموقراطية، وعبر توسع الطبقة الوسطى الجديدة في مرحلة الثورات التكنولوجية، وتعميم القراءة والكتابة والصحافة المكتوبة. وقد رافق ذلك عملية توسيع المشاركة الديموقراطية وشمولية (inclusion) مفهوم المواطنة، وعملية تنشئة سياسية تدريجية (political socialization) وعملية تعويد (habituation) على احترام قواعد اللعبة الديموقراطية ومبدأ سيادة القانون. ولكن الحديث عن عملية التحول الديموقراطي في بلداننا يهدف إلى تبني نتائجها الجاهزة والمطورة، التي لا يمكن تجاهلها نتيجة لارتباط المطالب الديموقراطية بها ونتيجة للاطلاع عليها عبر العولمة الإعلامية الجارية (global communication).
وقد اعتاد الفكر النقدي للعولمة على التشديد على جوانبها الثقافية تخوفًا من تهديدها "للهوية الحضارية" الوطنية أو القومية أو الدينية، كما تصوغها التيارات المختلفة التي تتعامل مع العولمة كتهديد. ويتم تجاهل الآثار الأخرى للعولمة والتي لا تقل أهمية وهي تعميم أو عولمة الحاجات البشرية المادية والمعنوية، من دون عولمة الأدوات والإمكانات اللازمة لسد هذه الحاجات. وتؤدي هذه العملية إلى نشوء فجوة حياتية وعاطفية سحيقة بين الواقع والتوقع، وبين الموجود والمرغوب، وبين الكلمات ودلالاتها الحقيقية، وبين الاسماء والمسميات... إلى درجة أنها تهز الكيان الإنساني الفردي والجماعي. هذه أيضًا عملية العولمة، وتتحمل هذه الفجوة السحيقة الناجمة عن العولمة مسؤولية ردود الفعل المتوترة، والتي تزداد توترًا بازدياد الفرق بين درجة التعرض للعولمة من ناحية والواقع المعيوش من ناحية أخرى، وبين الأدوات العلمية والمهنية من ناحية والمستوى الثقافي من ناحية أخرى، وبين أداتية العلوم المعولمة من ناحية والقيم الثقافية من ناحية أخرى... وهكذا.
وينسحب هذا الوصف على موضوعة الديموقراطية. فقد تمت عولمة الوعي بالديموقراطية والحقوق الليبرالية من دون أن تعمم معها القيم اللازمة لإسناد المشاركة الديموقراطية والليبرالية في الممارسة، ودون أن "تعمم" معها القوى الاجتماعية والسياسية ذات المصلحة بتطبيق الديموقراطية. ولذلك تؤدي عملية العولمة في ما يتعلق بالثقافة السياسية إلى موقفين متوترين من الديموقراطية، يتجه الأول إلى رفضها كرد فعل يؤكد على خصوصيتها الغربية، ومن هنا تتشعب مواقف شتى من اتهامها بالانحلال الاجتماعي والإلحاد والفوضى والتدخل بحاكمية الله إلى اعتبارها خطرًا على وحدة الأمة (بالمفهوم القبلي للأمة)، ويتجه الموقف الإيجابي إلى تبنيها بشكل مجرد كما عُممت (وكل تعميم هو في الوقت ذاته تجريد) أي كوصفة علاجية لمرض شُخّص كـ"نقص في الديموقراطية"، وكمادة تبشيرية، وكمجموعة قواعد للتلقين. ولا بأس بذلك ولكن تلقين قواعد الديموقراطية المجردة شيء، والموقف منها المنحاز لا والمؤدي إلى النضال من أجل فرضها كنظام شيء آخر مختلف.
لقد تطورت الثقافة السياسية الديموقراطية في الدول التي تنشأ فيها النظام الديموقراطي، عبر سيادة القانون، واحترام التعددية السياسية القائمة، وتعددية المصالح، وحقها في التعبير عن ذاتها بشكل منظم، تطورت هذه الثقافة السياسية من ثقافة نخب سياسية واقتصادية ترى إمكانية تحقيق مصالحها عبر النظام الديموقراطي السائد، إلى ثقافة مهيمنة أو سائدة اجتماعيا عبر فترة تاريخية طويلة، تخللتها أزمات وهزات عميقة. فهل يعني التحول الديموقراطي في بلداننا العربية مثلًا المرور بنفس التحول التاريخي الطويل وذلك بدءًا من اقتصار اللعبة الديموقراطية في البداية على النخب المتنورة ثم توسيعها بالتدريج؟ هذا غير ممكن بالطبع، فقد وصلتنا الديموقراطية الليبرالية جاهزة ولا يمكن تجاهل ذلك. والمقصود بكلمة جاهزة هو وجود أنظمة سياسية في أماكن أخرى من العالم تسمى ديموقراطية ليبرالية وتجمع بين أنظمتها قواسم مشتركة باتت تعتبر شرطًا أساسيًا لا غنى عنه لأي نظام حكم ديموقراطي.
وإذا كان الهدف هو تعميم الديموقراطية الجاهزة على كافة فئات السكان المواطنين فلا بد أن تطرح، بحدة أكبر، موضوعة الثقافة الديموقراطية مقارنة بدور الثقافة الديموقراطية في الغرب، والتي نشأت تدريجيًا عبر التجربة والخطأ والممارسة، مرورًا بعدة أزمات دموية، ومرورًا بالتحديات التي طرحها الفكر الاشتراكي والحركات القومية اليمينية، وغير ذلك.
ربما كانت لحظة تبني الديموقراطية في العالم الثالث هي اللحظة الوحيدة في تاريخ الديموقراطية التي تلعب فيها درجة ديموقراطية قيم الثقافة النخبوية والشعبية دورًا هامًا. وقد يكون هذا الواقع "غير منصف" إذا صح التعبير. فهذه الدول المشوّهة بنيويًا، والتي تقوم فيها البرجوازية المحلية بدور غير منتج، وتتضاءل فيها استقلالية السوق الداخلي، ولا تلعب فيها الضرائب دورًا مركزيًا مقابل الاقتاصد الريعي (rentier state, rent economy) الملحق بالخارج، ولا توجد فيها طبقة وسطى واسعة، ولم ينتشر التعليم فيها بعد بشكل كامل، هي نفس الدول التي فرض التاريخ أن يطالب فيها بالديموقراطية وأن تمارس الديموقراطية فيها جاهزة من دون تطور تدريجي، هذا إضافة إلى أنه بالضبط حيث لا تنتشر ثقافة ديموقراطية من المفترض أن تلعب الثقافة دورًا مساندًا للديموقراطية. ولأن المقومات الاجتماعية والاقتاصدية المادية شبه غائبة تكتسب الأيديولوجيا كما يكتسب دور القوى السياسية المنظمة أو غيابه أهمية قصوى.
ولم تذكر هنا المقومات البنيوية والقوى الاجتماعية جزافًا أو كإضافة مقتضبة لا مجال للتوسع فيها هنا، فقلما عولج موضوع نشوء الديموقراطية في الدراسات الغربية المتأخرة من دون ذكر دور البرجوازية المنتجة واقتصاد السوق الداخلي والنظام الضريبي والطبقة الوسطى وانتشار التعليم. وهذه المقومات إما هشة أو غائبة في حالتنا، وهذا يعني التعويض عن غيابها بقوة الدافع الديموقراطي والثقافة الديموقراطية والبرامج السياسية الديموقراطية التي رفعتها وناضلت من أجلها قوى سياسية منظمة، أي بقوة الفعل السياسي صاحب المشروع الديموقراطي. ولكن عندما نتحدث عن المشروع السياسي والبرنامج السياسي فإننا نتحدث عن الثقافة السياسية السائدة في دول العالم الثالث مقارنة بدورها في عملية نشوء الديموقراطية في الغرب. ويبرز هذا الدور على خلفية الظرف التاريخي التالي:
عدم إمكانية تطبيق الديموقراطية على النخبة فقط وضرورة تعميمها كحق اقتراع على الجماهير الواسعة بشكل غير تدريجي.
ضعف البنى الاجتماعية الاقتاصدية المساندة للديموقراطية.
تسربت هذه الحقيقة، بشكل واعٍ أو غير واعٍ، إلى النقاشات الدائرة حول موضوع الديموقراطية في العالم الثالث، بشكل عام، والدول العربية والإسلامية، بشكل خاص، حيث تم التشديد، بشكل غير متناسب (Unproportional)، على موضوعة غياب الثقافة الديموقراطية شعبيًا في هذه الدول كعائق في طريق التحول الديموقراطي. ولا شك أن هنالك حاجة لمناقشة العوائق القائمة في الثقافة الشعبية، ولكن من ضمن العوامل الأخرى، وبترتيب للأوليات وأجندة البحث والعمل من أجل الديموقراطية لا تعفي النخبة السياسية والاقتاصدية التي تتحمل العبء الأساسي من مسؤولية إعاقة التحول الديموقراطي. وبموجب رأي الكاتب فإنه لكي تتوفر إمكانيات إقامة النظام الديموقراطي يجب أن ترى أجزاءً واسعة من النخبة الاقتاصدية والسياسية مصلحة لها فيه.
ونستطيع أن نجزم أنه في موضوع الثقافة الديموقراطية فإن ثقافة النخبة المعادية للديموقراطية في بلداننا تتحمل مسؤولية أكبر بما لا يقاس مما يمكن تسميته بالثقافة الشعبية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموضوعات مثل الحريات المدنية والسياسية واحترام حقوق المواطن، وعندما يتعلق الأمر بموضوعة تداول السلطة بين النخب نفسها. نقول ذلك رغم أن محاولة تطبيق الديموقراطية كنظام حكم يشمل حق الاقتراع العام، منذ البداية ومن دون تدرج، يزيد من ثقل الثقافة الشعبية التي تحولت إلى ثقافة جماهيرية، بشكل لم يعهده تاريخ تطبيق الديموقراطية تدريجيًا في الغرب.
وتتحمل ثقافة النخب السياسية والاقتاصدية والفكرية مسؤولية أولى لسببين أساسيين:
لأن ثقافة النخبة تساهم مساهمة أساسية عبر أدوات الحداثة في تشكيل ثقافة الجماهير. ولم تكن هذه الأدوات متوفرة في مرحلة نشوء الديموقراطية تاريخيًا. ومن زاوية النظر التاريخية هذه فإن النخب السياسية والاقتاصدية والفكرية صاحبة المشروع السياسي الديموقراطي في حينه لم تتوفر لديها الأدوات: وسائل الاتصال، تعميم التعليم، التعليم الرسمي، قوة جهاز الدولة، المتوفرة اليوم. وكان تأثيرها على الثقافة الشعبية محدودًا للغاية. ولذلك يبدو الأمر لعين الباحث المؤرخ وكأن النخبة والشعب ذاته كانا ينتميان إلى جملة ثقافات مختلفة المصادر والمرجعيات. فالنخب الأوروبية السياسية والفكرية والاقتاصدية كانت أقرب إلى بعضها البعض من حيث ثقافتها ومصادر هذه الثقافة (وحتى من حيث النسب والقرابة في حالة الأرستقراطية) مما كانت إلى شعوبها التي تحكمها والتي توزعت إلى عدة ثقافات شعبية جهوية في الدولة ذاتها. وقد زادت الدولة القومية والحركات القومية الحديثة من التباعد بين النخب الوطنية في الوقت الذي قلصت فيه الهوة بين الثقافة الشعبية والنخبوية في نفس البلد عبر عملية بناء الأمة... إلى أن نشأت طبقة المديرين وفئة الخبراء والفنيين والمساهمين الكبار في الشركات المتعددة القوميات وفي الشركات المالية الكبرى فعدنا إلى طبقات جديدة عابرة للثقافات الوطنية.
يجب أن تحمل راية المشروع السياسي الديموقراطي نخب سياسية وفكرية واقتصادية، وهي التي تعمل في صراعها من أجل البقاء في السلطة، أو من أجل الوصول إلى السلطة، على طرح البرنامج الديموقراطي. لا ينتظر أن يصدر المشروع الديموقراطي (والليبرالي بشكل خاص) من أوساط الجماهير الواسعة، تمامًا مثلما لم يخرج المشروع القومي أو الاشتراكي أو الديني السياسي من أوساط الجماهير، رغم أنها حركات تتحدث باسم الجماهير ضد النخبوية. ولذلك وعند تناول المشروع الديموقراطي لا بد من الحديث عن قوة منظمة سياسية وفكرية واقتصادية حاملة لهذا المشروع تتوجه به إلى الناس، وفقط عندما يتوفر هذا الشرط يصح الكلام عن العوائق القائمة في الثقافة الشعبية، والتي لا بد من أخذها بعين الاعتبار عندما يطرح المشروع، ولو كبرنامج إصلاح تدريجي. وإلا فما معنى الكلام عن العوائق أمام التحول الديموقراطي القائمة في الثقافة الشعبية إذا لم يكن المشروع مطروحًا من قبل أوساط واسعة ذات وزن من النخبة؟
قد لا تحمل الثقافة الشعبية قيمًا ديموقراطية، ولكنها لا يمكن أن تكون معادية للديموقراطية عندما يتعلق الموضوع بتوسيع حقوق المواطن وحمايته من تعسّف السلطة، أو عندما يتعلق الأمر باستقلالية القضاء، أو الحريات المدنية. وهذه مبادئ تمسك النخب الحاكمة بزمام المبادرة لتنفيذها. أما الأوساط الشعبية فقد تتعامل معها بهذا القدر أو ذلك من المبالاة. ولكن لا يتم التعامل معها بعداء إلا في أوساط النخبة السياسية والعسكرية والاقتاصدية والثقافية، أو في أوساط النخب الجماهيرية (الجديدة) المناهضة لها.
ذكرنا إذًا حتى الآن عاملين يرجحان من وزن الثقافة الشعبية، فهل نستنتج من ذلك أن التحول الديموقراطي يجب أن يبدأ بدمقرطتها، وما دامت على هذا القدر من الأهمية هل هو مشروط بها؟ لا، فلا يمكن أن تبدأ عملية تحويل الثقافة الشعبية لتتبنى قيمًا ديموقراطية من دون إصلاحات ديموقراطية تدريجية تعمق مفاهيم الثقافة الديموقراطية عبر ممارساتها من قبل الدولة وفي الدولة، ومن دون أخذ قضايا مثل سيادة القانون وحقوق المواطن بجدية قبل طرح موضوعة تداول السلطة إن لم تكن النخب الحاكمة جاهزة لتقبلها بعد. فهل تشكل الثقافة الشعبية عائقًا أمام هذا التحول المطلوب لكي يحصل تحول في الثقافة الشعبية؟ وهل نحن أمام دوامة الدجاجة والبيضة المفرغة؟ لا يمكن انتظار دمقرطة الثقافة الشعبية، ولكن في الوقت ذاته لا يجوز تجنب مناقشة ومعالجة ومواجهة تحدي العوائق التي تضعها أمام التحول الديموقراطي، والسؤال الأهم والذي يجب تشخيص الإجابة عنه هو: متى تصبح القيم غير الديموقراطية قيمًا فاعلة معادية للديموقراطية في الثقافة الديموقراطية تدعم التحول الديموقراطي، كما تعوقه الثقافة المعادية للديموقراطية، أما الثقافة الشعبية فغير ديموقراطية ولكنها ليست بالضرورة تتفعل كمعادية للديموقراطية.
وعند الحديث عن الثقافة الشعبية فإنه، غالبًا ما تطرق الباحثون الغربيون، والعرب نقلًا عنهم، إلى موضوعة الدين كمركب أساسي من مركبات الثقافة الشعبية يعوق التحول الديموقراطي أو يناقض الديموقراطية كـ"عقلية" على مستوى النخبة والمؤسسة الدينية وعلى المستوى الشعبي أيضًا. ولا نود أن نتطرق هنا إلى نقد أو محاكمة أبحاث جزء من المستشرقين الغربيين حول التناقض بين الإسلام والديموقراطية المبنية على كون الدين مركبًا أساسيًا في الثقافة الشعبية أو "العقلية" السائدة كما تسمى. أولاً: لأن جزءاً كبيراً من المستشرقين بات لا يستخدم هذه المقولة بشكل عام، وثانيًا: لأننا نعتقد أنها أُشبعت نقاشًا وجدلًا. ونكتفي بالإشارة إلى أن "الدين" كمفهوم، و"الدين" كنص تاريخي ليس له علاقة بموضوعنا، لأنه يعكس مستوى آخر من التجريد، بحيث يجوز بحث علاقته بمفاهيم مثل: الحرية، القداسة، الخوف، المجتمع، الفرد، في حالة "الدين" كتجريد، أما في حالة الدين كنص فهو قضية تاريخية لا تبحث خارج سياقها التاريخي. وموضوعة التعامل مع النص الديني وما تفرضه من زوايا تفسير وتأويل ونظر إلى النص، بما في ذلك حرفية النص كشكل من أشكال التأويل المعاصر، فتدخل ضمن موضوعنا كممارسة اجتماعية مترتبة على نمط محدد من أنماط التدين.
وإذا أصرّ الباحث على تناول العلاقة بين الدين، أي دين، كمفهوم مجرد ولا تاريخي وبين الديموقراطية كنظام حكم وكثقافة وممارسة اجتماعية فلا بد أن تكون العلاقة مع الديموقراطية علاقة تناقض، بل علاقة إقصاء (exclusion)، سواء كان الحديث عن الدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي. ولا طائل من وراء بذل الجهد هنا، ولا فائدة نظرية أو عملية ترجى منه. أما إذا أُخذت النصوص كما هي خارج السياق التاريخي للوحي أو للصياغة أو للكتابة وخارج ما سمي "أسباب النزول"، فعند ذلك حدّث ولا حرج: سوف نجد معينًا لا ينضب للاقتباسات المتناقضة التي تصلح لتبرير عدم التناقض بين الديموقراطية و"الدين"، كما تصلح لإسناد التناقض بينهما ناهيك عن التوافق. من الأفضل إذاً التركز في موضوعة التدين (religiousness)، أي أنماط الممارسة الاجتماعية للدين في سياق تاريخي معين. فهذه الأنماط ناشئة ومتطورة ومحددة تاريخيًا، وقد يستفاد من بحث علاقة الثقافات التي ترافقها بالثقافة الديموقراطية كمقدمة لدراسة تفعُّلها كثقافات مساندة أو معوقة لعملية التحول الديموقراطي.
"الدين" كتجريد هو مقولة فارغة، فالدين بحد ذاته غير قائم إلا كتديّن أو كوحي ديني. وحتى الأبحاث الأولى حول الدين الطبيعي الناجم عن الخوف عند دوركهايم، أو الأبحاث الأكثر حداثة حول جوهر الدين (مفهوم المقدس عند رودولف أوتو)، فإنها تلامس جانبًا هامًا من جوانب هذه الظاهرة، ولكنها تنطلق في الواقع إلى تعميمات من أنماط تاريخية محددة من التديّن، بحيث تسعى للوصول إلى "الأصل"، أو إلى أكثر طبقات الظاهرة الدينية تجريدًا، وذلك إمّا كقاسم مشترك بين بني البشر (الطبيعة البشرية، إذا استنبط الدين منها)، أو كقاسم مشترك بين الأديان يميزها عن بقية الظواهر الاجتماعية. وباعتقادي فإن الجهد الذي قام به وليام جيمس في الفكر وميرسيا إيلياد في تاريخ الأديان وكليفورد جيرتس في الأنتربولوجيا هو جهد أكثر نفعًا لأنه تعامل مع التديّن وأنماطه كنشاط اجتماعي تاريخي أكثر مما تعامل مع الدين. ونصبح أكثر إنصافًا إذا استدركنا وقلنا إن رودولف أوتو عندما تعامل مع "العظيم – الغامض – المخيف" والخشوع أمامه فإنه قد تعامل أيضًا مع طبقة شعورية ضرورية في التدين، ورغم أن هدف ذلك النوع من الأبحاث كان التوصل إلى التعريف بجوهر الدين، إلا أنه تقدم بنا خطوات إلى الأمام في فهم التديّن وممارسته اجتماعيا.
لقد قسمنا أنماط التديّن الاجتماعية في مكان آخر تقسيمًا تقليديًا يشمل:
نمط التديّن الرسمي أو المؤسسة الدينية (religious establishment).
نمط التديّن الشعبي (popular religion, volks religion etc.)، ثم أضفنا إلى ذلك 3- نمط التديّن السياسي. وهذه بالطبع تقسيمات مفهومية بنيوية الطابع يلزمها أيضًا تحديد تاريخي. ولا شك أن ما يلوح أمامنا في هذه المقدمة هو المجتمعات العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. وهذا يلزمه تحديد أكبر في البحث ذاته قبل أن يتم الانطلاق إلى تعميمات. فهنالك فرق جوهري بين أنماط التديّن في الخليج العربي وعلاقتها مع الدول التي اعتبرت نفسها "تقليدية" من ناحية وديناميكية أنماط التديّن في مجتمعات الجمهوريات العربية "الثورية" وعلاقتها بالدولة من ناحية أخرى. ويجب أن نعود إلى ذلك.
ويرجى هنا التمييز بين هذه التقسيمات وبين الأصولية (fundamentalism)، لأن هذا المصطلح لا يشير إلى نمط تديّن اجتماعي بعينه، ولا يحدد ظواهر اجتماعية، وإنما يشير إلى أشكال من الوعي الديني المؤسس على التمسك بحرفية النصوص أو العودة إلى الأسس (fundaments) وإلى السلف (والتسلّف الصالح أكثر نقاءً لأنه أقرب تاريخيًا إلى الأسس) في محاولة يائسة ومستحيلة لتنقية الدين المجرد من "الشوائب" التي علقت به تاريخيًا، فيتحول هو ذاته إلى نمط تديّن (غير نقي بطبيعة الحال) عندما يتفاعل مع أحد الأنماط الاجتماعية القائمة (المؤسسي، الشعبي، السياسي) وتتحول حرفية النص إلى أيديولوجيا، أو إلى حجة سجالية في مقاومة الخصوم.
قد تكون المؤسسة الدينية أصولية التوجه، كما قد تكون ليبرالية أو على الأقل منفتحة التوجه والتفسير. وقد تتغلغل الأصولية في مرحلة تاريخية كما حصل بأدوات الإعلام المتلفز مؤخرًا إلى الوعي الشعبي فتتفاعل بصعوبة مع هذا النمط من التدين، فألوان التدين الشعبي تبدي مقاومة لرمادية الأصولية، ولكن الأصولية تثبت أنها أيضًا براغماتية، خصوصًا عندما يحمل لواءها التديّن السياسي. وقد تحاول الأصولية اختراق الوعي الشعبي من دون السياسة الحركية كما حصل مع جمعيات تبشيرية مثل "الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر" أو "الجمعية الشرعية" أو "جمعية العاملين بالسنة المحمدية" والتي نشرت وتنشر فكرًا أصوليًا وهابيًا من دون قرنه بالعمل السياسي وغيرها من الجمعيات في العالمين العربي والإسلامي التي قامت بدعم من دول أو مجتمعات المملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام. وتتقرب هذه التنظيمات في نشاطها من الجماهير الواسعة عبر: تأهيل الوعاظ، توزيع المنشورات، والخدمات الاجتماعية التي توصلها إلى المحتاجين.
وقد يكون التدين السياسي إصلاحيًا، وقد يكون أصوليًا، كما هو الحال بالنسبة للنموذج الأكثر انتشارا في أيامنا لنمط التدين السياسي. والنقاش حول إصلاحية أو أصولية المصلحين الإسلاميين من الأفغاني إلى محمد رشيد رضا مرورًا بمحمد عبده أصبح معروفًا لأي باحث. وباعتقادنا لا توصل هذه النقاشات إلى نتيجة لأن البعدين توفرا في فكرهم كما في البروتستانتية الأولى، ولكن وزن كل بُعد قد تغيّر، فنحن نرى أن البعد الإصلاحي عند الأفغاني يطغى على الأصولية الواجبة في أي إصلاح يتم ضد.. (ضد تعفن المؤسسة الدينية، ضد الخرافات، ضد البدع...إلخ)، ولكن الأصولية تطغى على الإصلاح عند محمد رشيد رضا وبداية التديّن السياسي إلى حد أن الانتقال الفكري إلى حسن البنا يصبح انتقالا تدريجيًا.
ليست الأصولية إذًا حكرًا على نمط معين من التديّن. وقد انتشرت في أبحاث السبعينيات والثمانينيات حول الحركات الدينية السياسية في مصر وإيران محاولة لإيجاد تطابق بين الأصولية والإسلام السياسي، (أو نمط التديّن السياسي). وهذه المطابقة منتشرة فعلًا في الواقع التاريخي ولكنها ليست ضرورية ولا إصطلاحية. وصحيح أن حركات التديّن السياسي بشكل عام كانت حركات تدّعي الأصولية والتمسك بحرفية النص، وهي في الواقع تعتمد تفسيرًا معينًا للنص دون غيره وتعتبر تفسيرها اعتمادًا لـ"حرفية النص" (هو في الواقع التفسير الحرفي للنص)، وحتى هذا أيضًا بتفاوت فيما بينها. ولكن هنالك تيارات سياسية لبست لبوس الدين، أي سيّسته، أو ديّنت السياسة باتجاه ينفتح على بعض مبادئ الديموقراطية وقيمها. كما طرأت عملية تحول تدريجي لدى بعض التيارات الإسلامية السياسية باتجاه إصلاحي، من ضمنها حزب الوسط في مصر، محاولات خاتمي الإصلاحية في إيران، محاولات راشد الغنوشي الإصلاحية الهامة بعد انحسار حركة النهضة في المهجر، و"بيان للناس" من حركة الإخوان المسلمين في مصر العام 2000، والذي أثار نقاشًا مطولًا في مصر في نهاية التسعينيات، وكلها نزعات متفاوتة في جذريتها ومتفاوتة أيضًا في أهميتها ضمن ما يمكن تسميته حركات الإسلام السياسي.
وباعتقادي يكمن التحدي في فهم دور الثقافة الدينية السائدة في إعاقة عمليات التحول الديموقراطي في هذه النقطة بالذات، أي في السؤال: كيف تتعرض أنماط التديّن المختلفة إلى شكل الوعي الأصولي؟
لا يوجد نمط تديّن مناقض للديموقراطية، أو متفاعل معها مساند لها، في جوهره. فكل نمط هو ظاهرة تاريخية مرتبطة بموقع القوى التي تتبناه في الصراع الاجتماعي والسياسي القائم. ولكن بالإمكان من خلال تعميمات سريعة طرح التحليلات والفرضيات التالية:
دين المؤسسة: كان قائمًا منذ أن تطورت الدولة بتعريف ذاتها ووظائفها العلمانية باستقلال نسبي عن مرجعياتها، وكلما زاد تركيب وتنويع وظائف الدولة العلمانية ازداد الفرق بينها وبين المؤسسة الدينية وضوحًا. ولكن بالإمكان شرح عملية تحوله إلى نمط قائم بذاته يميز رجال الدين المنتظمين في مؤسسة دينية وفقهية صاحبة قدرة على الافتاء ذات هرمية مرتبطة بالدولة ومنفصلة عنها في مؤسسة متميزة من ضمنها وإلى جانب مؤسساتها كنتاج لعملية التحديث. وكان دين المؤسسة قائمًا مع وجود الدولة، كدين دولة، أي كدين ودولة. هذا هو دين العلماء والفقهاء في المدينة القرسطوية من خلال تفاعله مع الدولة في خدمتها وفي نقدها. إنه الدين الذي ينتج النصوص والتفسيرات والفتاوى ويؤهل القضاة والأئمة. إنه الدين المؤسس للتقاليد الدينية الكبرى canonic culture كما سمي هذا النوع من التقليد الديني الذي ترعاه المؤسسة الدينية great traditions التقاليد العظمى مقابل the small traditions التقاليد الصغرى التي نعت بها تقليد التدين في الريف، هذا التدين المتفاعل مع بنية الجماعة المحلية وغير القادر على تعميم ذاته كنمط منصوص أو مؤسس أو مصاغ صياغة قابلة للنقل أو للتبشير، وهو أيضًا لا يعي ذاته كأيديولوجيا قابلة للنشر، رغم انتشاره كحالات قائمة في الجماعات العضوية الريفية.
ولكن عملية العلمنة المستمرة بشقيها: علمنة الدين أي ازدياد الحاجة إلى تدخل رجال الدين المباشر في شؤون الدنيا، وعلمنة الدولة أي نشوء فرق وتمايز وظيفي بينها وبين المؤسسة الدينية، هي التي حولت دين المؤسسة إلى نمط تدين قائم بذاته. وهو كأي لاهوت (theology) يعبر عن الحاجة إلى الوساطة بين الله وبين الدولة، بعد أن توقفت الدولة عن اشتقاق شرعيتها من الله مباشرة. أي بعد أن تعلمنت وأصبحت دولة فعلًا، وقبل أن ينفصل الدين عن الدولة انفصل الحاكم عن الألوهية المدّعاة.
ولأن المؤسسة الدينية هي نتاج عملية التحديث، ولكونها تبريرية بطبيعتها تتوسط بين الله والدولة، وبينهما وبين الناس عبر مراقبة التديّن الشعبي وضبطه بإقراره وتسليمه على مستويات متزايدة باستمرار بمرجعية المؤسسة الدينية، فإن استراتيجيتها المألوفة تجاه خطوات الدولة، ومن ضمنها خطوات الدمقرطة أو اللبرلة، هي استراتيجية دفاعية. إنها تحاول الدفاع عن مواقعها المتضررة نتيجة لإصلاح بنية الدولة وعلمنتها والفصل بين التعليم الديني والرسمي. ولكنها لا تلبث أن ترى العلاقة بين التعليم الرسمي وضرورة نشر عقيدتها "الرسمية" عبر دروس الدين. كما ترى أن إصلاح الريف يضعف التديّن الشعبي ليس لصالح تيارات أيديولوجية أخرى، وإنما لصالح صيغة معممة للتديّن تحل محل انكسار التنوع الذي كان قائمًا في التدين الشعبي، والباقي في مجالات متناقضة تتعايش معها المؤسسة الدينية. والمؤسسة القادرة على تعميم صيغة موحدة للدين هي المؤسسة الدينية، إذا تعاونت مع الدولة، وإذا أدركت مبكرًا قوة وسائل الاتصال الحديثة وحتى قوانين العرض والطلب في سوق جديد لم يكن قائمًا في السابق هو سوق الحاجات الروحية. وقد طوّره الوعّاظ الأميركان في مجتمع سوق فردي إلى مقاييس غير معروفة. ونجد حاليًا بدايات حالات مُلطّفة منه لدى طبقات وسطى ووسطى عليا عربية كاستهلاك ديني لربات البيوت بدلًا من نوادي "الهاي سوساييتي" أو إلى جانبها وإلى جانب الـ"جيم". وما زال نمط التديّن الأساسي السائد في المجتمع العربي نمطًا يغلب عليه البُعد الجماعي الاجتماعي وبُعد الهوية الجماعية، وليس فرديًا بالمعنى الذي يمكّن قوانين السوق من استغلاله لتحويل المؤسسة الروحية إلى مرشد فردي أو نفسي أو إلى مقاول للعلاج والتنفيس الجماعي.
المؤسسة الدينية حاضرة للتكيّف مع ازدواجية عالم الحداثة الذي تنفصل فيه المعاملات عن العبادات، والحاجات المادية عن الروحية، ومتطلبات السياسة عن فرائض الدين لأنها نتاج هذه الازدواجية. وهي تُفضّل أن تُفتي، وبأثر رجعي إذا دعت الحاجة، لتبرير خطوات قامت بها السلطة الحاكمة، وأن تتكيف مع حاجات ومتطلبات الدولة عبر التأويل وعبر ابتداع الحكم والأحاديث على أن يتم الاستغناء عنها. وقد تضطر المؤسسة الدينية إلى قبول شروط الدولة تجنبًا لمخاطرة أن تخاطب الدولة الدين الشعبي بغير وساطتها ومن خلال نفخ وتعظيم مقاسات الانتماءات والهويات الأخرى لدى المواطن مثل الوطنية والقومية واكتشاف التقاطعات بينها وبين الدين الشعبي على مستوى الانتماء والشرف والكرامة والرجولة وغيرها من قبل الدولة الميكيافيللية.
ولكن المؤسسة الدينية تواجه صعوبة في التكيّف مع قضايا العائلة والمرأة، وتدافع بشراسة عن دورها الاجتماعي المباشر الذي تبقيه لها عملية العلمنة(secularization)، وأقصد دورها في كل ما يخص الأحوال الشخصية وقوانين العائلة بشكل خاص. وإذا استطاعت أن تستقطب اهتمام الرجال واستنفارهم ضد إصلاح قلعتهم وقلعة المؤسسة الدينية، العائلة، فإن المؤسسة الدينية لا تُضيّع الوقت وتتحول فورًا لإثارة قضايا أخرى سكتت عليها مضطرة في الماضي، وتم تمريرها من قبل الدولة.
هذا النمط الدفاعي يتحول إلى الهجوم في حالة تبني المؤسسة الدينية نمط الوعي الأصولي، فتبدأ بالمبادرة إلى الهجوم على حرية الرأي الآخر والتعبير، وتحاول فرض قوانين رقابة وقوانين تحدد الحريات الشخصية، ويكون ذلك في حالة إيجاد القاسم المشترك مع التديّن السياسي. هذا مع أن التديّن السياسي ذاته يبدأ حياته السياسية بالهجوم على عملية العلمنة التي تفصل بين الدين والدولة، والهجوم على المؤسسة الدينية، التي تكيفت مع هذا الانفصال إلى درجة تحولها إلى أداة بيد السلطة العلمانية غير الملتزمة بالشريعة الدينية.
وقد تستغل المؤسسة الدينية حاجة الدولة للدين كمصدر شرعية في غياب الشرعية الديموقراطية وانهيار الشرعية الثورية أو القومية، فحالما تدرك المؤسسة الدينية صاحبة الخطاب الديني المحافظ (بمعنى حفاظه على تقاليد هذه المؤسسة التفسيرية والفقهية والطقسية) والمسؤولة عن عملية تأهيل رجال الدين والقيّمة بالتالي على الوساطة بين النص (أو النصوصية) وعامة الناس، حالما تدرك حاجة المؤسسة السياسية إليها حتى تبدأ بإنتاج خطاب ديني يلائم حاجاتها معيدة إلى الأذهان نموذج تمرد حرّاس النص الأصلي الثابت ضد تقلب واعتباطية السلطة. وفي التقاليد الدينية ووعي المؤسسة الدينية مكان لاعتبار النصوص الدينية ملجأً من اعتباطية وتعسّف السلطة الاستبدادية وفي محاولة لوضع شيء ما، اعتبار ما، ولو كان النص المقدس فوق سلطة الحاكم، هنا تظهر المؤسسة الدينية كممثلة "للحق"، أو للثوابت الاجتماعية والعقيدية أمام تعسف السلطة السياسية: والنموذج هنا استبسال الإمام ابن حنبل في الدفاع عن أزلية القرآن في فترة ما يسمى بـ"محنة خلق القرآن" في مواجهة المعتزلة والخليفة المأمون. وغالبًا ما يُضاف إليها حكايات بطولات لأئمة متشددين رفضوا علنًا فساد الخلفاء والسلاطين الأخلاقي وحذروهم من مغبة إهمالهم لأحكام الدين، وكانوا مستعدين لدفع ثمن ذلك الموقف.
وكلما ازداد ممثلو المؤسسة الدينية تعنتًا في هذه الحالة اعتبروا أكثر نقاءً وأهلية لموازنة إرادة الحاكم المطلقة وتحديها، ولكنهم في الواقع الحاضر لا يتحلون بشجاعة أسلافهم المتأخرين القريبين وغير المتعصبين أمثال علي عبد الرازق، الشيخ الأزهري الذي تمرّد على إرادة الملك الذي أراد أن يصبح خليفة وحاربته ونبذته المؤسسة الدينية. فهم مع ازدياد تعصبهم وابتزازهم للدولة لا يجسّدون شجاعة وإنما هم يستغلون حاجة الدولة إليهم بعد أن قوّتهم كمصدر شرعية.
ولكن المحاولات البطولية المتمردة من صفوف المؤسسة الدينية على المؤسسة السياسية استثنائية (والبطولة استثناء بحكم التعريف). وما يميز المؤسسة الدينية وفقهها هو التكيف لحاجات المؤسسة السياسية الحاكمة، وآلياتها ومن ضمن ذلك تسخير الأحاديث النبوية الشريفة، تفسيرها واختلاقها، والفتاوى. وهي تتكيف بهذه الآليات مع حاجات المؤسسة السياسية من دون أن يترتب على ذلك إصلاح للدين. إنها إحدى الحالات الفذّة في تاريخ المؤسسات الدينية التي يتم فيها التكيف دونما حاجة إلى إصلاح. وهذا أخطر ما في سياستها التبريرية: إنها تحاول بآليات تلفيقية أن تُكيّف الخطاب الديني مع حاجات المؤسسة السياسية من دون أن تطلق عملية إصلاح نابعة عن تفاعل جدلي مع هذه الحاجات. هكذا أصبحت المحافظة والتلفيق وجهين لعملة واحدة في بلداننا، وكذلك المحافظة ومراءاة الحكام، وبالعكس.
غالبًا ما كان الإصلااح الديني النادر ضمن المؤسسة الدينية يتضمن أصولية في العودة إلى الأصول وأركان السنّة، كما يتضمن رفضًا للتكيّف السريع مع حاجات الحكّام بإصدار الفتاوى. وإن جدية المصلحين ضد الانغلاق والتلفيق وحماستهم واندفاعهم التبشيري في رؤية الإصلاح الديني كرسالة اجتماعية تمنعهم من التكيّف الفوري مع حاجات الحكام التي كانت ترافق الانغلاق. أي أن ثقافة المصلحين كانت أصولية ضد التكيّف ومنفتحة ضد المحافظين، على عكس حال المؤسسة الدينية التبريرية والمحافظة في آن.
وعندما تدرك المؤسسة الدينية المحافظة بالتجربة المتراكمة حاجة الحكام المتواصلة وغير الآنية إليها والناجمة عن عدم قدرة الدولة على تطوير خطاب سياسي – اجتماعي يحظى بمصادر شرعية غير دينية، فإنها تنتقل إلى طرح الشروط وتوسيع نفوذها الذي قلصته عملية العلمنة التدريجية والمستمرة للمجتمع نتيجة لازدياد نفوذ الدولة، إما عبر كونها دولة ريعية توزع على المجتمع ما تحصل عليه من بيع "ثرواتها الطبيعية" أو من أموال المساعدات، أو عبر القطاع العام في الاقتاصد وتوسيع التعليم الرسمي. فالمؤسسة الدينية لا تكتفي بدور الأداة، ولا بدورها في الأحوال الشخصية وتتحول إلى الرقابة الشرعية على نشاط المجتمع ومؤسسات الدولة وخطابها السياسي مستفيدة من الشرعية الجماهيرية التي اكتسبتها عندما أفردت لها الدولة شرف إسباغ الشرعية على ما تقوم به.
المؤسسة الدينية تبريرية بطبيعتها الوظيفية. ولكن كلما ازدادت حاجة الدولة إليها للتبرير ازدادت قوتها في فرض الثقافة الدينية على الحيز العام، الأمر الذي يقربها من التديّن السياسي الذي من المفترض أن الدولة العلمانية (وكل دولة حديثة هي دولة علمانية) تحتاج لها لمقاومته. إن أحد المبادئ الأساسية للتدين السياسي الحركي هو رفض الفصل بين الدين والدولة الذي يُجسّده وجود مؤسسة دينية خاضعة للدولة. ولكن الحاجة إلى تسييس المؤسسة الدينية، أي الحاجة لتوريط المؤسسة الدينية في صراع الدولة السياسي مع الحركات الدينية السياسية يقلب وظيفتها التاريخية ويقربها من التديّن السياسي. والثقافة المركبة، الناجمة عن السجال بين الدين الرسمي والدين السياسي، لا يمكن أن تكون ثقافة ديموقراطية أو مساندة للديموقراطية، فهي ثقافة وسيطة بين تديين فكر الدولة غير الديموقراطية وفكر الحركات الدينية السياسية.
تشكل السياسات والأوضاع الاجتماعية المؤدية إلى اللقاء بين خطاب المؤسسة الدينية وخطاب الحركات السياسية الدينية عقبة حقيقية أمام أي تحول ديموقراطي. ولا شك أن الحركات الدينية السياسية تتضامن مع المؤسسة الدينية عندما يتعرض نفوذها للخطر خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق المرأة وغيرها. في هذه الحالة تتخلى الحركات السياسية الدينية عن اتهامها للمؤسسة الدينية أنها مجرد أداة بيد الدولة العلمانية وتنضم إليها في المعركة دفاعًا عن العائلة كقلعة للقيم الدينية الاجتماعية.
ولكن عندما تتضامن المؤسسة الدينية الانتهازية والخائفة عادةً مع الحركات الدينية السياسية ضد ملاحقة جهاز الدولة لها، فإن هذا يكون دليلًا على قوة الخطاب الديني سياسيًا، إلى درجة تجرؤ المؤسسة الدينية على التدخل مباشرة في شؤون السياسة. وتنبش المؤسسة الدينية في تاريخها فتجد ما تستند إليه في تراثها القريب، إذ شكلت في مرحلة التحرر من الاستعمار أحد روافد المقاومة، عندما استخدمت الشعور الديني ضد ظلم المستعمرين الأجانب، كما استخدمت نبرة التحرر من الاستعمار لمعارضة إصلاحات تحديثية أدخلها الاستعمار. لقد كانت مقاومة المؤسسة الدينية لنفوذ الاستعمار الثقافي مزدوجة الطابع دائمًا، إذ تحمل بعدًا تحرريًا وبعدًا آخر معاديًا للتحديث. ولكن اللقاء الجديد بين المؤسسة والحركات الدينية السياسية لا يقوم إلا على أساس ازدياد نفوذ الحركات الدينية السياسية وازدياد نفوذ الخطاب الديني السياسي مع أسس ثقافية أصولية مشتركة بينه وبين المؤسسة معادية للإصلاح والتطور والتقدم الاجتماعي.
التديّن السياسي: وانتشاره هو ردة فعل على فشل عملية التحديث وجزء أساسي من هذه العملية (المشوهة في حالتنا) في الوقت ذاته. ونحن نستخدم تعبير "عملية تحديث مشوهة"، لأننا عادة نقارن التحديث في البلدان العربية وبلدان العالم الثالث عمومًا بالنموذج الأصلي للحداثة الذي أُفرز تجريدًا على شكل نمط الحداثة التاريخية المعروف والمتمثل بتحولات اجتماعية وفكرية واقتصادية وسياسية عميقة وتدريجية شكلت بمجملها انتقالا نوعيًا قياسًا بما قبلها بحيث يصبح بالإمكان التصنيف بين حداثة – وما قبل الحداثة. وقد كانت إستراتيجية التديّن السياسي الأساسية إصلاح الدين لكي يصبح أكثر تلاؤمًا مع متطلبات الحداثة. والمشترك بينه وبين نمط الوعي الأصولي، في هذه المرحلة، هو الرغبة في تنقية الدين من الشوائب الخرافية والأسطورية التي علقت به، مع الفرق أن العودة إلى الأصول في هذه المرحلة المبكرة، تتم من أجل إيجاد أساس متين لعملية الإصلاح. التديّن السياسي في مراحله الأولى بروتستانتي الطابع. ولكن سرعان ما ينتقل من إصلاح الدين والدولة، بموجب تحديات الحداثة، إلى إصلاح الدولة لكي تتلاءم مع متطلبات الدين المؤدلج. هنا يصبح التديّن السياسي أصوليًا ولا إصلاحيًا. ويتحول بذلك، أيضًا، إلى حزب سياسي وسلطوي (authoritative) التوجه لأنه يحول الدين بتأويله كـ"دين ودولة" إلى أيديولوجيا سياسية. وينبغي هنا قراءة التديّن السياسي كظاهرة حديثة هي جزء من عملية التحديث المشوهة التي لن نحاول تعريفها وإنما نكتفي بذكر بعض ما تتضمن وله علاقة بموضوعنا:
أ نشوء خطاب الدولة السياسي الجماهيري غير الديموقراطي والذي يمر بعملية تديين sacralization خاصة بعد فشل الأيديولوجيات الجماهيرية الطابع السابقة.
ب نشوء بنية الدولة القومية الحديثة فاقدة الشرعية نتيجة للتقسيمات الاستعمارية من ناحية وفقدان الديموقراطية من ناحية أخرى.
ج تطور وسائل الإعلام الحديثة المحتكرة من قبل الدولة.
د عملية التمدين (urbanization) التي تتحول من عملية تمدين الريف إلى عملية ترييف المدينة، وذلك لأن مدينة الخدمات تدخل المهاجرين إليها من الريف ولا تستوعبهم في نسيجها، بل تبقيهم مذررين (atomized) خارج ثقافة المدينة، وخارج البنى الريفية الحميمة، في الوقت ذاته. العملية التاريخية التي أنشأت خطاب الدولة القومية الجماهيري، أو الموجة للجماهير، هي العملية نفسها التي أنشأت "الجماهير" (masses) التابعة والمهيأة لتلقي هذا الخطاب، ثم الحركات الدينية التي سوف تستولي عليه. لقد نشأت الثقافة الجماهيرية من رحم الحداثة. وفي مراحل فقدان شرعية الخطاب القومي لتحوله إلى خطاب تبريري للسلطة القائمة ومع تنامي قوة الدولة العربية يرافقه فقدان الأسس المادية لشرعية الدولة السلطوية، وأقصد قدرتها على القيام بدورها في العقد الاجتماعي وذلك بتزويد المواطنين بحاجاتهم المادية الأساسية، يصبح بالإمكان، بسهولة، أسلمة الثقافة الجماهيرية.
لقد أنشئت العديد من الأبحاث والدراسات حول التديّن السياسي على موجات ذات علاقة بمراكز الأبحاث وأجندة مموليها وبالعرض والطلب في سوق الكتب ودور النشر: الأولى بعد نجاح الثورة الإيرانية بإطاحة نظام الشاه، والثانية بعد مقتل الرئيس المصري أنور السادات، والثالثة بعد نشوء وانتشار الحركات الإسلامية في الجزائر وبقية دول شمال أفريقيا، والرابعة والمستمرة بعد بروز الإسلام السياسي الخليجي – الباكستاني المتقاطع مع حركات متطرفة ودموية الطابع من بقايا الموجات الثلاث الأولى، الذي اتخذ شكلًا شديد الخصوصية في تخلّفه، معاديًا للحضارة والمدنية بشكل عام بما في ذلك مظاهرها الإسلامية. وكل موجة من الدراسات تركزت على جانب بعينه من جوانب نشاط وأيديولوجيا الحركات الإسلامية الحديثة ومصادرها الفكرية. فتارة يبدأ الباحث بحركة الإخوان المسلمين ومؤسسها حسن البنا، وتارة يبدأ الباحث بسيد قطب ومعلمه الروحي أبو الأعلى المودودي وناشر أفكاره أبو الحسن الندوي. ويعود بعض الباحثين إلى حركة الإصلاح الديني في مرحلتها السلفية المتزمتة (محمد رشيد رضا)، ويجعل آخرون البداية عند ابن تيمية أو ابن حنبل ويعود بعضهم إلى بدايات الإسلام والخلافة الراشدة.
ونحن لا نقلل إطلاقًا من الدراسات حول المصادر الفكرية والتاريخية للحركات الإسلامية، ولا نقلل إطلاقًا من أهمية تحليل نصوصهم والنصوص التي يستندون إليها، بما في ذلك بعض الآيات القرآنية المدنية ذات العلاقة المباشرة بالمعاملات. كما أن ظاهرة وفكر الحركات الدينية السياسية قد أشبع تمحيصًا بسبب الطلب الكثيف الإعلامي والسياسي، ومن ضمن ذلك أبحاث ممتازة. وما ينقص هو بحث استيعاب الناس لهذه الحركات وتفاعلها مع التديّن الشعبي وقضية انتشارها. ولكن لا توجد إمكانية لفهم نشوء وتطور، والأهم من ذلك انتشار المزاج السياسي والثقافة السياسية التي تحملها الحركات الإسلامية دون تحليل معمق للتحول الثقافي، بل والحضاري الناجم عن الانتقال من نمط التديّن الشعبي إلى نمط التديّن الجماهيري، والانتقال من المجتمع الأهلي الريفي إلى المجتمع الجماهيري وما يرافق ذلك من تحولات بنيوية في ظروف انهيار الطبقات الوسطى والمدينة القديمة وعدم نشوء طبقات وسطى حديثة في مكانها.
وفي ظروف ترييف المدينة قد تتحول وظيفة الدين من التديّن الشعبي إلى أيديولوجيا جماهيرية أو إلى وظائف ذات طابع أيديولوجي على مستوى الهوية وعلى مستوى آليات الدفاع عن الذات الجماعية أمام تعسّف الدولة وعنف الحداثة وغيرها. ولم يكن التديّن الشعبي عبارة عن أيديولوجية منتشرة في أوساط الشعب، بل نمط حياة متنوعًا ومختلفًا بين الريف والمدينة.
وعلى أية حال فإن نمط التديّن السياسي ليس ديموقراطيًا، ونحن لا نقول إن أي حزب يحمل صفة دينية تقليدية لا يستطيع أن يكون ديموقراطيًا، فهنالك أحزاب سياسية في أوروبا ذاتها وفي الولايات المتحدة تصرّ على أن تؤكد على علاقتها مع التراث المسيحي، تضيف كلمة مسيحي إلى كلمة ديموقراطي. وبإمكاننا تخيل الحزب الديموقراطي الإسلامي في نظام برلماني في أي دولة عربية. ولكن حركات التديّن السياسي القائمة هي حزب ديني سياسي لا يكتفي بحمل صفة الدين كحضارة وكسياق تاريخي وحتى كعقيدة، وإنما نحن نتحدث عن حركات سياسية تصرّ على أن الدين والنص الديني كما تفهمه هو أيضًا نص أيديولوجي سياسي، وأنها هي ممثل هذا النص والمتحدثة باسمه.
لا مجال لحسم نقاش إمكانية تقبّل التديّن السياسي للديموقراطية، أو تكيّفه معها على الأقل، وتقبّل الديموقراطية له في الحلقة المفرغة التي يخلقها الدوران بين وجوب قبول نتيجة انتخابات بالأغلبية إذا وصلت أحزاب الإسلام السياسي إلى الحكم بالانتخابات وبين عدم احترام هذه الأخيرة الديموقراطية كنظام دينوي لا يستند إلى نص ديني صريح، وإمكانية قيام هذه الأحزاب بإلغاء النظام الانتخابي أو تقييده بما يتلاءم وفهمها للشريعة الإسلامية بحيث تُقصى منه على أقل تقدير تلك الأحزاب التي تعارض تطبيق الشريعة علنًا. نعود هنا إلى مبدأ "الديموقراطية للديموقراطيين"، أي عدم جواز أن تُستخدم الديموقراطية من قبل غير الديموقراطيين كمجرد أداة من أجل الوصول إلى الحكم ثم تقويض الديموقراطية ذاتها. والمبدأ الأهم منه والذي تستند إليه القناعة السائدة في الديموقراطيات الليبرالية بأن الديموقراطية ليست حكم الأغلبية، بل هي حكم الأغلبية بموجب القيم والأفكار الديموقراطية الليبرالية، تمامًا كما يقول الإسلاميون إن نظام الحكم الإسلامي هو ليس حكم الشورى، بل الشورى بموجب الشريعة كما يفهمونها، وإلا فما التعارض بين النظام البرلماني والشورى... هذا إذا تجاوزنا النقاشات المعهودة وغير المثمرة إطلاقًا عمّا إذا كانت الشورى "في الإسلام" ملزمة أم لا.
وقد أدخلت بعض الحركات الإسلامية السياسية التي تؤمن بالعمل السياسي وبالاقناع بأفكارها بالطرق السلمية إصلاحات على فكرها السياسي من نوع "بيان للناس" الذي وزعته حركة الإخوان المسلمين المصرية. وقد تم ذلك على أثر النقاش بينها وبين الحركات الجهادية والجماعات التكفيرية على أنواعها. وتتضمن هذه الإصلاحات بشكل عام التزامًا بمبدأ المواطنة في الدولة الوطنية واحترامًا لمؤسسات هذه الدولة. ولكن العائق الأساسي أمام اندماج هذه الحركات في عملية ديموقراطية هو ادعاؤها الكلام باسم الله أو باسم الدين، أو على الأقل خلقها لمثل هذا الانطباع. فهذه الحقيقة البسيطة وحدها تمنع الحوار العقلاني وتنسف قواعد النقاش لأنها تضع نفسها منذ البداية، ليس كمؤسسة دينية، بل كحزب فوق بقية الأحزاب. وليس هذا العائق الوحيد أمام التواصل والحوار أو التنافس الديموقراطي مع الحركات الدينية. ونحن لا نتحدث هنا إطلاقًا عن الحركات التي تحمل علنًا راية العداء للديموقراطية باعتبارها نظام كفر، وهي في ذلك ليست أوفر حظًا من أي قرية في ريف الجزائر كفر أهلها، وتعتبر الذبح واستهداف المدنيين الآمنين جهادًا، وتستشهد في ذبحهم أو معاملتهم معاملة العبيد وسبي نسائهم بغزوات إسلامية تمت في الماضي السحيق بموجب قواعد الغزو التي كانت قائمة. فهذا لا يحتاج إلى حديث.
لا توجد إمكانية نظرية حقيقية لفهم الحركات الإسلامية الحديثة من دون مفهوم الجماهير. فالثقافة الشعبية (كمفهوم شامل مقابل لثقافة النخبة)، والتي تشمل الثقافة التقليدية والريفية وغيرها من أنماط التديّن الشعبي غير المسيس، لا تشكل أساسًا للتدين السياسي. لقد أصبح انتشار التديّن السياسي جماهيريًا مع نشوء ظاهرة الجماهير والثقافة الجماهيرية في المدن، وهي الثقافة الناجمة عن لقاء الفرد المذرر مباشرة مع مؤسسات الدولة ومع وسائل الاتصال الحديثة وعن أدلجة الأفراد مباشرة من دون المرور بوساطة الجماعة العضوية (العائلة، الحارة...)، وعن تذرير الأفراد من دون إعادة صياغة العلاقة بينهم عبر المواطنة وسيادة القانون، وعن عملية ترييف المدينة في الأحياء الشعبية المتسعة بالاستمرار. لقد أصبح الحديث عن أنماط التديّن الشعبي (popular religion) غير كافٍ: الصوفية كنمط تدين شعبي (مع أن هنالك بالطبع صوفة نخبوية أيضًا، تُجيب على روحية أخرى)، الشعائر الريفية، التقاليد الزراعية المختلفة وعلاقة التديّن بالتقاليد المتوارثة في المكان من ديانات أخرى، التقاليد المرتبطة بالأولياء في كل منطقة بعينها. وهناك حاجة للتخصيص وتناول موضوعة التديّن الجماهيري (mass religiosity) بشكل يميزها عما يجمع أنماط التديّن الشعبي الأخرى.
هنا ننتقل إلى الثقافة الشعبية فالعلاقة بين التديّن السياسي وبين فضاء الثقافة الشعبية الدينية تمر عبر نشوء الثقافة الجماهيرية. والثقافة الشعبية لم تكن جماهيرية دائمًا. وحتى تلك اللحظة كان المكون الديني للثقافة الشعبية في حالة تنافر مع الإسلام السياسي الأصولي. كانت العلاقة بين النخب الدينية وبين عموم المتدينين تمر، عادة، عبر قنوات الاتصال بين بين المؤسسة الدينية، بقضاتها ووعاظها وأئمتها، وبين عموم المتدينين. وكانت الدرجات الدنيا من رجال الدين شديدة الارتباط بالدين الشعبي، في حين يقترب رجال الدين من دين المؤسسة مع ارتفاع منزلتهم. وقد كُتبت العديد من الدراسات حول التديّن الشعبي المتوارث الذي اختلط فيه إسلام النص والسنة مع الثقافات المحلية قبل الإسلام، واختلطت فيه فروض الدين المستقاة من تعاليم المؤسسة الدينية بالوعي الأسطوري، وطقوس السحر، والشعوذة، وزيارات الأضرحة، والتضرع للأولياء، وغير ذلك مما تنبذه المؤسسة الدينية، ولكنها تعودت أن تتعايش معه طالما ضمن ذلك ولاء جمهور المتدينين.
فالمؤسسة الدينية الأرثوذوكسية (السنية) لا تبتعد عن رعيتها حتى لو أدى ذلك إلى تجاهل النصوص الصريحة، أو إلى المشاركة في احتفالات الموالد. اختلف التديّن الشعبي، بالطبع، بين الريف والمدينة. فالتديّن الشعبي في المراكز المدينية كان، عادةً، أقرب إلى المؤسسة وإلى رؤية محور التديّن والسلوك الديني كأداء فرائض دينية.
العلاقة بين التديّن الشعبي والمؤسسة الدينية علاقة جدلية وديناميكية، والتديّن الشعبي لا يتأثر بالمؤسسة الدينية فحسب، بل يؤثر فيهان أيضًا، إلى درجة تبنّي العديد من الطقوس الشعبية المخالفة للسنّة وذلك لتجذرها بين جمهور المؤمنين وعدم الفائدة من منازعتها. فهنا تفضل المؤسسة الدينية استيعاب (co-option) الجمهور بدلًا من مخاصمته، وأكبر مثل على ذلك تقبلها التدريجي للطقوس والشعائر الشعبية حول عيد المولد النبوي الشريف، ثم تبنيها له. لا تمثل المؤسسة الدينية في مرحلة ما قبل الحداثة مصدر فتاوٍ للدين الشعبي فحسب، بل هي العلم ذاته، ورجالها هم العلماء. وقد يتحولون، أيضًا، في مراحل معينة، مثل مرحلة الصراع مع الاستعمار، إلى قادة شعبيين.
يتكيف الدين الشعبي ويبدي مرونة تجاه أنظمة الحكم المختلفة التي تقصي عامة الناس عن السلطة. ولكن بسطاء المتدينين يبدون أيضًا مرونة تجاه الديموقراطية السياسية في حالة عدم اقتصار ممارساتها على النخبة. وحين تدعو جمهور المتدينين إلى المشاركة في عملية الاقتراع فإنهم يشاركون بمنتهى الحماسة والجدية إلى أن يتضح لهم أن السلطة لا تنتخب فعلًا. ويشارك عامة الناس بالعملية السياسية عندما تتاح لهم الفرصة، وعندما لا تتضمن العملية الديموقراطية هجومًا صداميًا مباشرًا على العادات والتقاليد الاجتماعية، خصوصًا في ما يتعلق بالأحوال الشخصية التي تتوحد من خلالها المؤسسة الدينية مع المواطنين من الرجال ضد الإصلاح الديموقراطي، أو بالأحرى الليبرالي في هذه الحالة.
يشارك المؤمنون من سواد الناس في العملية الديموقراطية بجدية عندما تتاح لهم الفرصة، وعندما يدركون أن العملية الديموقراطية جدية فعلًا، وليست مجرد تمثيلية. وقد لا يمارسون كل الحريات المدنية المتاحة، ولكن ليس نتيجة لموقف معادٍ لها، وإنما نتيجة لخبرة زادت من ريبتهم وشكهم تجاه الخطوات التي تقوم بها الدولة فيما إذا كانت امتحان ولاءٍ لهم أم خطوات ديموقراطية حقيقية.
والاعتقاد أنه توجد للمواطن العادي مصلحة في ألاّ يُعتقل من دون سبب، وألاّ تُهان كرامته من قبل ممثلي الدولة في أي مناسبة، وأن يستطيع أن يحصل على حقه عبر القانون هو اعتقاد صحيح، ومن السذاجة الاعتقاد بعكس ذلك. ولا توجد قيمة شعبية تتعارض جوهريًا مع مثل هذه الإصلاحات في الحقوق السياسية والمدنية للمواطن. قد تتعارض البنى الاجتماعية القائمة، والتي يتمسك البسطاء بها لفترة طويلة في الحداثة (وأقصد الانتماءات العضوية الجزئية مثل العشيرة والحمولة والطائفة) مع البنى الحزبية الأيديولوجية أو النقابية المهنية أو الطبقية، وذلك نتيجة لطبيعة الحداثة المشوهة ونتيجة لانعدام حقوق المواطن. فهذه البنى تحول دون أن يمارس المواطن فرديته، كما تحول دون انتماء مباشر إلى الأمة ذات السيادة، وبذلك تحرم عملية التحول الديموقراطي من التعددية الحزبية السياسية، وتحولها بسرعة إلى تعددية سياسية طائفية أو عشائرية تهدد وحدة وتماسك الدولة الديموقراطية لأنها تفتت ولاءاتها، ولأنها لا تنطلق من تفسيرات مختلفة لنفس المصلحة الجماعية، بل من مصالح جماعية مختلفة. ولكن الحفاظ على هذه البنى وتحجرها في ظل الحداثة لم يتمّا نتيجة لموقف معادٍ للديموقراطية، وإنما لغرض الحماية من انعدام الديموقراطية.
ولكن لا يمكن تجاهل مركبات أساسية في التديّن الشعبي قائمة في الثقافة الريفية والشعبية في كل مكان وإن بتفاوت:
الإيمان بالسحر والأساطير، وتأثير هذا الإيمان على فهم المجتمع والقوى التي تتحكم به، كقوى خير وقوى شر، وتعرض هذا النوع من الاعتقاد إلى التجند والتعبئة لصالح قوى ضد قوى دون الحوار والتنافس المطلوب للعملية الديموقراطية، وبقايا هذا النمط من الوعي في نظرية المؤامرة وتجسيد الشر المطلق بالآخر وغيره.
عدم تلمس الفرق بين الحيز العام والحيز الخاص في الثقافة الشعبية العفوية المتوارثة من دون تدخل سيادة القانون والتثقيف الديموقراطي أو التعويد الديموقراطي. وهذه عقبة قائمة في المجالات المتعلقة بالملكية الاجتماعية وحقوق الفرد بشكل عام ولكنها قائمة أيضًا في المجال الديني حيث يصعب على التديّن الشعبي فهم الدين والتديّن والقرار الشخصي الفردي بشأنهما كقضية خاصة.
الضغط على الفرد عبر مؤسسة التقاليد للحفاظ على تماسك الجماعة، والذي لا يقتصر على الضغط المعنوي وقد يتحول من حين لآخر إلى القسر بالقوة والعنف. هنا لا تعترف الجماعة أصلًا بحق الفرد بالاختيار وقد تدخل في عملية الاقتراع الديموقراطي ذاتها بصفقات جماعية لصالح مرشح أو حزب. ناهيك عن تدخل التقاليد بخيارات الفرد الشخصية في شؤون السلوى في الحياة وتعريفه للسعادة.
الموقف السلبي والتشكيكي من الدولة: قد ينتقل الوعي بالدولة من اعتبارها جسمًا خارجياً يخضع إليه بآليات القسر أو الخشوع عندما تختلط الطاعة بالخشوع وبالفرائض، إلى اعتبارها جسمًا متطفلًا على المجتمع لغرض التجنيد أو جمع الضرائب من دون مقابل واضح في الريف بشكل خاص، أو لخداع الناس من أجل توريطهم في سياسة تعود عليهم بالأذى.
تغلب الهوية المحلية أو الطائفية والتقاطعات الهائلة بين التديّن الشعبي والانتماء على مستوى الهوية الطائفية، وتغليب هذه الهويات على هويات متخيلة تتطلبها الديموقراطية، مثل القومية، أو تحويل المواطنة إلى هوية تهم الفرد على مستوى جديد غير قائم في المجتمع التقليدي هو المستوى المدني.
التعامل بشكل سلبي مع بنى حديثة تحتاج إلى ممارسة انتماء غير الانتماء العضوي من نوع الطائفة والعائلة مثل الأحزاب. وقد تستغل القوى غير الديموقراطية هذا الالتباس لتأجيج عصبية الانتماء إلى الحزب في نوع من تخريب التعصب للبنى القبلية، أو قد تستولي الانتماءات الأخرى على الانتماء الحزبي السياسي لتسخره لصالحها، ومن دون أحزاب أساسية تعتبر ما يجمع أعضاءها هو البرنامج السياسي أو الرؤيا الخاصة بالحزب لتنظيم المجتمع بأسره من الصعب تخيل عملية انتخابات برلمانية تمثيلية.
الموقف ضد حرية التعبير عن الرأي. لا تعتبر حرية التعبير عن الرأي قيمة في أي ثقافة شعبية إلا حيث تم تذويت القيم الديموقراطية عبر أجيال. والأهم من ذلك أنه في ظروف تعبئة وتحريض قد يتحول هذا الموقف إلى معاداة حرية التعبير عن الرأي باسم المس بالقدسات، أو العقائد، أو "المشاعر" (وهذا التعبير الأخير: "المس بالمشاعر الدينية" أدخل حديثًا على الثقافة الشعبية في الدول الحديثة كأداة بيد من يراهنون على سياسات الهوية)، أو التعرض للعادات المتّبعة والأعراف والتقاليد والأخلاق العامة. وهذه تعابير يستخدمها المحرّضون ضد حرية التعبير وليس المحرّضون.
عدم وجود حساسية تجاه مفهوم الحقوق. فالناس في المجتمع الأهلي التقليدي لا تتعامل مع بعضها كأفراد عبر مفهوم الحقوق. صحيح أن هنالك فهمًا أوليًا لحقوق الناس على بعضهم البعض وواجباتهم تجاه بعض، ولكن الحقوق غير مرتبطة بالفرد كحامل لها، بل كمتطلبات اجتماعية وأعراف وتقاليد وأنماط سلوك متعلقة بالأدب والذوق العام، وهذه كلها معايير للسلوك ضرورية للحياة حتى في المجتمع الديني، ولكن مفهوم الحقوق المرتبط بمفهوم الدولة والفرد هو شأن آخر ولا غنى عنه في الديموقراطية، ومن المفترض أن يكون الحق مرتبطًا بالفرد وأن يحترم بقية الأفراد والدولة هذا الارتباط.
الخضوع السريع لذوي الشأن والسلطة والقوة وتبرير ذلك. هنالك تقاليد كاملة وثقافة شعبية تبرر من منطلق الصراع على البقاء ضرورة المراءاة ومسايرة الحاكمين والنفاق لهم أو الخضوع لهم بواقعية الحفاظ على الذات، وقد تبرر أيديولوجيا أيضًا بتذويت التفوق للحكام والحاكمين كحالة طبيعية مثل أن الأبوة في المجتمع البطريركي تستوجب الطاعة، وبالطبع تزود الرؤية التقليدية لله كأب أساسًا لاشتقاقات لا حدود لها من رأس الهرم إلى قاعدته.
النظرة البطريركية والموقف الرجولي التقليدي قبل الشوفينية الرجولية الحديثة هو موقف محافظ في ما يتعلق بحقوق المرأة وواجباتها المنزلية، بدءًا بالتعامل مع جسدها كعورة ونقطة ضعف، ونهاية باعتبارها قاصرًا من الناحية الروحية والعقلية، ولا توجد ديانة توحيدية واحدة لا تبرر ذلك على مستوى العقيدة والنص التاريخي والمؤسسة الدينية والتديّن الشعبي. هذا الوضع الدوني للمرأة يستند، في ما يستند إليه، إلى نص وتقاليد في كافة الديانات.
كل هذه بنى ثقافية فكرية متأصلة في كل ثقافة شعبية في أي مجتمع. وهي تطبع التديّن الشعبي بطابعها وتختلط معه بحيث لا نميز أي عناصرها ذو أصل ديني وأيها لا علاقة له بالدين، بل بالجهل أو الفقر وحدهما مثلًا. ولكن الثقافة الشعبية ليست هي التي تولد الديموقراطية ولا البرامج الديموقراطية، وليس المطلوب توقع ذلك في التحول الديموقراطي. والسؤال هو مدى قدرتها على التعايش مع النظام الديموقراطي ثم استبطان بعض مبادئه في العرف الاجتماعي السائد. وقد علمتنا التجربة أن هذه الثقافة غالبًا ما تكون قادرة على التكيف مع ازدواجيات من نوع: طاعة النظام "حتى" لو كان ديموقراطيًا، أو الاحتفاظ بهذه الأفكار والمعتقدات لحياة القرية أو الحي أو العائلة، والتصرف بموجب قواعد أخرى "في الدولة" كما يقال، أي في الحيز العام من دون تحديده بالضبط.
لا يوجد تناقض جوهري بين الثقافة الشعبية القادرة على التكيف، قبل أن تتغير بالتدريج باتجاه ديموقراطي، وبين عملية التحول الديموقراطي. والتناقض الفعلي الذي يقع في الممارسة من دون تعبئة أو تحريض ضد الديموقراطية أو الحداثة عمومًا هو بين ممارسات وتقاليد شعبية من ناحية وسيادة القانون الجنائي والمدني الذي قد يتعامل مع هذه البنى والممارسات كخرق له. خذ مثلًا عادات مثل الثأر أو القتل على خلفية الشرف أو ختان المرأة أو تعدد الزوجات أو طغيان العلاقة الأهلية بين الغني والفقير والتي تصل حد الاستعباد والخروج على قوانين العمل المرعية، كلها عادات تصطدم مع نمط الحياة الحديث في دولة يسودها القانون خصوصًا إذا كانت ديموقراطية. وبالإمكان محاصرة هذا التناقض. هنا ندخل باب الحزم والحكمة، في تطبيق القانون من ناحية، والتربية والتنشئة البعيدة المدى في ظل سيادة القانون، من الناحية الأخرى.
إن أقصى مواقف التديّن الشعبي سلبية تجاه عملية التحول الديموقراطي لا يتجاوز مقاطعة هذه العملية والعزوف عنها، أو محاولة فرض البنى العضوية عليها لتحل العشائر أو العائلات أو الطوائف، أي لتحل العصبيات، محل الأحزاب. وهي معضلة صعبة لأن التعددية الديموقراطية ليست هي التعددية التقليدية التي تعيشها الثقافة الشعبية، والتديّن الشعبي بشكل خاص. ولا أتخيل إمكانية حل لهذه المسألة إلا من خلال الاقتاصديات الحديثة وتوسيع الطبقة الوسطى التي تساهم في دمج المجتمع وتطور العملية الديموقراطية ذاتها. ولا بديل لتوسيعها في عملية بناء الأمة الحديثة nation building وهي العملية الكفيلة بدمج المجتمع – الأمة في وحدة تمكن من الانقسام على أساس الاختلاف على تعريف مصلحة هذا المجتمع – الأمة والمعبر عنه في تعددية البرامج السياسية.
أما عند حصول تناقض بين فرائض الدين والمحللات والمحرمات، كما يتصورها الدين الشعبي، من ناحية والسياسة المنتهجة من ناحية أخرى، فسوف يفرض على الدولة المتجهة نحو التحول الديموقراطي إما فرضها بالقسر وتحمل نتائج وتبعات ذلك، أو التخلي عن هذه الممارسات في المدى القريب إلى أن يحين الوقت للعودة إليها من جديد بعد أن يكون المجتمع قد نضج لتقبلها، أو الاستعانة بالمؤسسة الدينية من أجل تبريرها وإيجاد فتوى لها، كما كانت الديكتاتورية تفعل أحيانًا، ولكن من خلال عملية تشجيع للتيار الإصلاحي الديني وليس الأصولي في المؤسسة الدينية، كل ذلك قبل أن يتمم التحول الديموقراطي عملية علمنة المجال الاجتماعي الذي نتحدث عنه.
الثقافة الشعبية قادرة على التكيّف، وهي لا تتحول إلى ثقافة سياسية فاعلة، أي معادية للديموقراطية إلا إذا استخدمت من قبل قوى منظمة غير ديموقراطية في التعبئة السياسية. ويجب أن تتوفر عدة شروط لكي تكون هذه القوى قادرة على التعبئة ضد الديموقراطية باستخدام عقائد التديّن الشعبي وأنماط السلوك التي تبررها هذه العقائد. وتتميز قوى التديّن السياسي بالقدرة على ذلك بعد أن تكون قد جرفت فئات من النخبة معها ذات المصلحة بتعبئة الجماهير ضد الحداثة وما تمثله، وضد قيم الديموقراطية. وتلعب الثقافة الشعبية دورًا هنا أيضًا إذ تمكن الحداثة المسرّعة من انتقال قوى شعبية الثقافة إلى مواقع النخبة بسرعة، وقبل أن تتذوت قيم الحداثة، وإذا لم تستوعب الحداثة ومؤسساتها هذه النخب لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، فإنها تكون أكثر تعرضًا للموقف المعادي للحداثة، إذ تحمل معها إلى مواقعها الجديدة قيمًا غير ديموقراطية وغير حديثة من خلفية الثقافة الشعبية، يضاف إليها استخدام الأدوات الحديثة: التنظيم، التعبئة، الحزب، ديماغوجيا السياسيين وكذبهم، الخطاب والاجتماع الجماهيري، المظاهرة، وسائل الاتصال الحديثة...
وتصبح عملية التعبئة ممكنة إذا توفرت جاهزية الناس للتعبئة بتحولهم إلى جماهير، ومع التحول من الثقافة الشعبية إلى "الثقافة الجماهيرية السائدة" القابلة للتعبئة والتجنيد لهدف سياسي.
إذا توفرت هذه العوامل سوية فسوف تواجه القوى الديموقراطية مشكلة حقيقية تواجه عملية التحول الديموقراطي برمتها. ولا يمكن مخاطبة الثقافة الشعبية الجماهيرية المحزبة ضد الحداثة بشكل وعظي أو تلقيني أو تدريسي، كما كانت قوى التنوير تخاطب "الشعب" في الماضي لأن هذه القوى تدعي لنفسها إمكانية التعبير عن ذاتها بشكل متساو مع البنى الأخرى الحزبية والاجتماعية الأخرى من منطلق القيم التعددية. وهي تراهن بذلك على إحراج القوى الديموقراطية ووضعها في امتحان مبادئها ذاتها، ثم لا تلبث أن تفرض هي الوصاية والتفوق على الآخرين من منطلق تمثيلها للدين في السياسة.
يطرأ تغير جذري على موقف التديّن الشعبي من الديموقراطية عندما يتحول إلى تديّن جماهيري معرّض للتسييس. وتسييس الدين الشعبي غير موجه ضد الديموقراطية بشكل خاص، بل قد يكون معبئًا ضد الديكتاتورية وفي مواجهتها (شريعة الله هنا ترمز إلى ضبط اعتباطية وعشوائية الحكم). ولكنه في نهاية المطاف ينجب وعيًا معاديًا للحداثة، وبالتالي لعملية التحول الديموقراطي، أيضًا. التديّن الشعبي تديّن عضوي نابع من تصور وحدة عضوية (community) في القرية، أو الحي، أو "الأمة" بمفهومها الديني كجماعة المؤمنين، بحيث تنشأ ممارسات الإنسان الدينية من انتمائه إلى الجماعة، ولا تنبع من تصور فردي أو حزبي أوعقائدي (ideological) كالتزام فردي بالتصرف بموجب الشريعة، أو السُّنة، أو غير ذلك. التديّن الشعبي، من هذه الزاوية، مغلق رغم تنوعه وتكيفه. وهو لا يتفاعل مباشرة مع الديموقراطية، فإما أن يتعايش معها بحيث يفصل المواطن بين وعيه الديني، الأخلاقي بطبيعته، وبين الديموقراطية الطارئة، إلا إذا دامت وتعلم أن يأخذها بجدية، وإما أن ينعزل عن العملية الديموقراطية بلا مبالاة وعدم اكتراث بحيث تبقى السياسة "لعبة الكبار".
أما التديّن الجماهيري فينشأ كظاهرة حديثة نابعة من تفتيت الجماعة العضوية من دون نشوء المواطنة الديموقراطية في مكانها. لقد تم تذرير الأفراد، ولم يتم تحويلهم إلى مواطنين، بحيث تنظم الحقوق والواجبات علاقتهم مع المواطنين الآخرين ومع الدولة.
تتم مخاطبة هذا الجمهور من قبل النخبة أو النخب السياسية، وذلك عن طريق تعميم التعليم وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع والدعاية والكاسيت والمنشور والخطاب السياسي التعبوي الموجه، ومؤخرًا بواسطة تحويلهم إلى مشاهدين مدنين على الدراما الإعلامية كتسلية وكتعبئة. لقد ولّدت القوى العلمانية ومن ضمنها الحركات القومية، في حينه، خطابًا جماهيريًا ونمط عمل سياسي جماهيري، وحاولت تجنيد الجماهير إلى جانبها في صراعها مع النخب التقليدية القديمة، ولكنها انتهت إلى إقصاء "الجماهير" خارج السياسة، رغم استمرار استناد شرعيتها إلى الخطاب الجماهيري.
في مرحلة اهتزاز شرعية الدولة، في ظل الأزمة الاجتماعية والسياسية للديكتاتوريات الفاقدة الشرعية، أصبح من السهل أسلمة "الجماهير"، ليس في خطاب الإسلام السياسي فحسب، بل في خطاب الدولة التي باتت تتنافس مع الإسلام السياسي في اتخاذ الإسلام مصدرًا لشرعيتها أيضًا. وفي مرحلة انعدام شرعية العمل السياسي يصبح متنفسه الوحيد هو أماكن العبادة التي تحتفظ بحصانة نسبية أمام الدولة مقارنة بالشارع والنادي والمقهى.
وكان الجمهور أصلًا قابلًا للتديين السياسي نتيجة لاستمرار تلازم مفرداته مع مفردات الوعي الشعبي الدينية. فمفرداته دينية ومفاهيمه وثقافته كذلك. ونتيجة لتفتت واهتزاز القاعدة المادية للتدين الشعبي الريفي، عند فئات آخذة بالاتساع من السكان، ونتيجة للبحث عن أيديولوجيات تعبوية جديدة، بدلًا من الخطاب الشعبوي أو الاشتراكي، وعن جماعة عضوية متخيلة (imagined community) بعد تفتت الجماعة العضوية المباشرة (face –to- community). والأمة القومية، كجماعة متخيلة، لا تنشأ فعلًا، باعتقادي، أي لا تصبح ممارسة فعلية خارج فترات الحروب والتحرر الوطني إلا عبر رابطة السيادة، ووجهها الآخر هو المواطنة. وبغياب هذه الرابطة يجري البحث عن جماعة عضوية متخيلة أخرى ينبغي أن تصبح ذات سيادة، فقد كانت مرة ذات سيادة وتحقق، بأثر رجعي، أوتوبيا (retrospective utopia) أو عصر ذهبي إنقضى، وينبغي أن يستحضر كبديل للحاضر.
الجمهور حاضر، إذاً للتأثر بالتديّن السياسي. وعندما ينمو هذا الأخير في مرحلة تعفن الديكتاتورية، والدولة العربية القطرية عمومًا، يجد آذانًا صاغية وأماكن لسماعه، وأيضًا الوسائل للوصول إلى الجمهور، وحتى اللغة السياسية جهزتها له الحركات الجماهيرية غير الدينية. وقد تبين أن الدول التقليدية والتي حاولت أن تحافظ على خطاب ديني رسمي محافظ كأيديولوجية دولة لم تكن أحسن حظًا من ناحية طرح التديّن السياسي نفسه كبديل لها مع نشوء حالة جماهيرية وثقافة جماهير وبوجود حركات التديّن السياسي.
ولكن مأساة التديّن السياسي، الذي يطرح نفسه للجماهير كأيديولوجية تعبوية بديلة للأيديولوجية القومية، أنه يصبح أكثر عداءً للديموقراطية، كلما أصبح أكثر جماهيرية. لقد انتهى النمط الإصلاحي في التديّن السياسي منذ زمن بعيد، وبات مقتصرًا على نخبة ضيقة. وحركة الإصلاح الديني لم تكن جماهيريةً في يوم من الأيام إلا عبر التحالف مع عملية التحرر الوطني.
أما النمط الأصولي المنتشر في التديّن السياسي فإنه يبدأ طريقه في حالة صراع مع التديّن الشعبي وعاداته الخارجة عن أصول الدين، وفي هذه المرحلة يكون التديّن السياسي نخبويًا. ونشوء الثقافة الجماهيرية وانتشار التعليم يجعلان الناس البسطاء أكثر تعرضًا لقبول الأفكار الأصولية. ولكن هذا لا يعني أن التديّن الشعبي بجماهيريته أقل أسطورية، أو أقل إيمانًا بالوسطاء الذين يتوسطون بين الفرد والله (أولياء، أضرحة، شعوذة، سحر، استحضار أرواح، عجائب...)، وغير ذلك من مميزات الدين الشعبي التقليدي. وسرعان ما يكشف التديّن السياسي أنه لا يخاطب "العقل الفقهي" ناهيك عن "العقل النصي" لدى الجماهير، وأن قابلية القاعدة الجماهيرية لتصديقه لا تنبع من الاعتقاد الفقهي بنقاء النص الديني، أو من الإيمان بمعتقداته كحزب سياسي، بل نتيجة لمخاطبته أكثر الغرائز الجماهيرية تخلفًا، وأكثر أشكال الوعي خرافية وسلطوية في الوقت ذاته.
يحافظ نمط التديّن الجماهيري على البعد الأسطوري الخرافي للتدين الشعبي، ولكنه يخلطه مع انعدام التسامح ورفض التعددية القائمة في نمط التفكير والتفسير الأصولي، لتنمو تركيبة ثقافية جماهيرية معادية للحداثة وللديموقراطية. هذا هو الشكل الجاهز لتقبّل التديّن السياسي عندما يصبح شعبويًا تعبويًا. ولذلك يتفاجأ المراقبون من الفرق الهائل بين خطاب الإسلام السياسي في الحوار مع القوى الأخرى، في محاولته التكيف مع أجزاء من التجربة الديموقراطية، وتبني مفهوم المواطنة وغيرها في مرحلة الصراع ضد الديكتاتورية، وبين خطابه الموجه للجماهير، وجماهيره هو بشكل خاص، وهو خطاب غير متسامح لا مع الرأي الآخر ولا مع الديانات الأخرى ولا مع الحريات المدنية. هنالك في التديّن السياسي في وضعه الحالي تلوّن في طرح المواقف الديموقراطية والمتسامحة في الحوارات الأكاديمية أو الإعلامية واعتماد خطاب عصبوي تكفيري ومنغلق عند تعبئة الجماهير ضد القوى الأخرى.
وحتى في مرحلة أزمة التديّن السياسي وانتشار النقد الذاتي، بعد فشل العنف في قلب أنظمة الحكم بعد حالتي إيران والسودان، نجد أن الحركات الدينية السياسية غير قادرة على مخاطبة جماهيرها بهذه اللهجة من النقد الذاتي. وعندما تفعل ذلك مجاهرة، أي عندما تقوم بالتصالح مع بعض الأفكار الديموقراطية خلال عملية النقد الذاتي، تنشق عنها أنماط أخرى جديدة من التديّن السياسي من أوساط الجماهير المسحوقة في المدن بشكل خاص وبتحالف مع أنماط مرضية في درجة مغالاتها وتعصبها وسيادة الحقد على كل ما هو حديث ومشرق وجميل وواعد في المجتمع. وهي تبدي قساوة بالغة في معركتها ضدهم وتكفرهم (أنظر حالتي مصر والجزائر). وهذه حالات خاصة وشاذة ولكنها قد تكون عظيمة التأثير لإعتمادها الاستعراضية في تنفيذ أعمالها العنيفة واختيار أهدافها. ولم تكتمل دراستها بعد. على أية حال لم يعبر التديّن الشعبي بأغلبيته حتى الآن مرحلة التديّن الجماهيري.
حاولت في هذه الورقة القصيرة أن أظهر تميّز أنماط التديّن عن بعضها البعض في الموقف من موضوعة التحول الديموقراطي. والأمر المثير للاهتمام هو أنه في حالة توحد الأنماط الثلاثة، من خلال تأثير التديّن السياسي على المؤسسة الدينية وعلى التديّن الشعبي، فإن القاسم المشترك الأعظم يكون معاديًا للحداثة بشكل عام، وللديموقراطية بشكل خاص.
تكمن المهمة الأساسية، إذن، عندما يتعلق الحديث بالتحول الديموقراطي وأنماط التديّن، في منع نشوء وضع تتوحد فيه الأنماط الثلاثة، لأن خصم هذه الوحدة يكون حينئذٍ الحداثة عمومًا، وبالتأكيد عملية التحول الديموقراطي ذاتها.
تكون الثقافة السياسية معادية للتحول الديموقراطي بعد أن تكون الديكتاتوريات أو التحديث الفاشل والمشوه في دول تقليدية قد وحّدت أنماط التديّن الثلاثة في تحالف يعوق هذه العملية.
وهذا يعني أنه على القوى المعنية بالتحول الديموقراطي أن تبحث عن وسائل لفرز هذه الوحدة. وهي لا تستطيع ذلك إذا ما بدأ التحول الديموقراطي بالهجوم السافر على المؤسسة الدينية في شؤون الأحوال الشخصية –مثلًا- فهذا تكتيك خاطئ.
كما أن التحول الديموقراطي إذا كان مرافقًا لعملية إفقار واسعة ناجمة عن عملية خصخصة لا ترافقها ضمانات اجتماعية واسعة فإنه يَفقِد "الجماهير" ويزيد من اغترابها عن عملية التحول الديموقراطي باتجاه تبني طروحات التديّن السياسي. يقترب التديّن الشعبي من التحول الديموقراطي إذا وجد الناس مصلحة لهم في عملية التحول الديموقراطي، أي عندما يكون بالإمكان إضعاف التحالف بين أنماط التديّن الثلاثة ضد الحداثة وضد الديموقراطية. هذا التحالف ليس أبديًا إذ إنه نشأ في ظروف تاريخية محددة، وبالإمكان تفكيكه من دون معاداة أنماط التديّن القائمة منفردة، بل من خلال كسب بعضها لصالح الديموقراطية وتحييد البعض الآخر لتصبح المعركة السياسية مع القوى المعادية للديموقراطية ممكنة في ظل سيادة القانون ومن دون حاجة لدموية تغذي حلقة دم مفرغة من العنف السياسي والاجتماعي.
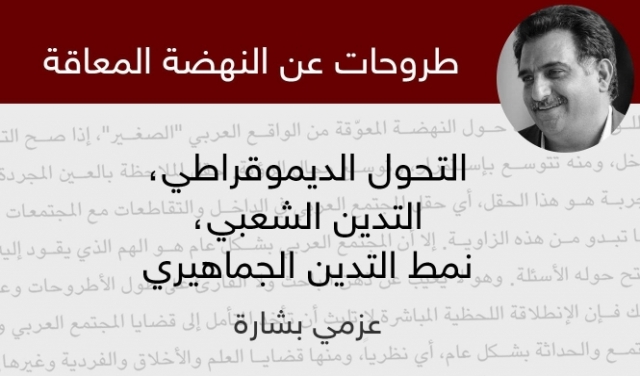
التعليقات