** كتاب "طروحات عن النهضة المعاقة" للمفكر العربي عزمي بشارة صدر عام 2003، ونُشر كسلسلة مقالات في صحيفة "فصل المقال"، يجمعها همّ عرض وتحليل المعوقات التي تقف في وجه النهوض بالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني نحو التحديث، ويلتقي فيها البعد النظري بالاجتماعي والسياسي. نُعيد في موقع "عرب48" نشْرَ هذه المقالات لأهميّتها وراهنيّتها.
____________________________________________________________________________
الخوف من الجمهور وأهمه الخوف المعنوي
يتصدى متقمص شخصية الجمهور، دائمًا وأبدًا، من بين الحضور، أو عبر الأثير في اتصال هاتفي بالبث المباشر. يهتف أو يقاطع مؤيدًا أو معارضًا بضمير المتكلم الجمع "نحن". هذا رغم أنه ينسب التواضع لنفسه بحكم تعريفه كـ "الجمهور" دائمًا. و"التواضع" بحكم التعريف ليس بحاجة إلى أن يتواضع، وباستطاعته المفاخرة بـ "نحن" ضد "أنتم". كما باستطاعته الاتهام: "شو عملتولنا نحن البسطاء؟". و"نحن البسطاء" هذه، أو "نحن العاديين"، تبدو تواضعًا، لكنها قد تعبر عن منافحة وغرور من نوع خاص. وغالبًا ما يتقمصها السياسي أيضًا مفاخراً بـ"بساطته" و "أصله الفلاحي" وبـ"نحن فلاحين مش متلكو" في محاولة للتقرب من الجمهور، من الشعب، من البسطاء، عبر تصنع التواضع.
وتصنّع التواضع أسوأ أنواع الغرور، لأنه يشمل، في ما يشمل، إضافة لإخفاء الغرور وتقنيعه، عملية استغباء للناس واستخفاف بذكائهم ومراهنة على المظهر. ويحتاج "المتواضع" نتيجة للتصنع إلى أن يتباهى بأصول فلاحية مدّعاة، أو غير مدعاة، أو أن يشدد على اعتبار التخلف بساطة، اإعتبار الذكاء أو الحكمة تعاليًا ونخبوية. يتملق المتواضع المختلق والمتكلف الجمهور كما يفهمه. ولأنه يدّعي أنه يفهمه، فإنه "يأخذه على قدر عقله". وبذلك ينتج نوعًا فتاكًا من الغرور والصلف يكرس "عقلية" الجمهور "الشعبية" كما يفهمها. وبتصرفه هذا يعيد المغرور تشكيل هذه العقلية على صورته ومثاله لتتحول صفة "الشعبية" إلى شعبوية تتباهى بمظاهر التخلف والبلادة وقلة الذوق على أنها بساطة وسليقة وحس جماهيري. يطالبك هذا المزاج باستمرار ألا تخاطب الجمهور بالعقل. فالجمهور، بموجب هذا المزاج، يجب أن يُحمّس وأن يُحرّض وأن يُعبّأ. وأية محاولة لإجراء محاكمات عقلية أمامه، أو إيراد معلومة في سياقها التاريخي، أو جعلها تبدو نسبية بعد أن بدت مطلقة، تعتبر تعاليًا على الجمهور. كما أن أي جهد علني لتصحيح خطأ شائع يعتبر ترفعًا عن مدارك الناس.
تُقيم هذه العقلية ادعاءاتها على اعتبار أن الجهل والغرائز والمعلومات الخاطئة، والرغبة في التعميم السريع، والخوف من المجهول، معطيات ثقافية جماهيرية قائمة وصلبة، يتم التعامل معها ببساطة، وتقبل من دون نقد، خصوصًا عند تشكيل صورة الآخر، أو صورة "المختلف عنا" أو "الغريب". أما إذا كان الآخر هو في الوقت ذاته "العدو" فعندها عمم ولا حرج، و"حدث ولا حرج"! ومرر المعلومات التي تشاء بمبالغة وانتقائية وخارج السياق، وراهِن على أنه عند نشر معلومات خاطئة بشكل مغرض فلن يتصدى لك أحد، ولن يحاول أن يصححك خشية أن يتهم بالتعاطف مع الآخر، أو العدو: "أنت معنا ولاّ معهم؟". لكن ما الغريب في الأمر؟ أليس هذا هو حال الثقافة الشعبية في أي مكان عندما ترسم صورة عن الآخر في فترات الحرب مثلًا؟ ما الغريب في التعميم السريع، أو إسقاط المخاوف الدفينة والنقائص التي يخشاها المجموع على صورة الآخر؟ لا جديد. نعرف هذه الظاهرة العميقة الجذور في ثقافات كافة الشعوب، ونراها تزداد قوة في مراحل الأزمات. ما الجديد في الخوف من تحدي الآراء الشائعة والمسبقة؟ هذه ظاهرة تؤرق المثقفين لدى كافة الشعوب وفي كافة المجتمعات. أين مكمن الفرق الذي يستفزنا إذًا؟ إنه يكمن في موقعين:
أولاً: إن هذا النقاش قد وقع في الماضي في المجتمعات الحديثة والمتطورة، إن عصري النهضة والتنوير قد حسماه، ليس لصالح تبديد الخوف من الجمهور أو سحق هذه الظاهرة واختفائها، وإنما لصالح تطور ثقافة تنويرية موازية، لها جمهورها وتؤثر في "الجمهور" ولا تخشاه. هذه الثقافة تحاول أن تنقّي نفسها باستمرار من الأفكار المسبقة والغيبية والعنصرية، خصوصًا أنها لم تكن منزّهة عنها في يوم من الأيام كثقافة تنوير. بل ويعي روّاد النظرية النقدية من أدورنو وهور كهايمر وحتى ريتشارد بوبكين أن العنصرية والآراء المسبقة كانت في صلب التنوير الأوروبي. لم تختفِ في المجتمعات الحديثة نزعة مسايرة المزاج العام على حساب الرأي الحر، وعلى حساب الحقيقة، وحتى على حساب المعلومة البسيطة المعروفة. لكن بالمقابل قامت ثقافة غير مقيدة بهذه الظاهرة، وغالبًا ما تكون مهيمنة على مستويات مثل: المؤسسة العلمية: الجامعة، مركز الأبحاث، عالم الفكر ودور النشر المحترمة، والمؤسسة القانونية: سلطة القانون والمؤسسة القضائية، (زاوية واحدة على الأقل من زوايا الحيز العام) وبعض الإعلام، وهكذا.
ثانياً: يكمن الفرق في اتّساع النخبة التي تتحدى، وتتضامن عندما تتحدى، وتحميها سيادة القانون عندما لا تتضامن. هذا هو الفرق، كل الفرق:
وجود ثقافة متنورة نهضوية بديلة ممأسسة وذات تقاليد قوية وجمهور واسع نسبيّا.
اتّساع النخبة، اتّساعها عددًا، نعم عددًا. ليس الفرق إذًا بين شعوب مختلفة وأخرى متقدمة. فمظاهر الجهل والتخلّف والآراء المسبقة قائمة لدى كافة الشعوب، إنما الفرق باتّساع النخبة غير الخائفة من هذه المظاهر، والتي تعتمد على جمهور واسع وتقاليد ومؤسسات وقانون.
هكذا وجد نصر حامد أبو زيد نفسه وحيدًا. لم تسعفه المؤسسة الجامعية ولا القانونية، بل حَرّضت عليه وقادت الحملة ضده. وهكذا صمت المثقفون الذين يكثرون من الحديث عن حقوق المواطن غارودي في فرنسا، أو عن حرية التعبير في إسرائيل. صمتوا. وتشاطر بعضهم وتلولب في حججه ليبرر صمته بحجج مثل: "هذا من ناحية... أما من ناحية أخرى"، و"الموضوع مركب وليس مجرد حق في البحث العلمي"، أو "يجب طرده من الجامعة أما تطليقه من زوجته فلا"... وهكذا دواليك ولواليب وأكروباتيكا وادعاءات حلزونية، من حيث بنيتها ومن حيث حركتها الزاحفة على البطون.
يلاحظ حتى الساذج مبلغ الظلم، للسياق وللموضوع، الماثل في اعتبار قضايا التنوير والنهضة في المجتمع العربي حرية تعبير عن الرأي. فمعركة جاليليو لم تتناول "حرية التعبير عن الرأي حتى لو كان خاطئاً". وهو لم يطلب من الكنيسة حق التعبير عن رأيه، بل حاول الادعاء أن ما يقوله صحيح وينسجم مع التعاليم المسيحية كما فهمها، وكذلك كوبيرنيكوس وبرونو وسبينوزا وغيرهم الكثير. لقد دافعوا عن صواب رأيهم أمام الجمهور وأمام المؤسسة على حد سواء، وليس عن حرية التعبير. ولا اعتقد أنه كانت لديهم أو لدى أنصارهم أية رغبة أو أي متسع لخوض معركة للدفاع عن حرية تعبير من يعتقدون أن رأيه خاطئ. فلم يشغلهم ما شغل فولتير المتنور، ولا توفر عندهم خبثه وسخريته المجبولة بالنفاق، فهل أصدق أنه "لا يوافق فلانًا على رأيه ولكنه مستعد للموت دفاعًا عن حقه بالتعبير عنه؟". ليست معركة النهضة معركة حرية تعبير بل معركة دفاع عن العقل ضد الخرافة، عن العلم ضد الجهل، عن التجريبية ضد الغيبية، عن النقد العلمي ضد العقائدية، وعن التشكيك والريبية ضد التّزمت.
قضية حرية التعبير قضية ديموقراطية حديثة، قضية ما بعد التنوير. وخلافًا للتنوير والنهضة، لا تميز بين الرأي الخاطئ والصواب، وبين الخرافة والأسطورة والحجة العلمية. وما دام الفكر العقلاني العلمي يقاتل من أجل حقه في التعبير فلسنا في معركة حرية التعبير، بل ما زلنا نراوح في معركة النهضة والتنوير. وما دام الرأي العلمي أو العقلي هو الاستثناء في المؤسسة وفي الجمهور، فهذا يعني أن النهضة ما زالت بحاجة إلى أبطال يدافعون عن صحة الرأي الصحيح، لا عن "حقه في التعبير عن ذاته ولو كانوا لا يتفقون معه". فما داموا يعرفون أن هذا الرأي صحيح، فإن عليهم أن يجاهروا بأنه صحيح وأن يدافعوا عنه لأنه صحيح، لا أن يأخذوا مسافة منه للدفاع عن حقه في الدفاع عن ذاته. وتنتفي الحاجة إليهم، وندخل معركة حرية التعبير، عندما ينشأ نوع جديد من "الأبطال" يدافعون عن حق رأي في التعبير عن ذاته، حتى لو لم يوافقوا عليه، وحتى لو كان غيبيًا. إنهم كديموقراطيين يدافعون عن حق ممارسة الشعائر الدينية، في حين أنهم غالبًا ما يكونون علمانيين.
ما زال الرأي العلمي والعقلاني بحاجة إلى أن يدافع عن ذاته في المجتمع العربي في وجه غير العلمي وغير العقلاني. وهو لا يستطيع أن يستظل بهيمنة اللاعقلانية، أما العكس فصحيح. أي أن اللاعقلانية تستطيع أن تستظل بهيمنة العقلانية وتحتمي بحرية الرأي في المجتمع الحديث. تمامًا كما أنه، في سياق تاريخي آخر، وفي مرحلة تاريخية أخرى، تستطيع الآراء غير الديموقراطية أن تستظل بالديموقراطية، أما الديموقراطية فليس بوسعها أن تستظل بالديكتاتورية.
يترجم الخوف المعنوي من الجمهور ومن الآراء السائدة خوفًا جسديًا يرجع صدى الحالة البشرية السحيقة كحالة بهيمية. الخوف من الجمهور ومن المزاج العام السائد هو خوف جسدي مترجم إلى حالة معنوية من التردد واللف والدوران والتملق وغيره. ترفض القبيلة الغريب، لكنها قد تتسامح مع الرأي الآخر المختلف الذي يتحدى مسلّماتها من داخلها. أما الجمهور فلا شأن له بالغريب إلا إذا حُرض وعُبئ ضده. يتسامح الجمهور مع الغريب أكثر من تسامحه مع أحد أفراده الذي يهدد "الوحدة". يشعر الفرد بالوحدة داخل الجمهور، وبالخوف الجسدي مضافًا إليها، إذا أقصاه الجمهور، أي أنه يخشى على نفسه من عدوان القطيع. ولذلك فإنه يتمنى العودة إليه في لحظة الضعف، أو يتمنى، وهو في كنفه، الهجرة عنه والهرب في أفضل الحالات إلى حيث يعيش في غربة دائمة ومن دون خوف جسدي. لكن من الصعب العيش خارجه وقربه في آن.
لكن الخوف من الجمهور لا يقتصر على ترجمة الخوف الجسدي إلى مخاوف معنوية. فالذين يخشون تحدّي الرأي العام ومزاج الجمهور غالبًا ما تحدوا، هو أنفسهم، المحتل الأجنبي رغم الخوف الجسدي. ومنهم من لم يخشَ السجن أو الموت في النضال ضد الاحتلال لكننا نراه يخشى الإشاعة أو الإقصاء المعنوي ويخجل من الاعتقال عند ابن جلدته. ففي النضال ضد الاحتلال يلتف حوله الجمهور. ومقابل التضحية والشجاعة هنالك جزاء معنوي يتمثل بالتقدير الاجتماعي والوطني للمناضل. أما في حالة النضال ضد الآراء الخاطئة المنتشرة فلا جمهور ليلتف ولا إجماع ولا مكافأة معنوية. وترتعد فرائض من أبدى شجاعة ضد الاحتلال الأجنبي من العزلة الفردية أو نبذ المجتمع لزوجته وأولاده، أو من تخلي الأقربين عنه، أو من إثارة إشاعة متعلقة بالخيانة أو الاستقامة، أو ربما الكفر. هنا لا يترجم الخوف المعنوي خوفًا جسديًا فحسب، فهو خوف قائم بذاته. إنه خوف من التضحية بلا مقابل معنوي وبلا معنى. خوف من العزلة. والانفراد في مجتمع لا فردية فيه إلا في سياق المنافسة المصلحية وفي مجال تأكيد الذات ضد بقية الأفراد، هو في الواقع عزلة.
الجمهور ليس معطى جاهزًا ومسلّمًا به. إنه ينتج باستمرار ويعاد إنتاجه. وثقافة الجمهور السائدة ليست معطى بل هنالك من "النخبة" من يريح سياسيًا أو اقتصاديًا من إنتاجها بإسمه وتسويقها له على أنها ثقافته ضد الثقافة النخبوية. هذه "النخبة" تعيد إنتاج ثقافة الجمهور على صورتها ومثالها وعلى صورة معاركها وأخلاقياتها.
ولا تنتهي عاقبة الخوف من الجمهور المفترض عند الصمت والتواني عن قول الحقيقة، كما لا تنتهي عند التراجع والتصبب عرقًا أمام أول محرّض يدّعي التحدث بإسم البسطاء لمجرد أنه يصرخ كلامًا غير مترابط، أو لأنه يتكلم بـ"العاطفة" بدل "العقل"، أو "من بطنه بدلًا من رأسه"، كما يحلو القول لبعض محبذي العفوية من المستشرقين المنحازين ضد الحداثة "عندنا". لكن هذه العاقبة قد تنتهي إلى الكذب الصريح والرياء. إن أخطر ما في الخوف من الجمهور ليس هو الصمت بل الكلام بغير الحقيقة التي يؤمن بها المتكلم. أي الكذب الصريح، إضافة إلى المسايرة والمراءاة والتملق، التي تتحول إلى مجرد مقدمات محدودة الضرر للكذب الصريح. يضاف إلى هذا انتقاء المعلومات التي تعجب القراء أو المستمعين أو المشاهدين وتتجاهل ما لا يعجبهم، وصولًا إلى الاستنتاجات التي ترضي لأنها تؤكد موقفًا أو مزاجًا مسبقًا.
ويفاجأ الجميع عندما يتضح لهم أن الجمهور الحقيقي، غير المفترض بشكل مسبق، قد يستمع بإعجاب إلى موقف غير مألوف ومعلل جيدًا بمنطق العقل السليم إذا لم يصغ بلغة استفزازية بغرض الاستفزاز وإظهار التميز، وعندما يرون أن معركة العقل هذه ليست معركة خاسرة مسبقًا على مستوى الجمهور، لكنها صعبة ما دامت بحاجة إلى أبطال. وهي خاسرة بالتأكيد إذا توقف تحديها عند البطولة والاحتفاء بها.
فمقابل محترفي الرياء والتملق الذين يكرسون التخلف، يبرز محترفو البطولة الذين يبدعون في طرح القضايا النظرية بشكل عقلاني، لكنهم سرعان ما ينتقلون إلى الغيبية ونظرية المؤامرة، ويفقدون العقلانية عندما يقومون بتحليل مجتمعهم والتعامل معه. ذلك لأن بطولتهم تصبح في مركز الصورة، وينقسم المجتمع بموجبها إلى صنفين: أولئك "الذين وقفوا معي"، و"أولئك الذين وقفوا ضدي" بغض النظر عن الدوافع. هكذا تنشأ تحالفات جديدة وسياسات جديدة.
وهنالك نوعان من الأبطال في مواجهة الخوف من الجمهور: نوع لا يرغب في احتراف دور الضحية، بل يرغب في الانتصار لموقفه ويبحث عن تحويل موقفه إلى موقف جماعة، إلى موقف نخبة، إلى موقف مؤسسة تناضل من أجل النهوض بالمجتمع لكي لا يحتاج إلى أبطال. ونوع يغرق في دور البطل حد تملق ومراءاة جمهور آخر يعتبره بطلًا، لأنه يقول "للعرب من هم"، ويؤكد بذلك نظرياتهم العنصرية ضد العرب. وبين هذين النوعين ثمة أبطال كثر لا يسمع عنهم لأنهم لا يرغبون في لعب هذا الدور، ولأنهم لا ينجحون، لأسباب عديدة، في التصدي بتحويل موقفهم إلى موقف صدامي فينكفئون بمرارة. وما دام المجتمع ينتج ضحايا من هذا النوع، أي ما دام الإحتمال قائمًا أن تشكل الاستقامة والعقل السليم سببًا رئيسيًا للفشل الفردي عند من لا يتوفر لديه التكوين النفسي أو القدرة على المواجهة ولا تتوفر لديه الانتهازية الكافية للاستفادة من هذا الدور، فإننا لا نزال في مرحلة الصراع على النهضة المعوّقة.
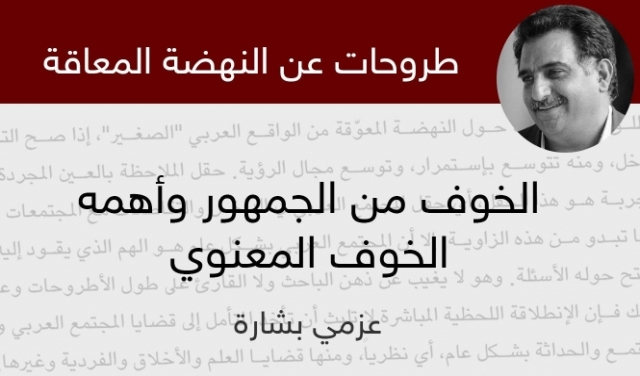
التعليقات