بير رَيّا
تردّدت قصّة طابور العين كثيرًا في عائلتنا، وعادةً تفيض قصص العين بالعواطف والمحبّة والعشق الممنوع والنّظرات المخطوفة، وتنتهي بلوعة وحسرة وحبّ خالد بين رجل شابّ وامرأة جميلة.
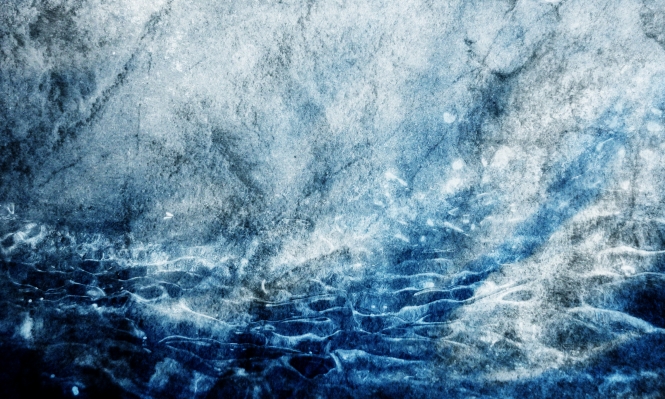
وقفت رَيَّا بنت مصطفى يوسف درويش سلايمة عطشى وتعبة في طابور من النّساء، هناك تحت سفح الجبل، تحمل دلوًا قديمًا أمام أعين البلد، تنتظر دورها لتملأه ماءً يروي أطفالها ويغسل هدمتها المعفّرة بتراب التّهجير، لعلّ رائحة النّكبة المتعرّقة من طول المسير تستبدل بريح صابون الزّيت الجميل.
خرجت ريّا مع عائلتها من السّجرة إلى الكهوف والجبال والأحراش، حيث انتهى بها المطاف في زريبة مواشٍ في طرعان المجاورة. أصرّ زوجها موسى ألّا يلحق بعائلتها، عائلة مختار السّجرة، واختار الاتّجاه المعاكس؛ هم إلى الحدود السّوريّة وهو إلى الحدود الطّرعانيّة، فالأزمة ستمرّ، وسيرجع هو أوّل النّاس إلى بيته. رحلت ريّا عن هذه الدّنيا ولم تسامحه أبدًا على فعلته هذه.
أحلم أحيانا بستّي رَيَّا؛ أتخيّلها مع زنّارها الحريريّ الأحمر المخطّط وثوبها المورّد الأخضر، وحطّتها السّوداء أحيانًا وأحيانًا بيضاء، تحتسي القهوة صباحًا، وتجلس الحاجّة عيدة إلى جانبها تشبك أعواد القشّ من القمح اليابس لتصنع منها أطباقًا.
أحيانًا أتذكّر هذه المرأة الجبّارة ونقاشاتها المريرة اللّانهائيّة مع أبي، تحثّه على أن يذهب إلى اليهوديّ في 'إيلانيا'، المستعمرة الّتي بنيت في العشرينات إلى جانب السّجرة، ليتّفق معه على أن تضمن أرضها: 'زتوناتنا وبدنا زيتهم لو اليهودي أخد نصّهم.' كما في كلّ عام، كانت تنتصر عليه وتفعل ما تريد، 'رَيَّا تفعل ما يدور في رأسها،' هذا الصّيت الّذي لحق بها في القرية الجديدة.
تردّدت قصّة طابور العين كثيرًا في عائلتنا، وعادةً تفيض قصص العين بالعواطف والمحبّة والعشق الممنوع والنّظرات المخطوفة، وتنتهي بلوعة وحسرة وحبّ خالد بين رجل شابّ وامرأة جميلة.
أمّا قصّة ستّي ريّا مع العين، فهي من نوع آخر، فبعد انتظار طويل في الحرّ الشّديد، دون أن تتكلّم أو تشكو لأحد، تقدّمت بقدميها الجريحتين خطوة بعد خطوة، إلى أن اقترب دورها من النّبع، وحين جاءت لحظة تلمّس يديها للماء البارد فتردّان فيها روحها، استوقفتها امرأة أخرى، بدت عليها القوّة والعنجهيّة: 'لحظة لحظة. من أنت يا امرأة؟' صاحت بها وشطفتها بنظرة ازدراء واشمئزاز من رأسها حتّى أخمص قدميها.
'أنا رَيَّا من السّجرة.' أجابت جدّتي بصوت ثاقب وهمّت لتنحني وتدلّي الدّلو في الماء.
'قومي قومي، ماذا تفعلين؟' صاحت المرأة بها. 'أنت من المقاطيع الّذين جاؤوا البلد؟' نصبت جدتي قامَتَها وقالت: 'نعم... طردونا اليهود وجئنا إلى بلدكم لفترة قصيرة، إلى أن تنتهي الحرب ونرجع لديارنا.'
لم تسعف جدّتي قصّة الحرب واللّجوء، فزجرتها المرأة 'الأصلانيّة'، 'غريب وبيلقّ حليب؟ غريبة إنت، انقلعي من هون لآخر الطّابور، أهل البلد أوّل!'
نظرت جدّتي إليها مصدومة جريحة وألقت بدلوها على الأرض، وقد اخترق صوتها الجبال الصّخريّة، 'أنا من لا تريد أن تشرب من مياهكم هذه قطّ ما حييت.' وفرّت مهرولة من هناك، عابرة الطّابور الطّويل من النّساء اللّواتي خرسن أمام الإهانة العلنيّة الّتي وقعت هذه الشّابة ضحيّتها. التّعب والإرهاق شديدان، لكنّ هذا لم يمنعها من الوصول إلى الزّريبة بسرعة البرق، حيث مكث جدّي مع أطفاله الثّلاثة. قالت له: 'قوم يا موسى قوم... لن نمكث في هذه البلدة أبدًا بعد اليوم، سنعود للسّجرة حالًا، ولو قتلونا جميعًا، لسنا أغلى من شهدائنا ولسنا أحسن حالًا من أهل البلد، قم من الأرض؟ وتعال نخرج.'
لم ينفعل جدّي من موجة الغضب هذه، ولم يحرّك ساكنًا. 'اجلسي اجلسي، وصلّي على النّبي، ماذا حدث معك؟' وجلست رَيَّا تبكي وتبكي. تبكي وحدتها، وذلّها، وأهلها الّذين هُجِّروا جميعًا، وأطفالها الجياع وزوجها العاجز أمامها، واسودّت الدّنيا في وجهها. لكن 'غريب وبيلقّ حليب' لم تفارقها، وكلّ أهوال التّهجير والقتل والتّفجيرات تقزّمت أمام 'التّغريب'، فهي بنت المختار، هي رَيَّا الّتي لا تهزّ ولا تذلّ، كيف تطرد هكذا من النّبع؟ كيف؟
سيطر الغضب والحزن والمسّ بالكرامة على جدّتي. أربع سنوات باعت فيها كلّ ما حملته من ذهب إلّا نقوطها من والدها، وهو عبارة عن بضع ليرات، واشترت أرضًا في طرعان، وبنت عقدًا لتسكن فيه، لكنّ طابور المذلّة لم يفارقها.
قرّرت رَيَّا أن تحفر بئرًا في ساحة الدّار. يقال إنّ جدّي عارض الفكرة الجنونيّة، وأقرّ أنّ زوجته فقدت صوابها، فحفرُ البئر يكلّف غاليًا ويأخذ وقتًا طويلًا. لكن، وكما نعرف رَيَّا، قد حصل. أربع سنوات من الحفر والنّقر بالصّخر، فتحت خلالها باطن الأرض الجوفاء حتّى وصل الحفر إلى تجمّع ماء كبير تحت الأرض، مغارة كبيرة تخفي الكثير من التّاريخ في طيّاتها؛ إنّها تلك البئر الّتي دفعت رَيَّا ثمنها ثمن الأرض كلّها، لكنّها الآن لها، مياهها وحياتها وبيتها حول هذه البئر الّتي لا ينضب ماؤها.
لي مع هذه البئر ذكريات، صيحات لا نهائيّة، يسمع صداها الّذي كان يرجع دومًا ولم يخيّب أملنا أبدًا. أمّا أبي فكان يحكي لنا أنّ مجموعة من الصّبيان نزلت إلى البئر للبحث واللّعب هناك ودخلوا المغارة، وكانت المغارة كبيرة لدرجة أنّ الصّبيان كانوا يركضون فيها حتّى يصلوا إلى بوابّة حديديّة قديمة من العهد الرّومانيّ، ولم يخبروا أحدًا بذلك خوفًا من استيلاء اليهود عليها أيضًا.
وكانت حرب الـ67 الّتي أرعبت سكّان القرية، حيث أشيع أنّ اليهود قد وضعوا السّمّ في مياه العين الجبليّة. ووصلت الإشاعة لساحة بيت رَيَّا وموسى. فكيف سيشرب أهل البلد الآن؟ ماذا سيفعلون؟ وإذ بها رَيَّا تقرّر أن تدعو كلّ أهل القرية لشرب الماء من بئرها، وأرسلت زوجها إلى الجامع ليعلن أنّ في البئر ماء يكفي للجميع.
فتحت رَيَّا البوّابة الخضراء الحديديّة لتستقبل نسوة طرعان اللّاتي وفدن إليها لتعبئة حاجتهنّ من الماء العذب النّقيّ. 'لا غريب هنا ولا قريب، كلّنا أبناء بلد، أهلًا وسهلًا بكم.' قالت بكلّ رحابة صدر بعد أن أعادت لها حرب جديدة كرامتها، وقد ديست في حربٍ جرت عشرين عامًا قبل ذلك.
يُنشر هذا النّصّ ضمن ملفّ مِفْتاح، الّذي أعدّته مجلّة فُسْحَة لمناسبة الذّكرى الـ 68 لنكبة الشّعب الفلسطينيّ عام 1948، ويشارك فيه عددٌ من الكتّاب والمختصّين الفلسطينيّين.





