أحذية الأدباء الفلسطينيّين

باعوا حذاء جبرا
في أثناء تدريسي مقطعًا من سيرة جبرا إبراهيم جبرا «البئر الأولى» (1986)، كنت أقصّ على الطلّاب حكاية كتابته سيرته، وتركيزه فيها على سنوات طفولته المبكّرة، وتحديدًا منذ كان في الخامسة من العمر حتّى الثانية عشرة منه.
غالبًا ما اتُّهِمَ جبرا بأنّه كاتب برجوازيّ كتب عن المثقّف الفلسطينيّ الميسور الحال، ولم يكتب عن نماذج فلسطينيّة فقيرة أو عن اللاجئين الفلسطينيّين في المخيّمات، بخلاف غسّان كنفاني، ويبدو أنّ هذا الاتّهام أزعجه فأراد أن يدافع عن نفسه، وأن يقول إنّه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنّ طفولته كانت بائسة فقيرة معدمة جدًّا.
أوضح جبرا ما سبق في مقدّمة سيرته، آتيًا على دافعه لتركيزه على سبع سنوات من حياته، فكتب عن البيوت البائسة الّتي أقامت أسرته فيها في بيت لحم، وعن عمل أبيه غير المستقرّ وغير المجدي، وذكر حكايات وقصصًا طريفة، منها قصّة أبيه وعدم قدرته على شراء الأحذية، ومنها قصّة الحذاء الّذي كوفئ به هو نفسه، من الكنيسة الّتي تردّد عليها طفلًا بسبب مواظبته على الحضور.
فرح جبرا بالجائزة واحتفل بها، خاصّة أنّ أعياد الميلاد على الأبواب، لكنّ فرحته لم تطل، فوالده الخبير بالأحذية؛ إذ عمل مصلّحًا لها، اقترح على زوجته أن يبيعا الحذاء الّذي كوفئ به الابن...
فرح جبرا بالجائزة واحتفل بها، خاصّة أنّ أعياد الميلاد على الأبواب، لكنّ فرحته لم تطل، فوالده الخبير بالأحذية؛ إذ عمل مصلّحًا لها، اقترح على زوجته أن يبيعا الحذاء الّذي كوفئ به الابن، وأن يشتريا بثمنه طعامًا لأعياد الميلاد، وحين زعل جبرا اقترح أبوه على أمّه أن تشتري له حذاء من حارة اليهود في القدس بسعر معقول. حزن جبرا من ناحية، وفرح من ناحية ثانية؛ حزن لأنّه خسر الحذاء الفاخر، وفرح لأنّه سيزور القدس مع أمّه[1].
حكاية جبرا مع الحذاء ليست الحكاية الوحيدة للأدباء الفلسطينيّين معه؛ أي الحذاء، فهناك حكايات أخرى أكثرها لافت، وكثيرها يعبّر عن حياة الفقر الّتي عاشوها، وقليلها يشير إلى فقر المحيطين بهم. قبل الحديث عن حكايات هؤلاء الأدباء مع الحذاء، يجدر أن أنقل الفقرة الآتية من سيرة جبرا، عن قصّة أبيه والحذاء: “يعود والد جبرا ذات نهار ومعه إطارة مطّاطيّة قديمة، ويُحْضِر صندوق عدّة تصليح الأحذية، ويقتطع من الإطارة بسكّين قطعتين، قصّهما وفق طول قدمه، ويثقبهما ثقوبًا أدخل فيها حبلًا رفيعًا، وحين انتهى من عمله لبسهما، وشدّ كلتا القطعتين بالحبل، وخاطب زوجته مريم:
- شايفة يا مريم؟ أحسن وطا!
ولمّا لم يرق مشهد الوطا لجبرا، يسأل أباه:
" -يابا، لماذا لا تشتري حذاء من الكندرجي؟
قال: عندما تكبر تفهم. أتعلم كم قرشًا يريد الكندرجي للحذاء؟ عشرين قرشًا، وإذا تساهل فخمسة عشر قرشًا. حذائي القديم بدأ يتهرّأ بالاستعمال؛ ولهذا سأحتفظ به لأيّام الأحد، فما رأيك يا أفندينا؟"[2].
وإذا كان جبرا استرجع حكاية أبيه مع الحذاء، وأغلب الظنّ أنّ هذا حدث في عشرينات القرن العشرين، فإنّ الكتّاب الفلسطينيّين الّذين عاشوا في فترة قريبة عاشوا الفقر نفسه، ومرّوا بتجارب قريبة.
جوربا معين بسيسو
في سيرته «دفاتر فلسطينيّة» (1978)، يكتب معين بسيسو عن أحد تلاميذه في «مدرسة البريج»: "ترك التلميذ المدرسة ليعمل شيئًا ما، أعطاه والده كلّ ما يملك، فاشترى صندوقًا خشبيًّا وبعض برطمانات الدهان وفرشاتين، لكن حلّت بأهله نكبة فاحتاج إلى بعض النقود، وطلبها من معين، كيف أقول له إنّني وأنا ناظر مدرسة البريج الإعداديّة لم أكن أملك تلك الجنيهات، وما زلت في منتصف الشهر؟
وبشكل تلقائيّ خلعت حذائي وقدّمته له، وكان حذاء جديدًا أرسله إليّ أخي من الكويت، وكانت أوّل مرّة أمشي به، في هذه الليلة، احتفالًا بتوزيع المنشور.
- خذه معك، هذا كلّ ما أملك. وأخذه الصبيّ ومضى... وعدت إلى البيت بجوربين مرصّعين بالوحل"[3].
حنّا إبراهيم حافيًا بين بلدين
في سيرته الذاتيّة «شجرة المعرفة: ذكريات شابّ لم يتغرّب»، الّتي صدر جزؤها الأوّل عن «منشورات الأسوار» في عكّا عام 1988، وصدرت مكتملة عام 1996، يكتب حنّا إبراهيم في الفصل الأوّل منها، تحت عنوان «على عتبة حياة العمل» عن فقره المدقع في أربعينات القرن العشرين، ويقصّ حكايات طريفة عن حذائه الّذي بَلِيَ لكثرة السير وقلّة العناية.
ويضطرّ أبو جميل إلى إصلاح الحذاء، فلم يكن حنّا يملك غيره، ولأنّ الإصلاح يحتاج إلى ساعة ونصف، فقد انطلق حنّا إلى الشاطئ يتمشّى حافيًا، ولم يكن السير حافيًا غريبًا عليه...
مرّة استُدْعِيَ حنّا لمقابلة عمل في «دائرة مساحة الأراضي» فَسُرَّ بعد يأس، وشعر بخفّة عجيبة وبرغبة في السير، لكنّ حذاءه لم يكن بحالة تسمح بذلك، وكان لا بدّ من إصلاحه عشيّة المقابلة العتيدة. كان ثمّة إسكاف على مقربة يعمل في بيته، ويستقبل الزبائن إلى وقت متأخّر من المساء، ولا يعزّر الزبون إذا تأخّر عن الدفع أكثر من المعقول. تعهّدت والدة حنّا بدفع التكاليف نقدًا؛ إذ لم تكن تحتمل الدين. خلع حنّا الحذاء، وقدّمه إلى الإسكاف، فقال له:
- ترجع بكرة أو بعد بكرة.
ضحك حنّا، وقال:
- وتبقيني حافيًا يا عمّي أبا جميل؟
ويضطرّ أبو جميل إلى إصلاح الحذاء، فلم يكن حنّا يملك غيره، ولأنّ الإصلاح يحتاج إلى ساعة ونصف، فقد انطلق حنّا إلى الشاطئ يتمشّى حافيًا، ولم يكن السير حافيًا غريبًا عليه[4].
ويوضّح حنّا عبارته" لم يكن السير حافيًا غريبًا عليه"؛ فقد قضى أربع سنوات في «مدرسة الرامة» القريبة من قريته البعنة، وكان يتنقّل في الإجازة الأسبوعيّة بين القريتين مشيًا، "وكيما أحافظ على الحذاء، فقد كنت أخلعه حال خروجي من الرامة، وأمشي حافيًا حتّى أصل إلى البعنة، وهكذا كنت أفعل في طريق العودة، وأغسل قدميّ في عين الصرّار أو عين الحضّين- حسب الطريق الّذي أسلكه- وأدخل القرية كأيّ إنسان محترم"[5].
لم يكن الفقر في تلك الأيّام مقتصرًا على حنّا، وهو ما جعل المدرسة تتساهل في أمر اللباس الموحّد، بل أكثر من ذلك، فـ "كثيرًا ما كنّا نذهب إلى المدرسة حفاة، وخاصّة حين يكون الطقس معتدلًا، وعليه أصبح السير حافيًا بين البلدين أمرًا عاديًّا بالنسبة إليّ"[6].
طه محمّد علي وحذاء المغربيّ
في السنة نفسها الّتي أصدر فيها حنّا إبراهيم سيرته، كتب الأديب طه محمّد علي قصّته «سيمفونيّة الولد الحافي ’ما يكون‘»، وهي قصّة طريفة جدًّا يسترجع فيها زمنًا آخر غير الزمن الكتابيّ عام 1996، إنّه يسترجع زمن طفولته؛ أي الزمن الفلسطينيّ قبل عام 1948، وهو الزمن الّذي كتب عنه تقريبًا كلٌّ من جبرا إبراهيم وحنّا إبراهيم في سيرتيهما، وتكاد قصّة طه تكون أيضًا مقطعًا من سيرته الشخصيّة.
يفتتح الكاتب قصّته بالفقرة الآتية: "العشر السنوات الأولى من حياتي سرتها حافي القدمين، غير أنّ مرارة إحساسي بالحرمان من الحذاء، وطغيان رغبتي في الحصول عليه يوم حادث حذاء المغربيّ وحده، فاقا، والله، كلّ عذابات الحفاء الّتي كابدتها في سنيّ العشر مجتمعة"[7]. وهو ما يتكرّر في القصّة ثانية بعد أربع صفحات، “هذا بحذافيره حقيقة، لكن حقيقة الحقائق، أيضًا، أنّ شتيت ما عذّبني وعانيت منه وأشقّائي على مدار عشر سنوات حفاء، قد جُمِعَ كلّه في يوم حادث حذاء ذلك المغربيّ، فما هي قصّة حذاء المغربيّ؟"[8].
عندما يرتدي خالد الحذاء توجعه قدماه، فيطلب منه والده أن يخلعه؛ لأنّ الفردتين يُمْنَيان، ينصاع خالد وهو يبكي لأمر والده، ويردّ الحذاء للمغربيّ ذي الجسد النحيل واللحية السمراء...
لم تكن بلدة أنا المتكلّم/ السارد تخلو من دكّان بيع أحذية، لكنّ أسعارها كانت مرتفعة، فقد كان في بلده يومها غير دكّان واحد يبيعها، بل "هناك مَنْ يصنعها، ويقدّم الزوج منها عن طيب خاطر لمَنْ يبذل الجنيه والنصف أو الجنيهين ثمنًا له"[9]، وكانت مشكلته تكمن في مبدأ ’مانع اللذّات‘، مبدأ ’ادفع واحمل‘ الّذي يحكم التعامل مع الأحذية جميعًا، سواء كانت في دكاكين بلده أو في خرجة المغاربة الّذين يأتون من المغرب الشقيق يبيعون الأحذية.
عندما عرف أنا المتكلّم/ السارد يومًا أنّ هناك مغربيًّا يبيع أحذية بسعر زهيد، ذهب إليه وشاهدها، فسأله عن سعرها الّذي بدا له معقولًا، وسرعان ما عاد إلى البيت ليحضر العشرين قرشًا الّتي استدانت أمّه من جارتها خمسة قروش لتجمعها.
يذهب أنا المتكلّم/ السارد إلى المغربيّ، فيجده باع أحذيته كلّها إلّا فردتين يُمْنَيَيْن لا تصلحان للبيع، ويصرّ هو على شرائهما، مع أنّ المغربيّ أوضح له أنّ هذا غير ممكن؛ إذ لا يستطيع ارتداءهما.
عندما يرتدي خالد الحذاء توجعه قدماه، فيطلب منه والده أن يخلعه؛ لأنّ الفردتين يُمْنَيان، ينصاع خالد وهو يبكي لأمر والده، ويردّ الحذاء للمغربيّ ذي الجسد النحيل واللحية السمراء، الّذي أرجع إليه ثمنه مع ما يشبه الاعتذار: قلت لك ما ينفعكاش.
هل كان خالد في القصّة هو طه محمّد علي نفسه؟ فأكثر قصص مجموعته الّتي حمل عنوانها عنوان القصّة المدروسة تتحدّث عن بيئة قريته صفورية.
شوك وشظايا زجاج في قدمي راشد عيسى
الشاعر راشد عيسى، ابن مخيّمي عين بيت الماء وعسكر الجديد، من مواليد سنوات النكبة، وقد عاش طفولة فقيرة بائسة دوّنها في رواية سيريّة عنوانها «مفتاح الباب المخلوع» (2010)، لكنّه في عام 2005 أصدر سيرة شعريّة عنوانها «حفيد الجنّ»، كتب قصائدها بين 1998 و2000، ضمّت قصيدة صاغها بأسلوب قصصيّ عنوانها «حذائي»، لخّص فيها حكايته في طفولته مع الحذاء.
في القصيدة يكتب راشد أنّه حتّى السادسة من العمر كان حذاؤه كمشة رمل أو نصف حجر، ثمّ صار بعدها قطعة خيش لا تقي من الشوك صيفًا أو الوحل شتاء، ولمّا كبر قليلًا صنع حذاءه من عيدان شجر لوز، وإذا ما اشترى له أبوه حذاء، ولعب به الكرة ينهره، و’يسوّد عيشة أمّه‘، ويقول له إنّه إذا ثُقِبَتْ رجله فَسَتُشْفى، ولو جُرِحَ حذاؤه فسيلزمه أن يدفع لمصلّحه قرشين، وهكذا يمنع عنه الحبّ لنصف سنة والخبز ليومين.
تكمن المفارقة في قصّة راشد مع الحذاء، في أنّه عندما كبر وامتلك المال وأتقن المشي، صار لديه ثلاثون حذاء، ولكن في الوقت نفسه سُرِقَتْ منه قدماه...
يكبر راشد، ويوفّر مصروفه، ويشتري حذاء مرتوقًا قديمًا بلا رباط ضيّق على مقاس رجله، وحين يعيده إلى البائع يرفض هذا إعادته، فالخلل في إصبع قدم راشد لا في الحذاء، وهكذا يكون لزامًا عليه أن ينحت من قدمه قليلًا. أوّل ما يتوظّف يشتري حذاء جديدًا تمامًا، أغلى من نصف معاشه، لم يعتد ارتداء حذاء مثله من قبل، وحين يجيء الليل ينوّمه قرب عيون الفانوس[10].
تكمن المفارقة في قصّة راشد مع الحذاء، في أنّه عندما كبر وامتلك المال وأتقن المشي، صار لديه ثلاثون حذاء، ولكن في الوقت نفسه سُرِقَتْ منه قدماه، فماذا ورد في السيرة الروائيّة؟
يعيد راشد في السيرة الروائيّة كتابة حكايته عن حذائه، مع إفاضات يحتملها النثر ولا تحتملها القصيدة الغنائيّة "لكن حذائي على الدوام قديم مهترئ، أو واسع جدًّا، أو ضيّق جدًّا... لذلك أفضّل المشي نهارًا بلا حذاء... وقبل أن تغيب الشمس أجلس قرب عنزنا، وأنزع الشوك وشظايا الزجاج من باطن قدمي... كان الحذاء مشكلتي الكبرى... حتّى أنّني في حصّة الرسم الحرّة رسمت رجلًا كلّ أعضاء جسمه أحذية مهترئة"[11].
يضحك المعلّم، ويسأل الطالب لماذا فعل هذا، فيجيبه لأنّه يحبّ الحذاء، فالدنيا كلّها حذاء مهترئ، وأرجّح أنّ العبارة الأخيرة من إسقاطات الزمن الكتابيّ.
ويظلّ أبوه يُمَنّيه بشراء الحذاء عندما يكبر، وعندما يبدأ عام دراسيّ يأخذه أبوه إلى المدينة، ويشتري له قميصًا وبنطلونًا وحذاء، "ابتهجت بالحذاء... فهذه أوّل مرّة ألبس حذاء غير مستعمل... جديدًا غير مخزوق ولا مرتوق... يلمع... لبست حذائي ومشيت في الحوش وأنا أنظر إليه باحترام... وفي كلّ دقيقة أمسحه بكمّ قميصي، حضنته وخبّأته في بطّانيّتي الّتي أتغطّى بها"[12]، لكنّ فرحته مثل فرحة جبرا لم تطل؛ ففي اليوم التالي يذهب إلى نابلس ليجمع أكياسًا يبيعها، وفي هذه الأثناء يطرق متسوّل فقير باب بيتهم يستجدي، فيتناول والده البطّانيّة ويعطيها له، دون أن يعرف أنّ حذاء ابنه مخبّأ فيها.
ما تجدر الإشارة إليه أنّ دالّ الحذاء احتلّ عناوين بعض المجموعات القصصيّة والروايات، وهذا يحتاج إلى مقاربة أخرى مختلفة.
إحالات
[1] جبرا إبراهيم جبرا، البئر الأولى (لندن: منشورات رياض الريّس، 1986)، ص 72-75.
[2] المرجع نفسه، ص 43.
[3] معين بسيسو، دفاتر فلسطينيّة، ط 3 (باقة الغربيّة: منشورات شمس، 1998)، ص 52.
[4] حنّا إبراهيم، شجرة المعرفة: ذكريات شابّ لم يتغرّب (عكّا: مؤسّسة الأسوار، عكّا، 1996)، ص 13.
[5] المرجع نفسه، ص 14.
[6] المرجع نفسه، ص 15.
[7] طه محمّد علي، الأعمال الكاملة (حيفا: دار راية للنشر، 2011)، ص 356.
[8] المرجع نفسه، ص 360.
[9] المرجع نفسه، ص 361.
[10] راشد عيسى، حفيد الجنّ (دمشق: اتّحاد الكتّاب العرب، 2005).
[11] راشد عيسى، مفتاح الباب المخلوع (عمّان: منشورات أزمنة، 2010)، ص 90.
[12] المرجع نفسه، ص 128-129.
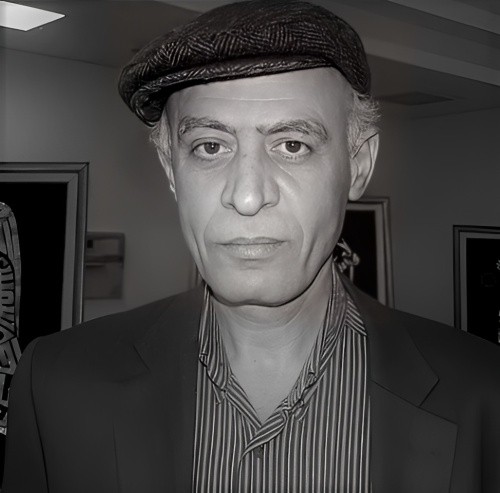
أستاذ جامعيّ وباحث. حاصل على الدكتوراه من جامعة BAMBERG في ألمانيا عام 1991. يكتب المقالة في الصحافة الفلسطينيّة والعربيّة. أصدر العديد من الكتب، منها: 'جداريّة محمود درويش وصلتها بأشعاره'، و'الصوت والصدى: مظفّر النوّاب وحضوره في الأرض المحتلّة'. يكتب القصّة القصيرة والرواية ويهتمّ بدراستهما.





