التوت الفاسد

مات أبي، ولم أبذل جهدًا ولو ضئيلًا لأحزن، كان بالنسبة إليّ مجموعة من الروائح والصور المختزلة والبشعة الّتي سأعجّل في نسيانها. في البداية صُدِمْتُ حين تخيّلتُ أنّ أظافره المقصوصة بإتقان، ويده ذات الجلد الخشن المفروشة بالنمش ستُؤْكَل، وأنّ زوايا فمه المتدلّية من فرط سمنته ستصير على بُعْد متر واحد تحت التراب. لكنّني ما إن تذكّرت لسانه السليط وجفنيه المتورّمين حتّى شعرت بالقرف؛ إذ لم أتخيّل قطّ أن يشارك جسده المتحلّل إلى فسفور وكربون في دورة الطبيعة، ويعود إلى العالم بطريقة ما. يا له من أمر مقزّز، أن تتّسخ أمعاء الديدان ببقايا رجل مثله! أشعلت سيجارة وشعرت بالأسف على نفسي لأنّني أفكّر فيه كإنسان. جلست أمّي بجانبي حاملةً المصحف، أرادت بشدّة أن يغفر الله له، بدأت تقرأ بصوت عالٍ وبخشوع، فكّرتُ في أنّها ليست إلّا امتدادًا له، جزءًا من تاريخه، وسألتُ نفسي: "إذا ما كانت جزءًا من تاريخه، فهل سيكون هو أيضًا جزءًا من تاريخها؟"، واستعدتُ تاريخي الأسود مفكّرةً في أنّه جزء من تاريخي أيضًا، وسيكون كذلك إلى الأبد، فهرعتُ إلى المغسلة، وحاولتُ أن أتقيّأ.
لا أحبّ أفكاري، وأحيانًا كثيرة أشعر بأنّني مُخْتَرَقَة من الداخل، وبأنّ شخصًا ما أصغر حجمًا منّي يجلس خلف مكتب صغير للمفاوضات داخل عقلي، ولسبب ما، يفوز باستمرار. تتبّعتُ بفضول نملة تسير بحذر داخل المغسلة، ثمّ أشعلتُ سيجارة ونفثتُ دخانها على النملة، في رغبة ملحّة منّي لصناعة قدرها، لأجعل هذا الضباب بمنزلة تحذير لها، يا نملة، لا تمضي من هذا الطريق، توقّفي وعودي أدراجك لأنّ سبّابةً سمراء ستسحقك بعد ثوانٍ من الآن؛ فقط لأنّ مزاجها متعكّر. ابتسمتُ ابتسامةً سرعان ما ذابت حين اكتشفتُ أنّ ظلًّا ضخمًا يعكس نفسه عليها، قالت أمّي من الأعلى:
- لماذا ترغبين في التقيّؤ؟
- وهل يُسْأَل الشخص عن سبب رغبته في التقيّؤ؟ هذا غريب...
وتقيّأت. كانت تعرف، حتّى قبل أن أرفع وجهي وأمسح فمي المغسول من بقايا القيء أدركتُ أنّها كانت تعرف، ليست نبرة الصوت، ولا إيماءاتها الّتي لم تكلّفني وقتًا لتخمينها، وليس حفظي لها نتيجة الإفراط في العيش معها هو السبب، بل لأنّ ثمّة معارف في هذه الحياة تأتي هكذا، على هيئة حدس. حدسي كان في مكانه؛ هي تعرف أنّه يمكن المرء أن يتقيّأ فقط لتذكّره والده.
كنّا في الربيع، وكانت ترتدي بلوزة ترابيّة اللون لن أنساها ما حييت، لأنّها صفعتني ذات مرّة في طفولتي لعجزي عن حلّ مسألة في الرياضيّات، وكانت ترتديها. تفرّست ملامحها، الكَلَف، الخطوط البارزة، المسامات الواسعة، الأنف المليء بنقاط سوداء لم تُسْتَعْمَل قطّ في نهايات جملها؛ ذلك لأنّها لم تحاول قطّ إنهاء أيّ جملة تقولها، وتهدف باستمرار إلى طرح أسئلة واسعة ومفتوحة؛ لأنّها امرأة تهوى الاستماع إلى الراديو، ونحن فقراء، لا نملك رفاهيّة أن يحكي لنا شخص ما عن مسار الشمس غدًا ونوايا الغيوم؛ لذا فقد استعاضت - بمرور الوقت - عن الراديو بالناس، وهم حمقى على أيّ حال، وغير مُتَوَقَّعين، مثل أخبار الطقس.
نفضتْ يديها في الهواء كمَنْ يحاول التخلّص من حفنة غبار، أو مشاعر فائضة، ثمّ نبرتْ:
ألن تذهبي لرؤيته؟
نظرتُ إلى صحن يجلس بهدوء جانبي، كمستمع لم يفكّر أحد في أخذ رأيه، ولطالما شعرتُ برغبة في إلباس الجمادات مشاعر غريبة، وقد قرأتْ هذه الرغبة في عقلي فانتزعتْه بسرعة من مكانه، وتوقّف عن كونه ضيفًا مستهدَفًا ليصير مجرّد صحن بحماية أمّي. أحكمتُ إغلاق قبضة يدي وأطلقت زفيرًا طويلًا:
- سأشيّع سؤالكِ الطائر في الهواء بعينيّ، وأراقبه يذهب بعيدًا، دون أن يشفق عليه أحد بإجابة.
وأردفتُ متأمّلة كلماتي الشاعريّة:
- إنّه مِنْ دواعي سروري أن يموت.
تبادلنا النظرات، أنا أعرف هذا النوع اليائس من النظرات، خاصّة حين تكون صاحبته أمّي، تُنْزِل رأسها وتحاول بمرارة رفعه إلى الأعلى، كأنّه يزن عشرات الكيلوغرامات الّتي لم تتدرّب على رفعها، وتخشى في آنٍ أن تسقط منها، فتتشظّى على الأرضيّة. تنهّدَتْ، وقالت بأعصاب باردة، أو مستوحاة من فعل البرودة:
أتفهّم مشاعركِ المشتّتة، ربّما أنت غاضبة أكثر من أنّك حزينة، لن أعاقبكِ؛ فالغضب في نهاية المطاف شعور.
وأمّي، وإن كنّا فقراء، علّمتنا أن نحترم كلّ شيء يُدْرَج في قائمة المشاعر، وحين ينجب المرء ولدًا، لا ينبغي له أن يسيطر على مشاعره. ومع ذلك، من الضروريّ أن تعرفي مدى حزني عليه كإنسان، لقد خسر الكثير، ولم يتسنّ له وقت كافٍ لإصلاح ما فات.
لا أؤمن بأمّي، لكنّني أحترمها، ربّما أحبّها، لا أعرف. لست إنسانة من السهل عليها أن تُصَنِّف أو تُصَنَّف. الحقيقة أنّ أمّي من النوع الّذي عاش طفولة حافلة، وسرّبت له على مضضٍ مقتطفات من حياة الأثرياء؛ لأنّ جدّتي كانت تفكّر كالأغنياء، وحين أَنْجَبَتْ أولادًا وبنات أخذت وقتها في تعليمهم أصول العيش، ولم تُلْقِ بهم في زاوية، ولم تقل: "اغربوا عن وجهي، أريد أن أحزن".
جلستُ على الأرض ودفنتُ رأسي بين يديّ، تذكّرته حين التقينا للمرّة الأخيرة في فناء البيت، احتضنني وغرستُ وجهي في بطنه، مثل أيّام الطفولة، وقال "أهلًا فقمتي"، ثمّ نظر نظرة خاطفة إلى عينيّ، وأردف "أسوأ يوم في حياتي، اليوم الّذي أنجبتكِ فيه". حدّقتُ بعينيه، وكانت هذه أعمق إهانة وُجِّهَتْ إلى فتاة وحيدة.
لم يحاول إصلاح علاقتنا، وغادر دون أن يأخذ الإهانة معه فخبّأتها وانتظرته، لكن بما أنّه عاد ميّتًا فالأجدر بي أن أنسى الموضوع، ونسيانه بالنسبة إليّ يعني التصرّف بلامبالاة؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة لردّ اعتبار الفتاة الصغيرة الّتي لا تزال في داخلي. أمّي لا تتّفق معي، تقول إنّني سأندم، فأنا مجرّد فتاة لم تنضج بما يكفي، تلتفت إليّ من تحت حاجبيها وتحذّرني بسبّابة ثخينة ناعمة سبق أن كانت تسير بلطافة على وجهي: "الندم ليس شعورًا من السهل العيش معه". أتساءل إن كان قد جرّب هذا الإحساس، هل آلمه؟ هل تمنّى أن يعود به الزمن ليمتنع عن قول ما قاله؟ هذه الجملة تذكّرني بشيء سبق أن قرأته للفيلسوف جاك دريدا، حين وصف حياة كلّ شخص بأنّها عالم متفرّد لا يمكن استرداده ولا تعويضه. أنا أيضًا أعتقد أنّ تجربتي مع هذا الأب لن تتكرّر مع شخص آخر، وإن حدث فلن تكون بالطريقة نفسها؛ ليس لأنّه لا يوجد إلّا أب واحد في الحياة، بل لأنّ أحدًا لا يعوّض مكان أحد، وإن كان على صعيد التعذيب والإهانة. فلماذا لا أسامحه؟ سألت نفسي وأنا أسير بضياع في الطريق الترابيّ المؤدّي إلى بيتنا، لماذا لا تسامحينه يا بنت؟ انظري إلى الطيور، إلى أشعّة الشمس، إلى يديكِ، إلى عينيكِ، إلى الحبّ الّذي باستطاعتكِ منحه، إلى الحزن، إلى كلّ حالة وجوديّة يمكنكِ عيشها مع مضيّ كلّ دقيقة، اغفري له، هيّا، سامحيه، فهو لن يحصل على أيٍّ من ذلك بعد الآن...
هكذا وجدتُ نفسي واقفة فوق رأسه في بيتنا القديم، كان جاهزًا للدفن، عائلته لا تبكي ولم تبكِ من قبل، لكنّهم صامتون، متأنّقون، تفوح منهم روائح مختلفة من العطور، هو أيضًا تفوح منه رائحة المسك، ها هو وجهه المليء بالنمش، أنفه الكبير، جبهته، وقفتُ فوق رأسه فأمرني أحدهم بالوقوف قبالته ليتسنّى له رؤيتي، وكأنّه سيراني بهاتين العينين الفارغتين من الروح، وكأنّه سيبكي أو يضحك أو حتّى يطردني. أذكر أنّني وقفت نحو خمس دقائق، لم أبكِ ولم أقل شيئًا، بعد فترة دخلوا وحملوه إلى قبره، كما حرصوا على تغطية وجهه جيّدًا!
بعد أن انفضّ الحشد ولم يبقَ أحد عنده، أخذتُ مجموعة من القرنفل وزرعتُها على امتداد قبره، جلستُ فوق التراب المبتلّ وقلت: "سيكون قبرك جميلًا فلا داعي لتشعر بالخجل بعد الآن، فقد أَثَّثْتَ طفولتي بالحبّ مرّة، ومن الضروريّ أن يؤثّث لك أحدٌ ما قبرك، ولو أنّك لم تتخلّ عنّي، لَشَمَمْتَ هذا الورد في حياتك".
حين خرجتُ من المقبرة، أوقفني رجل خمسينيّ، وسألني لاهثًا:
- هل دُفِنَ فعلًا بائع التوت؟
أخبرته - كذبًا - بأنّني لا أعرف، فهزّ رأسه مستنكرًا، وأردف:
- خسارة، هذا أسوأ توت اشتريتُه في حياتي، كيف سأغيّره الآن؟
* قصّة فائزة بـ "جائزة نجاتي صدقي للقصّة القصيرة للكتّاب الشباب"، دورة عام 2020، الّتي تنظّمها وزارة الثقافة الفلسطينيّة. وقد تكوّنت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام من: صافي صافي، زياد خدّاش، أماني الجنيدي.
تنفرد فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة بنشر القصّة بإذنٍ من كاتبتها.
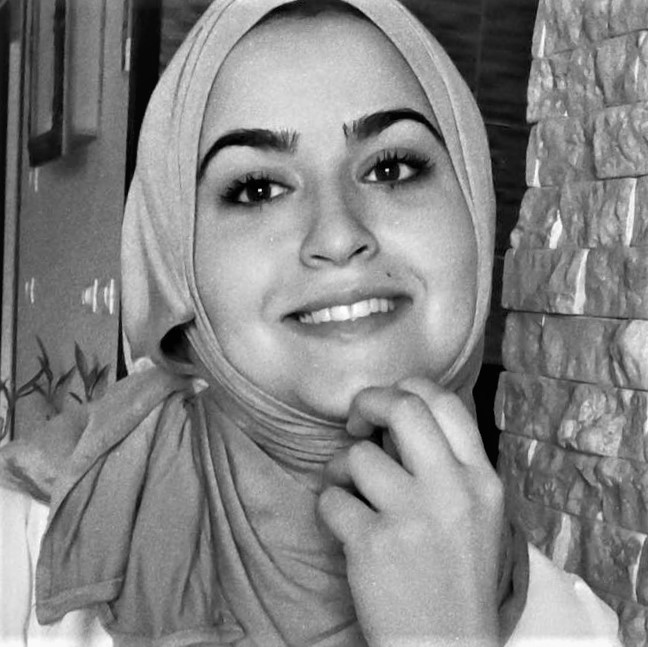
كاتبة فلسطينيّة من مواليد مدينة بيت لحم عام 1999، تَدرس الإعلام في "جامعة بير زيت"، صدر لها روايتا: "حبّ حيفا" (المكتبة الشعبيّة ناشرون: 2015) و"ألف عام من الركض" (عصير الكتب: 2017).







