أين تأخذ أحلام بشارات الأطفال عندما يقطعون النهر؟ | حوار

يشعر القارئ بأنّ ثمّة نوعين من الكتّاب: المهندسين والفطريّين. تنتمي الكاتبة أحلام بشارات إلى الصنف الثاني، الّذي يجد نفسه كاتبًا مثلما تجد الشجرة نفسها شجرة. على تواضع البيئة الأولى، سوف يتشكّل لدى أحلام، الطفلة، عالم ساحر، مأخوذ بالشخصيّات الخياليّة والطبيعة والأصوات والعوالم الخفيّة. ومن حياة فلّاحة تنقّلت بين قريتَي الطمّون والجفتلك في الأغوار، ستتفجّر الكتابة في البدء على شكل أصوات داخليّة، تسلّي الطفلة وهي تعمل في الأرض مع أهلها. ثمّ سنقرأ كلّ ذلك في مشروع واحدة من أبرز الكاتبات العربيّات في أدب الأطفال واليافعين. نقرأ مشروعها وقد اتّخذ أشكالًا عدّة؛ قصص الأطفال وروايات اليافعين والمذكّرات والشعر. تردّدت أحلام كثيرًا في نشر الشعر، إلى أن قدّمت لقرّائها مؤخّرًا مجموعة شعريّة جديدة بعنوان «اسم الطائر» (دار الرقميّة للنشر، رام الله)، لنجد، منذ المجموعة الأولى الّتي تطلقها، صوتًا خاصًّا مستمدًّا من أمكنة قد تكون حقيقيّة أو متخيّلة، لكن من أمكنة مادّيّة ومن شخوص قَصِيَّة وصور غائرة، لكن غضّة. تكتب كذلك عن صورتها ودواخلها وجسدها الملتحم مع هذا المكان. تقدّم أحلام قصيدة أرضها خصبة بشكل طبيعيّ؛ فهي لا تجتهد أن تحرثها أو تسمّدها. القصيدة ابنة أشياء كثيرة عدا التفكير «المُثَقَّف»، ولا يمكن لهذه القصيدة، على اختلاف شكلها ولغتها، أن تُنْتَزَع عن مشروعها الكتابيّ الممتدّ، ولا سيّما في الكتابة للأطفال واليافعين. فقد أنجزت أحلام، الّتي نجري معها في فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة هذا الحوار، مجموعة من الروايات لليافعين، منها «اسمي الحركي فراشة» و«أشجار للناس الغائبين» و«جنجر» و«شجرة البونسيانا» و«مصنع الذكريات»، تُرْجِمَ بعضها إلى الإنجليزيّة، ووصلت الأخيرة إلى «قائمة الشرف العالميّة لكتب الأطفال واليافعين» العام الماضي، ذلك بالإضافة إلى القصص الّتي تكتبها للأطفال. تعمل أحلام أيضًا موجّهة في الكتابة الإبداعيّة، خاصّة في كتابة الرواية لليافعين. تكتب أحلام هذه لأحلام اليافعة الّتي تجلس بين يافعين آخرين، عن فلسطين والاحتلال والموت وأخيها المطارَد وطفولتها. يبدو كلّ ذلك طبيعيًّا، كما عاشته هي، طبيعيًّا مثل شجرة.

فُسْحَة: كيف قضيتِ فترة الحجر؟ قرأت بأنّك كنت تنوين بناء بيت خشبيّ في الأغوار، أكانت فكرة أدبيّة أم حقيقيّة؟
أحلام: بإمكاني القول إنّي تعرّفت على نفسي أكثر. أغلقت باب البيت وقلت إنّي سأكون مع نفسي. شخصيّتي مونولوجيّة وحواراتي دائمة مع ذاتي - وأنا مدينة لذلك بامتلاكي للحكاية ولغتها - لكن كان ثمّة طرق أخرى قابلة للاستكشاف في الكلام مع الذات. رحتُ إلى تلك المساحة مدفوعةً بشيء خفيّ. ربّما كان ذلك قرارًا، لكنّه نابع من مكان خفيّ أيضًا. شغّلت الكاميرا في الموبايل وصوّرت أيّامي، بكلّ أفعالها ولغتها وأحداثها ونقص أشيائها وامتلائها، ومشاعري وتناقضاتها. دوّنت الملاحظات أيضًا. قضيت عزلة مطلقة مدّة ستّة عشر يومًا، خلال سبعة منها صرت أنا مع نفسي، ولم أعد أشعر بالوحدة. ظهرت نفسي خلال هذه الأيّام وأصبحت شخصًا آخر. في اليوم الحادي عشر ظهرت شخصيّات أخرى سمّيتها «الآخرين». ربّما نسأل نحن المعزولين الوحيدين كم نحن عقلاء أو مجانين؟ لكنّي ببساطة كنت أبحث عن شركائي في الحياة. قضاء الوقت مع النفس يكشف الشركاء في دواخلنا. بعد أن قطعت هذا المشوار في حياتي، أسأل إن كان لديّ أصدقاء في ذاتي بإمكاني أن أتّكئ عليهم. أنا مغرمة بالبحث والأسئلة، وتكاد ذراع هذه تلامس ذراعي. إن خرجتُ من هذه التجربة بمجرّد الاحتكاك بجلد الأسئلة فهذا منجز عظيم. خلال الحجر كنت أستيقظ باكرًا حتّى أقوم بفعل المراقبة، أراقب نفسي وأطرح عليها الأسئلة، أجيب عن بعضها وعن أخرى لا أجيب. كيف يمكن شخصًا أن يكون مراقبًا من ذاته وليس من الآخر؟ ذلك قرّبني من سؤال مجاور وواقعيّ؛ الأزمة الّتي يعيشها الأسرى، ثمّ سؤال عزلة الفلسطينيّ مقابل عزلة العالم. لم أكن مشغولة بهذه الأسئلة، لكنّها تؤكّد لي كيف أنّ الذات تتّسع لتصبح عالميّة، وأنّ الأخيرة تضيق فتصبح ذاتنا. أدركت أنّ فلسطين قد تصبح مشكلة أيّ إنسان في هذ العالم، وأنّ التناقضات في هذا المكان هي مشاكل أيّ إنسان في هذا العالم. بهذه الأفكار - وبالطبخ أيضًا - دفعت بحياتي كي تستمرّ. كان كلّ يوم يبدو غريبًا عن سابقه لكنّه يسحب لاحقه. لديّ شعور بأنّ ما أقوم به يشبه عرضًا سريعًا على خشبة مسرح، تسقط الستارة وأختفي، فأنا شخص يشكّك في الزمن وقد أختفي، ليس بفعل الموت بل الإمحاء، ووجود الآخرين ومحاكاتهم لوجودي قد يدفعني إلى مزيد من الشكّ في وجودي. التبس عندي الموضوع بين أن أضع نفسي في عزلة وبين فعل المحاكاة؛ فحيواتنا أصبحت كمَنْ يحاول أن يمسك حياة الآخر كي يتأكّد من وجوده أو وجود الآخر. قبل الأزمة كنت موجودة، لكنّ الأزمة والأعمال الّتي أنتجتها فيها كالطبخ ومراقبة الحيوانات في الخارج، أكّدت لي أنّي شخص حيّ أكثر من أي وقت مضى. أصبح على الحياة أن تؤكّد نفسها. هو أشبه باختبار في البحث ليس داخل العزلة بل لتأكيد فعل الحياة. بالمجمل، كتبت يوميّاتي عن الطعام مدّة ثلاثين يومًا، عملت على كتاب «دليل الانتباه» (كتابة ورسم)، وبحثت في المطبخ وزوايا البيت عن أشكال الكتابة والتعبير، وكنت أستدلّ من طريقة إلى أخرى، فلم أهدأ خلال هذه الفترة.
فُسْحَة: وُلِدْتِ لأمٍّ وأبٍ أُمِّيَّيْن. بيئتك ذكّرتني قليلًا ببيئتي المتواضعة. كيف صنعت منك هذه البيئة كاتبةً؟
أحلام: هي فعلًا البيئة المناسبة؛ تحدث الكتابة منها كما تصعد الأشجار وتسيل الأنهار وتمشي الحيوانات فيها بحرّيّة دون أقفاص. بيئة عاملة، كلّ شيء فيها موجود ليعمل بوظيفته. وأنا كذلك وُجِدْتُ حتّى أعمل في وظيفتي مثلها. وربّما ما جعلني أكون كاتبة أنّي أردت أن أسلّي نفسي. أتذكّر انشغالي مع أهلي في قطاف الخضراوات وأعمال الأرض، معظم الأوقات كنت أكون وحدي، كان صوتي الداخليّ عاليًا، أخترع فيه المونولوجات والقصص والحكايات لغرض التسلية. بدأت السرد الداخليّ هذا منذ أن اكتشفت صوتي واستدللت عليه. ربّما ثمّة سرد لحكاية واحدة لم تتوقّف حتّى اللحظة، كانت تتوقّف حتّى تأخذ شكلًا جديدًا وطريقة جديدة لتحكي نفسها، ثمّ تطوّرت لتحتوي على شخوص ورواة وأحداث وحبكات، امتلكتها وأدرتها ثمّ أدارت نفسها وحدها.
فُسْحَة: تقولين إنّ سردها تطوّر؛ فتقصدين نحو الكتابة، صحيح؟
أحلام: نعم. أتخيّل ذلك السرد وقد اتّخذ شكل دلو معدنيّ، سقط ذات يوم تحت أشجار الكينا في غور الفارعة في قرية الجفتلك، يوم كنّا نملأ الدلاء، وكاد الوادي يأخذ الدلو معه. كلّ ما في الأمر أنّي أردت إنقاذه. علاقتي بالكتابة تتلخّص في هذا المشهد، وفي التساؤل: ما الّذي لا يزال يجري حتّى الآن؟ وماذا لو أخذ الوادي الدلو فعلًا؟ ماذا لو استرددته؟ أتخيّل هذه الحياة الّتي تحوّلت إلى حلم طويل، وبدأت من نقطة صغيرة كنت أقف فيها على حجر في قرية الجفتلك. أفكّر كيف أنّي سأزداد طولًا وعمرًا لأكتشف أنّ السماء قريبة جدًّا من الأطراف، فألمسها وتلمسني ثمّ أحكي عن ذلك للآخرين، عن هذه التجربة اللصيقة بين المكانين، حيث رحلة الإنسان الممتدّة بينهما. ربّما هكذا أتصوّر رحلة الكتابة أيضًا. أشعر بأنّي على الدوام على خطّ التماس هذا؛ خطّ الالتصاق بين مكانين وبين قريتين عشت فيهما: الجفتلك وطمّون. عشت ما بينهما رحلة الشتاء والصيف فلّاحة مرتحلة، وما بين مكاني الشاغر بين الأثاث الفقير والحيوانات الّتي تتنقّل مثلي، لنقوم جميعًا بأدوارنا. وهكذا، أشعر بأنّ استمراري في الكتابة لا يختلف عن استمرار صوت الثغاء أو الأزيز.
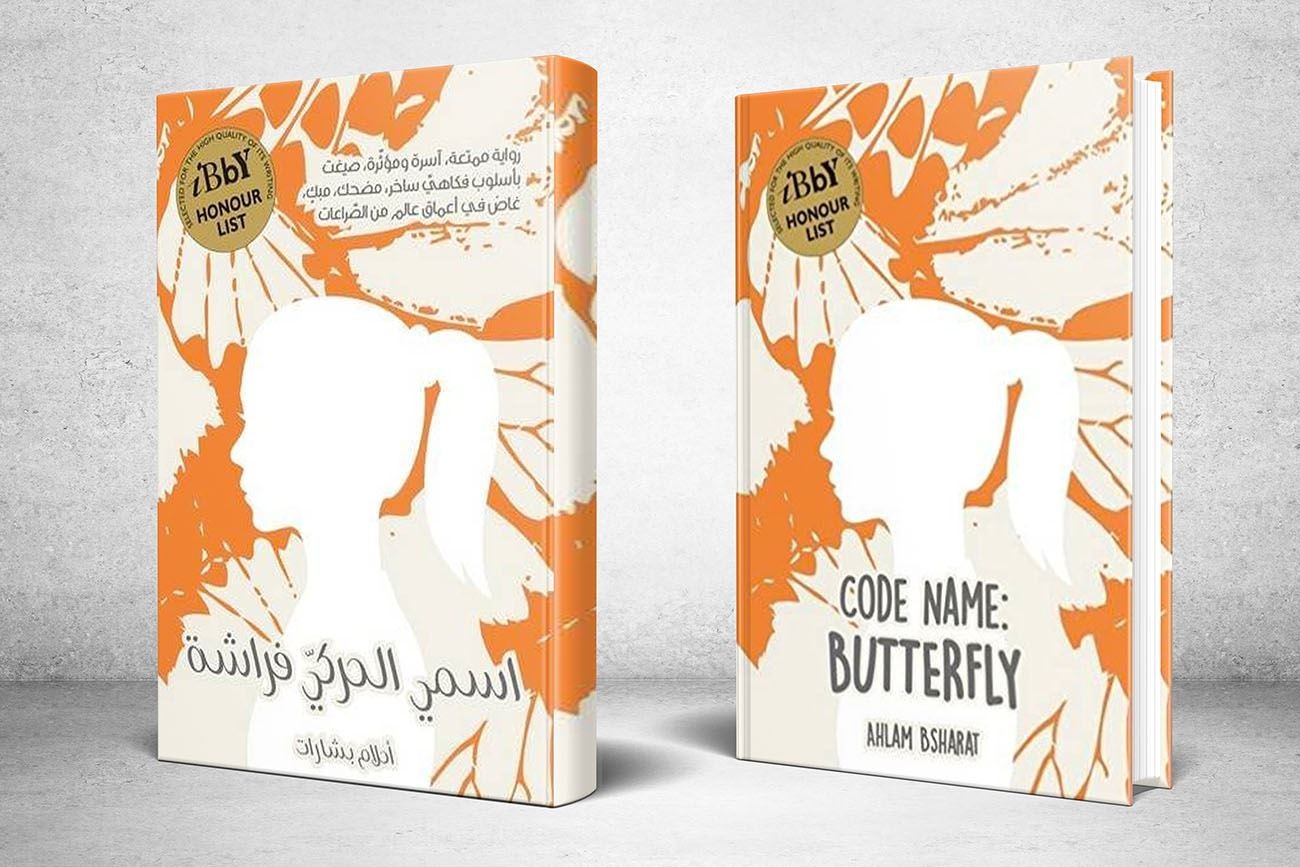
فُسْحَة: يذكّرني ذلك بقولك مرّة إنّنا نعيش كي نروي قصّتنا ونحن أطفال. يحضر مكانك الأوّل في معظم كتاباتك، السرديّة والشعريّة، كيف تنظرين إلى حضوره؟ وهل ساعدتك الكتابة في بناء هذه العلاقة؟
أحلام: أنا في الأساس أكتب تاريخي الشخصيّ، حتّى لو كتبت حكايات مخترعة بعيدة عن حكايتي. ثمّ إنّني أبحث داخل أسئلة شخصيّة، سواء تلك الّتي تعتمل داخلي، أو في المكان المجاور، أو عند ناس سمعتهم. وقد تكون أصوات خفيّة تنقل هذه الأسئلة، كائنات موجودة أو غير موجودة، ناس عرفتهم أو لمّا ألتقِ بهم بعد. بهذه الطريقة، أظنّ أنّني كوّنت لغة الشعر قبل لغة النثر، فكنت شاعرة قبل أن أكون ساردة. ربّما أؤكّد لنفسي اليوم أنّ كلّ ذلك لم يكن سوى سحر. كان ينبغي أن أسلك دربًا صغيرًا بين الحقول، فسلكت الدرب الأقصر والأضيق بينها، حتّى أذهب إلى الغاية نفسها. مشيت في هذه الدروب كطفلة، بين قريتين، بين مكانين، مكان للتعب وآخر للراحة، الأوّل البيت والثاني المدرسة. عشنا على هذه الطريق، نحاول أن نضيّع وقتنا وألّا نصل. أتوقّع أنّ اللغة ما زالت تتشكّل لديّ، سواء اتّخذت الدرب القصير أو الأقصر، الشعر أو السرد. أحبّ أن أفكّر في أنّ بإمكاني التحايل على الزمن، وقضاء وقت أطول بين المكانين دون تعب، فأكون ممتنّة لكلٍّ منهما وأنا أغادر أحدهما نحو الآخر. أقول هذا الكلام وأنا أتخيّل مسافة تكاد تُوْضَع بين الإبهام والسبّابة. ربّما هناك يكمن الشعر. أمّا النثر فهو أن تصبح الحكاية وطريقة سردها تناسب حياة إنسان ما، وقد تكون حياتي أو حكاية شخص آخر أسردها أنا، أو يعثر هو عليها، فتُنْقِذُه وتجعله يستمرّ أو ينهي حياته.
فُسْحَة: وعلى الرغم من ولادة الشعر قبل السرد، وعلى الرغم من قولك في إحدى قصائدك في مجموعة «اسم الطائر»: "وُلدت من عين الإبرة، والشعر وُلِدَ من عين الحزن، والتقينا ع ضفاف الوادي"، إلّا أنّك كنت متردّدة في شأن نشر الشعر. لماذا؟ وكيف تسلّل الشعر؟ من الحزن فعلًا؟ وهل قلتِ فيه ما لم تقوليه في السرد؟
أحلام: أرى أنّ الشعر يقدّم إجابات أكثر من السرد، ولعلّني كنت خائفة من الإجابات، خائفة من الاستدلال على الخريطة الشخصيّة. كنت أؤجّل النشر بشكل أو بآخر، فمن خلال «اسم الطائر» أدركت أنّي شخص يحاول أن يفكّ شيفرة العائلة الّتي ترعرعت فيها، الأشخاص الّذين نميت بينهم، الأصدقاء الّذين فقدتهم، الأماكن الّتي تنقّلت بينها. كنت خائفة أن أعرف كلّ هؤلاء أكثر. ربّما كنت أريد أن أعرفهم، لكنّي أدركت أنّ ذلك سيصيبني في القلب وسيصيبهم في قلوبهم. وقد ينقلنا هذا إلى الحديث عن الإحساس بأنّ الشعر قادم من الحزن. ليس بالمعنى البكائيّ أو الرثائيّ، بل الحزن الّذي يتجسّد في مسيرتي الإنسانيّة بين جبلين أو بين أرض وسماء، بين الحقيقة والخيال والوجود والإمحاء. هذا الحزن الآتي من كوننا ظلالًا، ومن كوننا عابرين وزائلين، ومن أنّنا حين نرحل سنترك لغتنا خلفنا، حزينةً، تشير إلى وجودنا، يقرؤها أناس آخرون سيستدلّون على أنّ ثمّة معامل للتعب والشقاء، وتشكّل العلاقات والفقد والصحبة، وأنّها كانت تُدار على مدار سنوات، ربّما على مدار واحد وخمسين عامًا، هو عمْر أخي الّذي توفّي، ربّما على مدار واحد وعشرين عامًا، هو عمْر بنت أختي الّتي توفّيت. سيستمرّ الحزن وسيشير إلى نفسه، ثمّة مَنْ سيتركه خلفه، ومَنْ يستدلّ عليه ويلامسه بعده عبر الشعر، عبر القصائد الّتي ستُقْرَأ بعد مئات السنين. نحن نموت داخل عائلة ممتدّة وفقيرة. كنّا ننام متلاصقين ومتلاحمين، ثمّ انفصلنا عن بعضنا بعضًا وقُطِعْنا عن بعضنا بعضًا، وسال الدم منّا جميعًا. رحل أحدنا ودُفِنَ تحت الأرض، فكأنّ أجزاء منّا دُفِنَت معه. لا يستطيع أن يحكي كلّ ذلك سوى الشعر. إنّ هذا البحث في التاريخ الشخصيّ لهو بحث في تاريخ القارئ المتوقّع والآنيّ، أكثر ممّا هو قراءة في حياة الكاتب.
فُسْحَة: وما الّذي أخذ بك إلى أدب الأطفال واليافعين؟ هل تذكرين لحظات أو فترات مفصليّة في مشروعك الكتابيّ دفعتك إلى هناك؟
أحلام: عام 2007، كنت أدرّس مادّة الأدب الفلسطينيّ لطالبات الصفّ الثاني الثانويّ العلميّ، جزء من هذه المادّة كان عبارة عن مقدّمة تاريخيّة للمادّة الأدبيّة، تسلّط الضوء على عام 1994، وهو العام الّذي كنت فيه في المرحلة الثانويّة فور دخول «السلطة» إلى فلسطين بعد «اتّفاقيّة أوسلو»، وكنت لا أزال أتذكّر المشهد بين طمّون وطوباس في فترة الامتحانات النهائيّة، أرى على مدّ بصري شاحنات تحمّل مقاتلين فلسطينيّين. حين شرحت المادّة التاريخيّة للطالبات، لاحظت أنّهنّ لم يرتجفن، لم أر في عيونهنّ ما رأيت عام 1994، لم أسمع الأسئلة الّتي سألتها وقتئذٍ؛ فشعرت بأنّ الحكايات قابلة للقصّ واللصق، يمكن ذات الحكاية أن تتمزّق أيضًا وتصبح شظايا، يمكن أيضًا تركيبها بغير طريقة واحدة. كنت في ذلك الوقت شخصًا يحاول الهرب من العبارات الجاهزة ليؤسّس عبارته الشخصيّة، واكتشافه الذاتيّ، ووعيه الشخصيّ في مسألة التربية والتعليم، مجال عملي. في تلك اللحظة، تملّكني شعور بأنّي مسؤولة عن صورة ما، صورة رأيتها ذاك العام وأنا في جيلهنّ، أريد في الأقلّ مقاربتها، إن لم أقل نقلها، لهنّ. بدأت مسارًا ما، مدفوعة بهذه المسؤوليّة. هذه المسؤوليّة أشبه بفوّهة بندقيّة، أو طائرة مسرعة نراها ونحن واقفون فوق الأرض؛ فنشعر بأنّنا لا نتحرّك.
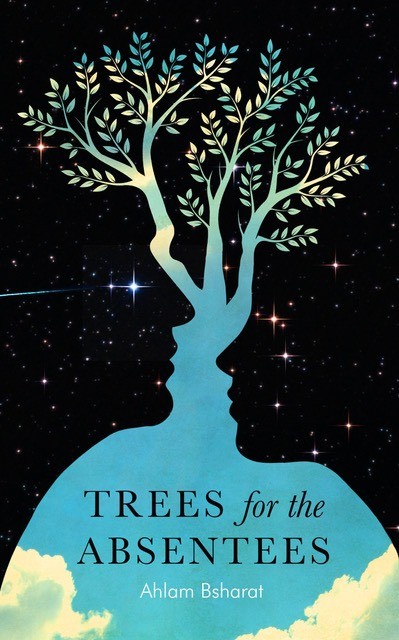
فُسْحَة: أسألك الآن كبائعة كتب سابقة، ثمّة إشكاليّة كبيرة في المجتمعات العربيّة في استهلاك أدب اليافعين، ثمّة أشخاص لا يعلمون بوجوده أصلًا. لماذا في رأيك؟ ولِمَ يضع الآباء والأمّهات جهودًا في قراءة أطفالهم، ثمّ سرعان ما ينكسر هذا العالم عند المراهقة؟
أحلام: عندما كنت يافعة، كنت أقرأ الجرائد الّتي تغلّف صناديق الخضار، لاحقًا قرأت في الصفّ العاشر في مكتبة المدرسة كتابَي «الأيّام» لطه حسين و«الأمّ» لمكسيم غوركي. في تلك الفترة، قرأت أيضًا لأحلام بشارات، الّتي كانت تسرد لي قصصًا بصوت غير مُعْلَن، ودون أن تكتب هذه القصص. قد تكون أكثر مَنْ قرأت لهم. أكتب لليافعين الآن، وأرى أحلام تجلس بينهم، فأكتب لها أيضًا، لكن بصوت مُعْلَن وكتابة موثّقة. أتخيّل أنّ هذه الطفلة، الّتي ترعرعت في الأغوار في مكان مكفهرّ في الصيف ومليء بالناموس والذباب، كانت تريد من شخص ما أن يحضنها. جوهر ما أفكّر فيه في الكتابة لليافعين توفير هذا الفضاء الحاضن والاحتوائيّ لهم، سواء من خلال الحديث معهم، أو من خلال القصص الّتي يحكونها هم عن أنفسهم سرًّا، أو الموضوعات الّتي لا يستطيعون أن يتحدّثوا فيها كالكبار، أو الأسئلة الّتي لا يمكنهم طرحها، الأخطاء الّتي يرتكبونها ويحاولون عدم ترك أيّ أثر، الأسرار الّتي يخبّئونها فلا يستطيعون جرّها إلى سنّ متقدّمة، وحين يفعلون تتحوّل إلى عملة معدنيّة غير مستعملة أشبه بعملة أهل الكهف. أسعى إلى أن أكون ذلك الشخص الّذي يقدّم لهم عملة يمكن صرفها في حياتهم الآن، والّذي يساعدهم في إنفاق كلّ ما لديهم من أسرار وأخطاء، وحكايا مكتملة وناقصة، ومخاوف ومغامرات. أحاول أن أجعل حياتهم ممكنة في هذا العالم المتخيّل، الّذي يبدو كأنّه حلم طويل سنستيقظ منه حينما نكبر. نقطع الطريق أو ضفّتَي النهر من الطفولة إلى الصبا، ولا أعرف متى يحدث ذلك، نحاول التأكّد من ذلك عبر لمس أجسادنا وهي مبلولة بماء الطفولة. أشعر بأنّي، باستمرار، أغدو وأجيء بين هاتين الضفّتين، وأجفّف نفسي يوميًّا من ماء النهر. ما الّذي سيجعلني أتخلّى عن هذا التنقّل؟ ما الّذي سيدفعني إلى الكفّ عن هذه المغامرة بين الضفّتين، والمشي فوق الحصى، واختبار مخاوف الغرق، وعن الاطمئنان بعد الوصول، وعن اكتشاف المفارقات؟ أنا أستغرب جدًّا حين يُقال لي: "أنت مشروع كاتبة رواية للكبار، ما الّذي تفعلينه هنا في عالم الأطفال واليافعين؟". ما الّذي سأفعله عندما أقيم في ضفّة دون الانتقال إلى الأخرى؟ فذلك يشكّل لديّ متعة ومغامرة دائمتين. أشعر بأنّي امتلكت أسرار الطفولة وموهبة التنقّل. أنا مدينة للطريق لأنّها سمحت لي أن أعبرها غير مرّة، وأنّ النهر ما زال يعرفني، وأنّ الضفّة لم تنكرني. عندما أنتهي من كتابة كتاب لليافعين أشعر بالحزن، كأنّي أغلق المكان على الشخصيّات، فأنا أريد أن أذهب معهم وأن نقطع النهر معًا، فينقص أطفال العالم عددًا، ويُسأل: أين ذهبوا؟ ربّما نعود مجتمعين أو فرادى، أو نعود على شكل حكايات، نختفي ونظهر. هنا تكمن عندي الكتابة.
فُسْحَة: قلتِ إنّك تقرئين للكتّاب الشباب أكثر من المكرّسين، حدّثينا عن مكتبتك، أتكوّنت في المدينة أم في القرية؟
أحلام: تشكّلت مكتبتي بعفويّة كاملة، ظلّت تتشكّل على هذا النحو لزمن طويل، في ذاك البيت الصغير حيث البنت الّتي يشغلها، أكثر ما يشغلها، ألّا تخيّب أمل العائلة، الّتي تاهت بداية الطريق، ولا سيّما حين ذهبت إلى الجامعة. لم تكن أخوات أو قريبات أكبر منها ذهبن إلى الجامعة قبلها. بدأت أتشكّل معرفيًّا، بعيدًا عن مونولوجاتي ولغتي الذاتيّة وعوالمي الفطريّة، ذهبت في طريق غريب تخلّى فيه عنّي مَنْ سبقني من إخواني الذكور. ذهبت مدفوعةً برغبة البنت الّتي تريد تسهيل الطريق لمَنْ سيأتي بعدها. معظم قراءاتي كان في مكتبة «جامعة النجاح»، مكتبة قديمة وجميلة معلّقة على كتف الجامعة. أتذكّر قراءتي لجبرا إبراهيم جبرا، لم أستعر الكتاب، بل كنت أذهب إلى المكتبة، المكان الّذي شكّل عندي اكتشافًا جديدًا، وهو عالم القراءة داخل المكتبة، عبر إكمال قصّة لشخصيّات أتركها فيها وأعود إلى البيت. أمّا مكتبتي في البيت فتشكّلت حين قرّرت أن أعود إليه في يوم من الأيّام بكتاب، عدت برواية «السفينة» وشخصيّاتها. تشكّلت مكتبتي من تعلّقي بهم، ومن أنّي لا أريد تركهم وحدهم، قبل أن يكون التعلّق بالكتاب نفسه، فاجتمعوا في مكتبتي قبل أن يجتمع المؤلّفون. لذلك، فأنا استكملت علاقتي بالكتاب على نحو احتفالي بالعوالم الّتي أحبّها. بدأت بالتعرّف إلى ميلان كونديرا فأُغرمت بشخصيّاته ولغته وصوته، صرت أعود إلى البيت بالشخصيّات والأصوات، ثمّ الكتاب. ثمّ جاءت مرحلة انتقالي بحياتي الخاصّة بعيدًا عن العائلة. استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الكتب في مرمى أيدي العائلة الممتدّة. أذكر الرفوف الخضراء الّتي وضعت فوقها أوّل محاولة لكتابة رواية، فاجتمع دخولي إلى المكتبة ووجود هذا الدفتر مع خروج أبي الغاضب، بعد أن قرأ محاولاتي لكتابة صوتي الخفيّ، الّذي لم يظهر إلّا على شكل مشاكسات ومحاولة لتأليف حكايات كاذبة. لكن فجأة أصبح لهذا الصوت دليل؛ بنت صغيرة في الانتفاضة الأولى تكتب عن فلسطين وعن جنود الاحتلال. كان إخوتي مطارَدين، وكان أبي - شأنه شأن أيّ والد - يخاف على أولاده وقد شعر بالخطر. وعندما يشعر بالخطر والغضب كان يترك لنا البحث عن طريقة للتعامل مع هذه المشاعر؛ فما كان منّي إلّا أن حملت هذا الدفتر، وذهبت إلى مكان خلف البيت، وأحرقته. تلك كانت طريقتي البدائيّة كي أعالج الغضب والخطر؛ بالنار.

فُسْحَة: أفكّر في العوالم الكثيرة الّتي تعمل ضدّ كلّ هذا؛ التكنولوجيا والعالم السريع والشرّ والحروب. كيف تتعايشين مع هذا الواقع؟ وكيف تجدين طريقك معه؟
أحلام: أظنّ في بعض الأحيان أنّي أسّست بعض الإجابات الخاصّة بي إزاء هذا الواقع الموحش، وعلى الرغم من أنّها غير نهائيّة، إلّا أنّها تظلّ إجاباتي المنحوتة والمصنوعة بيديّ، عليها بصمتي الشخصيّة وسخونة جسدي. أنا شخص ينحت إجاباته ويقطفها بعد انتظار. مهما كانت طبيعتها لكن لا يمكن بيعها في السوق، تظلّ خضاري وزرعي وإجاباتي الخاصّة. بالتالي، حتّى لو كانت عجراء وغير ناضجة ليراها الآخرون، أستطيع أنا أن أصنع منها طعامي لآكله. أتذكّر طعم الموالح اللذيذة في طفولتي، تعلّمت أنّ الخضار غير الناضجة يمكن أن تؤكل أو تُخَلَّل وتكون لذيذة. لا أريد أن أتّهم إجاباتي بالنصّ. أريد أن أصفها بذلك، فالإجابات الناقصة كافية كي نرتاح. ربّما ثمّة أشخاص يبحثون عن الخضار الناضجة، فيجدونها ويطبخونها ذات مساء ويشعرون بالفرح. أمّا أنا، الشاعرة، فلا أريد أن أفرح ذلك المساء، أريد أن أبحث عن الفرح. والتأسيس لفكرة البحث أمر قديم، وامتداد للطفلة في داخلي، الّتي كانت تجد طمأنينتها في بحثها وأمانها في مونولوجاتها الداخليّة. أختفي في ذلك العالم عندما أودّ أن أشعر بالطمأنينة، فأبحث عن المزيد من الأسئلة، والأفكار الجديدة، والكتابة ثمّ الكتابة ثمّ الكتابة، أكون فيه طافية وغير موجودة في هذا العالم الواقعيّ. لا أتخيّل نفسي إلّا كاتبة، وأستغرب من الناس الّذين لا يكتبون، ماذا يفعل هؤلاء في حياتهم؟ هل يكتفون بالخضار الناضجة وطهيها وأكلها على العشاء؟

شاعرة وصحافيّة. حاصلة على البكالوريوس في الصحافة والأدب الإنجليزيّ من جامعة حيفا. لها ثلاث مجموعات شعريّة؛ "ليوا" (2010)، و"كما ولدتني اللدّيّة" (2015)، و"لا تصدّقوني إن حدّثتكم عن الحرب" (2019). تشارك في أنطولوجيّات ومهرجانات شعريّة في العالم. تُرجمت قصائدها إلى لغات عدّة. عملت لسنوات في الصحافة المكتوبة وفي التلفزة. تدير حاليًّا "فناء الشعر"، وهي مبادرة مستقلّة أسّستها عام 2017. تكتب في عدد من المنابر العربيّة.







