أن تكون باحثًا فلسطينيًّا في جامعة إسرائيليّة

أن تكتب دكتوراه وأمامك خيول بيضاء
كتابة رسالة دكتوراه رحلة ومشروع حياة. في هذه الرحلة، كثيرًا ما تتكاثر عليك في شِعابها مشاعر الوحدة والعزلة، وكثيرًا ما تفرض عليك على مفترقاتها خيارات معرفيّة ومهنيّة ومجتمعيّة. في هذا المشروع، كثيرًا ما تبحث عن الفرادة والتجديد فلا تجدهما، وكثيرًا ما تهجس بأهمّيّة مشروعك وجدواه سائلًا: لمن ولماذا أكتب؟ وفي هذا وتلك، تقرأ، وتكتب، وتبحث، وتحاول نزع غلائل السحر، على حدّ تعبير عالـم الاجتماع ماكس فيبر، عن موضوع بحثك، سعيًا لدراسته بعقلانيّة ومهنيّة وموضوعيّة، بعيدًا عن سببيّة الغيب وأهواء الذات وتقلّباتها.
لكن في هذه المحاولة إعادة للسحر، كما فيها من نزع له، ولا سيّما عندما تُحصر هذه المحاولة ضمن تخصّصات أكاديميّة ضيّقة وأطر معرفيّة محدودة، تعيق رؤية موضوع الدراسة والبحث بشموليّة، وتضيّع صورة “الكلّ” بالتركيز على توضيح “الجزء”.
هكذا تصبح الغابة مجرّد أشجار متجاورة، والحقيقة مجرّد تفاصيل متعالقة، وفلسطين مجرّد ذكريات وتوقّعات. تصبح فلسطين سياقًا لما قبل، أو بعد، أو ضمن 48، أو 67، أو 94، أو 2000، أو الحاجز، أو المدرسة، أو السياسة، أو النجمة، أو التفكير الذي يمليه الحنين أو تحدّده الرغبة.
لكن، قد يحدث ذات مرّة، وقبل أن تنام وأن تعدّ مقالاتك في المجلّات المحكّمة كي تتأكّد من أهليّتك للدرجة العلميّة القادمة، أن تقرأ صفحات من رواية إبراهيم نصر الله "زمن الخيول البيضاء"، أو من رواية رضوى عاشور "الطنطوريّة"، فيصيبك الأرق وتتمنّع عليك شاشة الحاسوب في الصباح التالي.

هل بإمكانك أن تكتب بعد هذه الليلة بحثًا عن التعليم، أو العنف، أو الصحّة، أو القانون، من دون التعالي والتعامي عن التاريخ الفلسطينيّ المنكر، والجغرافيا الفلسطينيّة الممزّقة، والسياسة الفلسطينيّة المنقسمة، والخصوصيّات الثقافيّة، والدينيّة، والجهويّة المنكفئة على نفسها؟ هل بإمكانك أن تكتب “بتجرّد” وَ ”مهنيّة” وكأنّه لا صوت لك ولا هواجس، وكأنّه لم تصحب “الطنطوريّة” في رحلتها، ولم يملأ قلبك صهيل الخيول البيضاء؟ كيف يمكنك أن تكون باحثًا فلسطينيًّا في جامعة إسرائيليّة؟ إلى أيّ حدّ ستتنازل عن صهيلك أنت؟ إلى أيّ حدّ تستطيع أن تقهر نفسك؟
عن “المجمّد” وَ “الطازج” في الكتابة الأكاديميّة
يقف الكثير من طلبة الدكتوراه والباحثين الفلسطينيّين بعامّة، أمام مسألة الهويّة الفلسطينيّة بوصفها مشكلة بحثيّة تستحقّ الدراسة، أو بوصفها نزعة قد تؤثّر في حياديّتهم وموضوعيّتهم. يقفون ويكتبون ويعرضون أبحاثهم بالعبريّة، من دون أن تُتاح لهم الفرصة لأن يتواصلوا بلغتهم الأمّ، معرفيًّا ووجدانيًّا، مع محيطهم الطبيعيّ، ومع فئاتهم المستهدفة في البحث. يكتبون ونكتب، ونلبّي في ذلك أحيانًا حاجة مشرفي الأبحاث والزملاء اليهود في التلصّص الأكاديميّ على حيوات الفلسطينيّين ومعاشهم وذاكرتهم، تحت شعار “معرفة الآخر”. ومن المفارقات أن نُحرم في ذلك حتّى من “حقّنا” “بالفتنة بالمنتصر”، بدراسته، وفهمه، والاشتباك معرفيًّا معه، ويُفرض علينا “الافتتان بالمنتصَر عليه”، باختراقه ومَوْضَعته موضوعًا للبحث، وسلبه أصلانيّته وتطبيع قهره. حدود الفتنة بالمنتصِر ليست أبعد من تعلّم العبريّة، بصفتها لغة تعبّر بها عن نفسك حتّى أمام نفسك، وتدرس بها واقعك، وتصوغ عبرها خيالك. تبقيك العبريّة خارجها، إلّا في ما ندر من اختراقات فرديّة هنا أو هناك.
يكتبون ويحقّقون نجاحات وإنجازات شخصيّة، لكن من دون أن يعوا لأنفسهم دورًا في الحقل الثقافيّ الفلسطينيّ، في صناعة الهويّة الفلسطينيّة المشتركة، وفي إعادة امتلاك فلسطين بصفتها وعيًا ومخيّلة لكلّ الفلسطينيّين أينما كانوا. يكتبون بتوتّر ما بين الرغبة بدراسة الواقع بموضوعيّة، والرغبة بتقديم هذا الواقع من خلال التأكيد على خصوصيّة السياق الفلسطينيّ، وما بين موضوع البحث وذاتيّة الباحث. هذا التوتّر كثيرًا ما يملي على الباحث أو الباحثة كتابة تؤكّد بإفراط، أو تنفي بتفريط، فلسطينيّته ووطنيّته، وهذا الأخير هو الغالب و ”مستقرّ العادة”، على حدّ تعبير ابن خلدون.
هذا التوتّر في صلبه توتّر بين نوعين من الكتابة: كتابة التمثّل والقبول والاستيعاب، مقابل كتابة الرفض والتحرّر والتجديد. في الكتابة الأولى، نشرح ونلخّص ونحلّل، نعيد إنتاج المعرفة السابقة بكثير من الانبهار، وفي الكتابة الثانية نجدّد ونبدع ونحاور ونتجاوز. وعلى حدّ تعبير الفيلسوف المصريّ حسن حنفي، الكتابة الأولى قيدٌ، والكتابة الثانية تَحَرُّر. الكتابتان الأولى والثانية، ضروريّتان ومطلوبتان طبعًا، بما تقتضيانه من انفتاح حذِر على المعرفة الوافدة والتطلّع لمعرفة جديدة ومتفلّتة. من المهمّ أن ندمج بين الكتابة التي نطهو بها كتابة سابقة و"مجمّدة"، والكتابة “النيّئة” و"الطازجة" التي نلتحم بها مباشرة بالواقع دون نصّ يحجبه.
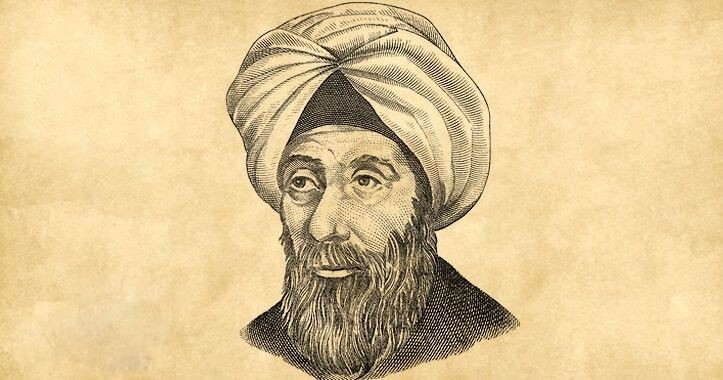
وعليه، حين نستبق القارئ بالقول إنّنا نتبنّى منظور دراسات ما بعد الاستعمار في الحالة الفلسطينيّة، وإنّنا نرى إسرائيل حالةَ استعمار استيطانيّ، ينبغي أن نكون حذرين من تقديم "لقمة" كتابةٍ مضغها الآخرون، بدلًا من لقمة ساخنة نأخذها مباشرة من يد الواقع. أسوق ذلك لأنّ الكثيرين ممّن يتبنّون هذا المنظور يتبنّونه موقفًا معياريًّا وقيميًّا، لا أداة للتحليل ولإعادة تركيب إحداثيّاته على نحو نقديّ. في هذا الموقف، كثيرًا ما نجد تبعيّة واستعادة لنصوص سابقة من قبيل ما يقول إدوارد سعيد، أو يدّعي نديم روحانا، أو غيرهما، دون أن تنعكس المقولات والادّعاءات في التحليل، أو أن يجري نقدها "والنزول بها إلى الشارع".
وبذلك، تصبح كتابة الإطار النظريّ للاستعمار الاستيطانيّ كتابة تحلّق فوق الواقع من دون أن تلامسه، كتابة "لا تؤثّر في الواقع ولا تحرّكه، بل تكون عبئًا عليه وستارًا يحجب رؤيته"، كما يقول حسن حنفي. أقول هذا للتأكيد على أهمّيّة التعاطي مع المنظور المذكور لا بصفته موقفًا قيميًّا فحسب، بل أداة تحليل كذلك.
عن النباهة والاستحمار
يقصّ المفكّر الإيرانيّ علي شريعتي، في معرض حديثه عن النباهة والاستحمار، حادثة زواج جعفر البرمكيّ بالعبّاسة أخت الخليفة هارون الرشيد،[1] فيقول: “أُقيمت وليمة الزفاف وطُبِخ من الطعام ما يخرجون باقيه من بغداد عدّة أيّام، حتّى تجمّع جبل من الطعام خارج المدينة. وبعد أن تغذّت منه الطيور والحيوانات أيّامًا، تعفّن، فأخذ يهدّد صحّة الناس وسلامتهم، ممّا اضطرّهم إلى استئجار جماعة لإبعاده عن المدينة”. يعرض شريعتي القصّة ليتساءل عن سبب عدم احتجاج أحد على هذا الإسراف والترف، “لا عالم ولا فقيه، ولا شاعر ولا نبيه، ولا غير نبيه، ولا فيلسوف، ولا إمام ولا !”.
ويستنتج شريعتي أنّ غياب “الدراية المجتمعيّة”، أو النباهة المجتمعيّة كما يسمّيها في مواضع أخرى، سبب هذا التواطؤ وهذه الحال من انعدام شعور المجتمع البغداديّ بمصيره الاجتماعيّ. هذا المجتمع، الذي وصلت فيه النباهة الشخصيّة أعلى الذروات في الفلسفة، والفنون، وعلوم الدنيا والدين، كانت فيه النباهة المجتمعيّة في الحضيض: “شعور الفرد بمرحلة المصير التاريخيّ والاجتماعيّ للمجتمع، وعلاقته بالمجتمع، المقدّرات الراهنة بالنسبة إليه وإلى مجتمعه، وعلاقته المتقابلة بأبناء شعبه وأمّته، والشعور بمسؤوليّته رائدًا وقائدًا في الطليعة، من أجل الهداية والقيادة والتحرير”.[2] في نظر لشريعتي، كان ذلك الجبل من العفن، والبذخ، والصمت مؤشّرًا مبكرًا لسقوط بغداد بعد قرابة أربعة قرون.
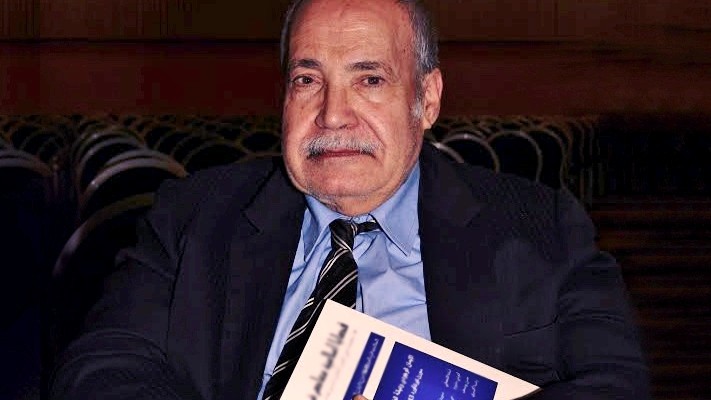
قد يكون في ذلك شيء من المبالغة؛ لا ريب في ذلك. لكن التمييز الذي يقيمه شريعتي بين النباهة الشخصيّة والنباهة المجتمعيّة يستحقّ التوقّف عنده، ولا سيّما في معرض تقديمنا لهذا العدد الخاصّ من "جدل"، الذي نعرض فيه بواكير أبحاث لطلبة دكتوراه فلسطينيّين. فهذا العدد يضمّ مجموعة أبحاث تدلّ على النباهة الشخصيّة والقدرة الفرديّة على النجاح على الرغم من الظروف، لا بسببها، وأعني ظروف التعليم العربيّ، أينما وُجدت أطره، التي قلّما تشجّع المرء على البحث، والتبصّر، واتّخاذ مواقف تجاه قضايا التحرّر والعدل. هذه الأطر ف تنتج معرفة لكنّها تنتج أيضًا، كما هي حال الجامعات الإسرائيليّة ذاتها، جهلًا، أو، توخّيًا للدقّة العلْميّة، نُظُمًا للجهل (Regimes of ignorance) فيها عدم المعرفة بالنتاج الفلسفيّ العربيّ مثلًا، يصبح ادّعاء لتدعيم “حداثة“ البحث وأهمّيّته، ويصبح إنكار التاريخ والجهل به فرصة لتسويق مقولات الحداثة والتنوير الإسرائيليّة، ويصبح التخصّص المهنيّ إسهامًا في الانكفاء على الذات، وطرد السياسة والهويّة من مقتضيات المهنيّة.
في هذا العدد، تستعرض مجموعة من الطلبة مواضيع تهمّهم، وأسئلة بحثيّة تشغلهم، وإجابات ممكنة خلصوا إليها. لكن يبقى السؤال: إلى أيّ مدى تعكس هذه الاجتهادات “نباهة مجتمعيّة”، وهل من سبيل إلى تدعيم هذه النباهة واستثارتها؟
الهابيتوس الجامعيّ الإسرائيليّ
يبدو السؤال السابق ذا وجاهة واستحقاق في سياقات اكتساب وإنتاج المعرفة بين أظهر الفلسطينيّين والفلسطينيّات بعامّة، وفي إسرائيل بخاصّة، حيث تأثير المؤسّسة الإسرائيليّة في منظومة التعليم العالي أشدّ أثرًا وأكثر مباشرة في تكريس ممارسات المحو، والإنكار، والعنصريّة، والإقصاء، والفصل، بوصفها أعمالًا طبيعيّة ونتاجًا ضروريًّا لسيرورات بناء الأمّة والهويّة. هذا التأثير يتعدّى إنتاج ونشر السرديّات التي تدعم الرواية التي تقدّمها الحركة الصهيونيّة عن ماضيها ومستقبلها، إلى إنتاج منظومة معرفيّة تعزّز حراك الصهيونيّة التوسّعيّ، وتسوّغه عبر ادّعاءات بشأن حقوق أخلاقيّة ودينيّة لليهود في فلسطين، وأخرى عن نشر توطين الحداثة والتقدّم والتنوير فيها.
من نافل القول، إنّ المشكلة في تعاطي الجامعات مع هذه الادّعاءات، وبخاصّة في المواضيع ذات الصلة ببناء الهويّات القوميّة، والدينيّة، والثقافيّة، في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، مع ما في هذه المقولة من وفرة التعميم والتبسيط، يجري من منطلقات خارج التاريخ، وخارج أيّ إمكانيّة لنقدها وللسجال الديمقراطيّ والتحرّريّ بشأنها.

المشكلة في هذا ليست شرعيّة الادّعاءات في حدّ ذاتها، بل في استحالة الاشتباك معها من دون وصم هذا الاشتباك بالتطرّف والكراهيَة لإسرائيل ولليهود، أو من دون حصره في أقسام جامعيّة، ومراكز بحثيّة، ومساقات تدريسيّة يجري تهميشها والضغط عليها لتنكفئ على ذاتها من دون وجود أيّ إمكانيّة للتأثير في جهاز التربية والتعليم، مثلًا، أو في البحث والتدريس في الأقسام والمساقات الأخرى. هذا الضغط المتواصل لا يبقي التيّار النقديّ في الجامعات الإسرائيليّة هامشيًّا فحسب، بل يتركه في حالة توق للتواصل مع المركز الصهيونيّ الذي به يُعاد ترسيم حدود الجماعة حسب مصالح حركة الاستيطان والتيّار الصهيونيّ المتديّن. حالة التوق هذه والبحث عن الشرعيّة الصهيونيّة تبقي هذا التيّار "ما بعد صهيونيّ" في أحسن حالاته، وغير قادر على تجاوز ذاته إلى نقد بإمكانه الاشتباك مع طبيعة الصهيونيّة.
وعلى الجملة، يسعى الهابيتوس الجامعيّ الإسرائيليّ، بتوقّعاته وممارساته، إلى بناء علاقة ترابيّة بين اليهوديّ والفلسطينيّ، وإضفاء الشرعيّة عليها، بوصف الأوّل صاحب حقوق تاريخيّة، وذا قيمة إنسانيّة أكبر وعطاء حضاريّ أغنى، وبوصف الأخير صاحب حقوق مدنيّة مجزوءة ومشترطة، وذا قابليّة للتطوّر والمشاركة في مشروع النجاح والتقدّم الإسرائيليّ (وهذا في الحدّ الأقصى).
عند هذا الحدّ، يستطيع الفلسطينيّ أن يقف بصفته طالب دكتوراه، أو محاضرًا جامعيًّا، أو باحثًا أكاديميًّا، ما دامت قدرته على خلخلة وتحدّي النظام المعرفيّ الذي تطرحه الجامعة الإسرائيليّة في حدّها الأدنى، وهو الحدّ الذي تتيح فيه الجامعة له أن يكون فلسطينيًّا، إذا أصرّ على ذلك، ونقديًّا، إذا فهم معنى ذلك، وتحريريًّا، إذا تبقّى له وقت بعد كلّ مهمّات الكتابة والنشر في مجلّات قلّ من يقرؤونها من غير المتخصّصين. ضمن الهامش الذي يؤكّد أنّ المركز بخير، يقف الفلسطينيّ، إلّا في ما ندر، مرغمًا على بحث التعليم، أو الصحّة، أو القانون، أو حتّى تاريخه وجغرافيّته، بمعزل عن فلسطينيّته وما لحق بها من قمع ونتج عنها من تمرّد، وبعيدًا عن نظريّات ما بعد كلّ شيء؛ ما بعد الاستعمار، وما بعد الاستيطان، وما بعد الهويّة. يقف الفلسطينيّ أو الفلسطينيّة مضطّرًّا إلى أن يكون أكاديميًّا متخصّصًا وحِرفيًّا، يدرس واقعه بتجرّد مصطنع، وبموضوعيّة زائفة، أو يدرس واقع غيره، محاولًا ألّا يشي ذاك بهويّته.
فضاءات ومفازات
من هنا، جاء برنامج "مدى الكرمل" لدعم طلاب الدكتوراه الفلسطينيّين، لا محاولة للتأكيد على أنّ الذات الفلسطينيّة ما زالت قادرة على التجدّد معرفيًّا، وعلى التعاطي مع همومها وتحدّياتها بأدوات العلم وباللغة العربيّة فحسب، إنّما لتقديم الفرصة للباحثين الواعدين أيضًا، لتطوير منظور نقديّ تجاه مشاريعهم والتبصّر بأهمّيّتها، وراهنيّتها، وصلتها بواقع الفلسطينيّين، وتاريخهم، ودوائر القمع، والإلغاء، والسيطرة، والرقابة، والضبط التي تحيط بوجودهم.

وبالعودة لشريعتي الذي يحذّر من محاولات كلّ ذي سلطة استغلال، أو استعمار، أو استبداد، أو استعباد، من محاولة تزييف وعي الانسان وحرف مساره عن “النباهة المجتمعيّة” النقديّة والمسائلة، من الصعب مقاومة هذه المحاولات وحيدًا، ومن الصعب تحدّيها في سياق الجامعة الإسرائيليّة. لذا، من المهمّ المبادرة إلى مراكز بحثيّة عربيّة. ومن الأهمّ إقامة هذه المراكز لا استنساخًا للجامعة الإسرائيليّة، بل فضاءات للمقاومة، الممانعة معرفيًّا. فضاءات لدراسة ما هو يوميّ ومعيش، وما هو مهمَل ومهمّش، وما هو غير مُفَكَّر فيه وغير مُتَلَفَّظ به في الجامعة الإسرائيليّة، مفازات لاستكشاف مناطق بحثيّة جديدة في تاريخ الفلسطينيّين والفلسطينيّات وتطوّر هويّاتهم، وكيفيّة انفتاح حيواتهم على الثابت، والمتحوّل، والدائم، والطارئ، والمقدَّس، والمدنَّس، والقمع، والمقاومة. من هنا أهمّيّة “مدى الكرمل” و“جدل” بصفتهما مشاريع تقاوَم عبرها آليّات الاستحمار، وهي الإلهاء والتجهيل.
..............................
[1] علي شريعتي. 2004. النباهة والاستحمار. بيروت، دار الأمير. ص: 106.
[2] المصدر نفسه، ص: 90.
[3] تُنشر هذه المقالة بالتزامن مع مجلّة "جدل" الصادرة عن "مدى الكرمل: المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة".

حاصل على الدكتوراه من جامعة بنسيلفانيا. محاضر في كلّيّة التربية - جامعة حيفا، ومدير سمينار طلبة الدكتوراه في "مدى الكرمل: المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة".








